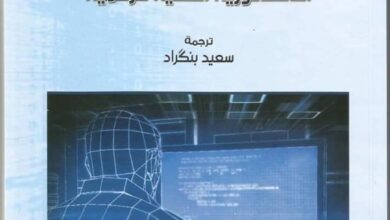ذكرى بول ريكور .. من أجل ذاكرة عادلة

- الضحك والقلب والتفلسف
من أهم سمات هذا الفيلسوف حرصه على وضع بناء فلسفي متسلسل، أي أنك تجد الكتاب الواحد يبدأ بمحاضرة جامعية، وسرعان ما يتحوّل إلى مجلّد ضخم، وهذا الأمر في حدّ ذاته يلخص فلسفة الإرادة، التي من خلالها استبدل مقولة ديكارت الشهير “أنا أفكّر إذن أنا موجود”، بالقول “أنا أريد إذن أنا أكون”. فكتاب “سيرة الاعتراف” هو في الأصل نتاج ثلاث محاضرات كان قد قدّمها بمعهد علوم الإنسان بفيينّا، ثم قام بمراجعتها وتقديمها من جديد بمركز أرشيفات هوسّرل بفرايبورغ.
إذًا، منهجية العمل هذه: المراجعة، الإغناء ثم التوثيق، هي التي تقف وراء التركيب الثري الذي تتميز به كل مؤلّفاته. ودعما لهذه الملاحظة نذكر نفس موقف جان غروندان في الفصل المعنون “فلسفة قُدُرات الإرادة ومواطن عجزها” من كتابه “بول ريكور”، حيث استهلّ الفصل بالحديث عن المسودّات الأولى من كتاب ريكور “فلسفة الإرادة” التي تعود إلى عام 1933، وهي موجودة بالأرشيف المحفوظ في موقع صندوق ريكور Ricoeur .
وجدير بالذكر أن كتابًا آخر لفيلسوفنا لم يُكتَب له الظهور، وجان غروندان يؤكد في كتابه المذكور أن عنوانه كان ينبغي أن يكون “شاعرية الإرادة”، وهو المجلّد الثالث لجزأين آخرين هما: “الإنسان الخطّاء” و”رمزية الشّر”. ورغم أن الجزء الثالث لم يظهر، إلا أن روحه وأجزاء منه ظلت موجودة في كل أعمال ريكور اللاحقة، عبر الاستعارة والاستدعاء والسرد والخيال.
- الإرادة والتأويل
كل دارسي ريكور طرحوا هذا السؤال: متى ولماذا تخلّى ريكور عن مسار فلسفة الإرادة؟ فكان الجواب مركّزًا على الانعطافة الهيرمينوطيقية التي حدثت سنة 1960، السنة التي بعدها توجّه نحو تعميق موضوع التأويل “وصراع التأويلات”، دون أن يعني ذلك تخليه كليا عن مشروع فلسفة الإرادة. ذلك أنه في سنة 1969 قدّم مشروعه لمنصب في الكوليج دي فرانس، وأكّد أن ذلك المشروع كان دومًا “ضمن فلسفة الإرادة” التي هي الخيط الموجّه لكل منشوراته. فالمفكرون والأدباء لا يتنكّرون أبدًا لنقطة انطلاقهم، فالبداية مستقبل، كما قال هايدغر.
تقوم تأويلية ريكور على مرتكزين؛ التأويلية التي تستخلص المعنى، و”التأويلية التي تُقيم مسافة مع تجربة المعنى المباشرة من أجل إيصاله إلى تدبير أكثر سرية” (ج. غروندان، التأويلية). وقد عمّق هذا المسار التأويلي في ثلاثة كتب أساسية: 1- فلسفة الإرادة (1950-1960)، 2- التأويل (1965)، 3- صراع التأويلات (1969).
وقد لاحظ دارسو ريكور أنه مع هذه الكتب الثلاثة استقلّ بنفسه، خصوصًا عن غادامير، أو على الأقل لم يعد هناك ظهور واضح لفكر هذا الأخير، رغم أن كلاهما، ريكور وغادامير، استقيا من التراث التأويلي نفسه. مع ضرورة إثارة الانتباه إلى أن تأويلية الثاني أثارت نقاشًا تأويليًا فاق ما أثارته نظرية ريكور (ج. غ)، ربما لانتظامها أكثر، في حين كانت نظرية ريكور أكثر تعقيدًا واستفادة من حقول عدة: فلسفة الوجود، نظرية المعرفة التاريخية، تأويل التوراة، التحليل النفسي، النظرية اللسانية، نظرية الفعل، ظاهراتية الزمان، الذاكرة والمعرفة، نظرية السرد والأخلاق. وكل كتاب تناول هذه القضايا كان يتطلّب القيام بمصالحات بين مقاربات مختلفة.
- رفض الموضات الفلسفية الفرنسية
كانت باريس، في الستينيات والسبعينيات، موطن التيارات والموضات الفلسفية الجديدة. وقد رفض ريكور كل المدارس الجديدة آنذاك، وانتقدها بشدة معتبرًا إياها أنها كانت تمارس إرهابًا فكريًا. “فكلّ شيء أصبح فيها بنيويًا من الأنثروبولوجيا إلى اللسانيات إلى الفرويدية إلى الماركسية.” (ج. زيناتي). وقد حاول أن يقف ضدّ التيار، فانتُخب عميدًا لجامعة باريس العاشرة، إلا أن عمادته انتهت سريعا. فترك فرنسا، بعد أن كاد يشكّل التهديد الوحيد المتماسك للبنيوية.
مع صدور كتاب “الاستعارة الحيّة” سنة 1975، والذي ضمّ سبع دراسات، “بعضها يضمّ دراسات صعبة وجافة ” حسب ج. غروندان، كان ريكور قد أراد الرد على البنيوية واللسانيات. وقد حاول فيه تبيين فيه أن البلاغة تنظر إلى الاستعارة باعتبارها كلمة مرجعيتها هي المعنى الأصلي، غير أن المعنى لا معنى له إلا في الجملة كاملة.
وذلك هو الحدّ الأدنى. كما أن الجملة بدورها هي مقطع من خطاب، وهنا نحن أمام عالم التأويل للوصول إلى الواقع أو العالم الذي يروم الشاعر أو الأديب صياغته. وقد عملت هذه النظرية الجديدة في البلاغة، وفي التأويل، على تأكيد أفكار ثاقبة، ستعيش في الزمن لمدد طويلة؛ أليس ريكور هو الفيلسوف الذي لم يتوقّف عن التفكير في التمييز بين زمن الكتابة، الذي ينتمي إلى الزمن الفاني في الحياة الفردية، وبين زمن النشر، الذي يفتح زمن العمل على “ديمومة تتجاهل الموت”، حسب تعبير أولييه أبيل في مقدمة كتاب ريكور الأخير، الذي صدر بعد موته: “الحياة حتى الموت” (سوي، 2007).
- سفينة شراعية ثلاثية
ما ينتجه ريكور من تأمل فكري يكون دومًا غير متوقّع. وقد أشرنا إلى أن باريس لم تكن تتوقّع منه أن يقف ضدّ البنيوية. والهدية الأخيرة غير المتوقعة كانت كتابه “الذاكرة، التاريخ، النسيان” الذي صدر سنة 2000 عن دار سوي الفرنسية.
غير متوقع هذا الكتاب لأن ريكو حين نشره كان قد جاوز الخامسة والثمانين واعتقد البعض أنه لم قادرًا على تقديم مصنّف فكري بهذه الضخامة والثراء. فهو نفسه سماه “سفينة شراعية ثلاثية”، إذ وضعه مقسّمًا إلى ثلاثة أجزاء مخصّصة لفينومينولوجيا الذاكرة، وإبيستيمولوجيا المعرفة.
وقد كان شديد التواضع حين اعترف في مقدمة كتابه بأنه يعكس ارتياده لأعمال وحلقات ومؤتمرات تدخل فيها مؤرخون محترفون واجهوا المشاكل عينها المتعلّقة بالصلات بين الذاكرة وبين التاريخ. كما أشار إلى أنه تناولٌ وتصحيح لسوء استعمال الذاكرة وسوء استعمال النسيان، فدعا بوضوح إلى ضرورة التفكير في سياسة قائمة على ذاكرة عادلة.
المصدر : ضفة ثالثة