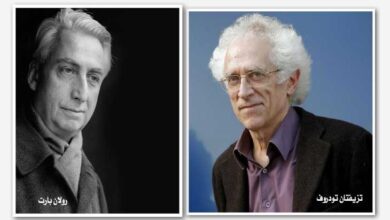الزمن والفضاء الافتراضي

تتميز التجربة الإنسانية بطابعها الزمني الخالص، فليست حياة الفرد والجماعة والأمة كلها سوى تصريف لكم زمني لا أحد يعرف حصته الحقيقية منه. ومع ذلك، فإن الزمن ذاته هو إفراز لِحِس ثقافي، وليس معطى سابقا مودعا في الذاكرة البكر.
فنحن لا نُدرك وجوده إلا عندما يتحول إلى “قيمة استعمالية” يحاصرنا بما أُنجِز أو بما هو موضوع للإنجاز داخله؛ وبدون هذه القيمة، فإنه لن يكون سوى سديم يمتصه الانفعال العابر في تفاصيل الوجود.
وذاك ما تُشير إليه إيقاعاته، فالزمن في البوادي النائية وفي الصحاري وعند البدائيين قبلهم كان يتسع لكل شيء، بما فيها حالات “الفراغ” التي لم يكن الناس يعرفون كيف يملئونها بفعل يتخذ الزمن داخله “شكلا”.
إنه بذلك، لا يمكن أن يوجد إلا في حالات “الإكراه” وحدها، أما خارجها، فهو “لحظات رفاه” يختلسها الناس للعيش خارج الزمنية أو في غفلة منها. وذاك ما دفعهم إلى اقتطاع زمن ثالث من دفقه الدائم وتوجيهه إلى المتعة والانتشاء بما يوجد خارج النفعي في وجودهم.
ورغم طابعها ذاك، فإن هذه التجربة تتحقق الآن داخله بطريقة لم يألفها الناس. لقد انزاحت، بفضل الاختراعات العلمية المتعددة، عن هذا التصنيف، أو وُجهت الزمنية داخلها وفق ما يشتهيه نظام اقتصادي يبيع كل شيء غايته الربح وحده. هناك إبدالات جديدة تتحكم في “صبيبه” وهي ما يحدد أشكال تَجَليه.
وذاك ما عبر عنه الرئيس المدير العام للقناة الأولى الفرنسية مرة، وهو يتحدث عن وظيفة التلفزيون، حين حصرها في “بيع الزمن المتبقي في ذهن المستهلكين إلى الشركات الكبرى”.
فكل البرامج في نهاية الأمر، من أبسطها إلى أعقدها، ليست سوى إعداد وتهيئ لذهن يجب أن ينتهي إلى شراء سلعة أو خدمة أو واجهة اجتماعية، وذلك وفق المتاح من الزمن في الافتراض الشبكي، أو في ما تقدمه المسلسلات الآتية من المكسيك أو تركيا.
بعبارة أخرى، إننا نعيش ضمن الإبدالات التي أفرزها العصر الراهن ضمن ” زمنية تهيمن عليها الهشاشة. إنها مزيج من اندحار البناءات الإرادية للمستقبل وما يوازيها من انتصار للقيم المتآكلة المرتكزة على حياة تتميز بطابعها الحاضر وحده. بعبارة أخرى، إننا نعاين، في هذا العصر، بروز زمنية اجتماعية فريدة تهيمن عليها الهنا والآن “(1).
فلا شيء يَلُوح في الأفق عند الناس، ولا شيء يأتيهم من الماضي، كل شيء يتم ضمن “الرغبة” باعتبارها لحظة هشة تشكو من جاذبية الأحلام ومتعتها.
فما يلهث الناس وراءه ليس “أملا” أو “رجاء”، بل محاولة للإمساك بمضمون شحنة انفعالية لا تُشبَع إلا في الافتراضي: ما يقدمه الهاتف المحمول، أو ما تُلوِّح به “جدران ” الفايسبوك التي تُعطي وتستعيد ما أعطته حسب ما تقوله “الجيمات” ( اللايكات) أو تتجاهله.
لقد “أُقصي” الزمن “الفعلي” من الفضاء العمومي وأُودع في مساحات الافتراضي ضمن ما تُبيحه الحواسيب واللوحات والهواتف المحمولة، وهي أشكال تواصلية جديدة تتحكم في وجودنا وتُوجهه وتَشْرِطه بكل ما يجب أن يقود إلى الاستهلاك وحده، ففيها أودعنا كل شيء : الرغبة والحلم والذاكرة.
وإليها نَهرب من واقع لم نعد ندرك تفاصيله إلا من خلال الصور الدالة عليه. يتعلق الأمر بإشباع لرغبات يتحقق جزء كبير منها في ممارسات لَهْو يقوم بها الكبار والصغار في كل مكان: في البيوت المغلقة وفي المقاهي والبارات والحدائق العمومية.
وقد يكون هذا ما يُفسر ظهور وحدات جديدة لقياس حجم الزمن بعيدا عن فعل يمتص جوهره ويحوله إلى “تعب” و”جهد” أو “حسرة” و”ندم” و”ترجي”، فما يؤثثه الآن حقا هو “لَهْو عابر” يتم ضمن حاضر منكفئ على نفسه.
لقد ظهرت للوجود زمنية جديدة هي “الزمنية الاستهلاكية”، وهي فضاء وجودي يتحدد من خلال “كميات” زمن ينتشر في شبكات التواصل أو يُباع ويُشترى في الأسواق، كما تُباع كل السلع: الساعة والدقيقة والثانية وطريقة تصريفها وفق رغبة الفاعلين في ميدان الاتصالات وسخائهم. فما هو أساسي في هذه الزمنية ليس الزمن في ذاته، بل طريقة تحققه في أفعال بلا “غاية”، هي ما يشكل المعنى الجديد للحياة.
لا يتعلق الأمر بإحالة مباشرة أو ضمنية على ما يمكن أن يَنتج عنه مردود محسوس، بل بما يؤكد الطابع الاستهلاكي للنمط الحياتي السائد أو الآخذ في الانتشار، أي تحديد فضاء حسي استهلاكي هو الهوية الوحيدة التي يحضر من خلالها المواطن في الفضاء العمومي.
فمن خلال هذه الحسية يعيش الناس الزمن خارج إيقاعه المعتاد، أو يعيشونه ضمن ما يمكن أن ينسيهم وجوده: فَصْل الحقائق الواقعية عن تربتها وتحويلها إلى تمثيلات بصرية هي الحاضن للزمن الوهمي في الذات. وهو ما يعني أن الانفتاح على العالم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عزلة قاتلة: إن استهلاك الزمن لا يتحقق داخل حميمية مباشرة، بل من خلال “البلازما” الباردة، أو على أمواج أثير عاجز عن نقل حرارة اللقاء الفعلي.
و”للكلام”، ضمن هذه الزمنية، موقع خاص. لا يتعلق الأمر بنشاط يُعَبر عن خاصية من خاصيات الإنسان، فهو الناطق وحده دون غيره من الكائنات، بل بما يمكن أن يكون وظيفة جديدة تتلخص في الثرثرة وحدها.
فضمن حالات الاستهلاك المعمم يفقد الزمن قيمته، إنه يُفرغ من الأحلام الممتدة في آفاقه لكي يستوعب رغبات يغطي عليها “حوار” بلا سياق ولا مقام ولا قصد. فهذا ” النشاط الكلامي” لا يلبي حاجة: حاجة التواصل أو حاجة التفكير والتعلم والتعليم، بل هو في ذاته وظيفة تحتاج إلى مُنْتَج موضوع للاستهلاك. لقد أصبح الناس مدعوين إلى تخصيص زمن “للكلام” يكون خاليا من أية مردودية عدا الكلامَ ذاته.
بعبارة أخرى، يتكلم الناس خارج “كلام” المعرفة وخارج ما يقتضيه الشرط الاجتماعي في التواصل. وبذلك تبدلت أشكال حضورهم في الزمنية، فهم لا “يملئون” وقتهم بفعل منتج، بل يَبْتاعون كَمًّا زمنيا من السوق لكي لا يتوقفوا عن الكلام أبدا.
وبذلك يكون الكلام، وليس الزمن، هو الدليل الوحيد على وجود مدى محسوس يفصل بين لحظة وأخرى، فكل زمنية موجودة خارج حدود الكلام لا قيمة لها. إن الاستغراق في الفعل يُعَطل التفكير، أما الاستغراق في الكلام فيُعطل التأمل والتفكير والعمل في الوقت ذاته.
يُمنح الناس أكبر قدر من الزمن لكي لا تكون لهم لحظة واحدة يتأملون فيها ذواتهم أو محيطهم، ويُحاصَرون بالحاضر وحده لكي لا يُسقطوا ما يشكل حلما في وجودهم، أو يستعيدوا لحظة من الماضي تستثير عندهم حنينا أو ندما. إن اللحظة وحدها قابلة للقياس وقابلة للتلاشي في الوقت ذاته، لأنها غير محددة بغاية بعينها غير استهلاك الكم الزمني المودع في المحمول.
إن الزمن جزء من إيقاع حياتي يستوعب وجود الناس، وهو ما يشكل الواجهة التي يقيسون من خلالها ما تحقق أو ما هو في طور التحقق. أما ما تقترحه الشركات الكبرى فشيء آخر، إن “زمنها” موجود على هامش الزمنية الأصلية، أو هو موجود لكي يتم استهلاكه خارج أي إيقاع سوى إيقاع الوهم الافتراضي. ولذلك وقْع على الذاكرة ذاتها، وهي “العداد” الداخلي للزمن.
لقد تحول النيت إلى ذاكرة هائلة تختزن معارف الكون كله، ووفرت على الناس الجهد والبحث المضني عن المعلومة، ولكنه حرمهم من ذاكراتهم. فكل شيء موضوع بين أيديهم، ولكن لا علاقة له بالذات التي تتطور وتنمو “في الشك الذي يبنيها ومن خلاله تكبر “(2) .
فنحن لا نتعلم وإنما نستهلك معرفة مصفاة دون استيعابها في الوجدان. إننا لا نراكم خبرة، بل نلتقط معرفة تقنية لتدبير سلوك مباشر، ننتقل من “تقنيات ” إلى أخرى وفق ما يمكن أن تأتي به الابتكارات الجديدة خارج ما يمكن أن يكون له وقع على هويتنا.
لذلك يُصر الفاعلون في الاتصالات، كما تُصر شبكات التواصل الافتراضي، على جعل الكلام مادة رئيسة لساكنتها، إنها تدفع بهم إلى الخروج من الفعل إلى الكلام، فلا خير في زمن بلا كلام.
إن الذي يعمل صامتٌ لا يلتفت إلى الكلام. وبذلك يكون الكلام هو وحده الدال على الزمن، فكلما تكلمنا كثيرا، كان حضورنا في الزمنية أقوى، كأن شرط وجودنا شبيه بشرط وجود شهرزاد في الحكاية : كان عليها أن تحكي لتستمر في الحياة، وعلينا اليوم أن “نتكلم” لكي نتخلص من الفضاء العمومي ونستوطن كائنات شبيهة بكائنات ” كهف” الفلسفة.
فأشياء مرت في حياتنا وأخرى تحدث الآن ومنها ما هو آت، وفي هذا التعاقب وحده يمكن التعرف على الزمن، أي” قياس ما لا كينونة له” بتعبير ريكور. أما مع الكلام فلا شيء يحدث سوى الاستهلاك في ذاته. إن “الكائنات الافتراضية” شبيهة من حيث الوجود ب”كائنات الورق”.
وهذا دال على أننا نعيش الزمن “بالمباشر” الافتراضي خارج تمفصلاته الأصلية التي تجعل منه كيانا قابلا للعد. لقد تحولت الحياة الحقيقة إلى “موعد” عابر في الواقع، لحظة بسيطة مستقطعة من زمنية تُعاش في الافتراض وحده. لقد حرمنا النيت من أن نكون وحدنا عندما أوهمنا أننا لن نكون وحدنا أبدا.
وفي الحالتين معا، ضاع منا ما يشكل جزءا من “هويتنا”، ما يعود إلى ما يأتي به الحوار الداخلي الذي نجيب فيه عما يضعه الزمن علينا من أسئلة خارج “الكلام”. لقد تحول “الإنسان من أجل الموت” الذي يصرف قلقه في فعل إبداعي منتج، إلى “إنسان من أجل الكلام” يصرف رغباته في عبثية بلا طائل.
وبهذه الطريقة خَلَّصنا الكلام من الزمن الفعلي، زمن الحياة والعمل والموت والمتعة الحقيقية، لكي يجعلنا نعيش ضمن زمن افتراضي غير قابل للقياس، أو لا يُقاس إلا بفراغه. وكما يفعل فوتوشوب مع صور العارضات والممثلات حيث يخفي عيوبهن، يفعل معنا الهاتف وفضاءات التواصل الافتراضي حين يقدم لنا زمنية هادئة بسيطة تُختصر في “جيم” ( لايك) يصفي الواقع من طابعه المركب ويعوضه بصور صامتة ينقصها الدفء الإنساني.
وضمن هذه الزمنية الجديدة انتقلنا من الإنسان الفرد الذي يأتي إلى “الفضاء العمومي” يحمل قيما وأحلاما، إلى ذات مستهلكة تحيى وتتصرف استنادا إلى علاقتها بموضوع استهلاكي هو الواجهة التي يحضر من خلالها في عين الآخر.
انتهى الزمن التاريخي لكي يحل محله الزمن الراهن الذي لا ينتشر خلفا ولا أماما، بل ينكفئ على اللحظة وحدها، تماما كما اختفى المواطن ليحل محله مستهلك يقيس حجم الزمن في حياته بالكميات التي يستهلكها منه.
1- Gilles Lipovetsky et Sébastien Charles : Les temps hypermodernes, Paris, le livre de poche, 2004,p.49
ذكرته Elsa Godart : je selfie, donc je suis, les métamorphoses du moi à l’ère du virtuel, éd Albin Michel, 2016, p.34
2- Marc Dugain , Christophe Labbé : L’homme nu, la dictature invisible du numérique, éd R Laffont Plon, 2016, p.166.