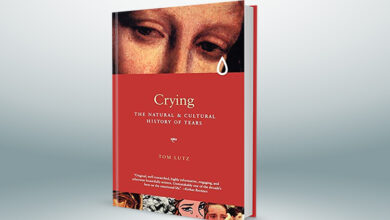“الرحلة اليابانية” وما لم نره من النهضة

ضمن أدب الرحلة، يمكن تخصيص فئة فرعية للرحلة إلى اليابان في مختلف آداب العالم، وهو حال أماكن أخرى التفت لها كتّاب الرحلة بشكل خاص، مثل إيطاليا ومصر بالنسبة للآداب الأوروبية، ورحلة الحج والسفر إلى باريس في الأدب العربي.
وقد حضرت الرحلة إلى اليابان في الكتابات العربية أيضا، وإن بشكل أقل من حضورها في آداب أخرى، ومنها كتاب “الرحلة اليابانية” لـ علي أحمد الجرجاوي الذي صدر سنة 1907، وهو لا يخرج عن شاغل معروف في الثقافة العربية عند تناول الحديث عن اليابان، وهو التساؤل لماذا نجحت تجربتها النهضوية بسرعة لم يتوفّر مثيلها في البلاد العربية؟
وفي حين أن الدراسات الفكرية مثل التي طرحها هشام جعيط ومسعود ضاهر وغيرهما تقدّم قراءات تستند إلى القراءة التاريخية والحضارية، فإن أدب الرحلة يقدّم مساهمة أساسية في هذا الإطار.
بل لعلّه يأتي بمؤشرات لا نقف عليها في الكتابة المنهجية، فهو يعكس وعيا حضاريا معيّنا يحدّد ما الذي ينتبه له كاتب الرحلة وما الذي يغفل عنه؟
كانت رحلة الجرجاوي في سنة 1906، حين كانت اليابان تعيش آخر مرحلة الميجي، على اسم أحد ألقاب الإمبراطور موتسوهيتو الذي حكم البلاد من 1867 إلى سنة رحيله في 1912، وهي مرحلة تاريخية ذات دلالة شديدة.
فقد انتقلت فيها اليابان إلى دولة حديثة، وبدأت تطمح كي تكون ضمن القائمة المصغّرة للأمم العظمى التي تقرّر مصير العالم، وهو ما بدأ بالفعل إثر الانتصار في الحرب الروسية اليابانية (1904-1905) التي يأتي ذكرها في كتاب الجرجاوي.
لكن رحلة المؤلف كانت لها سياقات أخرى، فقد ذهب إلى اليابان لحضور مناسبة مخصوصة، حيث دعا الإمبراطور الياباني إلى انعقاد مؤتمر تمثّل فيه مختلف أديان الأرض وتتحاور، وقد كان الجرجاوي أحد ممثلي الإسلام، ولهذا السياق تأثير بالغ في كتابة “الرحلة اليابانية”.
نجد أثر ذلك في مسار الرحلة نفسه، التي تقرّر أن يصحبه فيها رفيقان؛ أحدهما من مسلمي الهند والثاني من تونس، لذلك استقل الجرجاوي باخرة من الإسكندرية نحو إيطاليا، ثم اتجه إلى تونس، ومنها عاد إلى مصر عبر قناة السويس باتجاه بومباي.
قبل أن يتجه جميعهم صوب اليابان مرورا بمحطات سنغافورة وهونغ كونغ، وهي مدن نذكرها لأن المؤلف يصفها ويخصّص لها صفحات ويورد عنها حكايات، حتى إنها تأخذ مساحة تتجاوز الثلث من الكتاب.
وضمن هذا المسار نقع على أثر من عادات كتابة الرحلة في ذلك الوقت، حيث تحضر تلك النبرة الرثائية عند المرور بآثار عربية.
وفي خضم هذا الحديث كم مرّة يشرد بنا الجرجاوي في أحاديث مطوّلة مما يستحضره في التاريخ والأدب، وما قاله الشعراء عن هذه المدينة وتلك، وهي كتابة متشعبة تحتاج من قارئها صبرا كبيرا كي يصل مع الكاتب إلى اليابان.
ينزل الجرجاوي ورفاقه في يوكوهاما أوّلا، وطبعا يخصّص لوصف المدينة حيّزا يجمع بين مشاهداته وما عرفه من تاريخها، ثم ينتقل إلى وجهته الأخيرة؛ طوكيو التي يذكر قصة تحوّلها إلى عاصمة البلاد،
مشيرا إلى مهارة البناء فيها بموازاة حديثه عن تعدّد الزلازل والحرائق التي مرّت عليها، وهو ما يكشف بالنسبة إليه عن “همم اليابانيين” التي سيتتبّع أثرها في ميادين التعليم والحرب وغيرها.
هنا، كان لا بد من طرح المقارنة بين نهضة اليابان التي تشق طريقها، ونهضة العرب المتعثرة، حيث يقول إن “اليابانيين أخذوا الصالح من مدنيّة الغرب وعملوا به فعرفوا كيف يكونون أمة حية لا تدع غيرها يستأثر بمنافعها”.
وهو كلام يبطن رأيا لا يزال منتشرا بأن البلدان العربية التي بدأ حكّامها يضعون الإصلاحات مثل مصر وتونس والمغرب كانت ستبلغ مبلغ اليابان لولا عنف الهجمة الاستعمارية الأوروبية، التي حمى اليابان منها بُعدها الجغرافي عن أوروبا.
لكن الجرجاوي ينتبه إلى أن لدى اليابانيين أسبابا أخرى يتفوّقون بها، منها حال التعليم التي يصفها بصورة طريفة حيث يقول “حين شعرت اليابان بتأخرها وعرفت مزية العلوم ونشرها في البلاد وتعميمها بين الأفراد اندفعت اندفاع الشره الجوعان إلى لذيذ الطعام”.
لم يذهب صاحب الكتاب أبعد من هذه التفسيرات، فقد انشغل بأمور أخرى، منها المؤتمر الذي أتى من أجله والذي يعرض فيه مختلف ما قاله أهل الديانات الأخرى، وكثيرا ما يحاججها، ويعتبر أن قول ممثلي الإسلام في المؤتمر كان الأكثر عقلانية، وهو ما رصده من تقبّل الإمبراطور الياباني.
ولعل من أطرف ما يأتي به الكتاب هو فصل بعنوان “لماذا لم يسلم الميكادو؟”، أي الإمبراطور حسب العبارة اليابانية. يعتبر الجرجاوي أن الحاكم الياباني، وبعد أن سمع مقولة جميع الديانات، اقتنع بأن الإسلام هو أفضل الأديان.
“لكن هذا الإمبراطور بَعيدُ النظر في أمور السياسة، ومن بُعد نظره فيها أنه يراعي حال الأمة، فلما لم يجدها وافقت على دين تتخذه كي يكون الدين الرسمي لها، لم يصرّح بالدين الذي يعتنقه”.
وأغرب من ذلك نقاش دار بين أعضاء البعثة الإسلامية خصّص له الجرجاوي فقرة بعنوان “ماذا يترتّب عن إسلام اليابان؟”، حيث يرى بعضهم أن دخول اليابان بكثرة شعبها سيغيّر من العادات الإسلامية،
فيما يرى الآخرون – ومنهم الجرجاوي – أن “إسلام اليابان لا خطر فيه على الأمة” بل على العكس يقوّيها بما حصلته اليابان من أسباب القوة.
يذكر أن هذه النقاشات لم تأت من فراغ، إذ إن جميع من حضر إلى المؤتمر (ليس المسلمين فقط) قد عملوا على نشر دياناتهم في البلاد، ووجدوا من اليابانيين حسن السماع، ولكن هل تكفي رحلة تدوم 32 يوما – هي المدة التي قضاها الجرجاوي في اليابان – لتغيير عقيدة شعب بأسره؟
تلك هي عناصر الصورة التي رسمتها رحلة الجرجاوي إلى اليابان، وعلى الرغم من ثرائها بالتفاصيل إلا أنها تظل صورة ثابتة، في حين أن البلد كان يعيش منعرجا تاريخيا، وما المعمار وحيوية اليابانيين وحبّ العلوم سوى جزء ظاهر.
فقارئ تاريخ البلاد يعلم أن تلك الفترة شهدت زخما في الأدب والفن والفكر لم يفطن له الجرجاوي، ولكن ما هو أهم من ذلك أن نفس الفترة قد شهدت مراجعة لمشروع النهضة الأول في اليابان من أجل الدخول في مشروع جديد. إن ما لم يره الجرجاوي في اليابان كان ربما أكثر أهمية مما رآه ودوّنه.