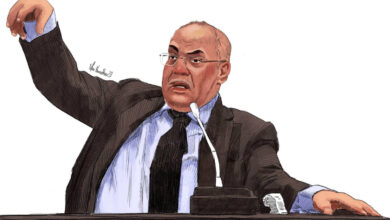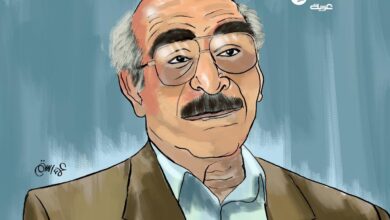قراءة في مشروع ناصر أبو زيد

إنّ القضية الرئيسة بالنسبة إلى نصر حامد لا تتمثل في كيف نجدّد التراث بقدر ما تتجلّى في إعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر، ولتحقيق هذه الغاية يتبنّى آليات تحليل الخطاب فيتعامل مع النصوص الدينية باعتبارها نصوصا منتجة للمعنى الكلي.
وفي هذا السياق شدّد على ضرورة الوعي بأنّ جميع النصوص بما في ذلك النصوص المقدّسة هي نصوص لغوية موصولة بالسياقات الاجتماعية والثقافية التي تشكّلت فيها، بيد أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ “إشكاليات القراءة [تتمثل في] اكتشاف الدلالات في سياقها التاريخي الثقافي الفكري.
بل تتعدّى ذلك إلى محاولة الوصول إلى المغزى المعاصر للنص التراثي […فكل] قراءة لا تبدأ من فراغ بل هي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث لها عن إجابات […فـ] طبيعة الأسئلة تحدّد للقراءات آلياتها”.
ومن هذا المنطلق اعتنى المشروع النقدي لنصر حامد بطرق قراءة النصوص الدينية بتفكيك بناها وتبيّن مقوّماتها. وذلك بالاستناد إلى المكتسبات المعرفية المعاصرة المُستمَدّة من علوم عديدة منها اللسانيات والسيمولوجيا وتحليل الخطاب…
على أنّ أهم مقاربة عوّل عليها في قراءة الموروث الديني هي المقاربة التأويلية التي تُعدّ المقوّم الرئيس في مشروعه النقدي الساعي إلى تجاوز النظرة التقليدية للتراث من خلال إعادة النظر في المسلمات التي حوّلها الضمير الديني إلى حقائق متعالية عن التاريخ.
- خصائص التراث الإسلامي وطرق قراءته
رأى نصر حامد أنّ الحقول المعرفية في الثقافة العربية الإسلامية على تعدّدها وتنوّعها تظل موصولة ببعضها البعض تتحكّم فيها بنية فكرية واحدة، فتنوّع مجالات التأليف والتفكير (اللغة، البلاغة، المنطق والفلسفة، علم الكلام،…) لا ينفي وجود جامع بينها، فهي تصدر عن رؤية فكرية واحدة اتخذت لها أشكالا معرفية متعدّدة.[10]
إنّ القراءة الواعية للعلاقات القائمة بين مختلف الدوائر المعرفية المُشكّلة للفكر الإسلامي تؤكّد أنّ الإلمام بخصائصه يقتضي الوعي بالخيط الجامع لمختلف الحقول المعرفية المشكّلة له، فالنحاة المسلمون القدامى (سيبويه، …) لم يسنّوا قواعد اللغة ولم يضعوا الأسس النظرية للنحو العربي بمنأى عن تأثير المنظومات الدينية (التفسير، الفقه، …). وكذا الأمر بالنسبة إلى البلاغيين (عبد القاهر الجرجاني، …) والمتكلّمين (المعتزلة، الأشاعرة، …).
فالبحث النحوي مع سيبويه أو المبحث البلاغي مع الجرجاني موصول بالمبحث الفقهي وبمباحث علوم القرآن (علم القراءات، …)، وهو ما يؤدّي إلى القول إنّ ثمّة روابط قوية بين التصوّرات الدينية عن الله والعالم والإنسان وبين تصور القدامى لطبيعة اللغة وعلاقتها بالعالم وبالبلاغة (المجاز).
وفيما يتعلق بهذه المسألة أشار إلى ضرورة الوعي بأنّ الفكر الإسلامي محكوم بسلطة المرجع الثقافي والمذهبي، مرتبط ارتباطا مباشرا بالسلطة السياسية، وهو ما جعل نصر حامد يسعى إلى وضع أسس قراءة علمية تكشف عن خفايا الخطاب الديني وتميط اللثام عن دور السياسي في بناء الفكر الديني ومقالات الأصوليين والمتكلّمين.
منبّها على أنّ للأفكار تاريخاً يبيّن أنّ ما قام به القدامى لا يعدو أنْ يكون اجتهادات لابد من تجاوزها، ناقدا بذلك القائمين على المؤسسة الدينية الذين حوّلوا اجتهادات القدامى ومدوّناتهم الفقهية والتفسيرية… إلى نصوص مقدّسة ماحين الحدود الفاصلة بين النص القرآني والنصوص الحواف ساعين إلى التوحيد بين الفكر والدين بإلغاء المسافة التي تفصل بين الذات والموضوع،
وبهذا الشكل نصّب الفقهاء والدعاة والوعاظ أنفسهم أوصياء على الدين يكلمّون الناس بلسان الله. وذلك كي يتحكّموا في العباد باستعارة سلطة دينيّة مطلقة مقدّسة ينكرها النصّ القرآنيّ ذاته، وهي ممارسة تؤدّي إلى إلغاء المسافة المعرفيّة بين الذات الباحثة في النصّ القرآنيّ وموضوعها.
ومن مظاهر ذلك رفع اجتهادات السلف أمثال الشافعي (ت204هـ) إلى منزلة القرآن الكريم ومحاولة إسقاطها على حياتنا الراهنة بكلّ ملابساتها ومستجداتها ومتغيّراتها، وفي ذلك “إهدار للبعد التاريخي”.
فالارتباط العضويّ بين “التوحيد بين الفكر والدين” و”اليقين الذهنيّ والحسم الفكريّ” ينتهي إلى محو المسافة التاريخيّة الفاصلة بين واقعنا وواقع السلف، وما يؤكّد ذلك اعتماد الخطاب الديني آلية الإسقاط المتمثّلة في ردّ جملة من المفاهيم المعاصرة مثل الديمقراطيّة والبرلمان إلى مبدأ الشورى.