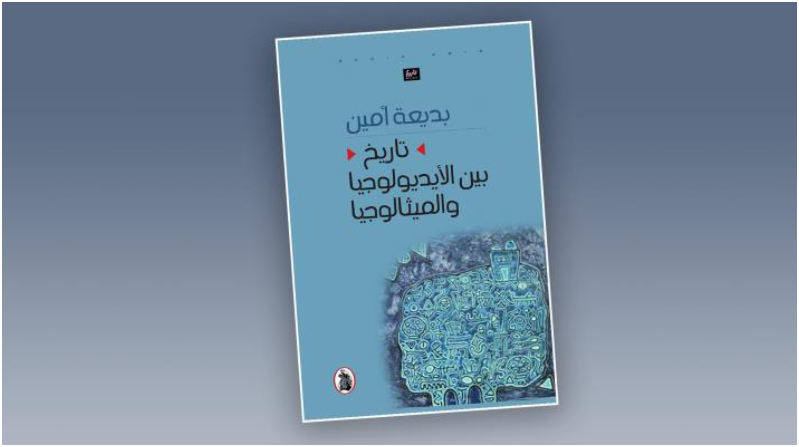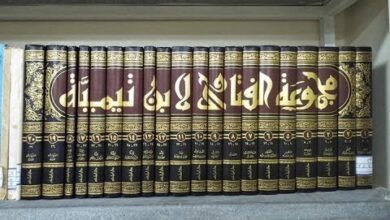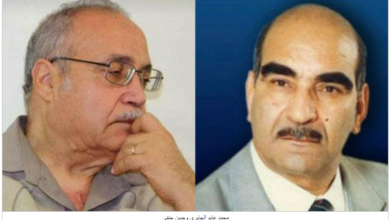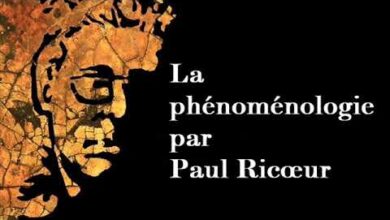نصر أبو زيد – الخطاب الديني وتقديس المنجز البشري

عدّد نصر حامد أسباب انغلاق الفكر الإسلامي ومظاهره مؤكّدا أنّ التيارات الدينية على اختلاف ألوانها ما انفكّت تتلاعب بالنص القرآني وبالمقدّس خدمة للسياسي الذي يسعى إلى الإبقاء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية بما يُلائم حاجته،
وذلك باستخدام الدين حجّة دامغة تضمن ولاء العامة وانصياعها لصاحب السلطان، فالدين من هذا المنظور سلطة رمزية مؤثّرة في حيوات المؤمنين وسلوكياتهم ومواقفهم، وفي هذا المستوى أشار الباحث إلى تقاطع المصالح بين السياسي والفقيه.
وللمحافظة على تلك المصالح التي تقوى في ظل انتشار ثقافة الاتباع تمّت الدعوة إلى اجترار مواقف القدامى وتبني آرائهم، فإذا بالأخذ بما أقرّوه من أحكام واجب على كل مؤمن، فالسلف هم المثال والنموذج الذي عرف ماهية الدين وسلك أفضل الطرق للتقرّب إلى الله، وهي صورة مشرقة يقابلها موقف سلبي من الواقع والتاريخ.
إنّ المقلّد يرفض الانخراط في التاريخ ويتجاهل قضايا الواقع المعيش بالانغلاق على الآفاق التي حدّدها القدامى، وهو بذلك يؤكد جهله بالعلاقة الجدلية القائمة بين النص والتاريخ وما يترتب عليها من إقرار بأنّ الدين تجربة حيّة استمرارها مرتبط بقدرة المؤمنين على تجديد العلاقة بين النص المقدّس والواقع.
ذلك أنّ “النصوص الدينية تحيا أو تموت بحسب إقبال المؤمنين بها عليها أو بحسب إعراضهم عنها.”[13]
فالفكر الديني القديم لم يع العلاقة التفاعلية بين الواقع والنص المقدّس الذي اختُزل في أحكام ونواه ثابتة يجب الامتثال إليها، في حين أنّ النص المقدّس شأنه شأن جميع النصوص يعبر عن واقع مخصوص، ويمثّل غياب هذا الوعي
– في تصور نصر حامد – أهم العوائق التي تحول دون إقامة الإنسان قراءة بنّاءة ومتجدّدة مع القرآن الكريم الذي حُوّل إلى مجموعة من الأوامر والنواهي فبدلا من أنْ يكون منشئا للواقع أصبح بفعل المتكلّمين باسم الله نصّا مكبّلا للإنسان، وهو ما تجلّى في إقرارهم مبدإ “لا اجتهاد مع النص”.
وقد لاحظ نصر حامد أبو زيد أنّ مفهوم النص في التراث الإسلامي لا يحيل على المعنى المُتداول في الفكر الديني الإسلامي. فالخطاب الدينيّ المعاصر من منطلق الدعوة إلى “الحاكميّة” حمّل “النص” دلالات لا صلة لها بما تواضع عليه القدامى الذين جعلوا النص دالا على كل خطاب يحمل معنى واحدا واضحا،
على حين أنّ القرآن الكريم حفل في تقديرهم بالمتشابهات والأمور المجملة ممّا جعل منه نصا مجازيا نحتاج لفهمه إلى إقامة علاقة تفاعلية بينا (القرّاء) وبينه.
- النص، القراءة، التأويل
إنّ النص القرآني في تقدير نصر حامد شأنه شأن أيّ نصّ آخر قُدّ من لغة مخصوصة تعبّر عن المجتمع المُشكّل له، وبهذا المعنى فالنص القرآني “منتج ثقافي” أي أنّه تشكل في الواقع الجاهلي خلال عشرين سنة (تقبّل الرسول محمّد للوحي).
وفي ذلك تقويض للطرح التقليدي المهيمن على الفكر الإسلامي القائل بأنّ للنص وجودا ميتافيزيقيا غيبيا سابقا لوجوده في عالم الشهادة.
وبخصوص هذه المسألة حرص الباحث على التمييز بين بين مصدر النص وطبيعة النص، فأنْ يكون القرآن الكريم وحيا إلهيا فإنّ ذلك لا ينفي عنه أنّه نص بشري بالنظر إلى أنّ الوحي قد تأنس عندما تجسّد في اللغة والتاريخ.
مما يجعل “القرآن الكريم” محكوما بجدلية الثبات والتغيّر، فالنصوص ثابتة في المنطوق مُتحركة مُتغيّرة في الدلالات، فالقول بألوهية مصدر النص لا ينفي واقعية محتواه، ولا ينفي انتماءه إلى البشر، وعلاقته الجدلية مع الواقع.
لقد انطلق نصر حامد في فهم لماهية “النص” من مقدمة مؤدّاها أنّ النص صنو الواقع الذي نشأ فيه، ذلك أنّ اللغة لا تكون مفارقة لثقافة الجماعة المُستخدمة لها، وبناء على ذلك ذهب إلى أنّ النظر في النص القرآني يقتضي الإلمام بنظام اللغة العربية ومنظومة القيم والأعراف والتقاليد الجاهلية.
كل النصوص لا تعدو أنْ تكون امتدادا للظاهرة الثقافيّة الخاصة بكل منظومة دينية أو ثقافية، ومن شأن اللغة المجازية التي تشكّلت منها تلك النصوص أنْ تجعل العالم متحرّكا غير ثابت (التأويل). فأصالة النصوص تُقاس بقدرتها على احتوى الرؤى المختلفة مما يعطى حياة للنص.
فالمشكلة الرئيسة عنده تتمثّل في كيفية تفاعل الإنسان مع النص، ذلك أنّها لا تحمل دلالة نهائية، وهو ما يجعل البحث في أُحادية المعنى أضغاث أحلام لا قيمة له معرفيا من منطلق أنّ النص الذي ينص على الحقيقة ينتهي بانتهائها.
وفي هذا المستوى يشير نصر حامد إلى أنّ فهم النص يتحدّد في ضوء الإلمام بمنطلقات فعل القراءة وثقافة القارئ وانتماءاته الفكرية… فالقراءة هي إنتاج للنص على هيأة جديدة، وهو ما عبّر عنه الإمام علي بن أبي طالب (ت 35هـ) بقوله إنّ القرآن “خطّ مسطور بين الدّفتين لا ينطق بلسان[…] وإنّما تنطق عنه الرّجال.”[14]
وبهذا المعنى فإنّ النص بما له من وجود (المنطوق، المكتوب) ينطوي على مجموعة من التعابير المجازية الرمزية، تجعل من القارئ (المفسر، …) مُنتِجًا للنص أي المعنى وفق ثقافته ورؤاه ومواقفه، وهو ما يعني أنّ كل قراءة تظلّ قراءة مُمكنة من بين قراءات أخرى.
وهو بذلك يجعل القراءة الفاعلة قراءة قابلة للتجدد والتغيّر مُتحرّرة من قيود امتلاك الحقيقة وأحادية المعنى مخرجا بذلك النصّ الدينيّ من دائرة التأويل والتأويل المضاد وفق مصالح المؤولين وانتماءاتهم الإيديولوجيّة.
لا بدّ من قراءة القرآن الكريم في ضوء المنهج العلميّ الموضوعيّ الذي يقيم للمعطيات التاريخيّة وللأحداث التي ينجزها الإنسان أهمية واضحة تنزع عن النصّ القرآنيّ كلّ أشكال الخرافة والأسطورة بما يعيد الاعتبار للعقل.
فالنصّ القرآنيّ حثّ الإنسان على العمل والأخذ بالأسباب والفعل في التاريخ واعتماد العقل ورفض الكهنوت الذي أسس له الخطاب الدينيّ المنغلق عندما ادعى أنّه وحده الذي يمتلك الحقيقة الإلهيّة من خلال فهم جوهر النصّ القرآنيّ ومقاصده فهما مطلقا.
لا يُوجد في تصوّر نصر حامد فَهْمٌ مطلق، فالنصوص عندما لا تعدّد معانيها تنتهي، ولذلك يحثّ الباحث الفكر الديني على تجاوز القراءة الأحاديّة إلى رحاب القراءة المنفتحة التي لا تقتل النصّ القرآنيّ ولا تسقط من اعتبارها الشروط التاريخيّة الحافّة ببعض الأحكام الواردة فيه.
عمل نصر حامد في جميع مؤلّفاته على تخليص الفكر الديني من سلطة الأوصياء بتبيّن الطابع الأيديولوجي الذي سيطر – وما يزال – على الفكر الديني، ذلك أنّ “كل الخلافات الاجتماعية (الاقتصادية، السياسية، الفكرية) بين الجماعات المختلفة في تاريخ الدولة الإسلامية كان يتمّ التعبير عنها من خلال اللغة الدينيّة في شكلها الأيديولوجي.”.