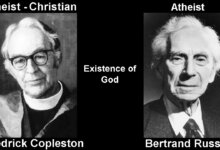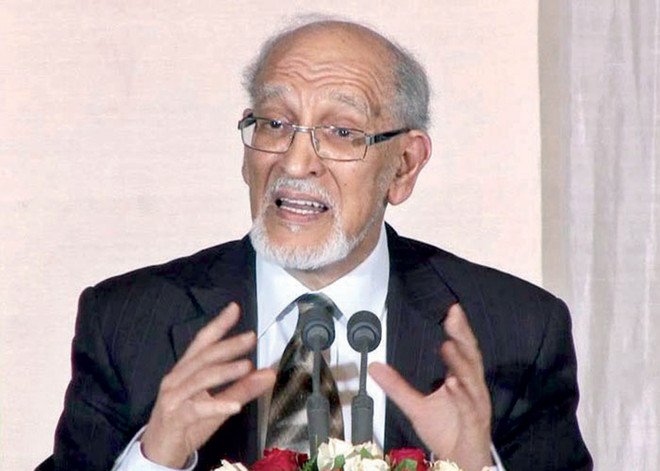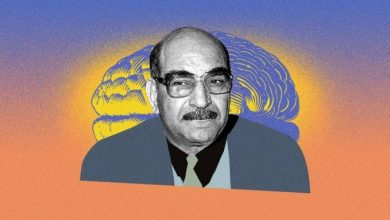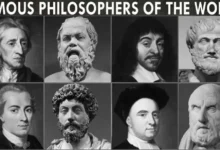في تاريخية القرآن – قراءة في كتاب “الحداثة والقرآن” لسعيد ناشيد
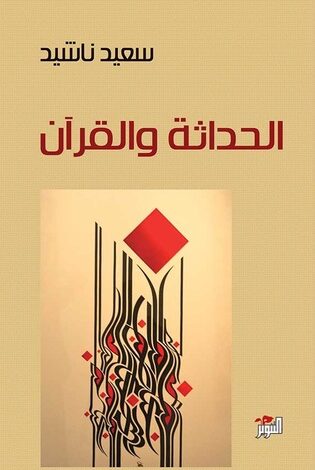
صدر كتاب سعيد ناشيد الموسوم بعنوان “الحداثة والقرآن” عن دار التنوير في طبعته الثانية سنة 2016، والتي تمتد على 248 صفحة من القطع المتوسطة، وتتضمن ثلاثة أقسام: خص الكاتب القسم الأول لبيان الانتقال الذي شهده القرآن من الخطاب وصولا للأدلوجة.
وذلك بمساءلة مجموعة من المسلمات التي علقت بالقرآن؛ وأفرد القسم الثاني للنظر في سبل العبور إلى الحداثة، من خلال فهم حداثي للقرآن، يتجاوز المسلمات، ويسائل المطْلَقات، ويضع الشروط التاريخية بالحسبان؛ وسلط في القسم الثالث الضوء على بعض الآفات التي من شأنها أن تسيء إلى الدين.
حيث تجعل منه نقمة وليس نعمة، مصدرا للشقاء وليس مصدرا للسعادة، سببا للفتن والضغينة وليس سببا للتعايش والسلام، ولعل من أبرز هذه الآفات ظاهرة النفاق الديني والتعصب الديني، وفي هذا الصدد يعتبر أن السبيل لتجاوز هذه الآفات هو إقرار الحرية الدينية التي من شأنها أن تعود على الفرد والمجتمع بالفضل العظيم.
تعود أهمية الكتاب، موضوع المقال، إلى كون صاحبه يستدرك على نفسه على سبيل مراجعة أفكاره وتمحيصها، معترفا أنه لم يكن على صواب في بعض أفكاره التي كان يعتقد في صلاحيتها، ولعل أهم مراجعة قام بها تكمن في استعاضته عن إلحاق صفة الإسلام بوصف من الأوصاف من قبيل الإسلام المدني أو الفطري أو الروحي أو الاجتماعي أو الشيعي أو القرآني أو الوحياني[1].
والاكتفاء بمصطلح الإسلام دون توصيف، اعتقادا منه أن الإسلام يأبى التخندق والتمذهب، ولاسيما أنه يقوم على عقيدة التوحيد العابرة للديانات[2]، فضلا عن أن قيمة الكتاب تكمن في جرأة أفكاره، وهي جرأة تفوق المعدل المسموح به في المجال العربي على حد شهادة جورج طرابشي، الأمر الذي جعل دور نشر عدة تعتذر عن نشره، قبل أن تنشره دار التنوير[3].
يسائل سعيد ناشيد القرآن، ويكشف المسكوت عنه فيه، في ضوء مكتسبات الحداثة الفكرية والسياسية، مثبتا تاريخية القرآن، ومقوِّضا القداسة المغرضة التي طالته، ولم يكن يلقي في ذلك بالكلام على عواهنه، إنَّما هو يستند إلى مرجعيَّات فكرية ودينية ينحدر أصحابها من حقول معرفية مختلفة، شأن الفارابي وابن عربي وسبينوزا وكانط وسروش والشبستري والقبانجي وطرابشي وغيرهم.
فأين تتجلى تاريخية القرآن؟ وما الغرض من إثبات تاريخيته؟ وإلى أي حد استطاع المؤلف النهوض بمهمة رفع القداسة المغرضة عن هذا النص وتغليب مكتسبات الحداثة ضدا على الأصوليات الدينية؟
يعتبر المؤلِّف أن القرآن يُعَبِّرُ عن ثلاث قضايا متباينة لا ينبغي الخلط بينها وهي بالترتيب كالآتي: “أولا، قضية الوحي الإلهي؛ ثانيا، قضية القرآن المحمدي؛ ثالثا، قضية المصحف العثماني”[4]. يرجع الخلط بين هذه المستويات المتباينة للقرآن إلى مُسَلَّمَةٍ وردت في الآية 78 منه وهي “كل من عند ربنا”[5].
والواقع أن الدفع بهذه المسلَّمة إلى حدودها القصوى يجعلنا لسنا في مأمن من “الآراء الساذجة، والتي تظن أن المصحف بخطه وأوراقه، وربما بمدداه أيضا، كل من عند الله”[6]؛ ذلك أن أفعال التأليف والكتابة والنسخ والنشر هي أفعال بشرية معرضة للنقص، ومن العبث نسبها إلى الله وهو الذي يتصف بالكمال[7]؛ فتسليمنا أن الله هو مصدر الوحي الرباني.
أي المادة الخام للقرآن، لا يجيز لنا أن ننسب هذا لله، مثلما لا يجوز لنا أن ننسب الخبز للمزارع، وإن كان هذا هو منتج المادة الخام للخبز؛ ذلك أنه في الحالتين معا نحتاج إلى وسيط ينهض بعملية التحويل؛ إذ نحتاج إلى مؤول للوحي الرباني في الحالة الأولى، وإلى خباز في الحالة الثانية[8].
إن فهم القرآن دون مراعاة التباين بين مستوياته، لعائق من عوائق تحقيق الحداثة؛ وعليه فإن هذه مشروطة بتجاوز الفهم القائم على الخلط بين المستويات المتباينة للقرآن، وهو خلط مُغْرِضٌ يروم جعل المتباين وحدة منتظمة لا تقبل الفصل والتجزيء، من أجل حمل الناس على الاعتقاد فيها اعتقادا جازما، والتسليم بها تسليما مطلقا يند عن الريب.[9]
يُعَدُّ القرآن نصا تاريخيا أبدع محمد في إخراج آياته، ويشهد على تاريخيته أن الرسول عندما مات ترك آياته متناثرة ومتفرقة، إن على شكل محفوظات شفوية أو على شكل شذرات كتابية على الحجارة المصقولة، وجريد النخل، وأوراق الشجر، وقطع الجلود، وكلها أدوات معرضة للتلف والفساد، لم يتم الشروع في جمعها وترتيبها إلا في عهد أبي بكر الصديق، ولم يتم إنجاز هذا المشروع إلا في عهد عثمان بن عفان[10]،
ولا يخفى أن عملية جمع هذا الشتات المتناثر على الرغم من الاحترازات التي تم وضعها من قبيل تحكيم شاهدين، لن تجعل القرآن في مأمن من الثغرات، سواء في “الذاكرة الإملائية للقائم بالإملاء أو التقديرات النحوية للقائم بالكتابة، ولاسيما أن اللغة العربية لم تكن قد خضعت[بعد] للتقعيد”[11].
يتضمن القرآن كذلك ثلاثة مظاهر تعكس تاريخيته، وهي في الواقع محددات المجال التداولي في عهد النبي محمد التي أسهمت في إنتاج النص القرآني: أولها موضوع القيم؛ حيث حرص القرآن على الاعتناء باليتامى، والرفق بهم، وصيانة حقوقهم، وهو في واقع الأمر جزء من سيرة النبي الذي كان يتيما[12]؛ ثم موضوع التجارة، والتي كانت النشاط الاقتصادي الأساس في عهد النبي،
وقد كان محمد تاجرا، لذلك يتضمن القرآن معجما تجاريا بَيِّناً[13]؛ وأخيرا موضوع القتال، وهو ظاهرة ارتبطت عموما بالمجتمعات القديمة، ووسيلتها لحفظ حدودها، والدفاع عن ممتلكاتها والبحث عن ثرواتها[14]، ومثلما كان “للصحراء خيالها الساحر”[15]،
كانت لها كذلك “غرائزها المدمرة، غرائز التوحش والثأر والقصاص وتبعية الفرد للقطيع (العشيرة)”[16]؛ ويتجلى هذا الموضوع في النسق القيمي الاحترابي الذي يقوم عليه القرآن، والمتمثل في ثنائيات جذرية لا تدع مجالا لمنطقة وسطى، من قبيل ثنائية الكفر والإيمان، ودار الإسلام ودار الحرب، وحزب الله وحزب الشيطان وقس على ذلك،
وقد ترسخ وتعمق هذا المنطق بشكل كبير بعد الانقلاب على الفكر الاعتزالي،[17] والذي كان أحد أركانه ركن المنزلة بين المنزلتين. تتجلى تاريخية القرآن أيما تجلي إذاً في أربع سمات وهي كالآتي:
أولا، تتراوح آيات القرآن بين المحكمات والمتشابهات، مما يعني أنها ليست على المنزلة نفسها من الإتقان بل على منازل؛[18].
ثانيا، المفاضلة القيمية بين آيات القرآن، كما تشهد على ذلك الآية “ما ننسخ من آية أو ننسيها نأت بآية خير منها أو مثلها”، والآية “اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم”؛[19]
ثالثا، ليست آيات القرآن معصومة من الخطأ، سواء ذلك الذي مرده إلى التوتر النفسي لمحمد والذي نتج عنه تسرب بعض الآيات الشيطانية قبل نسخها، كما هو بين في الآية “ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وهو عليم حكيم” أو مردها إلى عملية مصحفة القرآن في عهد عثمان[20].
كما تشهد على ذلك الهنَّات اللغوية[21] التي تعتور القرآن ويغض عنها الطرف الذين يعبدون المصحف ويقدسونه، بدعوى أنها ضرب من ضروب التشكيك في الوحي، والحال أن مردها في الواقع إلى أن المصحف كتب “بلغة عربية كانت لا تزال بلا قواعد، ولم تكن التقاليد الكتابية قد ترسخت بعد”[22]؛
رابعا، اكتفاء الرسول في بعض المناسبات بصياغة آيات ألقيت إلى مسمعه من بعض الصحابة[23].
يتبين من هذه السمات أن القرآن ليس كلاما مدونا في اللوح المحفوظ كما يدعي الخطاب الفقهي، ولا صياغة من الله في ظروف طارئة كما يزعم الخطاب الكلامي، ولا فيضا، إن من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، عن الذات الإلهية، كما جرى على ذلك الخطابين الصوفي والفلسفي[24]، بل مرده إلى الخيال الخصب للنبي محمد[25]،
وفي ذلك يقول باروخ سبينوزا: “النبوة لا تتطلب ذهنا كاملا، بل خيالا خصبا”؛ وهو ما يفسر تباين آيات القرآن بين المحكم والمتشابه حسب الحالة النفسية للرسول[26]؛ هذا إلى أن مخيال الرسول مشروط ببيئة صحراوية تحتفي بالنخيل واللبن والخمر والنساء والأولاد وهلم جرا من مظاهر البيئة الصحراوية، وهو ما انعكس على طبيعة الخطاب القرآني؛[27].
الأمر الذي يخول لنا رفع القداسة عن القرآن، واعتباره مجرد نص تاريخي صرف، ليس متعاليا عن أسباب نزوله[28]، تم جمعه وترتيبه في فترات تاريخية من طرف البشر، وحسب ما يستطيعون إليه سبيلا، ملتمسين في ذلك الأعذار لما لا طاقة لهم به.
يعترض رهط من الفقهاء على مكتسبات الحداثة التي حررت الإنسان من أشكال مختلفة من الوصاية طالما كبلت قواه الخلاقة، ودعته إلى حسن استعمال عقله، بحجة كون هذه المكتسبات تخالف الشريعة، والحال أن هذه لا تعدو جملة من اجتهادات الفقهاء دامت أزيد من ألف عام، ساعية لاستنطاق المسكوت عنه في القرآن، متوسلة في ذلك بجملة آليات، لعل أبرزها القياس.
فطفق أهل الفقة يخبطون خبط عشواء، عسى أن يجعلوا من هذا القرآن المحدود في الأصل شاملا جامعا مانعا لأحكام سرمدية، لا ينال منها الزمان[29]، والواقع أن ما يجعل من هؤلاء الفقهاء يستنكفون من الحداثة ومكتسباتها هو أنها تفضح سوءاتهم[30]؛ ذلك أنها تسمي الأشياء بأسمائها، دون لف أو دوران.
فزواج القاصرات اعتداء جنسي على الأطفال، وإجبار الزوجة على الجماع اغتصاب، وإرضاع الكبير هو ممارسة للجنس في مقر العمل، ونظام الإماء والجواري عبودية، وزواج المتعة والمسيار وجهاد المناكحة دعارة، والتطلع الانتحاري إلى حوريات الجنة هو اكتئاب عصابي أو ذهاني[31].
بالجملة، فالدعوة لإعمال شرع الله الموجود بين دفتي كتاب مضت عليه مئات السنوات، لهو عين النفاق الديني[32]، فضلا عن التخلف التاريخي؛ إذ من العبث أن يكون النص القرآني هو مصدر للتشريع، ذلك أنه محدود ويناسب مرحلة تاريخية مرت دون رجعة؛
وبالتالي فمن الحكمة الاستناد في التشريع على العقل البشري الذي يتطور بتطور الظروف التاريخية، والمنجزات البشرية؛ ذلك أن “الكثير من الأفعال التي كانت مقبولة لدى القدماء، بل تندرج ضمن تصورهم للخير والشر، لم تعد كذلك اليوم”[33]، ولاسيما أن “تفسيرات وتأويلات الخطاب القرآني قد استنفذت محاولات العصرنة والتحيين”[34]،
كيفما كانت أضربها، على خلاف ما يزعم البعض “أن معركة تأويل النص الديني لا تزال مفتوحة على ممكنات الاستئناف، وهي مفتوحة حتى أمام القوى العقلانية لتخوضها وتدلوا بدلوها”[35]، فأي تأويل يمكن أن نقدمه للآية 11 من سورة النساء “للذكر مثل حظ الأنثيين” على سبيل موافقتها مع المكتسبات الحقوقية للعصر؟[36] أَتنفع محاولات رفع الحرج، والتماس الأعذار،
والبحث عن ظروف التخفيف لأحكام ورد فيها نص صريح؟[37] إن حُكْماً من قبيل هذا لا ينفع معه لا تبرير ولا تأويل، اللهم إن أردنا الحياد عن جادة العقل السليم[38]؛ وبالتالي فمن العبث اعتبار القرآن في عصرنا هذا قانونا جنائيا، ولاسيما أن نظام العقوبات فيه يتعارض مع منجزات الحداثة السياسية.
ذلك أن العقاب لم يعد في “قبضة الغرائز والانفعالات (…) حيث منطق القصاص، والعين بالعين، ومشاهد الجلد والرجم والقطع والحرق، أمام أعين الملأ والمارة والفضوليين، وأحيانا بمشاركة الجمهور في تطبيق العقاب”[39]،
إلى إدراج هذا ضمن مجال القوانين والمؤسسات[40]، فضلا عن أنه من العبث اعتبار القرآن دستورا، ولاسيما أن هذا من جهة مفهوم دخيل على اللغة العربية، ولا أصل له لا في القرآن، ولا في التفاسير، سواء قديمها أو حديثها، هذا إلى أنه بأي معنى يكون القرآن دستورا وهو لا يعدو في أغلبه قولا مجازيا، تتراوح آياته بين المحكم والمتشابه،
ويحتمل كل تأويل، في حين أن الأصل في الدستور أن يكون كلاما صريحا، “لا يحتمل إلا هامشا ضيقا من التأويل”[41]، علاوة على إمكانية تغيير بنوده حسب ما تمليه مستجدات العصر، على خلاف القرآن حيث الأصل فيه الخلود والدوام؟[42].
بل إنه من التعسف تبرير قيام دولة دينية باسم الإسلام؛ ذلك أن تاريخ الدولة في الإسلام كان يقوم على مجرد العصبية كما يؤكد بن خلدون[43]، ولاسيما في ظل غياب سند شرعي[44]، وأخيرا إن فكرة الثوابت التي يتبجَّح بها من يدْعون إلى تطبيق الشريعة فكرة تتعارض مع الله نفسه، بما هو صيرورة لا يستقر على حال، إذ كل يوم هو في شأن كما ورد في سورة الرحمن[45].
نستخلص مما تقدم الحاجة الماسة لتحرير الخطاب الديني مما علق به من الشوائب والآفات، وهي مهمة تقوم على خمسة أسس وهي كالآتي:
أولا، “تحرير الخطاب الديني من النظرة السحرية للعالم”؛ ذلك أن القرآن ليس نصا سحريا يتضمن كل الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والبيئية وغيرها التي تعترض الناس، بل هو لا يعدو نصا تاريخيا استنفذ إمكاناته، ولم تعد له من صلاحية غير الصلاحية التَّعبدية[46]، فضلا عن الوظيفة الأخلاقية التي ليست حكرا على الدين الإسلامي وحده، بل تشمل جميع الأديان[47]؛
ثانيا، “تحرير الخطاب الديني من التوظيف الإيديولوجي”[48]، وتُعَدُّ العَلمانية في هذا الصدد حلاًّ ناجعا، لأنها تقوم على “قاعدتين أساسيتين: أولا الحياد الديني والمذهبي للدولة، ولمؤسسات الدولة؛ ثانيا، سيادة القانون المدني على قدم المساواة ومن دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو ما شابه”[49]،
وتجدر الإشارة إلى أن العَلمانية لا تتعارض مع الدين، بل تتعارض مع “التوظيف الإيديولوجي للدين في مجال الصراع على السُّلطة”[50]؛
ثالثا، “تحرير الخطاب الديني من النَّفْس الغضبية”[51]، وهو الأمر الذي يقتضي الاستعاضة عن تصحُّر الصحراء، وما تحيل عليه من همجية، إلى شِعرية الصحراء، وما تحيل عليه من خيال خلاق، يحتفي بألوان الحياة، ويتوق للخلاص الروحي، على شاكلة خمريات بن الفارض، وأشواق بن عربي، وطواميس الحلاج[52]، ولعل من مهام الإصلاح الديني في الإسلام استئناف هذه الروح الشِّعرية، بعيدا عن النزعات المتطرفة[53].
رابعا، “تحرير الخطاب الديني من مفاهيم الخطاب التقليدي”[54]، شأن الطاعة وملك اليمين والولاء والبراء والحريم والعورة وغيرها من المفاهيم التي تسوغ للحَجْر، وتعويضها بمفهوم الفرد والحرية الإنسانية والاختلاف والتعايش وغيرها من مكتسبات الحداثة.
خامسا،”تحرير الخطاب الديني من النزعة الطائفية”[55]، التي تذكي نار الفتن بين الناس ، وتلهب حماس التقاتل بينهم، وتجعلهم متخلفين تاريخيا، ومنتكسين حضاريا ومغتربين كونيا.
[1] سعيد ناشيد، الحداثة والقرآن، دار التنوير للطباعة والنشر، ط 2، 2016، ص 170.
[2] المصدر نفسه، ص 168.
[3] المصدر نفسه، ص 7.
[4] المصدر نفسه، ص 11-12. هذه هي الأطروحة الأساس للكتاب ، وقد عبر عنها الكاتب بصيغ شتى، وفي مناسبات مختلفة ، كما هو الحال في الصفحة 43.
[5] المصدر نفسه، ص 15.
[6] المصدر نفسه، ص 17.
[7] المصدر نفسه، ص 101.
[8] المصدر نفسه، ص 20-21.
[9] المصدر نفسه، ص 57.
[10] المصدر نفسه، ص 61-62.
[11] المصدر نفسه، ص 64.
[12] المصدر نفسه، ص 73-75.
[13] المصدر نفسه، ص 75-76-77-78.
[14] المصدر نفسه، ص 79-80-81-82-83.
[15] المصدرنفسه، ص 186.
[16] المصدر نفسه والصفحة.
[17] المصدر نفسه، ص 117.
[18] المصدر نفسه، ص 43-44.
[19] المصدر نفسه، ص 44_45.
[20] المصدر نفسه، ص 45.
[21] يقدم الكاتب أمثلة عن الهنات اللغوية التي تعتور القرآن، ومنها رفع المعطوف على المنصوب؛ ونصب الفاعل؛ وتذكير خبر الإسم المؤنث؛ وجمع الضمير العائد على المثنى. من الصفحة 101 إلى الصفحة 108.
[22] المصدر نفسه، ص 102.
[23] المصدر نفسه، ص 45-46-47-48.
[24] المصدر نفسه، ص 53.
[25] المصدر نفسه، ص 55.
[26] المصدر نفسه، ص 132.
[27] المصدر نفسه، ص 136-137.
[28] المصدر نفسه، ص 58.
[29] المصدر نفسه، ص 191.
[30] المصدر نفسه، ص 211.
[31] المصدر نفسه، ص 210.
[32] يعرض سعيد ناشيد مختلف مظاهر النفاق الديني في الصفحات 205-206-207-208.
[33] المصدر نفسه، ص 158.
[34] المصدر نفسه، ص 36.
[35] يذكر الكاتب محمد عابد الجابري وأحمد شحرور كممثلين لأصحاب هذا الزعم، المصدر نفسه، ص 36.
[36] المصدر نفسه، ص 37.
[37] المصدر نفسه والصفحة.
[38] المصدر نفسه، ص 43.
[39] المصدر نفسه، ص 113.
[40] المصدر نفسه والصفحة.
[41] المصدر نفسه، ص 87.
[42] المصدر نفسه، ص 87.
[43] المصدرنفسه، ص 176.
[44] المصدر نفسه، ص 177.
[45] المصدر نفسه، ص 184.
[46] المصدر نفسه، ص 60-133-132-159-234-235.
[47] المصدر نفسه، ص 60.
[48] المصدر نفسه، ص 234.
[49] المصدر نفسه، ص 240.
[50] المصدر نفسه، ص 241.
[51] المصدر نفسه، ص 244.
[52] المصدر نفسه، ص 187.
[53] المصدر نفسه، ص 190.
[54] المصدر نفسه، ص 245.
[55] المصدر نفسه، ص 245.