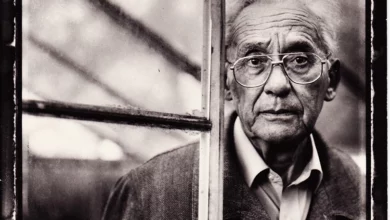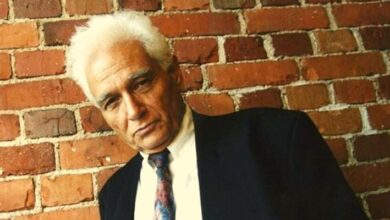محمد عابد الجابري: مسارات مفكر عربي

- أولاً: «مشروع الجابري» أم «مشاريع الجابري»؟
كان الفيلسوف الفرنسي الراحل بول ريكور (1913 ـ 2005) قد كتب في ردّه على أحد دارسي فكره من الباحثين الإنكليز، الذين راموا تقديم صورة مجملة عن مساره، فقال: «إن هذه المحاولة بالذات لهي ما يستدعي منّي، على الحصر، امتناناً ودّياً [اتجاه الباحث].
وذلك بسبب من أني عاجز بعجز ذاتي عن تحقيق مثل هذه النظرة الإجمالية [عن عملي]، وذلك لعاملين اثنين متضافرين: أولاً، لأنني مدفوع على الدوام إلى السعي إلى الأمام بفعل مشكلة جديدة تفرض نفسها عليّ، ولأنني، ثانياً، عندما يحدث لي أن أُلقي نظرة إجمالية واسترجاعية على عملي، فإن;ما يدهشني ليس هو الطابع التراكمي لهذا العمل بقدر ما هو أنحاء الانفصالات التي نتجت من متاوهي.
وإنني لأميل إلى اعتبار كل عمل من أعمالي كما لو كان جملة مكتفية بذاتها نشأت عن تحدٍّ أملاها، وإلى اعتبار العمل التالي كما لو تَوَلَّدَ هو عن المسائل غير المحلولة التي تخلّقت وتبقّت عن العمل السابق». كذلك هو حال كبار المفكرين على الدوام. وما كان المفكر العربي محمد عابد الجابري بدعاً منهم.
كان يتصور «مشروعه الفكري» بوسمه ـ وفق عبارة لطالما وردت على لسانه ـ «مشروعاً» طويلاً كنت أعيش بداياته، ولكن بدون أن تتبين لي نهاية له»، ولمّا سأله أ. محمد وقيدي في الندوة التي عقدتها مجلة الوحدة ، بعد صدور كتابه بنية العقل العربي.
ونشرت في العدد 26 ـ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1986، عن المرحلة التي كان وصل إليها مشروعه آنذاك، أجاب: «يمكن أن أصدر حكماً بأنني لا أعرف أين وصلت، ولا إلى أين سأصل». ولطالما ذكّر هو في حواراته ومذكراته بأمرين: الأول تعددية «مشروعه»، بله «مشاريعه»، و الثاني صدفية بعض التعالقات التي كانت مصيرية فيها.
من جهة أولى، عادة ما جارى الجابري ـ على تحفّظ ـ قرّاءه في الحديث عن «مشروعه الفكري»، بل كثيراً ما تحدث هو عن «مشاريع»، مفضلاً الحديث عمّا سمّاه ذات مرة «تاريخ مشاريعي الفكرية». ومن جهة أخرى، رفض مرات كثيرة الحديث عن ضرب من «التخطيط المسبق» الذي وجّه أعماله.
وذلك تلقاء اعترافه بالطابع الصدفي الذي حكم بعض ما صار ثابتاً من ثوابت فكره؛ فما عُرف بأنه مشروعه ـ نقد العقل العربي ـ ما كان مشروعاً عند البدء: «لم تكن لديّ في البداية ـ عندما أخذت في العمل من أجل كتابة تكوين العقل العربي ـ لم تكن لدي فكرة عامة عن المشروع: كيف سيتطور ولا إلى أين سينتهي».
والحال أن: «الطريق كان على مراحل. وبطبيعة الحال يأتي نقد العقل العربي في النهاية كمشروع متكامل. لكنه في البداية لم يكن مشروعاً مخططاً له. كان في بدايته عبارة عن دراسات قطاعية أنجزتها لمناسبات معيّنة (ندوات)، ثم جمعتها في كتاب «نحن والتراث» …كان ذلك هو منطلقي في نقد العقل العربي.
لكن كيف ننقد العقل العربي؟ من أين نبدأ وإلى أين ننتهي؟ ذلك ما أنتجته الممارسة». بدأ الجابري بفكرة تأليف كتاب واحد ووحيد في نقد العقل العربي، غير أنه حين شرع فيه، تبيّن له أن عليه أن يقسمه إلى جزأين: جزء خاص بتكوين هذا العقل، وجزء دائر على بنيته، فكان كتاب التكوين (الجزء الأول) وكتاب البنية (الجزء الثاني).
ولمّا أنهى الكتابين، تبيّن له أن ثمة جانباً عملياً لهذا العقل لم يتناوله ـ الجانب السياسي ـ فكان كتاب العقل السياسي العربي (الجزء الثالث). ولمّا كانت السياسة لا تنفصل عن الأخلاق، ما كان منه إلا أن ينتهي به المطاف إلى تأليف في العقل الأخلاقي العربي (الجزء الرابع).
أكثر من هذا، تبيّن له أن مدار الفكر العربي الكلاسيكي، برمّته، على النص المقدس، فما كان منه إلا أن يباشر هذا النص بالدرس، وكان أن أورث المشروع الأول ـ نقد العقل العربي ـ مشروعاً فرعياً ـ هو فهم القرآن.
على أن الجابري كان ينوي تدشين مشروع آخر ـ هو نقد العقل الأوروبي ـ فإذا بقيام الثورة الإيرانية والصحوة الإسلامية والحركات الإسلامية يصرفه عن ذلك، ويحدو به إلى النظر في موضوع فهم القرآن.
لهذا كله، كان الجابري يرى أن «من الصعب أن يؤرخ لفكره ولتطور فكره». ومع ذلك، فلطالما هو أرّخ لفكره، وذلك في حواراته وإفضاءاته.
والحال أنه يمكن أن نصنّف مجمل مؤلفات محمد عابد الجابري ـ التي درج المهتمون بفكره على تسميتها «المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري»، ولم يعترض على التسمية، وإن قال عنها: «ما أطلق عليه «المشروع الفكري» لمؤلف هذه الكتب أو: «ما سيطلق عليه في ما بعد «المشروع الفكري» لكاتب هذه السطور».
وإن فضّل هو الحديث عنها بصيغة الجمع: «مشاريعي» ـ بحسب طريقتين في التصنيف، كلتاهما ارتضاها المرحوم لنفسه، بل أوحى بها:
- الأولى ، تقسيم هذه الكتابات ـ بنيوياً ـ من حيث «مجالات اهتمامها»ـ أو ما سمّاه الجابري نفسه «فضاءات» ـ وذلك إلى أربعة فضاءات:
ـ فضاء قراءة التراث (نقد العقل العربي)، ويمكن أن ندخل فيه كتباً شأن مصنَّفي العصبية والدولة (1971)، و نحن والتراث (1980)، وثلاثيته النقدية (المقدمة إلى المشروع: تكوين العقل العربي (1984)، و بنية العقل العربي (1986)، و العقل السياسي العربي (1990)، و العقل الأخلاقي العربي (2001)، هذا فضلاً عن كتابيه الأخيرين: مدخل إلى القرآن الكريم (2006)، و فهم القرآن الحكيم (2008).
ـ فضاء مناقشة قضايا الفكر العربي المعاصر (نقد الخطاب العربي). ويمكن أن ندرج فيه مؤلَّف الخطاب العربي المعاصر (1982)؛ إشكاليات الفكر العربي المعاصر (1988)؛ المشروع النهضوي العربي (1996)؛ وجهة نظر: نحو إعادة بناء الفكر العربي المعاصر (1997).
ـ فضاء المستجدات في الفكر العالمي، أو التعامل مع الفكر الأوروبي نقداً واقتباساً وتبيئة (قضايا الساعة من قبيل «الديمقراطية» و«العولمة» و«حقوق الإنسان» و«الهوية» و«صراع الحضارات»). وقد صدرت له فيه كتب: المسألة الثقافية (1994)؛ مسألة الهوية (1995)؛ الديمقراطية وحقوق الإنسان (1997).
ـ فضاء الشأن المغربي الخاص، وقد أصدر فيه كتباً شأن: أضواء على مشكل التعليم بالمغرب (1973)؛ من أجل رؤية جديدة لبعض مشكلاتنا الفكرية والتربوية (1977)؛ المغرب المعاصر: الخصوصية والهوية…الحداثة والتنمية (1988).
الثانية ، تصنيف كتب الجابري، طريقة تصنيف هذه الأعمال ـ كرونولوجياً ـ بحسب «تطور فكره»، الذي وجد أن المنعطف الأهم فيه هي البحوث التي نشأ منها كتاب نحن والتراث (1975 ـ 1980).
- ثانياً: توظيف الإيبيستيمولوجيا في قراءة التراث
بعد حديثه عن مرحلة أولى من مراحل فكره، كما جسّدتها مقالاته الأولى في بعض الجرائد المغربية إلى حدود منتصف السبعينيات من القرن الماضي، صار يتحدث عن «المرحلة الثانية» من مسار حياته الفكرية، التي يجد أنها تميزت بـ’«الانصراف شبه الكلي إلى قضايا الفكر والثقافة»، و«الانقطاع إلى صخرة الثقافة».
والحق أن هذا أمر يستدعي ملاحظتين: الأولى هي أن لهذه المرحلة «بداية» بل «بدايات»، و الثانية أن «الانصراف شبه الكلي» لا يعني «الانصراف الكلي»، و«الانقطاع إلى صخرة الثقافة» لا يعني «الانقطاع بالكلية» عن «صخرة السياسة».
وإذا صح أن ثنائية الشأن السياسي/الشأن الثقافي هي العلامة الفارقة التي تميز المرحلة الأولى، وهي مرحلة الاهتمام بالسياسة وبالأيديولوجيا، من المرحلة الثانية، التي صارت مرحلة الاهتمام بالفكر والثقافة، فإن هذا لا يعني أبداً أن الرجل هجر السياسة والأيديولوجيا هجراً؛ ففي ما يخص الأيديولوجيا.
يعتبر الجابري أنها لازمة من لوازم كل بحث في العلوم الإنسانية: «أنا لا أعتقد أنه من الممكن البحث في الإنسانيات عموماً دون حضور هاجس أيديولوجي صريح أو ضمني»، وما كان البحث في التراث بدعاً من هذا: «إننا لا نستطيع أن ننظر إلى موضوعات التراث «نظرة محايدة» لا مبالية، فالهاجس الأيديولوجي حاضر فينا دوماً عندما نكون إزاء موضوع من موضوعات التراث».
وهكذا، «[فـ] إننا لا يمكن أن نقوم ببحث علمي مجرد في التراث بدون أن يكون هناك دافع أيديولوجي». على أن «هذا الدافع … يجب أن نعيه وأن نتصرف على ضوئه بوعي، ذلك خير لنا ألف مرة من أن نغفله، فنتحدث حديثاً أيديولوجياً ونحن نعتقد أننا براء من الأيديولوجيا». وفي ما يخص السياسة، يعتقد أن «السياسة أمر لا غنى عنه، وأننا حتى إن نحن لم نهتم بالسياسة اهتمت هي بنا».
ويعود هذا المنعطف، رسمياً، إلى عام 1980: «إن سنة 1980 لها دلالة خاصة في مساري الثقافي، قد تفسر مسألة «البداية»: فهي السنة التي صدر لي فيها كتاب «نحن والتراث» الذي كان له الدور الحاسم في التعريف بي، في المشرق خاصة لكونه طبع في بيروت»، لكن لا دلالة لهذه السنة هنا إلا تقريبية.
هي سنته المشرقية، أما سنة تحوله المغربية فيعود بها إلى أقدم من ذلك، إلى إعداد مداخلته لندوة بغداد الدولية عن الفارابي عام 1975 والتي اعتبرها: «أول نص كتبته كان له ما بعده في حياتي الثقافية على مستوى البحث العلمي والعمل الأكاديمي.
بل يمكن اعتباره «البشير الأول» بما سيطلق عليه فيما بعد «المشروع الفكري» لكاتب هذه السطور»، ويضيف: «إن أهميتها بالنسبة لمساري الفكري كانت ـ وما زالت ـ كامنة في أنه شكلت بالنسبة لي نقلة نوعية على صعيد المنهج والرؤية في مجال التعامل مع التراث (…).
كانت بالفعل دراسة تدشينية لما سيأتي بعدها من الدراسات التي تشكلت من تراكمها تلك «البداية» الكاملة التي تشخصت في كتابي «نحن والتراث».
وهي دراسة دشّنت بداية التحرر من «الطريقة التي كرّسها المستشرقون في دراسة الفلسفة العربية الإسلامية»، أراد هو في هذه الدراسة، ليس فقط أن يتكلم ««لغة» غير اللغة التي يتكلم بها هؤلاء الشيوخ الكبار»، وإنما أيضاً: «مهاجمة الأفكار التي كرّسوها حول الفارابي حتى صارت من نوع «الأفكار المسبقة» التي تحكمت في فهم هذا الفيلسوف في العصر الحديث».
كان منهج هؤلاء منهجاً فيلولوجياً يقتضي النظر إلى فلسفة الفارابي بوصفها جماع فلسفتين (فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو) إن لم نقل ثلاثة (بإضافة الأفلاطونية المحدثة)، وردّ كل مكوّن إلى أصله… أما ما كان يهم الجابري.
فقد كان أشياء أخرى؛ منها «المضمون الأيديولوجي للمدينة الفاضلة عند الفارابي»، من حيث إنها كانت تسعى إلى: «تشييد دولة الحرية والإخاء والمساواة، دولة العدل والعقل».
بما يجعل من الفارابي عديلاً لروسو! حيث ورد في مختتم الدراسة: «لقد تطلعت البرجوازية الفرنسية في القرن الثامن عشر إلى تشييد دولة الحرية والإخاء والمساواة، دولة العدل والعقل. وكان روسو بعقده الاجتماعي المعبّر عن تلك التطلعات، فلماذا لا نرى في الفارابي روسو العرب في القرون الوسطى؟».
وقد تصادف أن مهام التدريس ألجأت الجابري إلى تدريس فلسفة الفارابي للطلبة في كلية الآداب في الرباط منذ 1972 ـ 1973 على طريقة المستشرقين، لكنه وهو يفعل كان يتابع باهتمام زائد: «تلك الحركة الفكرية التجديدية.
على صعيد المنهج والرؤية، التي ازدهرت في فرنسا منذ أواخر الستينيات في أعقاب ظهور مؤلفات ألتوسير حول ماركس، وخاصة كتابه قراءة ماركس (وإليه يرجع الفضل في نشر مفهوم «القراءة»)، ومؤلفات فوكو وبالخصوص منها «الكلمات والأشياء»…
وكان كثير من طلبتنا في الكلية يتتبعون تلك الحياة الفكرية الجديدة التي انبعثت في فرنسا من خلال مؤلفات ألتوسير وفوكو، بعد أن بدأ نجم سارتر ووجوديته في الأفول».
- ثالثاً: سؤال كيفية قراءة التراث
يفضي إلينا الجابري: «أذكر هذا [الحراك الثقافي الجديد الذي عاشه الجابري مدرساً للفارابي ومنفتحاً على ألتوسير وفوكو..] لأنه في ذلك الوقت بالضبط، وفي ذلك الجو الفكري الصاخب، طُرح عليّ سؤال أيقظني من سباتي، وكنت أشبه بالنائم الذي أخذ حاجته من النوم ودخل في مرحلة ذلك النوم الخفيف الذي يحس النائم من خلاله أن وقت الاستيقاظ قد حان.
ولكنه يتكاسل وينتظر صوت المنبّه! كان السؤال المنبّه من طالب ألقاه عليّ بعد خروجنا من مدرج الكلية بعد انتهاء دروسي عن فلسفة الفارابي، فتحلّق بي مجموعة من الطلبة كالعادة، يسألون ويناقشون، وفجأة سألني أحدهم سؤالاً جعلني أشعر به كشخص نزل من السماء وأخذ مكانه وسط الطلاب المتحلّقين بي! لم يكن قد تكلم من قبل ولذلك لم يثر انتباهي.
وعندما تكلم واجهني بهذا السؤال: «أستاذ: كيف نقرأ التراث؟». لم أجب لأني فهمت الأبعاد التي صدر عنها هذا السؤال، ولم يكن من الممكن تقديم الجواب بكلمة أو كلمات ولا حتى بخطبة … فقد فهمت أنه أراد أن يقول: «كيف نقرأ تراثنا العربي الإسلامي كما فعل فوكو في قراءته للتراث الفكري الفرنسي، وكيف نقرأ الفارابي بالطريقة نفسها التي قرأ بها ألتوسير ماركس؟».
من هنا شعرت أن سؤال هذا الطالب ليس من الأسئلة التي تُطرح من أجل جواب فوري بل من أجل القيام بمهمة!». أكثر من هذا، «شعرت أن الطريقة التي كنت أدرّس بها الفارابي وغيره من فلاسفتنا القدامى لم تعد مرتفعة إلى مستوى تطلعات طلابنا، وأنه صار حتما عليَّ أن أُعدّ نفسي لكي أستطيع الارتفاع بدروسي إلى هذا المستوى».
والحال أنه تصادف أن الجابري كان يدرس الإيبيستيمولوجيا ـ فلسفة العلم ـ وقتذاك، بمبادرة شخصية [منذ أوائل السبعينيات] بالموازاة مع الفلسفة الإسلامية.
وبما أن الفيلسوفين الفرنسيين المجددين فوكو وألتوسير كانا ينتميان ـ في تصوره ـ إلى هذا المبحث الفلسفي، فقد اعتبرها صدفة سعيدة: «من هنا جاء الجواب الضمني الذي أخذ يعتمل في نفسي كردٍّ على سؤال الطالب المشار إليه: «كيف نقرأ التراث يا’أستاذ؟» في صورة إحساسي بضرورة الانتقال من الطرح الأيديولوجي الدوغمائي الذي يستورد المنهج الماركسي مطبقاً (…) إلى البحث الإبستمولوجي».
فإذن، كانت المادة متوافرة [التمرس على فلسفة الفارابي]، وأساسيات المنهج موجودة [التمرس على المنهج الإيبيستيمولوجي]، وما عاد ثمة إلا أمر «تطبيق المنهج على المادة».
تعكس بعض فقرات مقدمة كتابه من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية والتربوية (نيسان/أبريل 1977) ما سيتصدر المدخل العام لكتاب نحن والتراث، وفيه تعبير عن الحاجة إلى ما كان يسميه «قراءة جديدة لتراثنا»، ذلك أن التراث: «عولج ويعالج بمناهج مختلفة، وبالتالي انطلاقاً من رؤى معيّنة صريحة أو ضمنية، ولكننا رغم تعدّد المناهج والرؤى ما زلنا نحس بالحاجة تتزايد لقراءة تراثنا قراءة جديدة».
وهو ينبذ هنا مناهج أربعة لطالما انتقدها في ما بعد: «المنهج السلفي» الذي عدّه «منهجاً انتقائياً يسعى إلى تأكيد الذات أكثر من سعيه إلى أي شيء آخر»، و«المنهج الاستشراقي» الذي تؤطره: «رؤى تمليها نزعة «التمركز حول أوروبا»، والمحاولات التي «تتبنى الرؤية الماركسية، لا لتسترشد بها كمنهج بل تأخذ الماركسية في غالب الأحيان كمقولات وقوالب جاهزة جامدة».
ثم «الدعوات إلى تطبيق «البنيوية» والاستعانة بعلم اللسانيات المعاصر والأنثروبولوجيا البنيوية»، وهي دعوات «لا يمكن أن تؤدي إلا إلى طرق مسدودة، إلا إلى تكريس الانحطاط والجمود بدعوى إخضاع المتغيرات إلى الثوابت التي تحكمها».
وذلك لأن البنيوية: «باهتمامها بالكل أكثر من الأجزاء، وبنظرتها إلى الأجزاء في إطار الكل الذي تنتمي إليه ضرورية لاكتساب رؤية أشمل وأعمق، لا تكفي وحدها، بل لا بد من المزاوجة بينها وبين النظرة التاريخية، النظرة التي تتتبّع الصيرورة وتعمل جاهدة على ربطها بالواقع لاكتشاف العوامل الفاعلة فيها الموجهة لها».
وما يخلص إليه هو ما صار يعرف به على أنه منهجه في قراءة التراث قراءة جديدة: «هذه المزاوجة بين المنهج البنيوي والمنهج التاريخي والطرح الأيديولوجي ـ الواعي ـ هي الأساس المنهجي للرؤية التي نحاول اعتمادها في معالجة بعض مشكلاتنا الفكرية والتربوية التي عرضناها في هذه المقالات …».
تتصادى هذه الأرسومة المنهجية والمدخل الذي صَدَّرَ به كتاب نحن والتراث ـ وقد صدر عام 1980 ـ إلا أن بينهما كانت محطة نيسان/أبريل 1978 وبحث الندوة التي نظمتها كلية الآداب في الرباط عن ابن رشد «المدرسة الفلسفية في المغرب والأندلس: مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد»: «كان بحق علامة فارقة في مساري الفكري، خاصة على مستوى البحث في التراث».
ثم كانت المحاولة التي قدمت بندوة ابن خلدون التي عقدتها الكلية نفسها في شباط/فبراير 1979: «ما تبقى من الخلدونية: مشروع قراءة نقدية لفكر ابن خلدون»، فمداخلة ندوة «الفكر العربي والثقافة اليونانية» في كلية الآداب في الرباط: «ابن سينا وفلسفته المشرقية: حفريات في جذور الفلسفة العربية الإسلامية في المشرق» [لاحظ هنا الأثرين: أثر ألتوسير ـ مفهوم «القراءة» و«القراءة الجديدة» ـ الذي تكرر في عناوين المداخلات، ومفهوم «الحفريات» الذي يشي بأثر فوكو].
وبالجملة، «تأتي هذه الدراسات والأبحاث لتشكّل… سلسلة متصلة الحلقات على مدى خمس سنوات بدايات متجددة ومتكاملة حققت تراكماً، كمّاً وكيفاً، أنتج تلك البداية التأسيسية التي أرساها كتاب «نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي»». والحال أن مشروع الجابري، منظوراً إليه في جملته، كان مشروعاً بينياً توسطياً، بين:
1 ـ «الدعوة التي تنادي بقبول التراث جملة وتفصيلاً»، وذلك لأنها: «دعوة لا تاريخية غير منتجة»، «وكل ما يمكن أن تفعل هو أن تجعل ماضينا منافساً لحاضرنا باستمرار، الشيء الذي قد يصنع منا كائنات تراثية لا كائنات لها تراث»: نملك التراث أم يملكنا، نحيا في التراث أم يحيا فينا، نحتوي التراث أم يحتوينا: تلك هي المسألة عند الجابري.
2 ـ «أولئك الذين يقفون من التراث موقف الرفض الكامل»: من شبلي الشميّل إلى عبد الله العروي، مروراً بسلامة موسى وغيره، والذي عنده أن هؤلاء: «هم مستلَبون، لأنهم عندما يرفضون تراثهم العربي الإسلامي يقبلون قبولاً غير واع تراثاً آخر يتخذون منه منظومتهم المعرفية».
وعنده أن الارتباط بالتراث الإنساني العالمي مطلوب، لكننا نحيا في عالم من الصراع الأيديولوجي مخدوم بمفهوم «الخصوصية» و«الهوية»، بل: «إن تطوير العقل العربي أو الفكر العربي أو تجديده أو تكسير بنية الفكر القديم يجب أن يتم من خلال ممارسة هذا الفكر القديم نفسه، من خلال العيش معه، من خلال نقده من الداخل، من خلال التعامل معه، وليس من خلال رفضه رفضاً مطلقاً».
أكثر من هذا، لا يريد الجابري الاكتفاء بمجرد دراسة التراث دراسة أكاديمية موضوعية ومحايدة، وكأنه تراث الغير، وكأنه ما بقي يفعل فينا (تحقيقه، شرحه…)، وإنما يريد هو ما يسمّيه أحيانا «استعادته»، وأحياناً أخرى «تملكه»: «إننا لسنا محايدين، نعم يجب أن نفصل التراث عنا لندرسه دراسة علمية.
ولكن لا لنقف عند حدود الدراسة، بل لكي نعيده إلينا… إننا لا نمارس نقداً حيادياً بل نمارس نوعاً من النقد الذاتي، بمعنى أننا ندرس التراث من أجل أن نوظفه في إعادة بناء ذاتنا الوطنية القومية وليس فقط من أجل أن نفهم موضوعاً من الموضوعات».
ولهذا، فإنه: «في نظري إنه من الضروري أن ندخل في حوار نقدي مع أسلافنا، وذلك من أجل فهمهم فهماً أعمق وربطهم بنا بشكل من الأشكال، كلما كان ذلك ممكناً. وبعبارة أخرى، إنني أعتقد أن علينا، في المرحلة الراهنة، أن نجعل مقروءنا التراثي معاصراً لنفسه، بمعنى أن لا نحمله ما لا يستطيع، أن نفهمه على ضوء محيطه التاريخي ومجاله المعرفي وحقله الأيديولوجي.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى علينا أيضاً أن نجعل مقروءنا التراثي هذا معاصراً لنا على صعيد الفهم والمعقولية. وهذا لا يتأتّى إلا بالدخول معه في حوار نقدي يطلعنا على جوانب الخصوبة وجوانب الضحالة في موروثنا الفكري».
- من دواعي العودة إلى التراث وبواعثه عند الجابري:
1 ـ «لقد قامت النهضة العربية الحديثة، أو ما يسمى بهذا الاسم على أساس توفيقي: بعث الماضي أو ما يُعتبر فيه مشرقاً، والأخذ من الحضارة الحديثة ما ينسجم مع هذا الوجه المشرق من تراثنا.
الانطلاقة كانت إذن انتقائية توفيقية، فكأننا أردنا أن نؤسس الاستمرارية بواسطة شيء خارج هذه الاستمرارية، أي ما يقتبس من الغرب. هذه النظرة بطبيعة الحال نظرة لا نقدية، لا تاريخية.
ذلك أن المفروض في كل بداية جديدة حقيقية هو الانطلاق من نقد القديم. وعندما نقول نقد القديم فإن هذا يعني أساساً نقد العقل، لأن الموروث الثقافي ليس هو ذلك الذي تضمه المخطوطات والكتب، بل الموروث الثقافي هو دائماً ما يبقى في فكر الإنسان بعد أن ينسى كل شيء».
يلاحظ هنا أن تصور الجابري للتراث هو غير التصور المنسوب إليه: التراث = المؤلفات التراثية، ومن ثمة عدم وجاهة النقد الذي وجّه إليه بوصفه اهتم بالتراث من حيث هو «ثقافة عالمة»، ولم يهتم به من حيث هو «ثقافة شعبية».
ذلك بأن منذ أن عثر الجابري على تعريف الفرنسي هيريو الذي يقول بأن الثقافة هي ما يبقى في ذهننا بعد أن ننسى كل شيء، وهو مغرى بهذا التعريف، بل أعمله حتى في فهم معنى «التراث»: التراث هو ما يفكر فينا حتى من غير أن نعي ذلك.
بناء عليه، فإن: «البداية الحقيقية التي تستحق هذا الاسم يجب أن تكون بداية نقدية. النهضة الأوروبية الحديثة بدأت بداية نقدية جديدة مع غاليلو وديكارت، واستمر النقد ونقد النقد ملازمان [ملازمين] لتلك النهضة، يغذيها وينميها ويحملها على مراجعة نفسها باستمرار.
أما النهضة العربية الحديثة فلم تعش، وما زالت لا تعيش، لحظة النقد، نقد العقل. وإذن، فالسؤال: لماذا الابستمولوجيا؟ يجد جوابه في شعورنا بالحاجة إلى تأسيس انطلاقة فكرية عربية جديدة على أساس من النقد المنهجي للفكر وأدواته، حتى إذا رجعنا إلى التراث رجعنا إليه بعقول جديدة لا بعقول تراثية، فنتمكن من احتوائه بدل من أن يحتوينا كما هو الحال الآن».
2 ـ «من خصائص «العربي المعاصر» أنه مندمج في الماضي، منخرط في صراعاته، يعيشه لا كشيء مضى بل كواقع حاضر. بعبارة أخرى، إن العربي المعاصر يعيش في وعيه زمنه الثقافي ممتداً كامتداد الصحراء، فلا تتابع: لا سابق ولا لاحق، وإنما حضور على نفس البساط؛ فليس الماضي منافساً للحاضر فحسب.
بل هو يحل محله. أكثر من هذا، صورة المستقبل الآتي تشيد على غرار «المستقبل الماضي». لهذا، عادة ما حين يفكر العربي في المستقبل يبحث عنه، بالأولى والأحرى والأجدر، في ماض ممجّد. ولهذه الحيثيات، «لا يمكن للعرب كأمة لها تاريخها وتراثها، أن يتحرروا من هذا التراث ويرموه في البحر، هذا غير ممكن نهائياً،
ولذلك فالمطلوب منا هو استيعاب هذا التراث استيعاباً عقلانياً، وهذا الاستيعاب العقلاني يعني أول ما يعني ليس فقط نشر النصوص وتحقيقها وتوفيرها ـ هذه مرحلة تقنية تتعلق بتحضير المادة لا أتحدث عنها ـ وإنما يعني أن التعامل مع هذه النصوص التراثية، التاريخية، يجب أن يتم بشكل عقلاني».
ومن ثمة إلحاح الجابري، في كل ما كتب، على أن التجديد لا يمكن أن يحدث إلا من داخل التراث نفسه، وذلك باستملاكه استملاكاً نقدياً.
- المصادر:
نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ضمن سلسة “أوراق عربية” التي صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية.