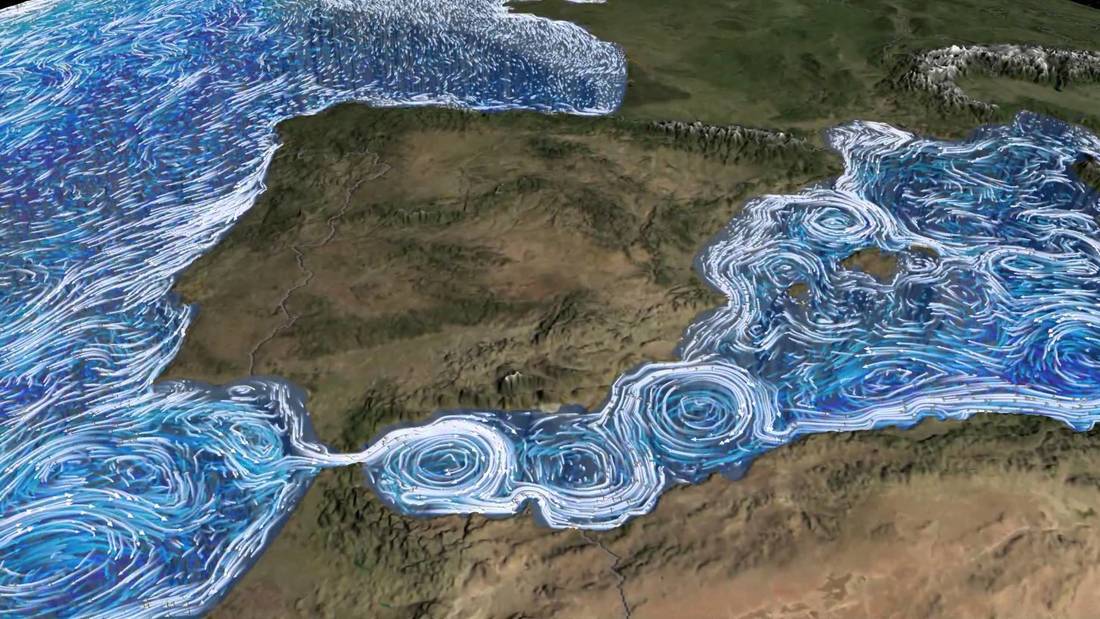البربر هم مَن عرَّبوا بلاد المغرب

بربرٌ أي سكان البرّين، السهل والوعر، كما قال به جمهور المؤرخين، مسلمين وأجانب، وأكده العالم اللغوي الجزائري (القبايلي) رشيد بنعيسى، بربرٌ أقحاح من صنهاجة ومصامدة وزناتة وزيانيين هم من أنشأوا دولا إسلامية وعرَّبوا بلاد المغرب. وبربرٌ أقحاحٌ أفذاذ من علماء وفقهاء وأدباء هم أيضا من عرّبوا بلاد المغرب، وهذا بيانه بالدليل والبرهان.
دأب نشطاء الأمازيغية من المغرَّرِ بهم من الغلاة والريعيين والمشحونين بكراهية مرضية للعرب والإسلام على تقديم العرب غزاةً محتلين سفاحين وغصّابين سابين في الديار البربرية، بينما الواقع المعترف به عند المؤرخين، مسلمين ومستشرقين، أن العرب قليلي الأعداد لم يدخلوا بلدان المغرب بصفتهم عرباً، بل مسلمين حملةَ رسالة اسمها الدعوة المحمدية التوحيدية،
حتى أن منهم من يصوّرهم كسعاة بريد لا غير، أو كمؤطرين عسكريين (كموسى بن نصير وعقبة بن نافع) للداخلين من البربر في الإسلام أفواجاً أفواجاً. ولما قويَ عود هذا الدين بالبربر، ولو باعتماد بعضهم، أحيانا ولأسباب سياسية بحتة، دعوات الخوارج المساواتية (من إباضية وصفرية).
وحوالي منتصف القرن الثامن ميلادي، كما يسجل جاك لوي ميياج، “تم إبعاد العرب عن المغرب، لكنَّ القرآنَ بقي فيه قائماً”. (Le Maroc، ص 23). وهذا الإقرار قال به أيضا هنري طيراس وشارل – أندري جوليان وآخرون.
وقد شكّل هؤلاء البربر بإيمانهم القوي الذراع الجهادية المسلحة لفتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد النفزي، وتحرير أهاليها الرازحين إذّاك تحت طغيان القوط الهمج ونيرهم.
وانعقد إجماع المؤرّخين، بمن فيهم مستشرقون، كلڤي بروڤنسال ور. دوزي، على أن البربر بعتادهم ومجاهديهم الإثني عشر ألفاً كانوا هم فاتحي الأندلس.
أما موسى بن نصير وسريّته قليلة العدد فلم يقوموا بعمل حربي ذي بال سوى تحصيل غلال القائد طارق بن النفزي زياد .. “وخلال السنوات السبع التي أمضاها طارق بن زياد في الحكم، تحوّل معظم أهل البلاد إلى الإسلام، وذلك بعد أن كان التحوّل تدريجيا قبل حوالي ثلاثين سنة.
بدءا بإسلام كسيلة وأتباعه ومرورا بمجهودات أصحاب الرباطات الأولى من التابعين وأهل العلم، إلى أن أمسك طارق بن زياد بزمام الحكم، الشيء الذي جعل الفقهاء يقرّرون بأن أرض المغرب قد أسلم عليها أربابها وليس فيها صلح ولا عنوة” (تاريخ المغرب، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، ص149).
الكلام السَّائبَ المعتلّ عن التعريب لا يأبه مروّجوه لكونه ليس وليد حصول المغرب على استقلاله، بل إنه في التمرحل التاريخي إعادة التعريب إلى نصابه ومجراه
وبعد ذلك العهد بأربعة عقود ويزيد، تم بالترجّي والترغيب استقدام طوابير هائلة من أعراب بني هلال وسليم ورياح (وهذا ما يعرف بالتغريبة الهلالية)، وذلك من طرف الخليفة مؤسس الدولة الموحدية عبد المومن بن علي المصمودي بالتبني والگومي الزناتي بالنسب.
وكانت غايته الإستقواء بهم لتمنيع انتصاراته وترسيخ الأمن وإدامته في كل ربوع إمبراطوريته الفسيحة، الممتدة من بلدان المغارب كلها إلى الأندلس، وكذلك للقضاء تماما على الخوارج والمهرطقين، أخطرهم تنظيم البرغواطة بتامسنا أتباع الداعية صالح بن طريف يهودي الأصل.
والقائل ببدع وترهات تشريعية ما أنزل الله بها من سلطان، وكانت نهايته على أيدي صنهاجة ومصمودة هو وأزلامه. ومن قبلهم حاربهم بنو أمية كما حارب أبو بكر الصديق فئات الخوارج المرتدين الفتّانين المسلحين؛ وهكذا وطَّن ذلك الخليفة المسلم العظيم أولئك الأعراب في السهول الأطلسية الخصيبة.
ومكّنهم من حرثها وحمل السلاح، فكانت هذه القبائل المستقدمَة عامل تعميق تعريب المغرب في جل أطرافه وأكنافه، وقد حدا حدوه الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي المصمودي، بطل معركة الأرك ضد مسيحيي الأندلس في 9 شعبان 591 هـ.
أخذ تاريخ القطر المغاربي مأخذ الجد يعلمنا ما يلي: العروبة عند المغاربة عموماً لم تكن قط مطلباً عرقياً ولا حتى قومياً، بل هي تماهٍ مع مرجعيةٍ حضاريةٍ إسلاميةٍ تبنّوها مبكّراً والتحموا حولها، فأنشأوا دولاً وأبدعوا بلسان تلك المرجعية وتراثها ثقافتهم المميّزة.
كانت هوية المغرب العربية – الإسلامية، إلى حد كبير، من صنع القبائل البربرية كما كان الحال مع الفرس والأتراك والأكراد، وغيرهم في القارّة الآسيوية. وكان أن استفرغوا جهودهم، فوق كل انتماء سلالي أو عرقي، في بناء ما يسمّيه ابن خلدون الحضارة والعمران والدولة العامة.
ومن ثمّةَ كان تنافسهم، مثلاً، في تشييد المدارس والمساجد والمآذن ونشر اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
وقد ساهم في هذا التنافس، كما نعلم، حتى المتصوّفة والزوايا، فكانت هذه الفلول من الأعلام الذين منهم على سبيل المثال لا الحصر: عكرمة المحدث، البوصيري الصنهاجي صاحب البردة والهمزية الشهيرتين.
وأجروم مؤلف الأجرومية في النحو العربي (مترجمة إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية، وهو مغربي بمثابة أبي الأسود الدؤلى العربي وإلى حد ما سيبويه الفارسي)، وابن معطي الزواوي، واضع أول ألفية في النحو العربي، والونشريشي الفقيه والمفتي.
والرحّالة ابن بطوطة المزاتي الطنجي، والبيذق وابن عذاري والجزنائي وابن غازي والفشتالي والأفراني والزياني وأكنسوس، وكلهم مؤرخون معروفون في قطرنا وغيره.
علاوة على الحسن اليوسي الأديب والفقيه صاحب مؤلفات بعربية شيِّقة وبتلكم “البطاقة” المرسلة منه إلى السلطان المولى إسماعيل مؤسّس الدولة العلوية الشريفة، ينصحه في أمور الدنيا والدين.
والمختار السوسي المؤرّخ والأديب صاحب سوس العالمة وموسوعة “المعسول وإليغ قديما وحديثا” ومبدع قصيدة العصيدة بعربية بيّنة بليغة.
أما في التصوّف فعدّدْ ولا حرج: الشاذلي والجزولي وأبو شعيب الدكالي وابن العريف وأبو يعزى، والدلائيون وغيرهم كثير.
ومن أراد المزيد فليرجع إلى مؤلف محمـد حقّي “البربر في الأندلس المسكوتِ عنه”، وكذلك “مفاخر البربر” لمجهول… ولا يتسع المجال هنا لإيراد أسماء الأعلام المعاصرين من أموات وأحياء.
وهكذا يقر محمد شفيق بنوع من الاعتزاز والفخر بأن الثقافة الإسلامية “بوسعها أن تستعرض بالمئات الأعلام البربرية التي أسهمت أيما إسهام في تنشئتها وتكوينها” (انظر مذكرات من التراث المغربي، مؤلف جماعي، ص 106).
وإلى قوائم من يسمّيهم شفيق “المتخصّصين في بيداغوجيا اللغة العربية”. يضيف حتى ابن منظور، صاحب “لسان العرب” المؤسس الشهير (!). وهذا الإقرار حقيقٌ بأكثر من اتعاظ تاريخي وبوقفة تأملية، لعل زبدتهما إذا ما امتخضت تُظهر جليا بما لا مراء فيه أن ثقافة البربر.
بعيدا عن أيِّ إحالة إثنية ضيقة، عربية قلباً وقالباً ومتناً ومبنى، وهي ما زالت كذلك ساريةً متنامية عند بربرٍ هم حقا أحرارٌ يحملون استعرابهم الثقافي في أسمائهم وإنتاجاتهم الفكرية والبحثية والأدبية بلغة الضاد اللاحمة المشتركة.
وفي السياق نفسه، سبق لابن خلدون أن عقد في الباب السادس من “المقدّمة” فصلاً سمّاه “في أن حَمَلَة العلم في الإسلام أكثرهم العجم”، أي من فرس وأتراك وكرد وبربر وغيرهم، عربيتهم كمنت في لسانهم وثقافتهم وكتاباتهم. وهنا يقوم الثالوث الذي لا يجوز القفز عليه إلا أن يكون القافز من محترفي الخلط والخبط والتدليس.
الواقع المعترف به عند المؤرخين، مسلمين ومستشرقين، أن العرب قليلي الأعداد لم يدخلوا بلدان المغرب بصفتهم عرباً، بل مسلمين حملةَ رسالة
أولئك البربر، كسلفهم البعيد والقريب، إنما يعتبرون العربية وثقافتها قوام هويتهم الدينامية المتحركة، بها يُظهرون أن المغرب قياسا إلى المشرق ليس “كُمَّ اللباس” (حسب تعبيرٍ مغرضٍ للمصري الشامي ابن فضل الله العمري)؛ وبها أيضاً يبرهنون على أن بضاعتهم ليست بضاعة عرب المشرق رُدّت إليهم (كما قال بذلك متهورا الصاحب ابن عباد عن “العقد الفريد“ لابن عبد ربه الأندلسي).
وبها يؤكّدون، أخيراً وليس آخراً، أن استعرابهم ليس من شأنه أن يشايع إيديولوجيا القومية العروبية المتعصّبة الجامحة ويسقط في أتونها. وبكلمة جامعة، إنهم بتلك الدينامية المتحركة ينشئون نبوغهم المغربي، معوّلين على نوابضهم العميقة وقيمهم المضافة.
وحتى نصل الماضي بالحاضر هي ذي أسماء تندرج في السياق نفسه، منها على سبيل المثال فقط: محمـد شفيق، الأخضر غزال، حدو أمزيان، عبد السَّلام ياسين، محمـد عابد الجابري، إدريس السغروشني، علي أمليل، المهدي أخريف، البشير القمري، عثمان أشقرا، سعيد أقضاض، محمد شكري، أحمد التوفيق، حسن أوريد، عبد النبي ذاكر، جمال حمداوي، مـحمد زفزاف…
وهؤلاء، وصنوانهم كُثر، مكونهم البربري في استعرابهم، واستعرابهم في مكونهم ذاك؛ وهويتهم دينامية ارتقائية وليست من صنف اجتزائي تنصلي، ولا من صنف الأكل من الصحن والبصق فيه أو التغذّي من الغلة وسبِّ الملة، كما هي حال العصائدي الفصامي.
ولا من الصنف الحنيني الغنائي الذي يشبه الكلامُ فيه وصف السلطان المنصور الذهبي لبلاد السودان: “هي غريبة لا تثبت إلاّ في الحلم […]، وهي غيلٌ لا تزحم وعروسة لا تقتحم، وعجماء أبية لا تنقاد، وحسناء عادت بينها عواد…” (هسبريس، 1923، ج3، ص 480).
العروبة عند المغاربة عموماً لم تكن قط مطلباً عرقياً ولا حتى قومياً، بل هي تماهٍ مع مرجعيةٍ حضاريةٍ إسلاميةٍ تبنّوها مبكّراً
بناءً على ما سقناه وتقصّدناه، الكلام السَّائبَ المعتلّ عن التعريب لا يأبه مروّجوه لكونه ليس وليد حصول المغرب على استقلاله، بل إنه في واقع التمرحل التاريخي إعادة التعريب إلى نصابه ومجراه الأصليين، بعد ما أصابه من وهن وإقصاء.
فعلهما الاستعمار الحمائي الفرنسي الذي سنَّ مقيموه العامون سياسة الحجر وفرق تسُد، وكان أبرز مهندسيها المارشال هوبر ليوطي، إذ أجراها بيدٍ من حديد في قفاز من حرير، سياسة نزع فيها بحزم واستماتة إلى استعداء البربر على العرب والحركة الوطنية، كيما يُحكِم قبضته على البلاد وأناسها.
وذلك ما تفصح عنه كتاباته ودورياته، وحسبنا في ذلك دوريته بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 1921، سيئة الصيت (سبقتها أخرى في سبتمبر/ أيلول 1914)، وعرفت أوجها التطبيقي في مايو/ أيار 1930 مع “الظهير البربري” الشهير، الذي يحرّم على البربر تعلم اللغة العربية.
وبالتالي التمكن من قراءة القرآن، كما أنه يرقِّي العرف البربري “إزراف” على حساب الشرع الإسلامي. وقد صفّق غلاة الأمازيغية وطربوا لهذه الترقية، مدّعين أن إزراف يحرم الإعدام معوّضا إياه بالنفي، غير مدركين أن النفي في مجتمع قبائلي قائم على عصبية القرابة والدم يكون النفي فيه صنوَ القتل أو أشد.
غير أن معارضة الحركة الوطنية، المستندة إلى شفرة عُمقية عربية – بربرية أحبطت مشروع المارشال ليوطي التفريقي، وأفشلت مراميه. وعليه، القول بإنسانية هذا الأخير وتفضيله على موسى بن نصير (وبالقياس على عقبة بن نافع)، بدعوى احترامه عقيدة السكان الدينية ومؤسساتهم وتقاليدهم.
إنْ هو إلا زعمٌ مشروخٌ وعصارة مغالطاتٍ وتدليسٌ صارخ، وذلك ما اجترحه الحاج حسن أوريد، غفر الله له، على صفحات Tel quel (عدد 637)، وردَدتُ عليه في الأسبوعية الفرنكوفونية نفسها، وكذلك بالعربية في موقع هسبريس، وعنونت مقالتي “حين يفقد مثقف الوجهة والبوصلة”.
وكم تأسّفت لزلّته تلك، سيما وأنه خرّيج المعهد المولوي والناطق الرسمي باسم القصر سابقا ووالي مكناس سابقا ومؤرّخ المملكة سابقا، وإن كان لا يتشبث إلا بصفة الناطق باسم القصر، إذ إنها تسعفه أيما إسعاف في الترويج الذاتي، نظرا إلى تأثيرها المعنوي والنفسي. ولله عاقبة الأمور.