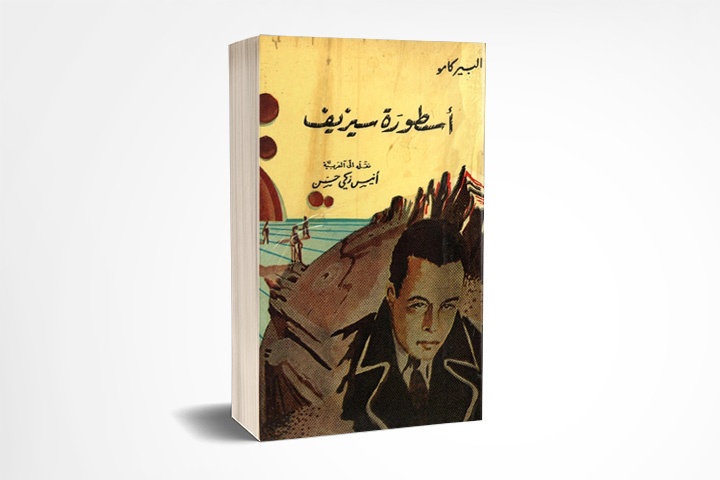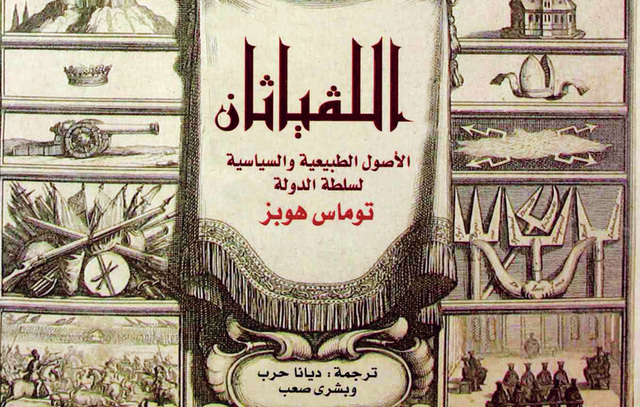
- الفلسفة والواقع: ثلاث مهام متباينة
هل هناك حقًّا دور لتلعبه الفلسفة في السياسة؟ وبصيغةٍ أعم: هل هناك فائدة عملية من الفلسفة أو هل لها -بعيدًا من المثاليات والطوباويات– أي دور لتقوم به في الواقع؟ هي أسئلة استنكارية، دون شك، تواجهها الفلسفة منذ بدأت حتى اليوم، لكن إجابات الفلاسفة عن مثل هذه الأسئلة تعددت بدورها.
قدّم هيغل، مثلًا، جوابًا نصف سلبي عن مسألة دور الفلسفة في الواقع، في مؤلّفه الشهير «مبادئ فلسفة الحقّ» الذي لخصه كما يأتي: «لا تفرد بومة منيرفا جناحيها إلا بعد أن يرخي الليل سدوله».
وإذا علمنا أن بومة منيرفا هي رمز الفلسفة، فإن هيغل لا يمنح الفلسفةَ سوى دور نظريّ، فهي تسعى لفهم الواقع الذي يسبقها ويتقدمها ولا يمكن لها التقدم عليه؛ فهي لا تخرج عدتها النظرية «إلا بعد أن يُكمل الواقع سيرورة تعيُّنه».
وعليه لا تستطيع الفلسفة، بوصفها «فكرة العالَم»، أن تقدِّم أكثر من وصفٍ وفهمٍ وتأويلٍ للعصر الذي وجدت فيه. ليس علينا التقليل هنا من أهمية هذا الطرح الهيغلي؛ ففهم العالم الواقع والمتعين ليست مهمة سلبية بالمطلق، بل هي مهمة شاقة ومعقدة، كما أن التأثير في الواقع يتطلب فهمه أولًا.
لا شك أن هذه الفكرة الأخيرة ليست لهيغل، وهي أقرب إلى ماركس الذي وجد أن وظيفة الفهم الفلسفي قد استُكملت مع هيغل وصار على الفلسفة أن تغير في الواقع وتتدخل في سيرورته.
ليس عليها من وجهة نظر ماركس، إذن، الاكتفاء بانتظار الواقع لتفسره وإنما عليها -بعد أن استوعبته نظريًّا- أن تتقدمه وتصنعه وتخطط له مساراته الممكنة وفق رؤية تاريخية مادية (ادّعت الماركسيات طويلًا علميتها التاريخية).
في أطروحته الحادية عشرة، من أطروحات حول فيورباخ، يوضّح ماركس فكرته بقوله: «لقد قصّر الفلاسفة دورهم على تفسير العالم بطرق عدّة، بينما المهمّ هو تغييره». مع ماركس ننتقل من النظر إلى العمل، أو من العقل النظري إلى العقل العملي، لو استعرنا (بشكلٍ جائر) مفردات كانط. مع ماركس تتخطى الإرادة المجنّحة التاريخ الزاحف وتجره خلفها بعنف في حين ترتدي الفلسفة وجه الأيديولوجيا وتتنكر اليوتوبيا بأقنعة العلم.

ستستمر الماركسية فاعلة في الفكر السياسي الحديث والمعاصر، لكنها لن تختصر الكلام عن دور الفلسفة في الواقع. يقدّم لنا الفيلسوف النمساوي فتغنشتاين تصورًا سلبيًّا خالصًا للفلسفة فهو يؤكِّد في كتابه بحوث فلسفية:
«أنّ الفلسفة ببساطة تطرح كل شيء أمامنا وهي لا تُفسِّر ولا تستنتج شيئًا، وبما أن كل شيء ملقى أمام ناظرينا، فليس هناك شيء ليُفسِّر».
ولأن فتغنشتاين يؤمن بأنّ الفلسفة «تترك كل شيء على حاله»، فإنه ينصحنا -في مكانٍ آخر- بالقول: «لا تفكّروا، ولكن انظروا».
بين مهمة نظرية، لفهم عالم الفعل المتعين (هيغل)، ومهمة عملية، تريد التحكم في الواقع وتوجيه السياسة وتغيير العالم (ماركس)، ومهمة سلبية شبه صوفية منسحبة من الواقع (فتغنشتاين، هايدغر)، أين تجد الفلسفة نفسها؟
يؤكِّد لنا تاريخ الفلسفة منذ الإغريق حتى اليوم أن الفلسفة تولّت هذه المهام الثلاث دائمًا، لكن على نحوٍ غير متساوٍ؛ إذ ليس علينا التقليل من عزوف الفلاسفة عن السياسة تنظيرًا وتغييرًا، فكثيرًا ما تَرَفَّعَ الفيلسوف عن السياسة أو اختبأ منها.
منذ تقسيم العمل عند الإغريق بين نظري للسادة وعمليّ للعبيد، ومع تعالي المُثُل الفلسفية إلى عوالم الأفكار المُعلّقة فوق الواقع الذي رمز عندها لما هو أرضي أي فاسد، ودنيء، وناقص ومشوَّه نشأ تصورٌ أرستقراطيٌّ للفلسفة (لا يزال حاضرًا حتى اليوم) يكاد يحصرها في عوالم الفكر الداخلية التي تحتمي خلف جدرانها المفاهيمية والرمزية من وجه قذارة العالم الخارجي.
نتعرف عند هيغل في «فينومينولوجيا الروح» بوضوح إلى هذه الحالة النفسفلسفية اللاجئة إلى قوقعتها النظرية من لوثات العالم من خلال فكرته عن «الروح الجميلة» التي «تحرص على العيش بعيدًا من التماس مع الواقع خوفًا من تلويث الفعل لنقاء سريرتها».
كما أننا نقرأ عنده في الكتاب نفسه، لكن في فصل سابق، كيف تتعارض، بألم، القيم مع مجريات العالم دون أن تستطيع تغييره. ولعل هايدغر هو أكثر الفلاسفة الذين جسّدوا في فلسفتهم حول أنطولوجيا الوجود تلك «الروح النبيلة» الساعية للانسحاب من عالم الفعل.
- الفيلسوف والحاكم
لكن وعلى الرغم من أن «الأرواح الجميلة» تسكن معظم الفلاسفة وتدفعهم إلى الابتعاد من السياسة تنظيرًا وانخراطًا، فإن إغواءات عوالم السلطة والقوة والثروة والجاه والنفوذ طالما أغرت الفلاسفة الذين لا يملكون في الواقع سوى عدة نظرية ومفاهيمية.
وفي المقابل كثيرًا ما أغوت الفلسفة الحكّام الذين يملكون الجاه والثروة والسلطة، لكنهم يشعرون بفراغ روحي ونقص معرفي وامتلاك رؤية كلية للعالم والكون فيسعون إلى ملء هذا الفراغ ومعادلة هذا النقص بتقريب الفلاسفة والعلماء منهم.
إن علاقة الإغراء المتبادل -على خطورتها- بين الحاكم والفيلسوف هي من أقدم الظواهر التي عرفتها السياسة والفلسفة معًا، وهي لا تزال قائمة وموجودة على الرغم من تقادم عهدها.
هكذا عرفنا عبر التاريخ ظاهرة مستشار الحاكم، أو فيلسوف السلطان، أو ناصح الأمير. عن هذه الظاهرة يمكن أن نذكر كثيرًا من الأمثلة منذ سعي أفلاطون لتقديم المشورة لدنيس رغبةً في تجسيد أفكاره المثالية حول الجمهورية و«تنشئة الملك الفيلسوف».
مرورًا بأرسطو مربي الإسكندر الأكبر، أو تقريب الخليفة أبي يعقوب يوسف لابن طفيل ثم لابن رشد، وسعي كريستين ملكة السويد إلى نصائح ودروس وكتب وأفكار ديكارت، أو علاقة توماس هوبز بكرومويل، أو تلك العلاقة المتوترة التي طبعت علاقة فولتير بفريدريك الثاني ملك بروسيا،
بل إن هيغل نفسه المُنظِّر لفكرة «الروح الجميلة» كان يسمى -عن حق- فيلسوف الدولة البروسية. ويمكن لنا ذكر بعض الأمثلة المعاصرة من قبيل استدعاء فرانسوا ميتران لريجيس دوبريه مستشارًا سياسيًّا، أو، عربيًّا، تسمية عزمي بشارة مستشارًا لأمير قطر… إلخ.
لا شك إذن أن السلطة بما تحمله من قوة ونفوذ وقدرة على تحقيق الأفكار والمشروعات الفكرية في الواقع قد أغرت وأغوت العديد من الفلاسفة حتى إن الكاتب النمساوي روبرت موسيل (1880– 1942م) كان يُشبه الفلاسفة بالحكام الدكتاتوريين.
لكن ولأنهم لا يمتلكون جيوشًا تحت تصرفهم فإنهم يسجنون العالم في أنساق فلسفية. تظل مثل تلك العلاقة بين الفلسفة والسياسة أو الفيلسوف والسلطان موضع نقدٍ وتشكيكٍ، بل محلّ إدانة أخلاقية، ليس فقط من جانب فلاسفة «الروح الجميلة» الذين لا يجدون في اقتراب الفيلسوف من السياسة سوى انحطاطٍ فلسفي، وإنما كذلك من الفلاسفة العمليين الذين انخرطوا بنقد السياسة فلسفيًّا، ووضعوا نصب أعينهم مهمة نقد السلطة.
منذ تنظير غرامشي لمفهوم المثقف وسارتر (سارتر يُمثِّل حالة قلقة مترددة بين السُّلطة والسياسة) لمفهوم المثقف الملتزم، تحول «اليسار الفلسفي» إلى تبني تصور لدور المثقف الملتزم يتلخص في نقد كل أشكال السلطة، وأن الفيلسوف، بالتعريف، هو عدو الحاكم.
هكذا سُجنت علاقة الفيلسوف بالسلطة في سجن أخلاقي أيديولوجي ومنعت أي علاقة منتجة يمكن أن تنشأ بين الفلسفة والسلطة. ويمكن للمشككين الناقدين بعلاقة الفيلسوف بالحاكم تقديم قائمة طويلة بتاريخ فشل،
مثل تلك العلاقة وخطرها على الفيلسوف الذي لا يملك أمام سلطة الحاكم سوى الندم على تقربه من السلطة -ما عدا الحصول على الثروة الخاصة وبعض المصالح الشخصية- يفشل الفيلسوف غالبًا في تحقيق مشروعاته الفكرية عبر السلطان، ويخفق في حمل الحاكم على الركوع أمام مُثُل الحق والخير والعدالة التي توجِّه فكر الفيلسوف.
بين الفيلسوف صاحب «الروح الجميلة» النافر، والمشمئز، بل المتخوف والمختبئ من عالم الفعل والسياسة، وبين الفيلسوف المثقف بالمعنى غرامشي المنخرط في نقد السياسة والسلطة والمعارض أبدًا لكل أشكال السُّلط والحُكّام، يقف فيلسوف السلطة الذي -على الرغم من إنكاره من جانب فلاسفة الروح الجميلة المنسحبين من عالم الفعل.
ومن جانب فلاسفة اليسار الغرامشيين- يظل ذا حضور حقيقي وفعلي وموجود ويمثله مجموعة كبيرة من أسماء الفلاسفة الكبار. من بين تلك الثنائيات الملعونة يمكن ذكر نكبات بعض الفلاسفة مع الحكام مثل نقمة دنيس على أفلاطون، وانقلاب أبي يوسف يعقوب المنصور على ابن رشد،
وانتقام أبي جعفر المنصور من ابن المقفع الذي حاول نصحه، أو نفي الخِديو عباس الأول للطهطاوي، إلخ. في كل تلك الأمثلة كان الحاكم ينقلب على الفيلسوف، وينتقم منه، أو يطرده عنه في أحسن الحالات.
ينشأ هذا الإغراء المتبادل من عالمين متناقضين يعوز أحدهما الآخر: من رغبة الفيلسوف في امتلاك أدوات التغيير التي تتوافر عند السلطة (دون إغفال رغبته في الإثراء والسلطة والجاه والمنصب)، وسعي الحاكم ليحيط نفسه بمستشارين وخبراء (دون إغفال حاجته الروحية التي يتوقف عليها الفكر وتعوز غالبًا رجال السلطة الذين يملكون كل شيء تقريبًا عدا امتلاء الروح).
وبمعنى آخر يعود ذلك التناقض إلى التوتر بين «ما هو كائن» وراغب في الاستقرار وبين «ما يجب أن يكون» وراغب في التغيير. فإذا كان دأب السياسة التعامل مع الواقع أو كما تُعرّف أحيانًا بوصفها «فن الممكن»، فإن الفلسفة بنزوعها الأخلاقي المثالي تبحث عمّا يجب أن يكون مطالبةً السياسة بالتسامي نحو مثل الحق والخير والعدالة.
- الفلسفة السياسية ومحنة الجامعة
على الرغم من تاريخية وواقعية ذلك التوتر الذي استعرضته آنفًا بين الفلسفة والسياسة، فإن قَصر العلاقة بين الفلسفة والسياسة، على تلك الحدية الثنائية، فيه شيء من الكاريكاتورية والظلم لمباحث الفلسفة السياسية. فما هذه الفلسفة السياسية؟
يمكن لنا العودة إلى أرسطو، وتحديدًا إلى كتابه «السياسة»، للحديث عن أول ظهور لمصطلح «الفلسفة السياسية»، الذي قصد به نقد النظام السياسي، معيدًا فيه تعريف الإنسان بوصفه «حيوانًا سياسيًّا». وإذ يمنح أرسطو الفلسفةَ السياسية اسمَ «العلم الأول»، مثلها مثل الميتافيزيقا، فإنه يقدمها على هذه الأخيرة ويمنحها الأولوية.
لكن الفلسفة السياسية ستتراجع كثيرًا بعد أرسطو لتظهر من جديد وبقوة مع بداية العصور الحديثة، أي مع ظهور نظريات «العقد الاجتماعي» عند هوبز ولوك وروسو وكانط.
قبل ذلك كان لظهور كتاب الأمير لمكيافيلي في عصر النهضة دور كبير في التنظير للفكر السياسي البراغماتي والتمهيد لما سيغدو لاحقًا مدرسة الواقعية السياسية الأنغلوساكسونية التي ستنتهج نهج مكيافيلي المبكر في الفصل بين الأخلاق والسياسة.

أيًّا يكن، فإن الفلسفة السياسية الحديثة ستعتمد منذ كانط معيارية عقلانية صارمة، وستستمر الفلسفات السياسية المعاصرة بتطوير العمل المعياري على نظريات العقد الاجتماعي عمومًا كما هو حال نظرية العدالة لجان راولس أو ميكانيزمات السلطة في بعض كتابات ميشال فوكو، حيث ترتبط القوة بالمعرفة savoir-pouvoir.
تلك المعيارية الصارمة التي ميزت تطور الفلسفة المعاصرة ستدفع بفروع هذه الفلسفة العملية (أي السياسة والقانون والأخلاق) إلى الانفصال بعضها عن بعضها الآخر وتكوين مباحث شبه مستقلة، إلى أن انتهت الدراسات السياسية إلى «علم» مُستقل يُدرّس في جامعات الغرب.
هكذا لم تستقل الدراسات السياسية كمبحث معاصر عن الأخلاق والقانون اللذين ارتبطت بهما طويلًا فحسب، بل تشعبت إلى مبحثين (على الأقل) بين فلسفة سياسية وعلوم سياسية.
لكن ما الفارق بين العلوم السياسية والفلسفة السياسية؟ على الرغم من النقاش الدائم المشكك بإمكانية إطلاق اسم «عِلم» على مباحث السياسة، فإن «العلوم» السياسية تظل علومًا حديثة نسبيًّا وتنتمي إلى عائلة العلوم الإنسانية الواسعة الكبيرة.
وهي بذلك تتقاطع معها فتنقسم بدورها إلى مباحث في النظريات السياسية، وعلم اجتماع السياسة، والعلاقات الدولية، والدبلوماسية، والإدارة، والحُكم، والسياسات المقارنة… إلخ. بل إنها تدرس فلسفة السياسة كعلم فرعي تابع لها.
في المقابل، تهتم فلسفة السياسة بدراسة مفاهيم وعلاقات السلطة، والحكومة، والدولة، والشعب، والمجتمع المدني، والتعاقد الاجتماعي، والقانون، والحق، والسياسية، والحرية، والعدالة، والحروب، والسلام، والفاشيات، والديمقراطيات، والجمهوريات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي، وهي بهذا تتقاطع مع مباحث القانون ومباحث علوم السياسة.
في هذا الإطار الأكاديمي الضيق، تجد الفلسفة السياسية نفسها خاضعة لسلطة السياسة وموظفة عندها كمُخبرٍ موظف براتب زهيد؛ إذ تُؤَطَّر دراسات الفلسفة في الجامعات الغربية المعاصرة (خاصة الأنغلوساكسونية) وفق حاجات السياسة ووظيفيتها وتطبيقاتها، فيتم بسترة الفلسفة في برامج تطبيقية ذات نتائج ملموسة يمكن الاستفادة منها عمليًّا.
هكذا تحولت دراسة الفلسفة إلى دراسة مَخبَرية عبر مراكز البحث التي صارت تطالب الفلسفة بدراسات تنتجُ عنها بيانات أي أرقام وإحصائيات وتقويم عملي وتوصيات مباشرة وتقارير مختصرة ترسل إلى مصادر القرار السياسي. في كل ذلك طغت المنفعة الأداتية ولم يبقَ للفلسفة من دور حقيقي ولا حتى حضور.
- الفلسفة السياسية والتحرُّر
في برامج التدريس الجامعي المعاصر نحن، مرة أخرى، أمام مغامرة سيئة للفلسفة مع السياسة. ومع ذلك تظل الفلسفة السياسية حية خارج إطار سياسات الجامعة وخارج سجون مراكز البحث. من المهمات المُلِحّة اليوم في رأيي، التي تقع على عاتق الفلاسفة ورجال السياسة معًا، هو تجسير تلك الهوة التي لا تزال موجودة بين الفلسفة والسياسة.
على الفلاسفة مثلًا التوقف عن النظر (السلبي والرومانسي) إلى الفعل السياسي بوصفه قاعًا ومنزلقًا للفيلسوف، وإلى السلطة بوصفها شرًّا مُطلقًا لا بد للفيلسوف من نقده وفضح ميكانيزماته وتعريته.
لا بد للفلسفة أن تعيد النظر إلى السياسة بوصفها حاجة عقلانية نبيلة لإدارة شؤون البشر والمجتمع. عندها يتراجع (من جانب الفلسفة على الأقل) ذلك التوتر الثنائي عن خلق حالة من النبذ المتبادل بين الفلسفة والسياسة، بين المجتمع المدني والدولة، بين المثقف والسلطة، بين النظري والعملي، بين الحق والواجب، بين الأخلاق وتحمل المسؤولية السياسية،… إلخ.
لكن، إذ تحتاج الفلسفة إلى التقدُّم خطوة من عالم الواقع السياسي، عالم الفعل والعلاقات البشرية بين الدول والمجتمعات، فإن عليها ألا تذوب فيها أبدًا؛ فمهمة إصلاح النظام السياسي العالمي هي مهمة الفلسفة عمليًّا.
ولا يمكن الاتكال بذلك على الساسة الذين أعمت الصراعات عيونهم وتغلبت عندهم المصالح القومية الضيقة على ما أنجزته الأخلاق والفكر السياسي والقانون الدولي من منظمات ومؤسسات وقوانين ومعاهدات وقيم وحقوق إنسان.
نعم، يجب أن تخرج الفلسفة من برجها العاجي وتقترب من عالم الفعل وتتخلى عن سلبيتها تجاه الواقع (فلسفة الروح الجميلة) أو الاكتفاء بنقد السلطة وإدانة كل ما هو سياسي (اليسار الغرامشي). يجب أن تظل حافزًا لتغيير ما هو كائن نحو عالمٍ أفضل، عالمٍ أقل ظلمًا وأكثر عدالة وإنسانية.

يخطئ من يظن أن تاريخ العالم هو تاريخ تصاعدي ارتقائي تقدمي دومًا يسير نحو الاكتمال كما توهم عصر التنوير أو هيغل أو ماركس.
فكثيرًا ما يكبو التاريخ وتتراجع القيم وتطغى البربرية وغالبًا ما يكون ذلك تحت أسمى الشعارات وأكثرها نبلًا مثل تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء على الإرهاب.
قد يقول قائل (عن حق ربما): ها أنت تعود إلى أحلام الفلاسفة الطوباوية وتحلم بتأسيس جمهوريتك الفاضلة.
لا. لأني أعتقد أن على الفلسفة السياسية الالتزام بمعيارية عقلانية موضوعية (دون أن تغرق في الوضعية المتطرفة أو في نظريات الواقعية السياسية أو البراغماتية المصلحية وسلطة الأقوى)، وأن تتعامل مع الممكن، لتحقق ما هو طوباوي.
كل المؤسسات السياسية الحالية والمواثيق الدولية والقوانين الضابطة لها كانت في لحظة ما طوباوية: العقد الاجتماعي (روسو)، حقوق الإنسان (لوك)، الأمم المتحدة ومجلس الأمن (كانط)، الاشتراكية (ماركس)، على سبيل المثال لا الحصر.
ومع ذلك طغت القوة على الأخلاق في هذه المؤسسات وسمعنا ونسمع صوت الفلاسفة عاليًا مطالبين بإصلاح هذه المنظمات مقدمين الحجج والمبررات على ضرورة إعادة النظر في القوانين الدولية وحقوق الإنسان وحق اللجوء والضيافة والمواطنة،… إلخ.
تذكرنا الحرب الحالية على أوكرانيا بهشاشة المنظمات الدولية، وبسبب فقدانها للقوة والسلطة فإنها خاضعة عمليًّا إلى سلطة القوى العظمي التي تظل فوق القانون. فها نحن نتابع منذ عقود، على سبيل المثال، عجز مجلس الأمن عن محاكمة جرائم الحرب في سوريا البارحة وفي روسيا اليوم.
كما تذكرنا مأساة سوريا وأوكرانيا كيف تَعَطَّلَ مجلس الأمن مرات ومرات لتضيع العدالة ويفلت المجرمون الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وكيف ينجو المجرمون من العقاب.
إن إصلاح القانون الدولي والمنظمات الدولية هي مهمة فلسفية أولًا؛ فالقوى الكبرى (حتى لو كانت ديمقراطيات) لا مصلحة لها في تحقيق العدالة بقدر ما تريد فرض هيمنتها وتوسيع نفوذها وتحقيق مصالحها. كل هذا لا يكفي بمطالبة الفلسفة التدخل بتحليل السياسة فقط،
بل هو يؤكد الحاجة المُلِحّة لها في عالم يسوده الصراع الأعمى حيث تلتهم القوةُ العدالة، وتختفي الغاية خلف الوسيلة، وتتحول السياسة إلى مجرد واجهة هشة لا تحجب بشاعة القوة الجائرة وظلم الأقوى وجثة العدالة المعلقة على صليب الصراعات على السلطة والنفوذ والثروة…
- خلدون النبواني – باحث سوري.