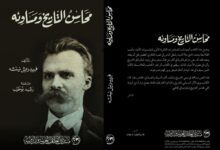مواقف وآراء العلماء من “علم الكلام”

- موقف أبي حنيفة من علم الكلام
هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ولد سنة 80 هـ على أرجح الأقوال، وتوفى سنة 150 هـ وقد اشتهر أبو حنيفة بالفقه وهو أحد أئمة الفقه الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة والمنتشرة في كافة بقاع الأرض، وهو أول متكلم سني في الإسلام، وأول ممثل حقيقي لمذهب أهل السنة والجماعة.
درس علم الكلام بالبصرة وكانت ملتقى النِحَل والآراء وبلغ فيه مبلغاً عالياً. وقد أطلق أبو حنيفة اسم الفقه الأكبر على الاعتقادات مقابلاً للفقه الأصغر الذي أطلقه على العبادات. والشك تطرق إلى كتاب الفقه الأكبر في صحة نسبه إلى أبي حنيفة لأنه يحتج على الأشعري والأشعرية وهي متأخرة عن أبي حنيفة قرنين من الزمان.
وفي بعض الروايات أن الفقه الأكبر ليس ما بين أيدينا، إنما هو كتاب في الفقه حوى نحو ستين ألف مسألة. وكانت أقوال مقاتل بن سليمان (150 هـ) في التشبيه والتجسيم قد انتشرت في هذا الوقت في خراسان، فأعلن أبو حنيفة تنزيهه الله – سبحانه وتعالى – عن مشابهة المخلوقات لقوله تعالى: (ليس كمثله شيء).
وأبو حنيفة أول من وضع الفروق الدقيقة بين صفات الذات وصفات الفعل. ومسألة خلق القرآن قد أثيرت في عهده، وقد صرح في الفقه الأكبر أن كلام الله غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله وهو قديم.
وقد كان أبو حنيفة أول القائلين بالمذهب الكسبي الذي سيكون سمة لأهل السنة والجماعة، ويورد الملا علي القاري نصوصاً متعددة عن الإمام أبي حنيفة من كتاب الوصية تثبت إيمانه بنظرية الكسب وأنه أول من وضعها، فيقول القاري: «…وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره».
وهناك موقفان لأبي حنيفة من علم الكلام، الموقف الأول هو اشتغاله بعلم الكلام، والموقف الثاني هو رجوعه عن الاشتغال بعلم الكلام، ونهيه عن الاشتغال به، ومعظم الروايات قد ذكرت هذين الموقفين، منها ما ذكره الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي في «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان».
يذكر في موقف أبي حنيفة من علم الكلام أنه في بداية طلبه للعلم، اشتغل بعلم الكلام، وبلغ فيه مبلغاً يشار إليه فيه بالبنان، وأعطى فيه جدلاً، فمضى عليه زمن به يخاصم، وعنه يناضل، حتى دخل البصرة لأن أكثر الفرق كانت بها، يقيم في بعض المرات سنة أو أكثر ينازع تلك الفرق من الخوارج والمعتزلة والروافض وأهل الإرجاء، لأنه كان يعد علم الكلام أرفع العلوم وأفضلها وأشرفها لكونه في أصول الدين.
وهذا الموقف يبين تأييد أبي حنيفة لعلم الكلام واشتغاله به. ولقد ناظر الخوراج، وعارض الآراء المخالفة لأهل السنة، ولقد ذكر عنه قوله: «قاتل الله جهم بن صفوان، ومقاتل بن سليمان، هذا أفرط في النفي وهذا أفرط في التشبيه».
وهذا يدل على مناصرة أبي حنيفة لآراء أهل السنة، ونقرأ أيضاً في مصنفات أبي حنيفة كـ«العالم والمتعلم» دفاعاً عن علم الكلام.
وأيضاً كان مذهبه الفقهي ذو صبغة عقلية يغلب فيه الأخذ بالرأي والقياس وربما كان هذا نتيجة لاشتغاله بعلم الكلام حقبة من الزمن في أول اشتغاله بالعلم. أما الموقف الثاني: وهو معارضة أبي حنيفة لعلم الكلام ونهيه عن الاشتغال به، ويرجع موقف معارضة أبي حنيفة لعلم الكلام إلى كرهه التعمق في الجدل وأن يكون الجدل من أجل الجدل، وأن يقصد به تكفير المخالف.
ويتضح ذلك عندما نهى أبو حنيفة ابنه حماد عن الاشتغال بعلم الكلام، فقال له حماد: «رأيتك وأنت تتكلم، فما بالك تنهاني»؟! فقال: «يا بني كنا نتكلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يزل صاحبه، وأنتم اليوم تتكلمون وكل واحد يريد أن يزل صاحبه ومن أراد أن يزل صاحبه فكأنه أراد أن يكفر، ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه».
وعلى هذا يمكن القول بكراهية أبو حنيفة لنوع معين من علم الكلام، وأنه لا يعارض أن يكون الجدل على قدر الحاجة، أما ما وراء الحاجة فإنه منهي عنه.
- المؤيدون
نجد فريقا من المسلمين أيد الاشتغال بعلم الكلام، ويقف على رأس هؤلاء المؤيدين المتكلمين أنفسهم، وهؤلاء رأوا ضرورة النظر في أصول الدين وإثباتها بالعقل، إذ أن الإيمان القائم على العقل أقوى من الإيمان الذي يقوم على التقليد، وساقوا الأدلة والبراهين على صحة موقفهم وأشاروا إلى ضرورة النظر في مصنفاتهم.
بل وأفرد بعضهم كتبا خاصة لأهمية النظر، منها على سبيل المثال استهلال الماتريدي كتابه التوحيد ببيان أن سبيل معرفة الدين تتم بالنظر بجانب العقل، وفي ثنايا كتابه الضخم تأويلات أهل السنة في مواضع كثيرة تأييد لاستخدام النظر في الدين، بل إن هذا الكتاب يقوم على أساس هذه الفكرة.
ونجد لأبي الحسن الأشعري كتاب استحسان الخوض في علم الكلام يبين فيه ضرورة النظر في الدين، وأن النظر مأمور به وليس منهياً عنه، ومن بعده نجد الأشاعرة أمثال: الباقلاني والجويني وغيرهما يوضحون أهمية النظر في الدين، وفي فريق المعتزلة نجد دعوة واضحة وصريحة لأهمية النظر، بل تقديمه على النقل والسمع، إذ عليه يتوقف صحة النقل.
ونجد ذلك في مؤلفاتهم كما ذكرها القاضي عبد الجبار في «المحيط بالتكليف» و«شرح الأصول الخمسة» وأفرد جزءاً من كتابه «المغني» بعنوان «النظر والمعارف» على بيان أهمية النظر وأنه أول الواجبات على المكلف. ولقد قدم هذا الفريق أدلته العقلية والنقلية منها ما ذكره عضد الدين الإيجي في المواقف:
الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وأن إيمان المستدل أقوى من إيمان المقلد الذي يكون عرضة للشكوك، ولا يستطيع دفع تلك الشكوك لأنه لا يملك الدليل على صحة إيمانه.
إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة.
حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين.
أنه يبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه يؤول أخذا واقتباسا.
صحة النية والاعتقاد، إذ بها يرجى قبول العمل وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين.
وهذا الفريق يرى أن علم الكلام هو أعلى مرتبة في العلوم، إذ أن موضوعه أعم الأمور وأعلاها وغايته أشرف الغايات وأجداها ودلائله يقينية يحكم بها صريح العقل، وقد تأيدت بالنقل وهي الغاية في الوثاق وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوها، فهو إذن أشرف العلوم.
واستند هذا الفريق إلى ما ورد في القرآن في أكثر من موضع في الحث على النظر، وإقامة البرهان والدليل، والتماس العلم والبعد عن الظن.
الإمام أبو حنيفة في رده على من ذم علم الكلام بحجة أن الصحابة والسلف لم يتعلموه ولم يخوضوا فيه فقال: «وقد ابتلينا بمن يطعن علينا، ويستحل الدماء منا، فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطئ منا ومن المصيب، وأن نذب عن أنفسنا وحرمنا، فمثل صحابه النبي الكريم كقوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح، ونحن قد ابتلينا بمن يقاتلنا فلا بد لنا من السلاح».
قال النووي في شرح صحيح مسلم: «قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة المبتدعين وما أشبه ذلك».
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية: الذي صرح به أئمتنا أنه يجب على كل أحد وجوبا عينيا أن يعرف صحيح الاعتقاد من فاسده، ولا يشترط فيه علمه بقوانين أهل الكلام لأن المدار على الاعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الأصح.
وأما تعليم الحجج الكلامية والقيام بها للرد على المخالفين فهو فرض كفاية، اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام أو ءالاته فيجب عينا على من تأهل لذلك تعلمه للرد على المخالفين.
قال شمس الدين الرملي: التوغل في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وإزالة الشبه فرض كفاية على جميع المكلفين الذين يمكن كلا منهم فعله، فكل منهم مخاطب بفعله لكن إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين، فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به.
قال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين: ولم يكن شيء منه – علم الكلام- مألوفا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة ونجت جماعة لفقهوا لها شبها ورتبوا فيها كلاما مؤلفا.
فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذونا فيه بل صار من فروض الكفايات وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة. وقال أيضا: فإذن علم الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة.
قال شمس الدين السمرقندي في الصحائف الإلهية: «فإن العلوم وإن تنوع أقسامها لكن أشرفها مرتبة وأعلاها منزلة هو العلم الإلهي الباحث بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة عن أحوال الألوهية وأسرار الربوبية التي هي المطالب العليا والمقاصد القصوى من العلوم الحقيقية،
والمعارف اليقينية إذ بها يتوصل إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته، وتصور صنعه ومصنوعاته، وهو مع ذلك مشتمل على أبحاث شريفة ونكات لطيفة بها تستعد النفس لتحقيق الحقائق، وتستبد بتدقيق الدقائق».
ويقول محمد السيد البرسيجي في تحقيقه لكتاب بحر الكلام للإمام أبي المعين النسفي: “والذين ينكرون على أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية اشتغالهم بعلم الكلام ماذا يريدون منهم؟ هل يريدون منهم أن يتركوا علم الكلام الذي ينزه الحق تبارك وتعالى عن صفات المخلوقات والمحدثات، ويشتغل بكلام المشبهة والمجسمة من الذين ينتسبون زوراً إلى السلف.
والذي ينفر منه كل ذي طبع سليم، فأين كلام هؤلاء المشبهة والمجسمة من كلام أئمة أهل السنة والجماعة؟! يقول الإمام الماتريدي متحدثاً عن ذات الله تعالى: «وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له – لا على جهة وحدانية العدد، إذ كل واحد في العدد له أنصاف وأجزاء – لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد، إذ في إثبات الضد نفي إلهيته.
وفي التشابه نفي وحدانيته، إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد، وهما علما احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. والله تعالى واحد لا شبيه له، دائم قائم لا ضد له ولا ند، وهذا تأويل قوله تعالى: {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} [الشورى: 11].».
وانظر إلى قول اللامشي في كتابه “التمهيد لقواعد التوحيد” متحدثاً عن نفي الجسم والصورة عن الله تعالى حيث قال ما صورته: «وإذا ثبت أن الله تعالى لا يوصف بالجسم، فلا يوصف بالصورة أيضاً؛ لأن الصورة لا وجود لها بدون التركيب.
وقال بعض المجسمة ممن ذكرنا أساميهم: إن الله تعالى على صورة الآدمي، وله من الأعضاء ما للآدمي، وإنه على صورة شيخ أبيض اللحية، وقال بعضهم: إنه على صورة غلام أمرد له شعر جعد قطط. وحُكِيَ عن هشام بن الحكم أنه قال: إنه كالسبيكة الصافية يتلألأ.
وفي كل ما قالوا إثبات كونه محدثاً. وقد نفينا ذلك بحمد الله تعالى.» فقارن بين كلام أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعرية وكلام غيرهم من المجسمة لتعرف الفرق ﴿فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون﴾ [الأنعام: 81].
وقد عقد ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فصلاً في الكلام على من زعم أن علم الكلام بدعة وردوده عليه. وفيه يذكر أن الإمام الشافعي كان يكره كلام أهل الأهواء والبدع، أما الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضّح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو محمود عنده وقد كان الشافعي يحسنه وبلغ فيه مبلغاً عظيماً.
وكراهية الشافعي لعلم الكلام لم تكن تنصرف إليه كعلم، وإنما تنصرف إلى كلام القدرية وأهل الأهواء والبدع. وقد روي عنه أنه ناظر حفص الفرد في الإيمان وخلق القرآن. ويروي ابن عساكر عن الشافعي أنه كان يجيد علم الكلام بقوله: «لقد دخلت فيه حتى بلغت منه مبلغاً وما تعاطيت شيئاً إلا وبلغت فيه مبلغاً حتى الرمي كنت أرمي بين الغرضين فأصيب من عشرة تسعة».
وهذا دليل على أنه تعلم الكلام وبلغ فيه مبلغاً عظيماً، ثم استحب ترك المناظرة فيه لأنه خشى أن يحل الكلام والجدل محل الكتاب والسنة خاصة وأن علم الكلام في عصره كان على طريقة المعتزلة من المبالغة القصوى في استخدام العقل في أمور العقيدة.
فكان يخشى أن يتحول الدين إلى قضايا عقلية فلسفية وبراهين منطقية وهذا ما حدث بالفعل. والشيخ محمد أبو زهرة يقول عن الإمام الشافعي: «وليس الشافعي العاقل هو الذي ينهي عن أمر لا يعرف موضوعه ولا يتصوره، إذ الحكم على شيء فرع عن تصوره».
وقد أورد الشيخ محمد أبو زهرة بعض آراء الشافعي في مسائل الكلام باختصار في قوله عن الشافعي: «كان يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق ويعتقد برؤية الله يوم القيامة ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وأن الإيمان تصديق وعمل.
ولذلك يزيد وينقص ويرى أن الإمامة لابد منها وأنها في قريش وكان يرى أبا بكر أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه ويرى أن معاوية وأصحابه كانوا الفئة الباغية وقد أخذ بسيرة علي في معاملة البغاة في كتابه الأم».
ويرى محمد أبو زهرة أن الشافعي إذا كان كره الكلام وذم المتكلمين فلم يكن ذلك إلا أنه أراد المعتزلة بالذم لمغالاتهم في الكلام وتطرفهم في استخدام العقل في الدين، فيقول أبو زهرة في كتابه عن الشافعي: «إذا سمعت الشافعي وابن حنبل وغيرهما يذمون علم الكلام ومن يأخذ العلم على طريقة المتكلمين فإنما أرادوا المعتزلة بذمهم».
ويرى أهل السنة والجماعة أن سند مذهبهم إنما يعود إلى علي بن أبي طالب ويعتبرونه أول متكلميهم ويذكرون أنه ناظر الخوارج في مسألة الوعد والوعيد وناظر القدرية في المشيئة والاستطاعة، ثم عبد الله بن عمر وقد ورد عنه أنه تبرأ من معبد الجهني في نفيه القدر.
ويتدرج الدكتور علي سامي النشار من عبد بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز (ت 101 هـ)، فالحسن البصري (ت 110 هـ)، فزيد بن علي (ت 122 هـ)، ويذكر كذلك عامر الشعبي (ت 105 هـ)، ثم ابن شهاب الزهري (ت 124 هـ)، ويلي هذه الطبقة مباشرة الإمام جعفر الصادق (ت 148 هـ).
ويجعل عبد القاهر البغدادي أول المتكلمين من الفقهاء أبو حنيفة النعمان ثم محمد بن إدريس الشافعي، ويذكر أن لكل منهما كتاباً في الرد على القدرية. وما ذهب إليه البغدادي من اعتبار أبي حنيفة والشافعي أصحاب كلام صحيح لأننا نستطيع أن نجد عندهما مذهباً كلامياً متناسقاً.