الإنسان .. الطبيعة واللغة

من أين أتينا؟ ومن نحن؟ وإلى أين نذهب؟ هذا السؤال المثلث، هو ما طرحته مجلة “العلوم والمستقبل” الفرنسية، في عددها الخاص الذي صدر مع مفتتح العام الجديد، والذي كرّسته للكلام على الإنسان.
وقد وجّه السؤال إلى مئة من مشاهير العلماء والفلاسفة، من مختلف الاختصاصات والجنسيات، على أن يكتب كل واحد إجابته في حدود صفحة واحدة أو صفحتين، استثناء، يوجز فيها خبرته ومعرفته وفلسفته في هذه المسألة، التي هي أم المسائل في النهاية.
ولو طُلب إليّ أن أسمي عملاً ثقافياً استأثر باهتمامي مع توديع عام واستقبال آخر، فسأختار العدد المذكور. أولاً؛ لهذا التنوّع الفائق في الإجابات، ثانياً؛ لأن المقاربات كتبت بلغة سهلة تصل إلى عموم القراء، ولكنها في الوقت نفسه موجزة بقدر ما هي غنية وكاشفة.
ثالثاً؛ لأن الموضوع هو الإنسان الذي هو السرّ واللغز، بقدر ما هو المفتاح والباب، وهو إلى ذلك مصدر الحيرة والالتباس والارتباك، ولذا لا تنفد الكلمات التي يصف بها نفسه، كما لا تنفد الكلمات التي يصف بها الأشياء والعالم.
وسأتوقف عند بعض الإجابات. الأولى لعالم الحياة الفرنسي ديدييه راوول، المختص في الميكروبات، وهي ملخص أطروحته التي يدحض فيها نظرية التطور، وكما يشرحها في كتابه الذي صدر حديثاً بعنوان “فلنتجاوز دارون”.
ومعلوم أن نظرية التطور تفسر نشوء الكائنات الحية، بما فيها الإنسان، من خلال مفاهيم الأصل والشجرة والانتقاء والبقاء للأصلح، وفقاً لمسار تسلسلي تصاعدي، مفاده أن الإنسان هو حبة الكرز في كعكة الأنواع الحية، أي ذروة التطور وغايته.
ما يعترض به راوول على دارون، هو أولاً؛ أنه لا يجاريه في نظرته التفاؤلية، لأنه يعتبر أن الطبيعة لا تنتخب فقط، بل هي لا تنفك عن خلق أنواع جديدة، قد لا تكون مفيدة، إذ هي لا تكترث كثيراً بمصائرنا، نحن الذين ننشئ النظريات حول الانتقاء الطبيعي.
أما الاعتراض الأساسي، فإنه يكمن في أن راوول يذهب، استناداً على بحوثه المختبرية، إلى أن للكائن الحي مصادر مختلفة ومتعددة.
فالإنسان لا ينحدر فقط من آبائه، جيلاً بعد جيل، وإنما هو أيضاً صنيعة المليارات من الميكروبات التي تعشش في جسده وتعمل فيه، والتي تنطوي برامجها الوراثية على أجهزة إعلامية، تماماً كبرنامج الإنسان.
ولهذا يستبعد راوول مفهوم الشجرة، الذي يعتبره مجرد تهويم خرافي، لكي يحل محله مفهوم المنظومة أو الشبكة. وهكذا، كل كائن حي يشكّل، بحسب هذه النظرة، منظومة بيئية بالغة التعقيد، بقدر ما هو حصيلة الميكروبات والفيروسات التي يتأثر بها جسمه ويؤثر فيها.
طبعاً هناك تطوّر، وهناك أب أعلى ينحدر منه كل فرد أو كل جيل من أبناء البشر، ولكن له أيضاً جد جرثومي أو فيروسي.
بهذا المعنى، ليس الإنسان الأوروبي مجرد تهجين بين الأشكال الأولى التي انحدر منها، كالإنسان الصانع وإنسان نياندرتال، وإنما هو أيضاً سليل الجينات التي يستوردها جسمه من الكائنات المجهرية بالغة الصغر.
وهكذا نحن إزاء انقلاب يغيّر النظرة إلى الحياة بصورة جذرية، لكي ندخل في حقبة ثالثة من أطوار علم الحياة: الطور الأول غطته “عقيدة الخلق”، من خلال استعارة “اللوحة”، حيث الأنواع الحية بقيت على ما هي عليه، من دون تطوّر أو تحوّل، منذ بداية الخليقة، أي منذ خروجها على يد بارئها.
الطور الثاني غطته “نظرية التطوّر”، من خلال استعارة “الشجرة”، حيث الكائنات الحية يتفرع بعضها عن بعض، وفقاً لخط تدرجي عمودي، لكي تزداد تعقيداً وكمالاً.
الطور الثالث، وهو ما يحاول تدشينه راوول، من خلال مفهوم “المنظومة البيئية“، حيث الكائن البشري هو “كيس من الميكروبات” أو موزاييك من الجينات التي تتبادل الرسائل. وهكذا فما تفعله الكائنات الحية، في نظره، هو تبادل الجينات، بما يشكل مسرحاً لعربدة جماعية هائلة.
بهذا يحاول راوول توجيه ضربة لدارون، لإنزاله عن عرشه وتحطيم صورته كصنم احتل المشهد لعقود طويلة، تشبه الضربة التي وجهها الفيلسوف ميشال أونفراي لصنم آخر من شيوخ الفكر والعلم، هو فرويد مؤسس التحليل النفسي.
نحن إزاء محاولة قتل الآباء للتحرر منهم، والتحرر يتخذ دوماً طابعاً عنيفاً في الابتداء. وفي ما بعد تهدأ الأمور وتعود إلى نصابها، ولكن لا شيء يعود كما كان. بمعنى أننا نتجاوز دارون.
ولكن ليس بإلغائه والتخلي عن المكسب التطوري الذي أنجزه، بل بإدراجه في سياق جديد مختلف، أكثر وسعاً وتركيباً؛ بحيث يصبح التطور، كما صاغه دارون، أحد العوامل الرئيسية في تفسير نشوء الحياة، ولكن ليس العامل الوحيد أو الأوحد. وهذا مثال على أن العلم يتطوّر بكسر القوالب وتحطيم الأوثان، ولو كانت علمية.
أما الإجابة الثانية فكانت للنرويجي أريلد أوتاكر، الذي هو عالم لغة. وعنوان إجابته: الإنسان هو شيء لا يخصك ولا يخصني. وهي تصدر عن أطروحة مفادها أن ظهور الإنسان شكّل جدة لا سابق لها في مسيرة التطوّر، من معالمها استخدام النار، صنع الأدوات، دفن الموتى، وبالأخص اختراع اللغة.
وقد تمكّن البشر، بفصل لغاتهم وأدواتهم، التي شكلت وسائط بينهم وبين محيطهم أو بينهم وبين أنفسهم، من خلق عش بيئي يشبه خلية النحل.
ولكن مع فارق بالطبع، هو أن الإنسان تمكن من تثبيت أقدامه وتأمين شروط عيشه، بقدر ما أفلت من قوانين التطوّر، فهو الكائن الوحيد الذي هو ثمرة التطوّر، ولكنه قادر في الوقت نفسه على التدّخل في مساره، عبر العمل على تدجين الطبيعة.
وتلك هي ثمرة الثقافة بمنظوماتها المتنوعة والمتعددة. لقد شكّلت نوعاً من “الفتحة” الوجودية، التي بسببها تحرر الإنسان من منطق المطابقات والماهيات، لكي يندرج أو يخلق مجاله العلائقي، وهو أخص مزاياه، برأي أوتاكر.
ويأخذ مثالاً على ذلك، اللغة التي لا يعتبرها بنية محفورة في ذاكرة الإنسان على شكل “نحو كلي“، معارضاً بذلك اللغوي الأميركي نعوم تشومسكي، ولكن من دون تسميته. فاللغة في نظره، هي علاقة المرء بنفسه وبالآخرين وبالأشياء.
بهذا المعنى، تشكّل اللغة سلاحنا البيئي والعلائقي، بوصفها منظومة من الاتصالات تختلف عما لدى الحيوان وعن الآلات، وذلك لأن الكلام هو شيء يستقل بوجوده عن جسم المتكلم، وإن كان لا يوجد إلا به. فهو ليس ملكي ولا ملكك ولا ملك أحد، مما يحرّر الواحد من علاقة التطابق المباشرة مع النفس والأشياء.
وهكذا يكسر أوتاكر منطق الماهية لصالح منطق العلاقة. هنا أيضاً، يتطوّر العلم بكسر القوالب الجامدة والنظريات الأحادية. وفي هذا شاهد على أن اللغة هي كالطبيعة، لا تعمل في النهاية، وفقاً لنظرياتنا أو رغباتنا، بل هي تتجاوزنا، ربما لأنها شرط وجودنا ومنبع بيئتنا البشرية.
ولذا يخلص اللغوي النرويجي إلى القول ان الإنسان هو كائن مؤقت بقدر ما هو علائقي، وقد لا تنقذه طبيعته، بقدر ما تتجاوزه لغته. فهل تنقذه معارفه وأدواته؟









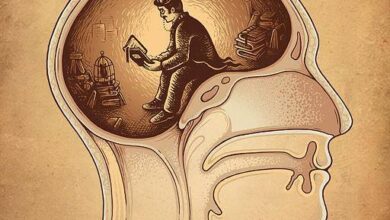





د. علي لا يفرق بين نظرية النشوء ونظرية التطور.. كما ان قوله ان ديدييه راوول يدحض نظرية التطور هو خطأ فاحش