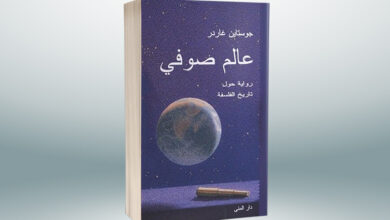سطوة الحكاية وسرديات الاستعادة في رواية (في بلاد النون)
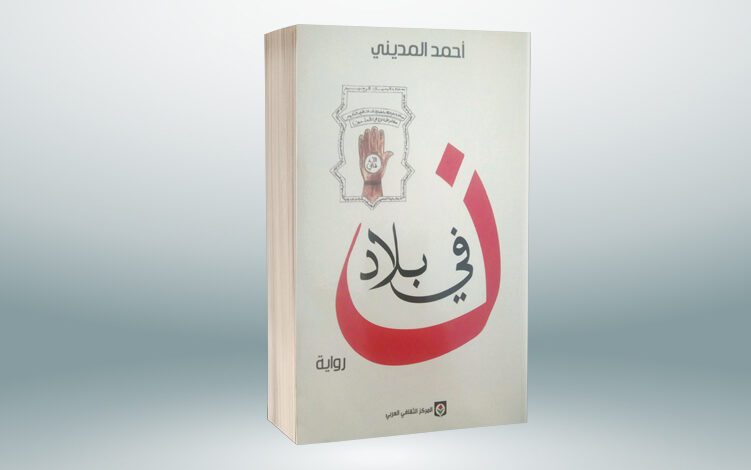
الكتاب: “في بلاد نون”
المؤلف: أحمد المديني
الناشر: المركز الثقافي العربي
تاريخ النشر:2018
عدد الصفحات: 320 صفحة
ليس هَجْرُ التّحبيك في بناء النَّص الروائيّ سوى مناورة سردية بإتجاه استعادة البنية الحكائية، والقصد من وراء ذلك تقديم توليفة مبتدعة جديدة يتوحد فيها المتخيل السرديّ بالوقائعيّ، لصنع صورة ما بعد حداثية لسرديات يمكن أن نصفها بـ(سرديات الاستعادة) تبغي توجيه الجنس السردي نحو الحكاية، مدخلةً إياها عنوةً أو يسرًا في بنيته، تعبيرًا عن أزمة بلغتها رواية ما بعد الحداثة.
والسؤال هنا أليستْ الحكاية نمطًا عفا عليه الزمن، واشتغالًا لا ينطوي على احتراف، كونه لا يواكب ما بلغه الحبك من غايات خطابية تستفز القارئ وتدفعه إلى الاندماج في صلب البناء السردي متلقيًا ضمنيًا كان أم حقيقيًا؟
لا خلاف أنَّ التحبيك في أي عمل روائي هو عنصر فاعل في الارتقاء بالقصّ من الاتباع إلى التسبيب، ومن سرد حكاية تاريخية إلى سرد قصة متخيلة، وذلك من منطلق نظريّ يرى أنَّ السرد ليس هو القص. وإذا كان القص متلفظًا خياليًا يُنتج حكيًا، فإنّ السَّرد فعل واقعيّ ينتج خطابًا. ولا شك أنّ التمثيل على الأول موجود في مرويات السّرد القديم، أما التمثيل على الثاني فموجود في السرديات الحداثية والمعاصرة.
وكان جيرار جينيت قد ميّز بين قصة/حكاية حيث الحكاية هي خطاب يتلقى شفاهيًا، وبين قصة/حبكة حيث القصة هي ترتيب الأحداث المسرودة منطقيًا. وإذا كان هناك تعارض شكلاني بين القصة والحبكة؛ فإن التعارض بين القصة والحكاية عديم المعنى(1)، ما لم يتحقق بالدمج بين الثلاثة(القصة/الحكاية/السرد).
وفي هذا الدمج يُدخل النص المتخيل المحض في النص التاريخي، فتغدو الحكاية داخلة في السرد، على أساس أنّ المشكلة ليست في تحبيك الزمن؛ وإنما في الجهة التي تنطق بالحكي التي هي في الأصل ليست متخيلًا محضًا، بل هي تاريخ متحقق.
وبهذا التصور الاستعادي للحكاية عند جينيت يصبح ما كان مندرجًا في الحكاية بوصفه متخيلاتٍ لفظية لتاريخ واقعي، هو النص بعينه وقد تضمن داخله نصين: نص السارد ونص الشخصية أو الشخصيات.
وهو ما أراده جيرار جينيت لسرد ما بعد الحداثة، أي أن يكون السرد مستعدًا لاستعادة الحكاية في بنائه النصي. واستعادة الحكاية تعني إعادة التمثيل إزاء البحث عن صورة للماضي، هي غير تلك التي تدلنا عليها الوثائق والبيانات والمستندات.
وقد أكد آر جي كولينجوود ـ حسب ما ينقل عنه جيم مردوخ Jim Murdoch أنّ الحبك لم يعد في عصرنا هذا قادرًا على تعليل الزمن التاريخي، لأنّ التاريخ ليس الماضي بمظهر “خارجي” قابل للملاحظة، بل هناك ما هو “داخلي” لا يمكن وصفه إلا بالمتخيل التاريخي أي التفكر في محكي الأحداث الماضية والتيقن من أنّ جزءًا من الحدث التاريخي يمكن إدراكه باستخدام حواسنا.(2)
والاستعادة الحكائية للتاريخ ترد عند جيرار جينيت باصطلاح آخر هو (السرد مثلي الحكاية) وفيه يكون ضمير أنا المتكلم تمييزيًا، لأنه يجعل التبئير واقعًا على السارد بما يجعل نص السَّارد هو نفسه نصُّ الشخصية، بعكس السَّرد بضمير الغائب الذي هو غيريّ القصة، لأنّ فيه يتنافر صوت الشخصية مع صوت السارد وعندها يقع التبئير على الحدث المسرود متحولاً به من الحكي إلى القص.
وهذا التعاقد على إعادة صياغة الخيالي في شكل واقعي هو تحويل للشفهي إلى مكتوب، فتكون الحكاية حكاية أفكار، والرواية رواية بحث كسيرة ذاتية أو رواية نفسية، وهذه هي أهم تمثيلات السرد مثلي الحكاية حيث القصة تصنع نفسها بنفسها.
وبهذا تكون مثلية الحكاية استعادية بينما غيرية القص تظاهرية وافتراضية، يقول جينيت: “يفترض في التاريخ والسيرة والسيرة الذاتية أن تعيد إنتاج خطابات ملغاة فعلاً ويفترض في الملحمة والرواية والخرافة والاقصوصة أن تتظاهر بإعادة انتاج خطابات مختلقة وبالتالي أن تنتجها في الواقع”(3).
وسنقصر حديثنا هنا على التاريخ الذي فيه المحكي التاريخي نمط من أنماط تمثيل سرديات الاستعادة إذ السارد مؤرخ أو يريد أن ينتحل صفة المؤرخ، منتزعًا التأرخة منه، مشككًا في مدونات التاريخ، ليخط مدوناته بإبداعه معيدًا إنتاج التاريخ بالاستعانة بالمتخيل الحكائي.
وهو ما ينتج رواية التاريخ(4) ومن أمثلتها (اسم الوردة) لامبرتوايكو التي فيها يظهر هذا الولع باستعادة المحكي التاريخي حول غموض العالم وخطاياه وفعل الشر واللاتناهي في الإلوهية. وبالشكل الذي يجعل المتخيل الحكائي قادرًا على تفنيد ما حفظه التاريخ،
يقول ايكو: “ولفهم الأحداث التي وجدت نفسي أشارك فيها فهما جيدًا قد يكون من الأفضل أن أذكِّر بما كان يحدث في تلك الفترة من بداية القرن كما فهمتها آنذاك وأنا أعيشها وكما أتذكرها الآن وقد أضيفت إليها حكايات سمعتها من بعد أن استطاعت ذاكرتي أن تصل بين خيوط تلك الأحداث المتعددة والغامضة جدًا”(5).
وهو ما فطن له أيضًا الروائي المصري جمال الغيطاني في رواية التاريخ (الزيني بركات)(6) التي فيها يستعين السارد بالمتخيل الحكائي من أجل مواجهة بصاصي القاهرة، محاولًا بذلك إعادة كتابة تاريخ القاهرة.
وهو ما نجده في رواية (في بلاد النون)(7) للروائي والناقد المغربي أحمد المديني التي فيها يعمل المتخيل الحكائي على جعل السرد مثليًا يروي نفسه بنفسه، من خلال استعادة توظيف الفعل الحكائي بطريقة تنميطية، تتداخل فيها الحكاية بالسرد، فيغدو الكون القصصي استعاديًا لمرويات المقامات والحكايات الشعبية، كإشارة اليغورية إلى ضمور الحداثة السردية أمام كفاءة القدامة السردية ورسوخها بما يجعلها قابلة للاستمرار الإبداعي في السرد ما بعد الحداثي.
ومن خلال تداخل الحكايات يَنتجُ لنا تعدد صيغي فيه حكاية أولى لسارد خارج القصة هو الحكَّاء الذي يُسمى بالحكواتي في بلاد المغرب العربي والقصخون في بعض بلاد المشرق العربي، والحكاية الأخرى هي نص محاذٍ يؤديه سارد قابع داخل الحكاية ويفكر بالحكاية نفسها. وعلى هذا الحكاء تقع مهمة تحقيق الوهم الحكائي الذي به ينمحي المقام السردي، ليكون الإنسان هو الأسمى ويغدو انتظار الفرج طوباوية مثلى بأنساق تخييلية معينة.
وهو ما راهن عليه د. أحمد المديني جاعلاً الاستعادة لفن الحكاية برتوكولاً سرديًا هو في الأساس استراتيجية نصية لا تريد تشييد رؤيا للعالم بالوعيين القائم أو الممكن اللذين يحققهما الإيهام السردي وقد تداخل الواقعي بالتخييلي، بل تريد تهديم رؤيا العالم أصلًا وإقامة يوتوبيا عالم آخر بدلها هي (بلاد نون) التي بشّر الحكّاء بها الناس طالبًا منهم الانتظار،
لا بوصفه ساردًا عليمًا ولا مشاركًا وإنما بوصفه ساردًا منجمًا وعرّافًا متنبئًا “أنا لست مبشرًا ولا مناضلًا انتظر ما سيحمله الغد من قوي جديد. أنا حكواتي بائع حكايات وشاريها أيضًا إذا وجدت، احتاج أن أتغذى دومًا بالأخبار .. مثلي لا يناسبه الاستقرار. الحكاية في الحلقة تنتقل .. تسير.. وهي تخترق الوقائع والأحلام”(8).
ويحتار الناس في هويته وحقيقته فهو تارة عشّاب دجّال يتاجر بالرقى، وتارة أخرى هو وليٌّ صالحٌ يحمل أورادًا وأدعيةً واذكارًا، وله كتاب (الاستغفار في عجائب الأمصار). وبسبب هذه الحيرة التي يتركها الحكّاء في نفوس متلقي حكاياته، يفخر بقدرته على الايهام التي منها يتحصل على رزقه “أنا السارد لا غنى عني احتاج أن أكون في كل مكان”(9) ولا يتوانى من استعمال اللهجة العامية المغربية في حكاياته، لكنه يعمد إلى جعلها مكتوبة بخط غامق تمييزاً لها عن السرد، وتوكيدًا أنّ الشفاهية هي أصل هذا الحكي المكتوب.
أما سائر السطور المكتوبة بخط فاتح وباللغة الفصحى فتشير إلى أن هذا السرد هو استعادة لتلك الشفاهية. وكثيرًا ما تكون العامية مدعّمة بذكر أمثال شعبية معروفة مثل (كل تأخيرة فيها خيرة/ما تسلم الجرة كل مرة/كيد الشياطين ولا كيد النساء).
وبهذا يسّكُّ البناء الروائي لغة جديدة من رفات اللغة الكلاسيكية في الحكاية القديمة، فلا تعود هناك قطيعة مع السرد القديم، بل هي قطيعة مع السرد الحديث، حيث الارتحال المكاني يتخذ سيولته من الماضي، محتويًا الواقعي والتاريخي.
ويتناوبُ ضميرًا المتكلم والمخاطب على سرد الراوية ذات الفصول الثمانية، لكن الأنا تطغى على الأنت جاعلة(السرد مثلي الحكاية) “علمتني السباحة في الحكايات أن أسل الخيوط وأحيك المفكك. أن أخفي المفكك…أن أطيل الصبر هو أول ما يحتاج إليه المشتاق ليبلغ مراده. وأنا هنا في حاجة لاستخدام صبري إلى أبعد تقدير.”(10)
فالحكاء هو البطل المتفرد الذي تمركز منتجًا، معاملاً جمهوره المتحلق حوله معاملة المستهلك، فمثلا حين تقترب سويعة صلاة المغرب يصبح واجبًا على الجمهور أن يتفرق. أما من أراد الاستزادة فعليه أن يزيد درهمًا إلى عشرة” هل تعرفون القصة الكاملة لطائر الرخ، حكاية عجيبة ذكروني بها لأقصها عليكم في يوم آخر”(11).
ولأن الجمهور ليس متعلمًا، يتقبل التخاريف بسهولة منومًا بالحكاية تنويمًا ممغنطًا مفتونًا بالجذبة والسحر والخيال في انتظار المجهول “فأنا جمهوري يجلس أمامي يحيط بي في حلقتي في ساحة عمومية عارية كلما نطقت بكلمة أو نقلت واقعة أو أنطقت مخلوقًا أو ذكرت معيبًا طلبت المغفرة والستر فما لا يصيبك قد يلاحق ذريتك”(12) بيد أنّ لهذا التنويم خطره على الحكّاء لأن بإمكان الجمهور إنزال أقسى العقوبات به إذا ما فشل في مهمتهن ومن ذلك مثلاً التقريع الذي قابلته به المرأة التي طلقها زوجها بسبب حكاياته.
وأكثر الذين يخافهم الحكّاء هم جمهور النساء اللائي هن الأكثر انصاتًا لحكاياته، بسبب قدرته على التعبير عن أسرارهن وفضح دسائسهن أكثر من تعبيره عن أسرار الرجال. ولهذا يلمنه بشدة ويبوبخنه بقوة إذا أساء إليهن، وهو ما واجهه الحكّاء حين أتته امرأة معها زوجها “جاءتْ به إلى حلقتي فاشبعني لَكْمًا،
قالت له هذا من حكى لنا كيف على المرأة أن تتمنع على زوجها أيامًا وليالي ولا تتركه يظفر بها إلا بعد ان تروضه مثل شهرزاد بعشرات الحكايات وانا فعلت ما قلت فبئس العاقبة والمصير”(13) كما باغتته امرأة أخرى، متهمة إياه بالسرقة والمواربة “كيف تسرق حكايتي هي حياتي ترويها بالمقلوب كيف؟!! (14).
وليس غريبًا أنْ يوعد الحكّاء جمهوره ببلاد اسمها بلاد النون ويطلب منهم انتظارها، والتي ستكون محطة الارتحال الأخيرة التي يهتدي إليها من خلال سورة نون والقلم التي هي عنده كالمنوم. وحين يصل إلى بلاد النون يجدها بلاد النساء التي فيها نونة عجوز شمطاء تعيش في الجبل وتأكل الرجال ولا تشبع.
لكن حقيقتها تظهر بعد أن يعثر الحكاء على المخطوطة الضائعة (سيرة القديسة نونة هادية بلاد الكرج) وتكون المفارقة أنّ نونة ليست هي الشّر؛ بل هي السّيدة الوقور القديسة التي ستسلب لبَّه، وفي هذا توكيد أنّ ما نقله التاريخ عن النساء خاطيء ومزيف فهن لسن الأغواء والخطيئة؛ بل هن الأمل والهداية نحو حياة أفضل.
ويؤدي الحكّاء مع نونة في خاتمة المتخيل الحكائي طقسًا فيه جذبة صوفية لا تتملص من واقعية الحياة لكنها تريد فهم هذه الواقعية بالتخييل “اعتدت أن أسبل جفني كلما دخلت في جدبة قصتي أحسبني أسايف وأعارك الفرسان والمصارعين وأتوله مع العاشقين فأنسى حالي”(15).
وتصبح نونة العجوز هي اللانونة المنومة بالحكاية فتنتفض وتدمدم وتنجذب وتترنح ولا يكون أمام الحكّاء إلا أن يسلِّم لها، ويكرر معها مناديًا (سيدي ومولاي) مع إنقاص كتابة (سأقوله له) بالعد التنازلي لينتهي عند الحرفين اللام والهاء كتوكيد للبعد الشفاهي للحكي وللتدليل على مقصدية التنويم التي أراد المؤلف أحمد المديني الترميز بها إلى واقع موهوم ينبغي الثورة عليه.
والحكّاء وإن كان شخصية تراثية انقرضت من السرد الحداثي كما انقراض توظيف الحكاية من الروايات والقصص، فإنه يستعيدها هنا مستندًا على الحكاية وفيها تتجسد رحلته الباحثة عن يوتوبيا ليس فيها شر ولا كسل ولا تخاذل ولا رقى ولا سحر ولا شعوذة، كنوع من استعادة ذاكرة تم محوها في سرديات الحداثة، ولهذه الاستعادة وظيفة ما بعد حداثية هي الثورة على أهل بلاد “أهلها فاترون وهم في انتظار فرج ما، لا يغامرون، طوعتهم الحاكمية، شردت رجالهم وأفسدت نسوتهم ويريدون سد الرمق في انتظار فرج ما.”(16)
وبهذا يكون الروائي أحمد المديني في استجلابه لدور الحكّاء القديم قد اقترب من سرديات مواطنه الروائي المغربي محمد عزِّ الدين التازي الذي وظَّف الحكاية أيضًا من أجل تحقيق تجليات صوفية ومناجاة فيها الذات عاشقة تتمسرب بذات المعشوق في بناء حلزوني؛ بيد أنّ المديني منح الحكّاء وظيفة جديدة تتجاوز استهلاكية التنويم إلى ثائرية التنوير، والدليل على ذلك مغايرته الموقف الذكوري من تاريخ المرأة بموقف تصالحي، كاشفًا الزيف التاريخي ومحاولاً تصحيحه، وهو بالضبط ما تريده سرديات الاستعادة.
- الإحالات:
(1) ينظر: عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار جينيت، ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2000، ص14.
(2) See; http://jim-murdoch.blogspot.com/2010/06/historical-imagination-and-historical.html
(3) عودة إلى خطاب الحكاية، ص63.
(4) رواية تاريخ مصطلح اجترحته بقصد الاشتغال الشكلي الموضوعي ما بعد حداثي على التاريخ الرسمي، تبنيًا لطروحات فلسفة التاريخ المعاصرة وتضامنًا مع توجهاتها التقويضية. والهدف المركزي هو عدم التسليم للتاريخ وفي الوقت نفسه الظفر بالحاضر الآني استشرافًا للمستقبل القادم وبما يضمن للإنسان وجودًا حرًا تأصيليًا ليس فيه احتواء ولا إقصاء. وما يهم كاتب رواية التاريخ هو الحدث لا الواقعة ومن دون تقييد موضوعي ولا تحييد فني أو حظر على استثمار المخيلة لا يجيز للكاتب الزوغان في المنقولات أو الانفلات من التوثيق للمرويات. ينظر: السرد القابض على التاريخ، د. نادية هناوي، دار غيداء للتوزيع والنشر، عمانـ الأردن، ط1، 2018.
(5) اسم الوردة، امبرتوايكو، ترجمة أحمد الصمعي، دار أويا، 1991، ص29ـ 30.
(6) الزيني بركات رواية، جمال الغيطاني، دار الشروق، القاهرة، ط2، 1994.
(7) في بلاد النون رواية، أحمد المديني، دار الروابي، ط1، 2018. والرواية بثلاث مئة صفحة وهي الرواية الخامسة عشرة لأحمد المديني وأول رواية له كانت (زمن بين الولادة والحلم) عام 1976، وله مجموعات قصصية كما كتب رحلات ونصوصًا سيرية ومجموعات شعرية. وآخر كتاب صدر له في الدار البيضاء عام 2019 هو (فتن كاتب عربي في باريس، سيرةُ ذات).
(8) الرواية، ص239.
(9) الرواية، ص285.
(10) الرواية، ص 132.
(11) الرواية، ص 302.
(12) الرواية، ص 177.
(13) الرواية، ص177ـ178.
(14) الرواية، ص 304.
(15) الرواية، ص 134.
(16) الرواية، ص238.
أ.د. نادية هناوي سعدون
كلية التربية – قسم اللغة العربية – الجامعة المستنصرية – بغداد