لماذا لا نُنتج نظريـات ؟

لا يمكن لمتتبع واقع الدراسات والبحوث الأجنبية الجديدة في مختلف الحقول والمعارف إلا أن يختزل عددا كبيرا من الأسئلة، وهو يطلع على ما ينجز في فضائنا الثقافي العربي، في سؤال واحد: لما لا ننتج نظريات؟ وتتولد من هذا السؤال عدة أسئلة منها: لماذا لا ننسب نظريات بعينها إلى أشخاص معينين يمكن اعتبارهم مرجعا أساسيا لكل منهم ما قبله، ومن الضروري أن يكون له ما بعده في مسيرة التطور المعرفية؟ وما هي العوائق التي تحول دون أن تكون عندنا نظريات، ويكثر لدينا المنظرون الذين يسهمون في إثراء المعرفة الإنسانية؟
حين أطلع على ما يكتب بالعربية، في مجال اختصاصي، أو في اختصاصات مجاورة أو بعيدة، أو أقرأ ما أحكمه من دراسات، أجدني بعد الانتهاء من القراءة أطرح هذا النوع من الأسئلة، التي قلما أجد من يعتني بها، أو يطرحها للتفكير والنقاش. لا ينقصنا الذكاء ولا تعوزنا الفطنة. وخير دليل على ذلك أن بعض من هاجر، ووجد مجتمعات علمية حقيقية انخرط فيها، واستطاع فرض نفسه وكسب اعتراف الجميع. أجد في العديد من المنشورات العلمية الأجنبية بعض الأسماء العربية التي لا نعرف عنها شيئا، وهي ذات مواقع متميزة في مجالات علمية نادرة. يعني ذلك أن توفير البيئة الملائمة كفيل بخلق من يفكر، ويشتغل كما يفعل الآخرون. فلماذا تعثرنا حيث كان ينبغي أن نسير، ووقفنا عند مفترق الطرق ساهين وغير معنيين بما يجري في العالم من حولنا؟
سأتناول للجواب عن بعض هذه الأسئلة ما اتصل بالدراسات الأدبية، علما بأن ما يمكن قوله عنها ينسحب بشكل كبير على الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، وغيرها من الاختصاصات العلمية الأخرى. سوف لا أقف على المشاكل البنيوية الكبرى المتصلة بالمؤسسات والبنيات والمجتمعات العلمية، التي ما تزال غير مشكلة في فضاءاتنا الأكاديمية بالصورة التي نجدها في البلدان المتطورة. ولن أتناول العوائق الإدارية، وعدم انخراط المؤسسات المالية الخاصة في البحث العلمي، فهذا من الموضوعات التي نستبعد التفكير فيها لهيمنة ذهنيات متخلفة، ترى أن الكسب السهل والبسيط والآني، والنزعة الأنانية، أهم من التفكير في المستقبل الذي يهم البلد. سأركز على قضايا تصورية تشكلت منذ عصر النهضة وما تزال تفرض نفسها إلى الآن، بوعي أو بغير وعي.
حين يكون قصارى همنا «الاستشهاد» بما تقدمه لنا النظريات الغربية، لا يمكننا إنتاج النظرية، لأننا لا ننطلق من روح الأسئلة التي ينطلقون منها، ونكتفي بالإجابات التي انتهوا إليها.
لا أحد يجادل في أن الغرب تطور علميا وتكنولوجيا، لكننا رغم كثرة أحاديثنا عن المركزية الغربية، وانتقادنا لها، نؤمن بأن الفكر والعلم والنظريات نتاج هذا الغرب. ولا يمكننا مضاهاته في ما وصل إليه. لقد ولّد هذا التصور «وهم الحقيقة» في كل ما ينتجه الغرب على المستوى المعرفي، وأن ليس أمامنا سوى «اقتباس» ما يتشكل فيه، وإعادة كتابته والاستشهاد به لدعم طروحاتنا التي نتبناها. ونجد في المقابل من ينكر هذا بدعوى أن الشرق شرق، والغرب غرب، ويستنكر من يمارس الاقتباس بأنه «يستورد» النظريات من الغرب. ليس في رأيي فرق بين التصورين. فكلاهما يؤمن بالوهم نفسه، غير أن الأول يتلقاه كما هو، والآخر يرفضه لأنه هو. وبين التلقي السلبي، والرفض العدمي، ينتفي «التفاعل الإيجابي» الممكن لردم الهوة على المستوى المعرفي. في حالة التلقي السلبي يتأكد وهم الحقيقة في الانطلاق من أن كل ما ينتج في الغرب، على صعيد الدراسات الأدبية كل متكامل ومؤتلف، ولا مجال فيه للاختلاف والتعدد. فيكون اعتماد كل ما ينتج هناك على أنه واحد، فلا يكون التمييز بين النظريات والاجتهادات، واختلاف التصورات. ولا ينتج عن ذلك سوى التسيب والفوضى. فنجمع بين المتضاد والمتناقض، بين التليد والطريف، والمتحفظ والجازم، وبين المتحمس والمتواضع. وفي كل هذه التصورات وممارستنا إياها، نعتبر عمل حاطب الليل الذي نقوم به مجهودا جبارا جمعنا فيه كل الصيد، وادعينا جعله في جوف الفرا، وليس علينا سوى أن ننتقي ما يتلاءم مع النص الذي نشتغل به. لا يمكن أن يتجدد الفكر وتتولد النظريات إلا بالاختلاف، والحوار، والنقد البناء المستكشف. لذلك نجد الاختلاف أساس الدراسات الأدبية الأجنبية. لكنه الاختلاف المؤسس على ائتلاف الرؤية العلمية إلى الأشياء، وبدون فهم الاختلاف في نطاق الائتلاف الذي يطبع الفكر الأدبي الغربي، وبدون تحديد نقطة انطلاق لمعاينة خريطة تلك الدراسات، ومحدداتها وأهدافها، ومميزات بعضها عن بعض، لا يمكننا فهم طبيعة الفكر الغربي، وبالتالي يصعب علينا التفاعل الإيجابي مع منجزاته، من خلال اتخاذ المواقف الملائمة للانطلاق. وفي هذا الغياب لا نجد أنفسنا إلا أمام التلقي السلبي، أو الرفض العدمي.
حين يكون قصارى همنا «الاستشهاد» بما تقدمه لنا النظريات الغربية، لا يمكننا إنتاج النظرية، لأننا لا ننطلق من روح الأسئلة التي ينطلقون منها، ونكتفي بالإجابات التي انتهوا إليها. ويدفع بنا هذا إلى الاكتفاء بما اطلعنا عليه من قراءات في زمن معين، ولا نواكب المستجدات المتواترة. التوقف عن المواكبة، يوقفنا عند حد لا نتعداه، فلا يكون سوى التكرار والاجترار.
يستحيل مع هيمنة التلقي السلبي والرفض العدمي أن نتطور أو ننتج النظرية.







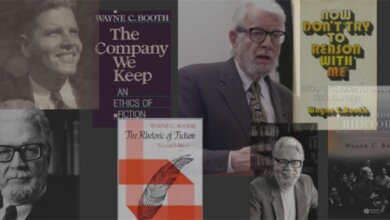


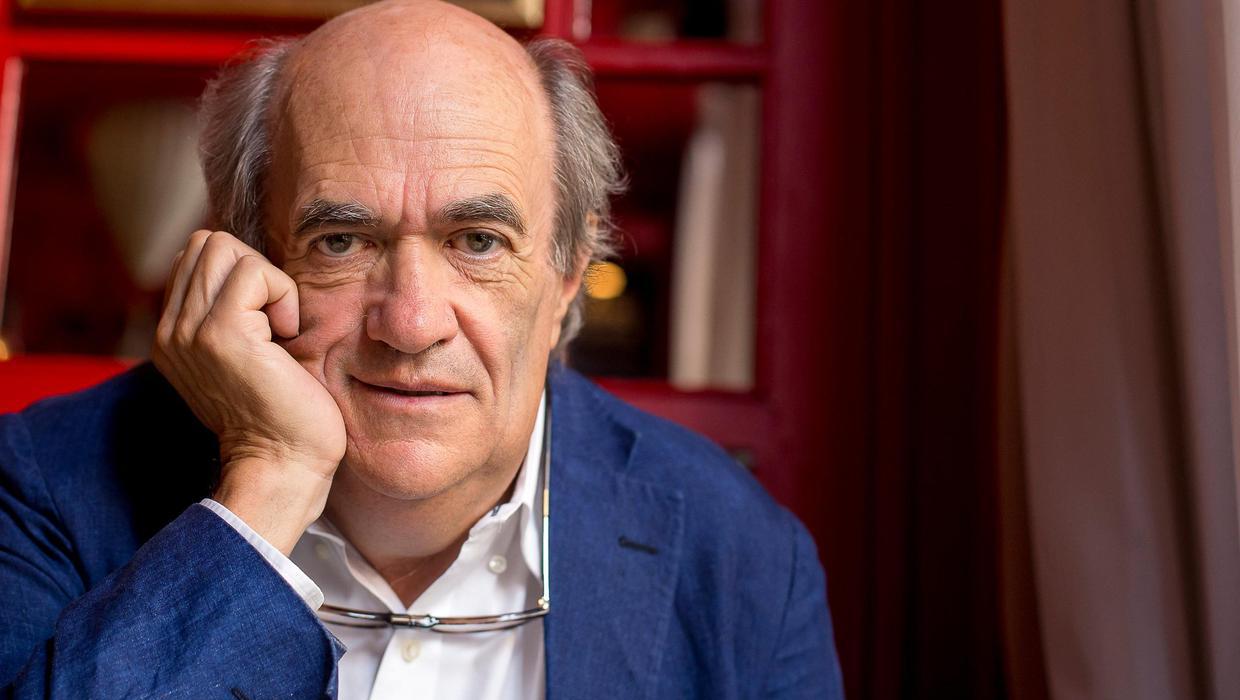




وكيف لنا أن ننشئ نظريات لا نظير لها فكلما أردنا إنشاء وابداع نظرية جديدة وجدناها عند الآخر ولا يمكننا نقض نظريات لها حجج ودلائل قوية معقولة هذا يتطلب دراااسات عديدة و متعددة