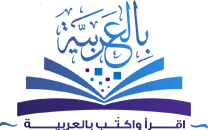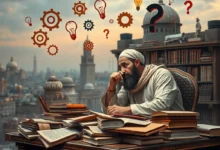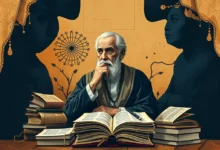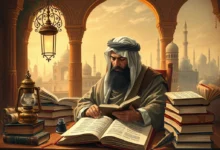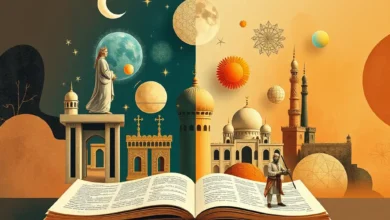فلسفة جورج طرابيشي – خلاصات مركزة جدا (8)

- 1- التجنيس وعلاقاته الحضارية في الرواية
“قد يقال إن تجنيس العلاقات الحضارية في الرواية يمتثل لضرورة فنية ورمزية. وهذا صحيح، ولكنه لا يكون مقبولاً إلا على أساس واحد، وهو تصور العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تساو وتشارك وتكامل، لا علاقة سيطرة وتحكم من جهة، ورضوخ وانقياد من جهة ثانية. ولسوف نرى من خلال النماذج القصصية التي سنحللها أن العكس هو الواقع: فالتجنيس فرضته بالفعل ضرورة الترميز الفني، ولكن ما لا يجوز أن يغيب عن البال أن منطق الرمز هو في الوقت نفسه رمز لمنطق: منطق رجال في عالم رجال وثقافة رجال ورواية رجال. والأدهى من ذلك أنهم رجال “شرقيون”.”
المصدر: جورج طرابيشي، شرق وغرب: رجولة وأنوثة – دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية.
- تحليل فلسفي:
يرصد طرابيشي في هذا الاقتباس كيف أن البناء الرمزي في الرواية العربية، خصوصًا في تناول العلاقة بين الشرق والغرب، يعكس هيمنة النظام الأبوي لا بوصفه مجرد سردية اجتماعية، بل كآلية راسخة في تشكيل الوعي الثقافي.
إن “التجنيس” هنا ليس فقط عملية فنية محضة، بل هو فعل أيديولوجي يعيد إنتاج بنى الهيمنة. يُظهر طرابيشي أن هذه الثنائية ليست مجرد انعكاس للمجتمع، بل تعيد تشكيل تصوراتنا عن العلاقات بين الهويات الحضارية والجندرية.
يمتد هذا التحليل ليكشف أن رمزية العلاقة بين الرجل والمرأة في السردية الأدبية ليست مجرد انعكاس للعلاقات الاجتماعية، بل هي تواطؤ مستتر يعزز منطق السيطرة الذكورية.
هذا يؤكد أن “الرجل الشرقي” ليس مجرد شخصية فردية، بل يمثل نظامًا من القيم التي تُعيد إنتاج نفسها عبر السرديات الثقافية.
2- أزمة العقل العربي بين التقليد والحداثة
“في زماننا المعاصر، حيث يبدو العالم العربي – والإسلامي بشكل أعم – مُهددًا بالارتداد نحو قرون وسطى جديدة، فإنّ ثورة كوبرنيكية على صعيد العقل، وعلى صعيد عالم العقل الذي هو التراث والتأويل الموروث للتراث، هي شرط شارطٌ لاستئناف عملية الإقلاع نحو الحداثة، التي كان لاح بارقها مع عصر النهضة، قبل أن يخمد في ما لم نتردد بأن نسميه عصر الردة..”.
المصدر: جورج طرابيشي، المعجزة أو سبات العقل في الإسلام.
- تحليل فلسفي:
يتبنى طرابيشي هنا رؤية ديكارتية ثورية تدعو إلى إعادة تأسيس العقل العربي على أسس جديدة، متجاوزًا القراءات التقليدية التي تُكبّله داخل إطار الموروث المغلق. يشير إلى ضرورة “ثورة كوبرنيكية“، أي قطيعة إبستمولوجية مع أنماط التفكير التي استحوذت على التراث الديني والتاريخي.
هذا الطرح يستند إلى رؤية هيغلية في فهم التطور الفكري، حيث لا يُنظر إلى العقل كمجرد أداة للتأمل، بل كمحرك تاريخي ينبغي أن ينعتق من قيود الميتافيزيقا التقليدية. يحذر طرابيشي من أن الجمود الفكري يُعيد إنتاج “قرون وسطى جديدة”، مما يضع العالم الإسلامي أمام تحدٍ مزدوج: إما الدخول في مسار الحداثة، أو الاستمرار في دوامة الانحطاط.
3- المثاقفة والخصاء الفكري في السردية الاستشراقية
“وما دمنا هنا في صدد الأدب الروائي الذي يتناول بالعرض والمعالجة العلاقات “الحضارية” بين الشرق والغرب، فإن العامل الأخير، أي المثاقفة، يبدو حاسم الأثر في إلباس تلك العلاقات الحضارية المزعومة رداءً ومضمونًا جنسيين. إن عملية المثاقفة، بافتراضها وجود طرفين موجب وسالب، فاعل ومنفعل، مُلقِح وملقَح، تطرح نفسها على الفور كعملية ذات حدين مذكر ومؤنث. ولكن نظرًا إلى أن الثقافة الحديثة – نظير القديمة – هي في الأساس والجوهر ثقافة ذكور، فإن المثاقفة لا توقظ في الطرف المتلقي إحساسًا بالدونية المؤنثة بقدر ما تبعث فيه شعورًا مُرهقًا بالخصاء الفكري والعنة الثقافية.”
المصدر: جورج طرابيشي، شرق وغرب: رجولة وأنوثة – دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية، ص 11.
- تحليل فلسفي:
يطرح طرابيشي هنا قراءة فرويدية – لاكانية للمثاقفة بوصفها عملية إدماج قسرية تمارسها الحضارة الغربية على العالم العربي. الفكرة المحورية التي يستعرضها تكمن في أن المثاقفة ليست مجرد تلاقح فكري، بل تتمثل في بنية ذكورية تُسقط علاقة القوة والهيمنة على المجال الثقافي،
مما يجعل الطرف العربي في موقع “الملقَّح”، أي المستقبِل الخاضع، في مقابل الطرف الغربي الذي يحتل موقع “الملقِّح”، أي الفاعل المسيطر.
ما يميز هذا التحليل هو تشبيهه للمثاقفة بعملية “خصاء فكري”، وهو مصطلح يكشف عن عمق الإشكال النفسي – الثقافي الذي تعانيه المجتمعات العربية. فالمشكلة لا تكمن فقط في التبعية الفكرية، بل في الشعور بالانكسار الحضاري أمام هيمنة الغرب.
وهنا نجد أصداء واضحة لتحليلات إدوارد سعيد حول الاستشراق، ولكن من منظور أعمق يأخذ بعين الاعتبار البعد النفسي – الجنسي للعلاقات الحضارية.