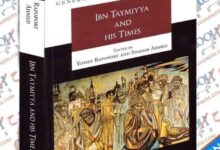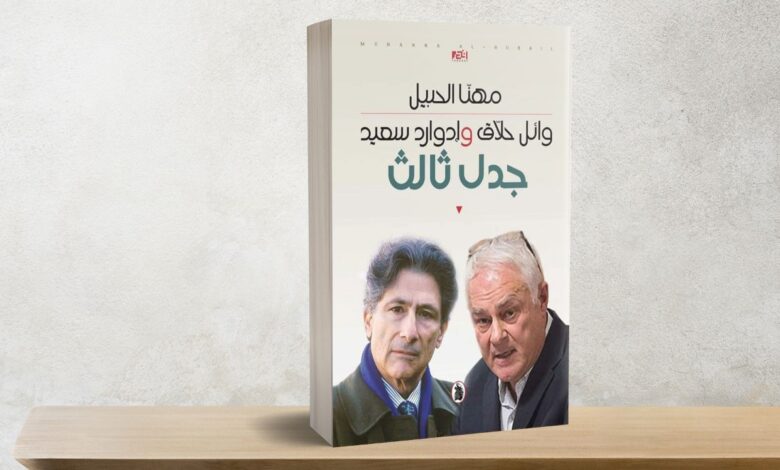
قال جان لو رون دالمبير مرّة – وهو أحد فلاسفة التنوير في فرنسا – في معرض حديثه عن الحداثة الفكرية التي تجتاح القارة آنذاك: (لقد حصل تغيّر هائل في أفكارنا وسرعة هذا التغيّر تعِد بالمزيد منه لاحقًا.
لقد حصلت ثورة فكرية حقيقية ولن تستطيع إلا الأجيال اللاحقة أن تقيس حجمها وأبعادها، أو إيجابياتها وسلبياتها).
ما يهمّنا من عبارة دالمبير هذه في مقامنا هذا هو إسناده مهمّة تقييم الحداثة الغربية إلى الأجيال اللاّحقة من بعده، وهي مهمّة نهض بها مفكرو العصور المتأخرة بالفعل وأسفرت عنها أعمالُهم، من ماركس ونيتشه وفرويد إلى رواد مدرسة فرنكفورت النقدية وسواهم من المفكرين غربًا وشرقًا باختلاف المناهج والمنطلقات.
وهو المصبّ ذاته الذي يصبّ فيه كتاب “وائل حلاق وإدوارد سعيد.. جدل ثالث” للباحث العربي مهنا الحبيل (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2021)- ضمن مشروعه التنويري النبيل – عبر دراسة أفكار المفكريْن سعيد وحلاق عن الاستشراق وعلاقته بالحداثة والخلاف الفكري بينهما إزاء هذا الإشكال.
إذن الاستشراق والحداثة هما أبرز الكلمات المفتاحية والمركزية لهذه الدراسة، كمحدّد أولي يبيّن فيه الحبيل بصريح العبارة اتفاق صاحب كتاب “الاستشراق” إدوارد سعيد مع مؤِّلف كتاب “قصور الاستشراق” وائل حلاّق في إدانة محصلة دراسات المستشرقين عن المجتمعات الشرقية الإسلامية، باعتبارها دراسات غير موضوعية لم تتعامل مع البنية الاجتماعية للشرق تعاملًا علميًا مجرّدًا من المؤثرات الخارجية والأهداف المسبّقة.
وإنما في الغالب الأعم ظلت معجونة بالأداتية والتوظيفية كنوع من “المصادرة على المطلوب” تُظهِر المجتمعات الشرقية على أنها مجتمعات متخلّفة وهمجية لم يسطع عليها نور التنوير الذي يضيء حياة الغرب بعد؛ وبالتالي استُخدمت هذه الحالة التي رسمها المستشرقون عن الشرق، كذريعة لاستعماره بزعم تمدين شعوبه وتخليصه من براثن التخلف والهمجية.
لكن الخلاف الرئيسي بين المفكريْن، كما يُبيّن الحبيل، هو كون الأول – سعيد- توقف عن نقد الاستشراق ولم ينظر بعيدًا عن مرتكزات الاستشراق وخلفياته الأيديولوجية، بينما الثاني- حلاّق- تجاوز نقد المنظومة الاستشراقية بل ألقى شباك نقده على روح الحداثة الغربية المادية باعتبارها روح العصر والأيديولوجية التي تصدر عنها الدراسات الاستشراقية، وهذا ما يجعل تحليلَ كتاب “الاستشراق” للاستشراق قاصرًا لأنه لم يمس كليّة الحداثة التي أفرزت مادتها، أي الدراسات الاستشراقية.
إبرازًا لهذا القصور وتبيانًا للرّابط البنيوي بين الحداثة والاستشراق قدّم حلاق كتابه “قصور الاستشراق” عملًا بقاعدة “البيّنة على المدّعي”، وهو الخط الذي يمشي عليه الحبيل في كتابه هذا، خط التفكيك والنقد للبنية المعرفية والفكرية الحداثية، وانعكاساتها الوخيمة إنسانيًا وأخلاقيًا على المجتمع البشري، وكما هو منهج المؤلف فهو لا يستنفد كل طاقته في تقويض البنية الحداثية، بل يضمّنه مقترحات إصلاحية من شأنها أن تُصلح ما أفسدته الحداثة المادية مستقبلًا.
ينوّه الحبيل في مستهل الكتاب إلى الاهتمام الكبير الذي ناله كتاب “الاستشراق” بين مختلف الأقطاب ودوره المؤثِّر في الحقل الأخلاقي، وبصفة عامة في التاريخ الاجتماعي الحديث بين الشرق والغرب كروح فكرية مرصودة ومستشعرة متفاعلة بين عالم الشمال والجنوب، ورغم الامتداد الزمني الذي يقطعنا عن تاريخ صدور الطبعة الأولى إلاّ أنّ قضاياه لا تزال حية وموضع تجاذب بين التأييد والمعارضة.
بيد أن حلاق في كتابه “قصور الاستشراق” استطاع أن يقفز بهذا المسار الذي سار عليه سعيد في كتابه إلى أفق أوسع وأرحب، بل أكثر تماسًا مع أزمة العصر، وواقع العالم الحديث يربط النكبات الإنسانية مع مسؤوليات الحداثة المادية.
بناءً على هذه الفسحة النقدية الذي فتح أفقها حلاق يرتئي الباحث الحبيل في تحرير هذا “.. الجدل الثالث” أنه: (لا ينبغي أن يُنظر إلى كتاب ’قصور الاستشراق’ كرد أو نقد لإدوارد سعيد فقط، وإنّما كمدوّنة مميّزة وتشكُّل خطابي أكثر عمقا، لنقد معطيات الفلسفة المقيّدة بهذه الحداثة ذاتها، أو التي أُنشئت تحت حقولها المقنّنة).
يستفتح المؤلف الفصل الثاني-“الضرورة المعرفية لتفكيك التنوير الغربي”- باستفهامات جادّة تمثّل تحرير إجاباتها قاعدة معرفية لمستقبل مختلف للعالم الشرقي المسلم بشكل خاص، وللمجتمع البشري بشكل عام، ومن بين تلك الاستفهامات:
ما الذي نعنيه في تفكيك مآلات التنوير الغربي، وتأثيرها التنموي والثقافي والحقوقي في المجتمعات الإنسانية، ومنها الشرق الكبير المبتلى بشتى المحن؟ وما الذي تُمثله خطايا الغرب واستبداده ضد الشرق وشعوب العالم الجنوبي؟.
يتموضع موقف الباحث الحبيل إزاء الإرث التنويري الغربي وسطًا بين الموقف التراثي الرافض للإرث التنويري ويعتبره شرًّا مطلقًا، والموقف اللائكي الراديكالي الاستنساخي الذي يمثّله مريدو الأكاديمية الغربية الحداثية، ولهذا توّخى فرز الصالح البشري والنجاح الحضاري عن المآسي والمآلات الثقافية التي نجمت عن الرؤية التنويرية للعالم.
وتحت عنوان فرعي “الإنسان الإله في مشروع الحداثة” يكشف الحبيل مع حلاّق لفتة مهمة، وهي أن المشاهَد من الصدامات الاجتماعية ضمن الصراعات الدولية بين الأمم، والصراعات الطبقية داخل مجتمع واحد، إنما بزغ بعد اكتمال تأثير ثقافة التنوير الغربي، بوصفها ثقافة تسود التوجهات الأكاديمية وتتصدر التأثير الدولي، وهي الفلسفة التي ينتمي لها عالم الغرب الحديث.
وهذا يندرج تحت مفهوم سيادة الإنسان الإله إذ نقْد التّحكم في الطبيعة- من منظور حلاّق- أو توجيهها أو تصنيعها لصالح البشرية، ليس مقصودًا به التعامل مع سنن الكون وجعل التقدم العلمي مسارًا حيويًا لاستثمار الأرض لصالح الإنسان، وإنما لفهم حصيلة التغول في تقديس العقل، وتحوّله إلى تأليه للإنسان.
ويلفت المؤلف هنا إلى دافع بعض الفلاسفة في تجريد الدين من أي مشروعية سياسية أو اجتماعية، وهو التخوّف من سيادة الدين القمعي القروسطي لصالح منح الإنسان قدرات الإله رغم أن البعض منهم كان قلقًا من عواقب هذا التأليه، فكان من تبعات هذا التأليه تقنين قوانين لا تقف عند أي ضابط أخلاقي، ولا مصالح القيم التي تنشر السعادة على البشرية وتحفظ كينونة ودّ المجتمع.
والواقع يؤكد إخضاع العالم للإنسان الإله، وهذا الإنسان الإله تطورت قوته على البشرية بناءً على كون العقل المادي لا الوجداني هو المحدّد الأوحد لتقدير الخير والشرّ، ثم صُنعت منظومة أخلاقية بناءً على ذلك، بعد إعدام كل قيم روحية.
ولأن المؤلف يستعين بالمرجعية الاسلامية- على غرار حلاّق- في إعادة تنظيم الحياة المعرفية والأخلاقية للأسرة الإنسانية؛ فهو يعرّج على القيم الإسلامية ومقاصدها التشريعية الكبرى وأهمّية تبنّيها للخلاص البشري.
لكن لا إسلام العادات الذي يشير إليه بمصطلح “عادات بني أميّة الجاهلية” المستبدّة عبر النّزعة التسلطية لفرض التوريث، ثم تحويلها في بعض كتب التراث إلى أبواب للفقه، وهو أحد الشواهد لتنحية الرسالة الإسلامية عن موازين العدل، عبر النموذج التطبيقي.
يعود الحديث إلى جوهر الخلاف المركزي بين سعيد وحلاّق في اختتام الجزء الثاني، حيث يزعم حلاّق أنه بالرغم من إدانة سعيد للاستشراق، إلاّ أنه في الوقت ذاته مجّد الحداثة وإنجازاتها باعتبارها المعيار الحصري.
لكن مأخذ حلاق على سعيد هو المرجعية الفكرية لسعيد التي ظلّ متأثِّرًا بها؛ وهي المرجعية العلمانية الليبرالية المقترنة بالحداثة الرأسمالية، بدليل أنه خضع تحت فكرة تمركز الإنسانوية، وهي القاعدة التي نشأت عليها منظومة الحداثة الليبرالية، إلى جانب جهله- أي سعيد- بإبداعات الفكرة الإسلامية، أو حتى أدب الشرق المعاصر، كما يستنتج الحبيل وبأن هذا هو جوهر الخلاف بينهما تقريبًا.
يدرس الباحث الشهادات الفكرية لمستشرق فرنسي بارز استشهد حلاّق بأفكاره في أكثر من موقف في كتابه “قصور الاستشراق”. إنه رينيه غينون أحد المستشرقين الذين أهملهم سعيد مستغربًا من إقصاء الحداثة عقله الحصيف.
يصف غينون الحضارة الإسلامية كمقابل لأزمة الحداثة (إن ما نطلق عليه حضارة تقليدية هي في الواقع حضارة تقوم على مبادئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وحينما نتحدث عن المبادئ بصورة مطلقة، أو عن الحقائق الفكرية الخالصة، فهذه دائمًا تشير إلى النظام الكوني وليس إلى أي شيء آخر).
وعلق حلاّق على هذه الخلاصات الفكرية التي انتهى إليها غينون: (ولقد منعتْ الدراسات الاستشراقية عن الإسلام كل سبل الوصول لهذا الفهم لغينون، في ضوء أفكاره عن الثبات والاستقرار والتغير، كقوة لا نظير لها في الحضارة الإسلامية).
- يُدرج الحبيل هنا مسارين مهمين لمنهج غينون:
1- لا يشترط غينون على الغرب التخلي عن استقلاله المعرفي، ولكنه يُذكرهم بأن حضارتهم لن يتم إصلاحها دون التصحيح الحقيقي للعلاقات الفكرية مع الشرق.
2- يطرح غينون مركزية التوافق على المبادئ الفلسفية، لتحرير الطريق الثالث.
ويستدل الحبيل بالمفارقة الصارخة في هذا الإقصاء وهو تشابه التمرد الفلسفي مع شخصية فكرية فرنسية أخرى من حيث الظرف النفسي، والتحول السلوكي، والأدوات التفكيكية الضرورية، أُحتفيَ بها بالمطلق وهي شخصية ميشيل فوكو، الذي يُقال إن الرئيس الفرنسي الأسبق ديغول ردّ على طلب الإذن باعتقاله في أحداث جامعة فنسن؛ بأنه لن يفعل حتى لا يُقال “إن فرنسا تعتقل عقلها”.
هذا فضلًا عن السمعة التي حققتها تأثيراته الفكرية وحفرياته التفكيكية لفرنسا باسم حرية المعرفة، وبالفعل تم اعتبار مؤلفاته ثروة وطنية للقومية الفرنسية،
في المقابل تم تحييد رينيه غينون، حتى في لغة الترجمة عنه، في الوسط الأكاديمي الفرنسي والغربي، أمّا نقاط التّشابه بين الشخصيتين المشار إليها أعلاه؛ فتقع على أن كِلتيْ الشخصيتين احتج على المعرفة السيادية الحداثية، وأخذ على عاتقة تفكيك منظومتها الفكرية.
وبينما نحا الأول في آخر مساراته الفكرية منحًى صوفيا، انتهى المسار بالثاني إلى السادية والمثلية الجنسيَتيْن، ولا يُفسِّر هذا الاقصاء والتغييب لفكر غينون إلا النزعة الانحيازية الغربية ضد الفكر الإسلامي ومنظومته القيمية،
إذ أن إسلام غينون وتمسّكه بنزعته الصوفية إلى آخر أيامه أسقط عنه – فرنسيًا- الميزان العلمي والفكري المفترض أن يتم التعامل به مع أفكاره، وواصل غينون- بعد قرار استقراره في مصر- مهمة تقويض الأسس الفلسفية للحداثة الغربية الماديّة، والتحرير الفلسفي غير الغربي الذي لا تعترف به أوروبا معلنًا عن استقلاله عن الأكاديمية الغربية.
بعد وقفةٍ مطوّلةٍ- لا يتّسع المقام للتّعرّج على كلّها- لشهادات رينيه غينون على المنظومة الفكرية الغربية لصالح الإسلامية، يدعو الباحث هنا إلى التأمل في التاريخ الاجتماعي لفوكو ومعيارية التقييم، لفهم أسباب تمجيد هذا المؤلف وتهميش ذاك.
ومن بعد يرصد المؤلف الحالة العامة للتعاطي مع الفلسفة الحداثية للمجتمعات الشرقية، ويقسّمها إلى صورتين رئيسيتين: الصورة التقليدية المرهونة بشخصيات الفلسفة الغربية، المناوئة لحلاّق، وهي ذاتها تعوق التقدّم لمنهج الحرية والاستقلالية بالعقل المجرّد، وتؤثر في الباحثين الإسلاميين.
وصورة أخرى معاكسة نسبيًا لمعت ما بعد الربيع العربي في الظاهرة الإسلامية التي تتعاطى مع الفلسفة الحديثة تعاطيًا إيجابيًا، لكنها تذكّر بالمحددات العلمانوية، التي صنعها العقل الاستشراقي، ليحتكر فيها عقل الشرق المسلم،
فتكون ثقافة رده من ذات المحدّدات، بدلًا من نقاش المشروعية الأخلاقية لتسلسل الفكرة، من خلال التذكير بالجوهر الأخلاقي للفلسفة، وليس كضمير نبيل يجب أن يلتزم به الباحث فقط، وإنما لوضع الهدف الكلي لعلم المعرفة البشرية.
أمّا في الفصل الرابع فيراجع تصنيفَ حلاّق للمؤلفيْن إدوارد سعيد ورينيه غينون حيث يضع سعيد في خانة المؤلف المعارض، وغينون في خانة المؤلف الهدّام، بالمعنى الإيجابي الذي يعتمد استقلالية المؤلف الفلسفي عن النّطاق المهيمن.
ومن ثم يتحوّل نقده إلى بنية تأسيسية تخرج من حالة العمى التي تسيطر على الباحث الغربي، أو المريد الشرقي للأكاديمية الغربية، بخلاف سعيد الذي عجز عن الانفكاك عن مرجعية الحداثة المادية.
يعقّب الحبيل بالتنويه إلى إلحاح ميلاد المؤلِّف المناهض كحاجة يفرضها الزمن الراهن، مؤلف لا يناهض لأجل المناهضة، وإنما للعودة إلى المناظير الكبرى لحركة العالم والوجود، وفهم خلل المسارات التي سبقته، ليحرر رؤيته الكونية.
يواصل الباحث تسليط الضوء على مظاهر السيادة الحداثية بأبعادها الرأسمالية وشركاتها المالية، يبيّن فيه تحوّل المنتج الأكاديمي إلى أداة ربحية للرأسمالية الشركات، بنماذج وإحصائيات. كما يبحث العنف الحداثي أو علاقة الحداثة بالإبادة في إطار قراءة حلاّق للحداثة، الذي يربط روح الحداثة ببنية الإبادة الاستيطانية والزحف الكولونيالي،
ويستدعي في ذلك الروح الحداثية التي يتحلى بها الفيلسوف القيادي في الحركة الصهيونية فلاديمير جابوتينسكي الذي يبرر سياسة الاستئصال للفلسطينيين بمفهوم الإبادة الايجابية للشعوب الدُنيا.
يلفت الباحث إلى أن الكولونيالية الغربية الراهنة- سواء بهذا المصطلح أو غيره – هي الحالة السياسية القائمة في حركة الغرب الثقافية ومعاهده الفلسفية والتي تنعكس في مشاريع الدول الغربية حتى اليوم، ولا أدّل على ذلك من سياسات الدمج القهري الثقافي للاجئين الوافدين من العالم الثالث من دون أحقية الحوار والنقاش الثقافية والحضارية.
وبعد تفكيك ونقد فائضين وشاملين للبنية المعرفية للحداثة ومعاييرها الاستشراقية الخرافية وإفرازاتها الواقعية، ينتهي المؤلف في الفصل الثامن والأخير إلى اقتراح مرتكزات إصلاحية تبلور أُسسًا جديدة تشاركية للمعرفة والقيم تضع المصالح البشرية فوق كل اعتبار؛ وفق رؤية حلاّق.
ومن تلك المرتكزات الشروع بحوار مفتوح بين المنظومات في العالم الجنوبي والشمالي كخطوة أولية لإنقاذ الحياة البشرية، واعادة الاعتبار للمبحث الأخلاقي الروحي الذي غيّبته الحداثة الماديّة باعتبار أن الأزمة المهددة أزمة أخلاقية روحية بالدرجة الأولى، رغم قول حلاق بأن بعض مزايا الإسلام الفرعية لا تتفق مع الذوق الحديث،
فإنه يعتقد أن التوازن الذي تمثله المعرفة الإسلامية، ودلالتها بين العقل والروح، وخارطتها في كونية العالم، لا توجد كمنظومة متكاملة في غيرها من المنظومات الأخرى، فضلًا عن منظومة الحداثة الغربية، بحيث أن العقلانية الإسلامية أكثر انسجامًا مع الطبيعة الكليّة للعالم والإنسان.
وفي الختام يُذكّر المؤلف بأن غاية هذه الدراسة ليس حسم المنتصِر في معركة الجدل بين وائل حلاق وإدوارد سعيد، وإنما الكسب الأكبر هو المعرفة من فكر الشخصيتين.
ويبدو جليّا عدم اختصار كتاب الحبيل هذا على عرض أفكار الخصمين فكريًا ونقْدِهما ثم الحكم بينهما، وإنما تجاوز ذلك إلى فتح أفق معرفي وفكري جديد مختلف، تتحقق عبره قواعد القيم، ومصالح الفرد والمجتمع الإنساني في قوالب معاصرة تساعدهم على الوصول إلى كتلة التغيير المنشودة.
وهكذا نظّم عمله القيّم هذا على هيئة مشروع تفكيكي نقدي وإصلاحي، ضمن مشروعه التنويري الشامل، الذي يحويه مفهوم (الجدل الثالث) أو الطريقة الثالثة للمعرفة، وهي الكلمة التي اختتم بها الكتاب.