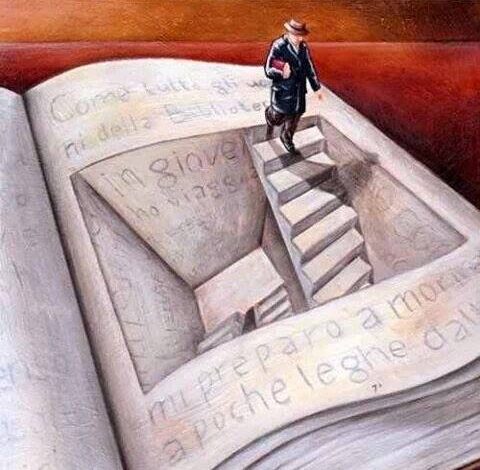
إنها حداثة في الشكل وحداثة فردية متشعرنة، فيها كل سمات النموذج الشعري، بجماليته من جهة، وبنسقيته من جهة ثانية. إنها تعيدنا مرة أخرى إلى كائنات بلاغية، تعيش الموت العظيم الذي يلازمنا خلية خلية،
1
- 1.1- تهشيم النسق:
في عام 1947 حدثت حادثتان ظاهرهما أدبي، وحقيقتهما ثقافية، حيث ظهر نزار قباني في دمشق، مع ديوانه طفولة نهد، وظهرت نازك الملائكة، ومعها حركة الشعر الحر والسياب. وكأنما كان ظهور نزار ردا نسقيا على ظهور نازك. ولقد سبق أن ناقشت مشروع الشعر الحر (قصيدة التفعيلة) بوصف ذلك حادثة ثقافية، بما إنها مسعى ثقافي لكسر عمود الفحولة، وإحلال نسق بديل ينطوي على قيم جديدة تنتصر للمهمش والمؤنث والمهمل، وتؤسس لخطاب إبداعي جديد يتطبع بالطابع الإنساني، له سمات النسق المفتوح على عناصر الحرية والإنسانية.
وكانت نازك الملائكة هي الرائدة فيه، ثم تلاها السياب في تطوير الخطاب وفي فتح آفاقه الإبداعية إلى أقصى مدى. ولن أكرر هنا ما قلته من قبل، غير أنني أستدعي الموضوع هنا لأشير إلى ما يمكن أن يفعله النسق المهيمن بسطوته الضاربة لمواجهة أي مسعى لكسر الهيمنة النسقية، وهي هيمنة انغرست في أعمق أعماق الوجدان الثقافي العربي، ولذا فإن ظهور نزار قباني متزامنا مع ظهور نازك والسياب سيكون هو الرد النسقي على محاولة زعزعة سلطة النسق الفحولي بسماته التي حددناها في الفصلين الثالث والرابع.
ولذا فإن نازك ونزار ليسا ظاهرتين أدبيتين فحسب، بل هما أيضا علامتان ثقافيتان ينطوي خطاب كل منهما على (نسق) عميق يتوسل بالجمالي لكي يمرر رسالته ويغرس تأثيره. كما إن نزار ونازك ليسا وحيدين هنا بل هما مثالان على خطابين متجذرين ومتفرعين، والسياب وأدونيس يأتيان في قلب المعمعة مع نازك ونزار، فالسياب من جهة، وأدونيس من جهة ثانية، هما علامتان على نسق وآخر، وبينهما اختلاف شاسع له دلالاته النسقية الخطيرة.
وإن كان السياب مع نازك يمثلان مشروعين في كسر عمود النسق الفحولي والتأسيس لخطاب جديد، فإن نزار وأدونيس سيتوليان إعادة الروح للنسق الفحولي بكل سماته وصفاته الفردية المطلقة والفحولية التسلطية، وسيحققان عودة رجعية إلى النسق الثقافي القديم المترسخ، والذي سيتجدد ويزداد ترسخا وقبولا على يديهما كممثلين فحوليين لذلك النسق، كما سنرى في هذا الفصل. وعبر الاستفحال الذي يمثله نزار، والتفحيل الذي يمثله أدونيس، ستجري إعادة النسق إلى نشاطه وفاعليته.
وسيجري تحويل مشروع العربية من ثوريتها على النسق، إلى خضوعها التام للنسق وانضوائها تحت شرطه الثقافي والذهني. وهذا لن ينحصر في الشعر فحسب، بل سنجد له آثارا في الخطاب العقلاني/الفكري، مثلما هو موجود في الخطاب الإعلامي والسياسي. وذاك يغذي هذا ويؤسس له. وسنعرض لنماذج على ذلك من نزار قباني وأدونيس، حيث سنسعى إلى ملاحقة النسق وكشف آثاره وفضح علاماته في ما يلي من مباحث.
على أن من المهم أن نشير هنا إلى أن النسق لا يتحرك على مستوى الإبداع فحسب، بل إن القراءة والاستقبال لهما دور مهم وخطير في ترسيخ النسق، ومن المؤكد أن نزار قباني كان صنيعة القراء مثلما هو مبدع لنصه، فاستقبالنا لنزار وحماسنا لشعره كان سببا لشيوعه من جهة، وكان سببا لاستمراره في كتابة ذلك النمط الشعري من جهة ثانية، كما أن تقبلنا لهذا الخطاب كان يخضع لدوافع نسقية تحرك ذائقتنا وتتحكم فيها وتوجه خياراتنا، مما يعني أننا نتاج نسقي وأننا كائنات نسقية.
ونشترك كلنا في صناعة النسق مثلما نشترك في الانفعال به. وليس أدل على ذلك من أن نازك الملائكة القارئة تختلف عن نازك المبدعة، حيث نراها في كتابها قضايا الشعر المعاصر تنقض ما كانت قالت به في شظايا ورماد، وراحت تقف ضد انطلاقات الشعر الحر وتتقمص دور الأب المربي الذي يأمر وينهى ويمنع ويعاقب ويعترض على ما في الخطاب الجديد من مظاهر التحرر والخروج على النمط القديم.
وهي بهذا تتكلم باسم النسق الذي يحتل ذائقتها القرائية، على الرغم من تحررها منه مرحليا في فعلها الإبداعي. وهذا يوضح مدى قدرة النسق على التغلغل إلى بواطننا والتحكم بردود أفعالنا، كما يوضح مدى سيطرة النسق على عاداتنا القرائية والذوقية، وإلا كيف نتقبل خطابا يتضمن الهيمنة ويدعو إلى عبودية الفرد وينطوي على فردية مطلقة وحس متعال ينفي الآخر ويقول بالإطلاق، في زمن نقول فيه بالحرية والتعدد والاختلاف وقبول الآخر…؟!
إن هذا يجري لنا في وقت واحد، حيث نستهلك خطابات الهيمنة ونتمثلها في تناقض تام مع ما نؤمن به صراحة، وهذا هو فعل النسق كما شرحناه في الفصل الثاني، حيث ينطوي الخطاب على بعدين ينقض مضمرهما منطق صريحهما دون وعي من مستهلك الخطاب ولا من مبدعه.
2
- 2 نسق الاستفحال:
2-1-لئن كان ظهور نازك الملائكة عام 1947 وكسرها لعمود الفحولة يمثل دلالة ثقافية عن فتاة يافعة تقتحم النسق الفحولي وتحطمه وتؤسس مع السياب حركة جديدة ومختلفة في ثقافتنا ولأول مرة، مع ما في ذلك من دلالات عميقة حيث تظهر المرأة فاعلة ومؤثرة في صناعة الخطاب وفي فتح نهج جديد، حيث بدا الخطاب الفحولي في موضع التحدي والمساءلة، إلا أن الثقافة لا تعجز عن اختراع ممثلين يمثلون سلطانها الأقوى ويتولون حراسة مكتسباتها، وهذا ما حدث فعلا، إذ كان ظهور نزار قباني في العام نفسه هو الجواب الرادع على حالة التمرد النسقي في مشروع الحداثة الغض وقت ذاك.
ولكي نتصور الأمر لنعد إلى نزار قباني في أول ظهوره مع ديوانه طفولة نهد، حيث نقرأ في الصفحات الأولى للديوان قوله:
“ماذا نقول للشاعر، هذا الرجل الذي يحمل بين رئتيه قلب الله، ويضطرب على أصابعه الجحيم، وكيف يعتذر لهذا الإنسان الإله الذي تداعب أشواقه النجوك”.
هذا كلام يقوله نزار عام 1947، عام ظهور حركة الشعر الحر، وينقل بعد ذلك كلمة كروتشه، وهي كلمة تتضمن قانون الفحولة التالي:
“على الناقد أن يقف أمام مبدعات الفن موقف المتعبد، لا موقف القاضي”.
هذه مقولات تتصدر مشروع نزار قباني الشعري، الذي سيجري وصفه في ثقافتنا على أنه مشروع تحرري وتنويري، وسيجري استهلاكه على هذا الأساس، مع شيء غير قليل من العمى الثقافي فينا وفي وعينا النقدي.
ولا بد هنا أن نستذكر ما سبق أن قلناه في الفصلين الثالث والرابع عن (اختراع الفحل) وعن الصورة النسقية للفحل الثقافي، وعن صورة (صناعة الطاغية)، وهي أنساق ثقافية متجذرة وظلت تمر من دون نقد حتى شكلت أساسا ثقافيا وذهنيا ظل يعاود الظهور ويزيف المشاريع الإبداعية، حتى ليبدو الرجعي عندنا تقدميا، ويتحول التقدمي إلى رجعي، وكل حالة خروج عن النسق يجري حرفها إلى المسار النسقي وإدخالها إلى بيت الطاعة بفضل جهود مغرية كشعر نزار قباني، بما يتحلى به من جمالية راقية ومن أناقة لغوية متفردة، ومعها جماهيرية واسعة لدى القراء والقارئات العرب. غير أن تحت الجماليات عيوبا نسقية فاحشة وخطرة، والجميل يحمل المعنيين معا: الجمال، والشحم، كما هو المعني العربي للكلمة.
وبما أن نزار فحل يرث أسلافه من الفحول فإنه سيضع نفسه في الموضع المتعالي، أليس يقول إن الشاعر هو الإنسان/الإله، وأنه يحمل بين رئتيه قلب الله، وأن على الناقد أن يقف موقف المتعبد أمام مبدعات الفحل الأسطوري..؟!، بما أنه يحمل هذا الموروث الفحولي بكامل نسقيته فإنه حتما سيتمثل هذه الفحولية شعريا، وها هو ينصب نفسه مانحا عبيده القراء والقارئات لجنات هي جناته ولنيران هي نيرانه، فيقول:
إني خيرتك فاختاري
ما بين الموت على صدري
أو فوق دفاتر أشعاري
لا توجد منطقة وسطى
ما بين الجنة والناري
ثم يتصاعد به الموقف إلى لحظة التوحد التام مع الذات عابدة/معبودة:
مارست ألف عبادة وعبادة فوجدت أفضلها عبادة ذاتي
هذه ليست مجرد مبالغات شعرية، ولعل عيب ثقافتنا هو في إصرارها على التعامل مع الأوهام بوصفها مبالغات شعرية، وعلى أن أعذب الشعر أكذبه. في حين إن هذه المبالغات المزعومة هي ما يؤسس للتصورات الذهنية والثقافية عن سلطوية الذات وسموها وجبروتها. وكان نزار يدرك فداحة الموقف مما جعله يقول:
وذنوب شعري كلها مغفورة والله جل جلاله التواب
هذه الذنوب لا يغفرها نزار لنفسه بل إن الثقافة ذاتها اتخذت لنفسها قاعدة متعالية بتجاوز أخطاء الفحول وغفرانها لهم، فهم الذين يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، وهم الذين يصورون الحق بصورة الباطل، والباطل بصورة الحق. وهذا قانون فحولي/سلطوي قديم ومتجذر، وهو ما يسمح لهذه الأخطاء بأن تتسرب إلى وجداننا من غير رقيب ولا نقد، ومن ثم تصبح نماذج تحتذى كأساس للسلوك الاجتماعي والسلطوي، كما أشرنا من قبل، وكما سنوضح بمزيد من التوضيح هنا.
ذاك ما يبرر التنمذج النسقي ويعزز مفهوم التسلط والتعالي الفردي ويدفع إلى طغيان الذات المفردة، والأنا المتوحدة، والمرتبط بالضرورة بإلغاء الآخر ورفض التعددية، وترسيخ الصوت الفرد، وهي قيم خلقها وعززها النموذج الفحولي الشعري، وصارت قاعدة مسلكين لكل نماذج التسلط والفردية الاجتماعية والسياسية، بما إن الشعر هو الوجدان العربي، ومن ثم فإن نماذجه هي ما يرسم القيم السلوكية الاجتماعية، من تحت غطاء التبرير البلاغي لكل أخطاء وعيوب اللغة الشعرية مما شعرن كل مظاهر حياتنا من غير أن نعي ذلك. ولم يكن الأمر مقتصرا على الشعر وجمالياته، بل إن المجاز الشعري تحول مع الزمن ليكون قيمة اجتماعية مسلكية، كما وضحنا في مبحث (صناعة الطاغية) في الفصل الرابع.
وحينما نتحدث عن نزار قباني هنا فلا شك أنه ليس إلا طرفا من سلسلة طويلة، وهو إحدى الخلاصات الثقافية للنسق الفحولي، ويعزز ذلك جماهيرية نزار مما يعني توافقه مع الحس الوجداني العام للثقافة، ومن همنا هنا أن نكشف ضمير هذه الثقافة ومستخلصاتها النسقية.
ولقد تجلت فحولية نزار عبر خطابه الذاتي الذي يخاطب فيه نفسه أكثر من مخاطبته للآخر، ومن أجل استقراء سيرة هذا الخطاب نقف عند اقتباسات جوهرية من كلمات قباني ومقولاته. على أننا نحتفظ دائما بفكرة أساسية وهي أن هذه الفحولية ليست من إنتاج نزار قباني بقدر ما هي موروث ثقافي استلهمه نزار وانساق وراءه، وخضع له.
كما أننا لن نغفل عن فكرة جوهرية، وهي أننا نحن كقراء مسؤولون مسؤولية مباشرة عن ترسيخ هذه الصورة، خاصة نحن جيل نزار وقراءه المباشرين الذي صفقنا له وتجمهرنا من حوله وصرنا معه مساهمين في صناعة النسق وترسيخه، ومن ثم نحن صناع طواغينا، بما إن النسق الفحولي الشعري هو ذاتي نسق الطاغية الاجتماعي والسياسي، كما قلنا من قبل ونزيد في القول.
2-2-إن الوقوف على سيرة الخطاب النزاري عبر التقاط اقتباسات دالة من مقولاته تكشف لنا عن سياسة الثقافة التي يؤسس لها هذا النوع من الأدب الجماهيري، ولعل ميزته هي علته في الوقت ذاته، إذ إن الجماهيرية مرتبطة بالنوازع النسقية مما يعني أن شعر نزار هو ما سيكشف لنا عن المضمر النسقي للثقافة العربية بوصفه شاهدا عليها وعلينا وعلى نفسه.
وها هو يقول عن نفسه بتصديق ذاتي مفرط: “أنا مؤسس أول جمهورية شعرية، أكثر مواطنيها من النساء”.
وهذه دعوى غير صحيحة طبعا، وليس يهمنا مدى صحتها، ولكن المهم هو حدوث الدعوى بذاتها وانتشاء (الأنا) بجمهوريتها المزعومة وبمواطنيها من النساء مذ كانت الفحولة الشعرية هي المبدأ المحرك لشهوة الإبداع عند الشاعر.
وبما إن الجمهورية هي جمهورية الفحل، فلا بد أن يكون الرعايا نساء. ومن حق السيد الشاعر أن يعلن عن غايته من جمهوريته هذه فيقول: “إنني أكتب حتى أتزوج العالم… أنا مصمم على أن أتزوج العالم”.
ويبدأ مشروع الفحل في تحويل العالم إلى جمهورية نسائية تخضع للاستفحال، يبدأ عبر انتهاك عذرية اللغة وفضها من قبل الشاعر الفحل، وذلك لأن الكلمات في اعتقاد الشاعر عذارى وتظل كذلك إلى أن يضاجعها كي تتعهر، وعبر معاشرة الشاعر الفحل لها تتحول اللغة إلى أميرة أو إلى خادمة.
هنا يظهر الشاعر بوصفه أمير الكلام، بما إنه يجوز له ما لا يجوز لغيره، وهو (الطفل الوحيد الذي يسمح له في المجتمع العربي أن يلعب باللغة). وهذه هي أخطاؤه التي يصفها بالأخطاء الجميلة، ويؤكد ذلك بقوله: “إنها أخطاء جميلة لأنني جين أستعرضها بعد أربعين سنة من ارتكابها أجدها رائعا حقا”.
هذا يعني أنها أفعال ليست عفوية أو انفعالية، إنها عمل مخطط ومبتغى مرتضى ومقصود، وهي مشروع طويل الأمد احتاج إلى أربعين سنة من البنية والتخطيط والانتشاء الفحولي بالنتائج مع الإصرار على الخطأ رغم وعيه به، وهذه من سمات الفحل/الطاغية، الذي يجعل الباطل حقا والحق باطلا، كما هو وصف الخليل للفحول.
هي مشروع لانتهاك اللغة والعالم وتحويل اللغة إلى خادمة تنصاع لمراد السيد الشاعر مع الرغبة في إذلال العالم وإخضاعه لنزوات الفحل، وبمعنى آخر هي بعث لعادة (الاستفحال) وهو: “أن يطلق الفحل الجسيم على النساء ليحبلن منه، وهي عادة في بعض بلدان الشرق”.
إن الشاعر هنا يقدم بإصرار وتعمد على استنبات مفهوم (الفحل) بخصائصه الفحولية المتعالية. ولن تكتمل هذه الفحولة إلا بإلغاء الآخر وإعلان وحدانية الذات، وهذا هو الوجه الآخر لصورة الفحل.
يقول نزار قباني في ذلك: “إنني لا أقيس نفسي بأحد.. إنني أقيس نفسي بنفسي”.
هذا هو علقمة الفحل الذي لا يرى أحدا غيره، ولذا كثر تبرم نزار بناقديه وأظهر الامتعاض منهم، وأعلن احتقاره لمنافسيه وازدراءه لهم، وقال إنهم يحسدونه ويغارون منه ومن شعبيته، ولذا فكر بإيجاد (قوة ردع أدبية) تلقي القبض على خصومه بتهمة الزنى بالكلمات والقذف العلني لسيدهم الشاعر/الفحل.
والفحل هنا هو الحجة والداعية، كما يقول فحل آخر سنراه بعد قليل، فالفحل يضع قوة رادعة ويبتكر التهمة التي قد تكون الخيانة العظمة والعمالة، مثلما هي الزنى بالكلمات والقذف العلني، وويل لمن لمس الفحل أو تحرش به فعداوته بئس المقتنى، كما هي قاعدة أي فحل سلطوي. والنهاية هي تصفية الجو للسيد الفحل بالحكم المطلق ولا أحد سواه.
وإذا كان الشاعر يحمل في داخله هذه المشاعر، فإننا نسأل عن جمهوريته التي ادعى تأسيسها، وأي جمهورية هي…؟
أهي جمهورية من رجل واحد والباقي جوار تستجيب لنزواته وشهواته بما في ذلك اللغة التي تنتظر معاشرته ومضاجعته لها، والعالم الذي ينتظر منه أن يدنيه إلى فراش الزوجية، وبعد ذلك يتولى الشاعر طرد الآخرين من جمهوريته الخاصة به وحده دون سواه.
هذه الجمهورية المحروسة بقوة الردع الأدبية التي تحمي حمى السيد الشاعر وتمنحه حق القول والفعل، أما من عداه فهم رعايا وخدم وجوار، وويل للمارقين.
هذا هو برنامج السيد الشاعر رئيس الجمهورية بوصفه الأب الرمزي الذي لا يصير فحلا إلا عبر تأنيث ما عداه، بمعنى أن هذه الفحولة –كما هو شأنها أبدا- ترى التأنيث نقصا ودونية وكائنا مسكينا تحتاج إلى الشاعر/الأب لكي يرعاها ويتكلم نيابة عنها –كما سنرى في الفقرة التالية-.
والفحل دائما فرد متفرد في فحوليته، وشيطانه ذكر لأنه نجم عجلي، أو هو عجل نجومي، هو وحده، لأن من سواه شيطانه أنثى وله الشيطان الذكر وحده.
- 2-3-الجميل الشعري/القبيح الثقافي:
تأتي النشوة البلاغية والهوس الجمالي بوصفهما حجابا يغطي على العيوب ويغشي العيوب عن التبصر. هذه هي لعنة الشعر حينما يكون جماليا فحسب، أو أنيقا فحسب. ومن تحت الأناقة تكمن البشاعة الإنسانية التي تأسست أصلا في الذهن الثقافي المهيمن وتوفر لها رموز يعيدون إنتاجها مستخدمين أجمل المبتكرات البلاغية والوسائل الأسلوبية. ومشكلة هذا النوع من الذوات والأنساق أنها ذات نسقية غير قابلة للتغير أو التحول. هي إياها لا تتغير. وها هو نزار في آخر أيام حياته، عام 1997 مثلما كتب في عام 1947، وكأن خمسين سنة من عمر الثقافة لم تمر ولم تفعل.
وفي واحد من آخر ما كتب من نصوص (جريدة الحياة 6/6/1997) تتردد جمل نسقية قالها من قبل خمسين سنة من مثل:
لم أزل من ألف عام،
لم أزل أكتب للناس دساتير الغرام
وأغني للجميلات…
على ألف مقام ومقام…
أنا من أسس جمهورية للحب…
لا يسكنها إلا الحمام…
***
لم أزل من ألف عام،
أحمل الأنثى على ظهري
وأرسيها على بر السلام
لم أزل أعمل كالنحلة،
في جمع الأزاهير
وتطبيع العصافير
وفي تزيين قاعات الشآم
أنا من ربيت دود القز
في أشجار نهديك
وحركت أحاسيس الرخام
***
منذ أن غنيت أولى كلماتي
وأنا أرفع شمس العشق
في وجه الظلام
لم أنم طيلة قرن كامل
يا ترى في أي قرن قادم
سوف أنام؟؟
***
قبل أن أكتب عن خصرك شعرا
لم يكن عالمنا
يعرف ما ريش النعام
***
كنت يا سيدتي خرساء قبلي
وبفضلي…
صار نهداك يجيدان الكلام…
***
فاشكريني…
كلما شاهدت أعضاءك في ماء المرايا
فبدوني لن يكون القد قدا
أو تكون الساق ساقا
أو يكون الكحل كحلا
أو يكون الورد وردا
وبدوني..
لن يكون الشعر المجنون إعصارا..
وسيفا يتحدى..
وبدوني..
لن تري في كتب التاريخ
عفراء وليلى
أو تري هندا ودعدا
***
واشكريني مرة ثانية
كلما جاء ربيع أو شتاء
فبدوني لن تكوني قمرا
يسكب الفضة والثلج
على نار المساء
وبدوني
لم يكن ثغرك مرسوما
كخط الاستواء..
***
يا التي رصعت كشمير يديها
بخيوط من قصب
وحواشي ثوبها
برقاقات الذهب
والتي مرت كعصفور ربيعي
ببستان الشعر كثيرا
أنت لولا الشعر، يا سيدتي
لم يكن اسمك مذكورا
بتاريخ النساء.
هذا نص يعيد صياغة التجربة الشعرية لدى نزار قباني مكررا أخطاءه (الجميلة..؟!) أو ذنوبه الصغيرة –حسب تعبيره- وهو جازم بأنه ذلك المتفرد الصانع الواهب فحل الفحول وشهريار العالم، الذي لولاه لما صارت الأشياء ولولاه لانهار الكون.
أنه يعيد جمله المركزية المتكررة في كل خطابه الشعرية والنثري، فيقول:
“أنا من ربيت دود القز
في أشجار نهديك
وحركت أحاسيس الرخام”.
مكررا ما قاله من قبل عقود:
“إن كنت أرضى أن أحبك
فاشكري المولى كثيرا
من حسن حظك
أن غدوت حبيبتي زمنا قصيرا
فأنا نفخت النار فيك
وكنت قبلي زمهريرا”
ذلك لأن الفحل ما زال منتشيا بفحولته فهو (مولاها) الذي لولاه لا تكون:
“قبل أن أكتب عن خصرك شعرا
لم يكن عالمنا
يعرف ما ريش النعام”.
شكرا لك يا مولانا… من نحن وما نحن لولا نباهتك وتنبيهك لنا عما كنا في عمى تام عنه لولاك أيها الرهبوت –مع الاعتذار لأمل دنقل-.
هذا عنا وعن العالم، أما النساء فلهن منه الهبات الكثار –مع الاعتذار للسياب-.
“كنت يا سيدتي خرساء قبلي
وبفضلي..
صار نهداك يجيدان الكلام”.
ألم يقل من قبل:
“ليس يكفيك أن تكوني جميلة
كان لا بد من مرورك يوما
بذراعي..
كي تصيري جميلة”
أما لماذا وكيف، فهذا ما كان جوابه جاهزا:
“ليس لك زمان حقيقي خارج لهفتي
أنا زمانك
ليس لك أبعاد واضحة
خارج امتداد ذراعي
أنا أبعادك كلها”.
لقد قالها مرارا ومرارا من قبل، غير أن السيد الشاعر يمن علينا دائما بتذكيرنا وتقرير الأوامر والتعليمات علينا فيعيد ما قاله قبل خمسين سنة في طفولة نهد حيث نتذكر قوله:
ما أنت من بعدي سوى طلل أنقاضه تبكي على بعض
وقوله:
اتركيني أبنيك شعرا وصدرا أنت لولاي يا ضعيفة طين
***
مشكلتنا أمام شعر كهذا أننا استسلمنا لقاعدة نقدية (بلاغية) ذهبية تمنعنا من النظر في عيوب الشعر لأنها تحرم علينا مساءلة الشاعر عن أفكاره وتحدد لنا مجال الرؤية في ما هو جميل وبلاغي، وليس لنا النظر في العيب والخطل الفكري، والرخصة الوحيدة هي في النظر إلى العيوب الشكلية في الأوزان والقوافي أو في عيوب التعبير اللفظي.
هذا ما تدربنا عليه ثقافيا مما يمثل مؤامرة جماعية ضد العقل والذوق تقبلناها وخضعنا لها، وكأنها هي صنم صنعناه بأيدينا ثم استسلمنا له خاضعين طائعين.
أو ليس هذا عمى ثقافيا..؟!
2-4-نعود ثانية إلى آخر قصيدة لنزار وعنوانها التقليدي –كما هو المعتاد الشعري لنزار-: (أنت لولا الشعر ما كنت بتاريخ النساء).
وهو عنوان يتضمن بالضرورة المعنى الحقيقي المخبوء في مضمر النص وهو: (أنت لولاي) بإحالة الضمير إلى الذات والتركيز على (الأنا) كما هو موجود في شعر نزار، وكما هو شرط الشاعر الفحل والأنا الطاغية.
وفي دعوتنا إلى النص لا بد أن نلحظ ترداد عبارة (وبدوني) التي طغت على القصيدة مكررة عبارة (أنت لولاي) التقليدية. هذا التكرار الذي يذكرنا بكلمة رولان بارت حول دور التكرار في التهييج الشبقي. وهو تكرار يقوم على الاستدعاء المستمر للملامح الجسدية للأنثى، هذه الكائنة التي تتقلص إلى مجموعة محددة من العناصر هي:
نهداك/أعضاؤك في المرآة/القد/الشعر/الثغر.
ولا شيء سوى ذلك، وهذه هي الأنثى مجموعة محددة من العناصر الجسدية تطفحبها لغة قباني، ويحدث من تكرارها المستديم حس تهييجي وشبقي صارخ.
على أن الحديث عن جسدية الأنثى ولا عقلانية الجسد المؤنث عند نزار قباني سيكون أمرا معادا ومكرورا، والجميع يتفقون عليه –ولا شك- ولكن السؤال هو: لماذا يصر نزار على ذلك، من جهة، ولماذا يندفع القراء (والقارئات) من جهة ثانية وراء هذا النسق الصارخ المقلص للجسد المؤنث والملغي لأي حس عقلي أو إنساني، مع ما فيه من استفحال وتصنيم للذات المذكرة..؟!
ومن المهم أن نأخذ مسألة الأنوثة عند نزار من قمتها، ذاك لأن الموقف من التأنيث هو الكاشف عن ألاعيب التفحيل، وهو الكاشف عن الموقف الفحولي من الآخر والمهمش، مع ما تمنحه الذات المذكرة لنفسها من سلطان على الأشياء والعالم والآخر (والأخرى)، ونبدأ من ديوان نزار الذي سماه (أحلى قصائدي) وهي مختارات شعرية انتقاها نزار من بين مختلف دواواينه وأعاد نشرها وسماها بالأحلى، وفيها نجد قصائد مرعبة من حيث ما تحمله من تصورات فحولية للذات عن ذاتيتها وعن علاقتها مع الآخر.
والآخر عند الذات الفحولية ليس سوى كائن أنثوي مختصر في جسد شبقي مشته، يدخل في علاقة (استفحال) مع الشاعر الكوني. وانظر مثلا هذه الأنثى التي تجثو أمام الفحل متوسلة إليه كي يشعل سيجارته من عينيها (ص ص24،49) هذا الفحل المتوحش الضارب اللاطم المستبد في قصائد يسميها بالمتوحشة (ص100) ذلك لأن الجسد المؤنث عنده ليس سوى دفتر يكتب عليه أشعاره. والمرأة بوصفها ورقة يخط عليها الشاعر فحولته وذنوبه وأخطاءه، في مرادف محدد الدلالة، فإذا كانت الكلمات ترادف الصفحات، والزجاجة للعطر، والبحر للمسافرين، فإن المرأة عنده ترادف الجنس تحديدا وحصرا، هذا ما نجده عند الشاعر المستفحل..!
وما بين قصيدة (لوليتا – ص45، أحلى قصائدي) وقصيدة (نهداك – ص105) يتقرر عمر المرأة، أي يتحدد الزمن الذي تكون فيه المرأة أنثى مطلوبة من السيد المستفحل ومرغوبة منه.
فلوليتا لا تلفت نظر السيد المستفحل إلا بعد أن تبلغ سن الخامسة عشرة، أما قبل ذلك فهي خارج البصر، ولم تكن مؤهلة لدخول القصر الإمبراطوري، ولكنها اقتطعت تأشيرة الدخول من لحمها ودمها، وصارت تستعطف السيد الشاعر بأن يتلفت إليها:
“صار عمري خمس عشرة
كل ما في داخلي غنى وأزهر
كل شيء صار أخضر
شفتي خوخ وياقوت مكسر
وبصدري ضحكت قبة مرمر
وينابيع وشمس وصنوبر
صارت المرآة لو تلمس نهدي تتخدر
والذي كان سويا
قبل عامين تدور
فتصور”.
تصرخ المرأة معلنة أنها صارت أنثى حسب شروط السيد الفحل، وبالتالي فإنها تستجدي نظرته إليها. وما من رجل يسمع هذه الكلمات إلا وتشتعل نيران فحولته وشبقيته، فهذا هو موسم القطاف. وهو موسم محدود، هذه بدايته، وسوف نرى نهايته في قصيدة (نهداك –ص105) حيث تسمع الأنثى أجراس الإنذار تدق في أذنيها حينما يقول لها السيد الفحل محذرا ومنبها:
مغرورة النهدين خلي كبرياءك وانعمي
بأصابعي، بزوابعي، برعونتي، بتهجمي
فغدا شبابك ينطفي مثل الشعاع المضرم
وغدا سيذوي النهد والشفتان منك فأقدمي
وتفكري بمصير نهدك بعد موت الموسم
بداية محددة، ونهاية محددة، يحددها النهد النابت للتو أو الذاوي للتو. هذا هو زمن القطاف وزمن الأنوثة لدى السيد المستفحل، وما خرج عن هذين الحدين المقررين من الشاعر فهو خارج النظر والرؤية، وصاحبته مطرودة من جمهورية الشاعر. تلك الجمهورية التي رعاياها نساء، ولكن أي فئة من النساء…؟
في داخل جمهورية السيد الزعيم تصدر بيانات الفحولة، ويكفي أن نقرأ قصيدته (الرسم بالكلمات) وهذه بعض أبيات منها:
لم يبق نهد أسود أو أبيض إلا زرعت بأرضه راياتي
لم تبق زاوية بجسم جميلة إلا ومرت فوقها عرباتي
فصلت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراما من الحلمات
هي كلمات بمثابة البيان الرسمي عن الاستفحال، وهي كلمات يتفوه بها نزار بلسان حال كل فحل وكل رجل، لأنها تمثل النسق الثقافي المغروس في أذهان الرجال عن وظيفتهم الوجودية مع الجسد المؤنث، كما عبر عن ذلك كتاب الروض العاطر مع شخصية (البهلول)، وأعاد قباني صياغته شعريا، في تجاوب تام مع النسق. وهذا هو المطرب والمغري فيها –حسب معيار الاستفحال ولا شك-.
ولكن السؤال هو هل هذا فعل صحيح ومسلك سليم وإنساني، في ظل ثقافة المساواة الإنسانية والحضارية التي نتنطع بها…؟!
وهل نقبل ذلك من دون حياء أو خجل، وهل يحسن بنا نقد هذه الصورة وتعريتها، أي نقد ذواتنا كرجال، ونقد ثقافتنا ومساءلة تصوراتنا بعيدا عن حالات الانتشاء والطرب –وهو انتشاء وطرب استغله نزار قباني بأقصى غايات الاستغلال واستثمره استثمارا ماديا مربحا ومروجا لأنه قدم للفحول لحما طريا وعبيطا يتلمظونه ويتبجحون به وبفتوحاتهم الجسدية المظفرة، في متعة تامة بالجمالي والبلاغي، وفي عمى ثقافي تام.
- 2-5-الطاغية والشاعر:
هل لنا أن نفترض السؤال التالي: ماذا لو أن الجمهور العربي انصرف عن شعر نزار قباني أثناء حياته، وقاطع أمسياته وامتنع عن شراء دواوينه ولم يزده تصفيقا وإعجابا..؟!
طبعا سيكون الجواب واضحا، وهو أن نزار قباني سيغير موقفه الثقافي وكنا سنرى منه مواقف مختلفة، وصورا أخرى غير التي تركها لنا، أو بالأحرى تركناه يصنعها لنا.
هذا يعني أننا نحن كقراء مسؤولون عن هذا الصنم الذي ابتكرناه لأنفسنا، وابتكرته الثقافة من أجلنا، وصار حالنا كحال الرعايا حينما يصنعون طغاتهم عبر التصفيق لهم، فيدفعون الطاغية إلى الرضا عن ذاته وطغيانه، وإلى مزيد من الطغيان.
إن الجمهور الراضي والمصفق يربي سيده على مزيد من الغلو والغرور. وهذا ما حدث بالضبط مع نزار قباني، إذ إنه صنيعة الثقافة الفحولية ومخلوق الجمهور المتغذي بهذه الثقافة والمرتوي منها.
إن نزار نموذج مطلوب في الذهن الثقافي، ولذا انوجد واستمر وثبت واتسعت رقعة انتشاره وتوزيعه.
ولهذا فإنه يلزمنا نقديا أن نشرع في نقد المستهلك الثقافي الجماهير لأن نقد هذا المنتوج ذي الشعبية العريضة سيكشف لنا عن (العيوب النسقية) الخطيرة الكامنة في وجداننا الثقافي، وسنرى (الجميل) بمعناه الآخر، أي (الشحم) داخل هذه التركيبة. ولا بد أن نكشف عن حالات (العمى الثقافي) التي بسببها نعجب بالعيب ونطرب للخطأ ونطلبه ونسوقه.
وإلا كيف نتصور شاعرا حديثا ومبدعا يقدم لنا صورة عن الذات الدكتاتورية/الطاغية، التي تنفي الآخر وتلغيه، وتحول العالم إلى جارية تتوسل سيدها الفحل بأن يتسرى بها مثلما يتسرى باللغة، ويحول الكلمات إلى خدم ومحظيات ينتهك حرمتهن متى ما شاء، لكي يتزوج العالم ويحقق مشروعه في (الاستفحال).
إذا كان هذا هو النموذج الشعري الأكثر شعبية في مرحلتنا هذه، فهل نلوم النماذج الاجتماعية والسياسية إذا كانت الثقافة ذاتها هي ثقافة النموذج الدكتاتوري الطاغي والمتفرد والنافي للآخر..؟!.
أو ليست الثقافة الشعرية باعتمادها لنموذج الفحل هي التي تؤسس وتنمذج صورة الطاغية في الذهنية الثقافية، متوسلة بالجمالي والمجازي لتمرر نماذجها وتجملها في ذائقتنا..؟!. ولقد رأينا في الفصلين الثالث والرابع ما يعزز هذا الزعم ويؤكده، وذلك منذ أن تشعرنت القيم الثقافية، وتشعرنت معها الذات العربية، وجاءنا عبر الجماليات الشعرية عيوب نسقية هي غاية في الخطورة، لا سيما أنها ظلت تمر من غير نقد ولا مساءلة، واكتفينا بالتغني بجماليات الشعر وغنائيات الشعراء عن ذواتهم المتضخمة، وسرى ذلك فينا حتى صار هو النموذج المحتذى.
ولذا فإن العلة ليست في نزار قباني بذاته، فنزار ناتج سقي للثقافة، مثلما أننا نحن شركاء في الذنب، فنحن نتاج نسقي أيضا تربينا على المعطى النسقي، وصرنا نطلبه ونطرب له مثلما نتمثله مسلكيا وقيميا. ولعل الفرق هو أننا لا نغفر لأنفسنا ذنوبها على عكس موقف نزار الذي لم يبال بذنبه النسقي، مستجيبا لدواعي النسق ذاته.
ولن يكون غريبا أن نقول إن مثل أشعار قباني هي التي تؤسس لميلاد الطاغية، وتعطي الطغاة صورة جاهزة للتسلط، طالما أن النموذج الثقافي هو كذلك. كما أنه لن يكون عجيبا أن يظهر قباني في العام ذاته الذي ظهرت فيه القصيدة الحرة والشاعرة الحرة والشاعر الحر، أي الخطاب المتحدي للنسقية والخارج عليها، والمهشم لعمود الفحولة. فظهور القباني هو الجواب النسقي على هذه الثورة في الخطاب الإبداعي. ولسوف نرى جوابا أشد فداحة من صنيع قباني.
3
- 3 – تفحيل الحرة (أدونيس ورجعية الحداثة)
3-1- في رابطة عضوية مضادة ظهرت الظاهرة الأدونيسية في الإبداع العربي الحديث، لتكون في ظاهرها مشروعا في الحداثة على مستوى التنظير والكتابة، وتظهر شخصية أدونيس بوصفها علامة وعنوانا على هذه الحداثة. وكما احتل نزار قباني مساحة التذوق الجماهيري العربي وعلى مدى خمسين سنة من الزخ المتوصال، فإن أدونيس أيضا يأتي عارضا رمحه الفحولي أو التفحيلي، محتلا الذائقة النخبوية والحداثية فكريا وتأسيسيا. وليس الاثنان معا، نزار وأدونيس، إلا جوابا ثقافيا نسقيا مضادا، وإن بدا الأمر على غير ذلك.
إنهما الصورة الأخرى للمشهد الثقافي، بحيث إن ما بدأته حركة الشعر الحر، وما بشرت به من تحرير للخطاب النسقي، وتأسيس لعقلية مختلفة في الفهم والتصور والتعبير، يأخذ في البعد الإنساني والتعدد والمختلف والمهمش والتأنيثي، وكل هذا الذي هو من نواقض الفحولة ومن اختراقات النسقي الفحولي، كل ذلك هو ما أسس لجواب مضاد اتخذته الثقافة للدفاع عن فحوليتها عبر ممثليها وحراسها النسقيين.
ويأتي أدونيس كأحد أشد ممثلي الخطاب التفحيلي بكل سماته النسقية، كما سنوضح هنا. ومثلما كان أبو تمام حداثيا وتجديديا في ظاهره، ورجعيا في حقيقته، فإننا سنرى أن أدونيس أيضا رجعي الحقيقة، وإن بدا حداثيا وثوريا. وسنرى أنه ظل يمثل النسق الفحولي ويعيد إنتاجه في شعره وفي مقولاته. بدءا من الأنا الفحولية وما تتضمنه من تعالي الذات ومطلقيتها، إلى إلغاء الآخر والمختلف، وتأكيد الرسمي الحداثي، كبديل للرسمي التقليدي، وإحلال الأب الحداثي محل الأب التقليدي.
وكأنما الحداثة غطاء لنوع من الانقلاب السلطوي لهدف إحلال طاغية محل طاغية، كما هو المفهوم المحرف لمعنى الثورة. مع ما نجده لدى أدونيس من تأسيس لنوع من الخطاب اللاعقلاني، وهو الخطاب السحراني، كما نسميه في هذه الدراسة، وبالتالي تأسيس حداثة شكلانية تمس اللفظ والغطاء بينما يظل الجوهر التفحيلي هو المتحكم بمنظومتها النسقية ومصطلحها الدلالي المضمر.
- 3-2-الأب الحداثي:
ولد الفتى أحمد سعيد ولادة طبيعية مثله مثل أي طفل ريفي فقير، وظل عشرين سنة من عمره يعيش حياة فطرية شعبية لم يعرف مدرسة ولا كتابا، وفي العشرين من عمره اكتشف المدرسة والأبجدية، وتحول علي أحمد سعيد إلى (أدونيس) وهو تحول له دلالته النسقية، حيث هو تحول من الفطري والشعبي إلى الطقوسي.
وهو هنا يختار مسمى سيكون علامة ثقافي فاصلة تتضمن الفحولية الجديدة، حيث هو اسم مفرد كبديل عن الاسم المركب. وهو اسم يحمل مضامينه الوثنية التفردية والمتعالية، ويحمل هيبته الأسطورية وعلوه المهيب، في ذاكرة تسلم بالمطلق وتخضع للأب وتنصاع للتعليمات، ومسمى أدونيس الأسطوري يؤكد هذه الدلالة ويعززها. ومن التحول من الاسم الشعبي المركب إلى الاسم الأسطوري المفرد، يتحول الفتى ليقول شعرا ويشبعه بالتنظير، وكل ذلك في خطاب ينضح بالنسقية والفحولية.
وكما تحول اسمه إلى المفرد الكلي الأسطوري فإن خطابه الشعري يتوسم لتحول مماثل، وهذا ديوانه المسمى (مفرد بصيغة الجمع) يقدم صيغة مثالية للنسق، في تجاوب تام مع تحولات الاسم والسيرة. وفي هذا الديوان يضع الشاعر جملة ذات بعد نسقي دال، هي قوله مباشرة بعد العنوان: (صياغة نهائية) وهي جملة تظهر على الغلاف، وتتكرر على الصفحة الأولى من الديوان.
وهذه لحظة من التجلي المكشوف لسيرة النسق التي يتمثلها الشاعر، فهو مفرد جامع ونهائي، وبما إنه كذلك فإن خطابه سيأتي على هذه الصفة، بما إنه خطاب لذات مفردة جامعة، وقولها هو الكلمة النهاية، قول صاغه فحل أسطوري متفرد متعال هو أدونيس، هذا المسمى الرسمي الذي اختاره صاحبه رافضا الاسم الذي منحه له أهله.
ذاك لأن من شأن الفحل أن يكون أبا لذاته، كحال المتنبي صار أبا لجدته. وهو أب أسطوري يمثل الرغبة في العودة إلى الأصل الأسطوري بما فيه من عبادة للفرد وما فيه من تسليم مطلق بالصياغة النهائية، ولذا جرى وصف قول السيد الأب بأنه صياغة نهائية، بما إن السيد الأب مفرد جامع، وبما إنه أدونيس الفحل.
وما أن تشرع في قراءة النصوص حتى تصدمك الأنا الأدونيسية بتضخماتها المسرفة بالتعالي الأسطوري في تفرد هذه الذات وتميزها الخرافي، فهي ترى ذاتها بأنها: أنا العالم مكتوبا، وأنا المعنى، وأنا الموت، وأنا سماء وأتكلم لغة الأرض، وأنا التموج، وأنا النور، وأنا الأشكال كلها، وأنا الداعية والحجة.
هذه سمات المفرد، أما صيغته الجامعة فتأتي من كونه يرى ذاته بما إنها الفضاء الكوني كله: أنا الموزع بين زحل والزهرة وعطارد، وأنا الصوت يرتجل الفضاء، وأنا الحجر يتطوح وقراره الموج، وأنا الصارية ولا شيء يعلوني، أنشي سلطة الرغبات. لذا ترى الذات ذاتها في درجة النبوة، وتسمي طفلها: سمه النبي والخالف. وبما إنه كذلك فإن الأنا تضيق عن الأنا، ويصير العالم نافذة لا تتسع لأهداب هذه الذات المتعالية كل هذا العلو، وتنتهي بأن تنادي:
“اقتربي أيتها الرياح
اجتمعي إلي
أخلق بك
أخلق منك”.
وعندها تبلغ الذات حد الثقة المطلقة فتسأل: أيتها الشمس ماذا تريدين مني..؟.
ويجب علينا هنا أن نحتاط لأنفسنا فلا يأخذنا الوهم إلى أبعد مما يصح، إذ ليس من الصحيح أن نتصور أن هذه المقولات مجرد تعبيرات شعرية مجازية. وهي ليست كذلك لأسباب عدة، منها أن هذه الجمل ليست من مبتكرات أدونيس، وهي ليست سوى جمل مكررة عن شعراء سبقوا أدونيس إليها، كما عرضنا من قبل في الفصل الثالث والرابع عن (اختراع الفحل) وهناك رأينا جملا مماثلة لم يفعل أدونيس سوى أن استعادها وتمثلها في ذاته.
ثم إننا –ثانيا- لا نقول بمجازية هذه الجمل لأنها تتكرر عند أدونيس في خطابه التنظيري، تماما مثلما هي في أشعاره، كما سنوضح بعد قليل، وهذا معناه أننا أمام جمل ثقافية نسقية، حسبما حددناه من قبل عن مفهوم الجملة الثقافية (الفصل الثاني).
وإن الخلل الثقافي في النقد الأدبي وفي الاستقبال الأدبي الخالص هو في عدم تمييزه بين الجمالي المجازي من جهة، وبين العلامات الثقافية النسقية من جهة ثانية، وتكتفي الممارسة الأدبية بالتذوق الجمالي متعامية عن عيوب الخطاب ومشاكله النسقية. وهذا ما يوجب قيام نقد ثقافي يعنى بعيوب الخطاب، وما يختبئ وراء الجمالي. وليس الجمالي إلا غطاء تتقنع به الأنساق لتمرر هيمنتها على الذائقة العامة متوسلة بحراسها الفحول وأدونيس من أبرزهم، ولا شك.
- 3-3-زمن الشعر/زمن الموت العظيم:
يحمل كتاب أدونيس المعنون بزمن الشعر دلالته النسقية، من حيث توصيفه للزمن بهذه الصفة، فهو ليس زمن العقل ولا الفكر، وما هو بزمن الفعل والسياسة. إنه زمن الشعر، حتى أن لا حداثة في العالم العربي إلا في الشعر، كما يقول أدونيس. ولا وجود لحداثة في الفكر أو الاقتصاد أو السياسة والمجتمع.
ومن ثم فالزمن زمن الشعر فحسب، بل هو بالأحرى زمن الشاعر، أو زمن الشاعر الأب، أدونيس ذاته، كما تضمر مقولات أدونيس في هذا الكتاب وفي غيره من أعمال الشاعر. ومن الواضح أن هذه تمثل عودة رجعية إلى زمن الفحل وزمن الشاعر/العراف، والقصيدة/السحر. كما هو الأصل الجاهلي الأسطوري للرجل الأب.
في زمن الشعر يتكلم أدونيس منظرا لهذا الزمن في عبارات لا يمكن وصفها بأنها مجازية، لكنها نسقية بكل تأكيد، فيقول: “الشاعر الجديد متميز في الخلق وفي مجال انهماكاته الخاصة كشاعر. وشعره مركز استقطاب لمشكلات كيانية”.
هذه جمل تأتي في مطلع الكتاب وكأنما هي استهلال فحولي لمشروع تفحيل الحداثة، وتدجين الاستقبال الجديد، فهو هنا يتصدى لوصف مشروع (الشاعر الجديد). ولو كان هذا وصفا لحال الشاعر النسقي التقليدي لكان من أصدق وأدق الصفات. فالشاعر أو الفحل النسقي هو المتفرد المتميز، وهو مركز الاستقطاب الذاتي، ومجال رؤية الذات لذاتها بوصفها مركز الكون، وبما إنها ذات خصوصية كيانية متعالية.
ويصف أدونيس فكرة الشاعر (الجديد…؟!) من حيث إنه الذي يخلق أشياء العالم بطريقة جديدة. وهذه جملة ثقافية نسقية تصف بها الذات فعلها وتمنحه الصفات والمزايا التي تريدها، بطريقة ادعائية. والذات فيها هي الداعية والحجة –حسب عبارات أدونيس ذاته- والشاعر هو الفائق والخارق، وهو أكثر من ذلك، النبي والمتأله، بفعل من ذاته ودعوى منه.
هذا الجديد المزعوم هو (انبجاس سيد) وهو (واحد في كثير) وهو (أفق: إنني أفق، وقدري أن اشع)، هذا ما يقوله أدونيس على مستوى التنظير والتفكر، مما يؤكد عدم مجازية عباراته الواردة في قصائده، ويحولها إلى مقولات نسقية ذات بعد نظري وثقافي يؤمن بها الشاعر ويحدد مشروع الحداثة بسماتها، حسب تصوره للحداثة.
وهو تصور لا يقدم فهما جديدا لا للذات ولا للخطاب، وهو الذي يقول عن شعره: “إنه اللهب وما يدفع إلى أبعد من اللهب”، وهو “شاعر الخطر والأسرار”، “حارس يقرأ نبض العالم”، “ويربض في إيقاع التاريخ”، “الساحق الغامر الخالق”، “زمن يتضمن ما هو أكثر من الزمن”.
كل هذا وأكثر من هذا الذي هو خطاب في الذات وعن الذات، في مسعى تفحيلي صارخ، لا نعجب معه أن يكون النموذج الاجتماعي والسياسي فحوليا وذاتيا مطلقا وقطعيا متعاليا مذ كان النموذج الثقافي، الموصوف بالحداثي، هو على هذه الشاكلة الصارمة في تفردها وقطعيتها وانغلاقها وتعاليها.
وهذا الذي أوردناه ليس مجرد اقتباسات معزولة أو منتقاة، بل هو اللب الأعمق والمسيطر على خطاب أدونيس ومقولاته وأفكاره. وأي قراءة لأعمال أدونيس الأخرى المبكر منها والمتأخر سيعطي النتيجة ذاتها، بل إنه ليعيد ويكرر هذه المقولات مع شيء يسير من التعديل في الصيغ، ويصر على التكرار هذا لسبب جوهري هو البحث عن الصيغة النهائية المطلقة، كما وصل إليها وأعلنا بثقة نسقية قاطعة على غلاف ديوانه (مفرد بصيغة الجمع). وهو ديوان يلخص بيان الفحولة ورجعية الحداثة الأدونيسية ونسقيتها بشكل صارم وصريح.
وفي صدمة الحداثة يصرح بأن الأساس هو الشاعر لا الشعر، ويقطع بفرادته، لأنه كل شيء ولا شيء سواه. وبما إنه كذلك فهو يرى ذاته على مقياسه هو وسيقول عن نفسه من دون مواربة: أنا “قادر أن أغير لغم الحضارة – هذا هو أسمى”، هذا اللهب الساحر المشتعل الذي يركض الوطن وراءه، فيمشي بين المحير والمعجز، وتلك هي ملذاته، وهي ملذات تأتي من معجم غني بالتفرد ومن ثم نفي الآخر.
هذا خطاب (الموت العظيم) حسب تعبير أدونيس، كما سنشرح بعد قليل.
- 3-4-أنا الحق/أنا المطلق:
ينطوي خطاب أدونيس على طبقية ثقافية يعتلي الأب قمة الهرم فيها، وهي طبقية ليست من اختراع أدونيس ولم يؤسس لها، ولكنه يرثها عن النسق الفحولي، ولقد ناقشنا الطبقيات الثقافية في الفصل الرابع، وما فعل أدونيس إلا استجابة نسقية لذلك المخزون الطبقي. ومنذ اتخذ الأب الحداثي لنفسه مسمى ذا بعد أسطوري (:أدونيس)، وهو في صدد تصنيم الذات وتتويجها على صورة (البعل) الأسطوري.
الذي ترد رسومه في النقوشات القديمة كأكبر ما يكون الرجال على هيئة الفحل الكامل والجسد الضخم. وإن كانت الثقافة القديمة تعبر عن معانيها بالرسم فإن أدونيس يتوسل باللغة لخلق الصورة الفحولية للذات الشاعرة عبر القول الشعري وعبر التنظير. وفي زمن الشعر يقدم الشاعر على تمييز عريقان.
ثم يضع الشاعر فوق الشعر، وبما إن شعره اللهب وما هو أبعد من اللهب فإنه يشرع في إحلال نفسه محل كل من عداه، وفوق الجميع. فهو الخلاصة الكونية (ص117)، وهو مالك الحقيقة. والحق مع الشعر، وهذا تعبير سلطوي يرادف تعبيرات الحق مع الزعيم، والحق مع القانون، والحق مع الثورة (ص116)، حيث يمتلك العالم (ص137) ويخضع العالم له، ينطقه متى ما شاء ويخرسه متى ما شاء (ص141)، هو الشاعر فحل الفحول الذي يصف نفسه كالآتي:
“مالك ملكه الأرض والسماء
شعره النبات
جسده الأقاليم
عروقه الأنهار
ويداه جناحان يمشي بهما في الفضاء
ظاهره بر باطنه بحر
أو
كما
قيل (…)
اخرج إلى الأرض أيها الطفل” مفرد بصيغة الجمع، ص14.
هذا هو مشهد ميلاد الفحل الحداثي الذي سيسمي نفسه أدونيس، والذي يشهدميلاد ذاته، ويحدد سمات هذه الذات الخارقة. الذات البعولية الأبوية (الحداثية..؟!).
وبما إنه كذلك فإنه بالضرورة الفحولية ناف للآخر. وهذا ما يحدث تماما، فكل ثورة غير ثورته ليست بثورة، وكل بيئة غير بيئته ستوصف بأنها مهترئة ومتعفنة، والكل متخلفون، والجماهير العربية جاهلة. ولذا فإن قيمته في تعاليه، كما يحدد هو، ويقرر أنه فوق الشعب، متعاليا بذلك على الناس الموصوفين عنده بالجهل والتخلف، ليظل هو في عليائه وتفرده.
وينتهي إلى نهاية تشبه نهاية نزار قباني، حيث يرشح نفسه بعلا كونيا ويتزوج العالم والأرض بين يديه امرأة، حفيد قايين، ويصطفي الشبق من بين تقاليده، لكي يعطي الكون أسماءه وصفاته، بعد إخضاع الكون للاستفحال. والجسد هو أطول طريق إلى الجسد.
هذا الشبق هو الغذاء الأسطوري للأب الفحل، وهذه هي سيرة المنظر الحداثي العربي الأكثر مقروئية بين النخبة الحداثية العربية، فأي حداثة هذه يا ترى…؟؟!!.
4
- 4 – الخطاب اللاعقلاني (السحراني)
4-1-يحق لنا أن نتساءل عن الحداثة، كما يقدمها أدونيس، وأي حداثة هذه..؟ ذاك لأن المشروع الأدونيسي محصور في الشعر وفي الشعرية، وبسبب هذا الحصر لم يستطع أدونيس أن ينفك من سلطة النسق الفحولي عليه. ولم يفعل ما فعله السياب ونازك الملائكة ومن جاء بعدهما من شعراء، ومن كتاب في السرديات بأنواعها، ممن تواجهوا مع النسق واخترقوا كتلته.
بل إن أدونيس فعل الضد لما يمكن أن يكون ثورة حداثية تغييرية، وراح أدونيس بضاغط نسقي واضح يعيد صياغة المعنى النسقي العميق للثقافة العربية ذات الجذر الشعري والمتشعرن في نظام القيم ونظام السلوك الفردي. وانطلق من البعد ذاته ليمسخ المشروع الحداثي ويحوله إلى مسخ نسقي يرسخ الفردية والطبقية والمطلقية والتعالي ونفي الآخر، وتسخير المجاز لخدمة هذه التصورات.
ونجد عند أدونيس عداء خاصا، وهو عداء نسقي، لكل ما هو منطقي وعقلاني، فالحداثة عنده لا منطقية ولا عقلانية، وهي حداثة في الشكل، وهو يصر على شكلانية الحداثية ولفظيتها، مع عزوف واحتقار للمعنى، وتمجيد للفظ. ونحن نعرف أن النسق الثقافي يضع اللفظ كمرادف للفحل/الذكر، والمعنى يرادف المؤنث، وهذا ما يفسر تعلق أدونيس باللفظ وحربه للمعنى، بما إنه حفيد الفحولة، وزعيم التفحيل.
والنص الحداثي نص سديمي، حسب وصف أدونيس له، وهو عبثي، ومناف للمنطقي، يقوم على انفصام بين أدوات التعبير وما يراد التعبير عنه، وهو ذاتي ولغته انفعالية غير عقلية ولا علمية.
وبما إن الشعر هو هذا الموصوف بهذه الصفات فإن الشعراء سيصبحون هم السحرة الجدد، وهذا هو وصف أدونيس لهم كشعراء للحداثة. وهذا توصيف يعيد النموذج الجاهلي، أو النموذج/الأصل، كما يقول أدونيس، حيث السحري والعرافي بوصف النص ضربا من الكهانة والخوارقية الشخصانية.
وهذه سمات تحقق نوعا من الشعر الخالص والمتميز في خلقه الإبداعي، ولا شك، غير أنها لا تصلح أساسا لوعي حداثي جديد ينقض النسق أو يجدده. أولا لتقليدية هذه الصورة وقدامتها المفرطة، ولم ينكر أدونيس هذه القدامة ولم يخف الرغبة في العودة إلى الأصل الجاهلي. وهو بذا يسجل في ثقافتنا العودة الثانية إلى النموذج الجاهلي، بعد عودة الأمويين ومتابعة جيل المدونين العباسيين لمشروع احتذاء النموذج الجاهلي، مما يعني أننا ما زلنا في شواهد العودة والالتزام بشروط النسق والتسليم بها.
وهذه ليست حداثة إلا على مستوى الشكل فحسب. ثم إن مجافاة المنطقي والعقلاني هي شرط شعري خالص وعتيق، وقد ينتج عنها شعر خلاب، لكنها لا تصنع وعيا حداثيا أو تحررا نسقيا، لأن النسق لا يشتغل إلا في مثل هذه الخطابات، وهي وسائله السحرية لفرض شرطه من غير رقابة أو نقد، كما حدث لنا على مدى قرون، وجاء أدونيس ليرسخ هذا الاستسلام المعرفي عبر تدجين الذوق وترويضه بإطعامه زادا بائتا من الطبخة النسقية إياها.
4-2- لا يملك علي أحمد سعيد، وقد دشن نفسه ليكون (أدونيس) الجديد إلا أن يتمثل شروط الفحل الأول، الفحل/الأب، ويتحلى بالسمات ذاتها ليصطنع منها خطابه الذي سنرى أنه خطاب سحراني، لا عقلاني، ولا منطقي، يترسم ويتوسم النماذج والرموز التي تحكي صفة البعل الأول. ومن هذه الرموز يأتي نموذج القرمطي، الذي يقدمه أدونيس كالتالي:
“قال القرمطي
أنا النور لا شكل لي
وقال: أنا الأشكال كلها – مفرد بصيغة الجمع، ص78″.
وقال: أنا الحجة والداعية، (ص79)، ومثله يأتي البهلول لينشئ مع الشاعر سلطة الرغبات (ص85)، ويعلن: أنا الصارية ولا شيء يعلوني. وهذا هو التمهيد الطقوسي لميلاد الطفل، الذي سيعلن أنه السيد الجديد: أدونيس. وسيجري تدشين الوعد المنتظر، من أجل لغة التفحيل:
“استغونا أيها السيد استدرجنا
قل لنا من كذب ومخرق
من البلية
من خدع الجسد بنواميسه – ص79″.
هذه صورة ينتجها النسق متوسلا برموز منتقاة حسب صفاتها المتوائمة مع مشروع الترميز النسقي. وهي تتضمن تغييب البعد المنطقي ومن ثم إخضاع الخطاب إخضاعا تاما للبعد السحراني:
“تريد أن تعرف..؟
إذن، اجهل ما أنت
واجهل غيرك – ص107″.
وهذا شرط أولي، فلكي يجري تدشين الشخصية المتشعرنة بصفات النموذج النسقي لا بد من إفراغها من شرطها الفطري والطبيعي، ولا بد لها أن تجهل ما هي وتجهل غيرها، لتكون مادة بكرا تقبل التشكل المقترح، وحينها سيتسنى تحويل علي أحمد سعيد ليكون أدونيس. وسيتسنى أن تكون (أنا = أنا) – ص12″.
والأنا هنا هي الذات التي سردنا سماتها في المبحث السابق. مما يحيلها لتكون هي الأصل وهي النقيض، أي النقيض لنفسها وضد نفسها في عبثية صوفية هائمة، لا شيء فيها غير جماليتها الشعرية الخلابة، مع شيء غير قابل من التقليدية المغرقة في تقليديتها بوصفها صورة نسقية مكررة. فهي: أنا الموت، وأنا التموج، وأنا سماء وأتكلم بلغة الأرض… (ص65)، وما إلى ذلك من معجم الصفات الفحولية التي يرثها أدونيس عن أجداده، من جرير والفرزدق وأبي تمام والمتنبي، كما رأينا في الفصل الرابع.
وتنتهي الحكمة في هذا الخطاب السحراني كالتالي:
“تخرج فراشة تدخل فراشة والمسرح بهيئة الطبيعة
أتحول إلى طبيعة ثانية
وتنزلق بين فخذي النباتات
كل حجر حارس يسهر معي
وأدخل في أبعاد ترشح من شقوقها البخارات
حيث تطبخ الحجارة
تكون منها الأمواج المختومة
وفلك الرياح والمصابيح
وتكون السيمياء والحكمة
****
“الحياة أن تتماوت
أن تكون منذ البدء، الميت-الحي
الحي-الميت-“.
وبعد هذا كله يتحول أدونيس إلى شاعر غنائي مغرق في غنائيته، كما نجد في ديوانه (مفرد بصيغة الجمع)، الذي يحمل البيان الختامي لخطاب التفحيل، وتتصدره عبارة (صياغة نهائية) وفيه تتجلى أدق سمات الأب الفحولي الجديد، وهو أب تحركه الرغبة والسلطة والشبق، ويتغنى بتفرده وتعاليه، ويصطنع لذاته قيمة أسطورية سحرانية خالصة الوجدانية.
وهذه هي أقصى (وأجمل…؟) حالات الشعرية الخالصة، التي يدركها أدونيس ويتغنى بها:
“منذ أسلمت نفسي لنفسي وساءلت:
ما الفرق بيني وبين الخراب..؟
عشت أقصى وأجمل ما عاشه شاعر:
لا جواب”
هذه هي الحالة الشعرية السحرانية الأقصى والأجمل حيث اللاجواب، وهي حالة شعرية خالصة، ولكنها ليست حالة وعي حداثي، مما يترجم المشروع الأدونيسي إلى مجرد تغيير شكلي ظاهري، لا يمس الجوهر ولا يغير في مسارات النسق المهيمن بل يستجيب له ويسلم به.
إن لعبة الترميز تكشف عن مضمرها النسقي، ونحن نتذكر كيف جرى توظيف شخصية البهلول في الروض العاطر توظيفا لا عقلانيا يجرد الجسد من كل مقوماته المعنوية ويقلصه إلى كائن شهواني شبقي خالص الشبقية، ويتحول الرجل إلى عضو الذكورة، وتتحول الأنثى إلى جسد شهواني، حسب طلب النسق الذكوري الذي تصدر عنه ثقافة الكتاب وقراء الكتاب، بينما شخصية البهلول تتحول عند أدونيس لتمثل الفحل بخطابه السحراني، حسب مواصفات النسق المتشعرن. وكلا الفعلين، فعل الروض العاطر وفعل أدونيس يصدران عن الشرط النسقي ومتطلباته.
5
- 5 – رجعية الحداثة:
5-1-هناك فكرتان مركزيتان تترددان لدى أدونيس بشكل متواتر، ويعاود ترديدهما عقدا بعد عقد، تشير إحداهما إلى أن الحداثة تغيير في الشكل، وأن شكل القصيدة هو القصيدة. وتشير الأخرى إلى أن لا حداثة في الثقافة العربية إلا في الشعر، أما المجالات الأخرى الاجتماعية والفكرية والسياسية فلم تلامسها الحداثة، ولم تتحدث.
ونحن لو تأملنا هاتين المقولتين المركزيتين لدى أدونيس وربطنا بينهما وبين ما قلناه في المباحث السابقة عن الخطاب السحراني الذي يتأسس عليه المشروع الأدونيسي، فإننا لن نعجز عن كشف علاقات السبب والنتيجة في هذا الذي يتحدث عنه أدونيس، ذلك لأن الشعر، مذ كان هو الأساس الذي انبنت عليه حداثة أدونيس، ما كان ليكون إلا عودة أخرى للأساس الشعري في تكوين الشخصية العربية.
ونحن نعرف، من عرضنا السابق في الفصلين الثالث والرابع، ما تسببت به عمليات شعرنة الذات العربية، وشعرنة القيم، من تركيز على الذاتية، والمطلقية والتعالي، والأنا المتضخمة، وتحويل القيم من بعدها الإنساني إلى بعد مصلحي ذاتي، تتحكم فيه عناصر السلطة والقوى، واستذلال الفرد لنفسه في سبيل تحقيق غاياته التي صارت غايات فردية. ولم يعد للغايات العامة، وطنية كانت أو إنسانية، من وجود في الخطاب المتشعرن.
هذه هي الصورة العامة للنسق الشعري الفحولي برموزه الكبرى كأبي تمام والمتنبي وغيرهما ممن لهم الحظوة القرائية والاستقبال التاريخي المتصل. وكانت ثورة القصيدة الحرة وتمثلها على يدي امرأة يافعة، كانت مناسبة ثقافية فريدة لاختراق الهيمنة النسقية وفحوليتها الصارمة، وتهشيم عمودها.
وقد تحقق في ذلك بعض الإنجازات المهمة، كما وضحنا في كتاب تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، غير أن الثقافة تملك حيلها الخاصة في الدفاع عن أنساقها، خاصة المترسخ منها، ولم تعدم الثقافة رجالا يطلعون علينا من رحم الخطاب وفي العام ذاته، حيث تزامن ظهور نزار قباني مع ظهور حركة القصيدة الحرة، عام 1947، وفي ذلك أجابت الثقافة على مشروع تأنيث الشعر بجوابين، أحدهما من نزار كمشروع للاستفحال،
ومن بعده أدونيس كمشروع للتفحيل، ولكل واحد منهما جمهوره العريض المتحرك بدوافع النسق، وهي دوافع فحولية متأصلة بين الجمهور العريض المتجاوب مع نزار، والنخبة الحداثية المتفاعلة مع أدونيس. ولأدونيس خطورته النسقية بما إنه يعتمد على التنظير مثل اعتماده على الإبداع، وهما عنده في حال تجانس تام وتطابق خالص مما يدل على مدى تغلغل النسق في ضمير أدونيس، ومدى إخلاصه لرسالته في تفحيل الثقافة.
والواقع أننا هنا ننسب لأدونيس دورا مماثلا للدور الذي لعبته الحقبة الأموية في إعادة الحياة للنموذج الجاهلي، وأدونيس يعيد الفعلة نفسها حيث يستلهم النموذج الجاهلي، الذي يسميه بالنموذج الأصل، ويركز على أصوليته. ومن ثم فهو يتمثل قيم هذا النموذج الأصل في سماته النسقية الفحولية، كما مثلنا هنا.
5-2- يدرك أدونيس هامشية الحداثة، وعجزها عن تحقيق إنجاز نوعي في الأنساق الذهنية العربية، ويقول إننا ندرك مشكلة الحداثة في الواقع العربي “حين نتذكر فشلنا أو تقصيرنا في إحداث الجوانب الأخرى من الثورة: في العلوم الرياضية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية الأخرى، وبخاصة الاقتصادية. فعلى الرغم من المغامرة المدهشة التي قام بها بعض أسلافنا، كل في مجاله، لم نقدر أن ندخل الفلسفة، مثلا، بالمعنى الدقيق، في بيئتنا الثقافية.
وما ينطبق على الفلسفة ينطبق على العلم أيضا. وفي هذا الفشل ما قد يفسر بقاء ما نجحنا فيه على هامش الحياة العربية: التجربة الصوفية، والتجربة الشعرية. وما يبدو من الشعر أنه في متن الحياة العربية، كما يتوهم بعضهم، ليس إلا صيغة من النثر الموزون، إنه تفريع وتنويع بالمعنى الاجتماعي، على الأدب الموروث بالمعنى التقليدي”.
يقول أدونيس هذا الكلام/الاعتراف، وهو كلام أو اعتراف شجاع وصادق، ولا شك، غير أنه كلام متلبس بالداء ذاته، مما يجعله لا يرى العلة، ويقف عند حدود الأعراض وعلامات الداء، وذلك لأنه ما زال يقرأ الحدث بعيون الشاعر المنبهر بسلطانية الشعر، ولم يقرأ الحادثة بعيون الناقد، وبالأخص عيون النقد الثقافي، وكلنا مثله حيث ظلت الشحنة الشعرية تحتل بصيرتنا مثل احتلالها لذائقتنا، ومن ثم ظللنا نعتقد أن العلاج هو في الشعر ومزيد من الشعر –أي نداوي أنفسنا بالتي كانت هي الداء.
حسب القانون الشعري القديم، كما سنه أبو نواس- دون أن ندرك أن هذا هو ما ظل يحبس وجودنا في خيمة الشعرنة للذات وللذهن. ولا عجب هنا أن تكون الحداثة على هامش الوجود العربي، وتظل خارج الفعل والتفاعل والتغيير الجذري. حتى إن هزيمة الأمة في حزيران 1967 لم تغير الشعر، كما يقرر أدونيس. والأمر في رأينا ليس في أن الشعر لم يتغير مع هذه الحادثة الفادحة.
فحسب، بل إن الشعر هو ما حجب فرص التغيير، لا سيما الشعر حسب التصور الأدونيسي الذي يستعيد النسق ويستلهم شرطه ويتمثل نموذجه، في حال عمى ثقافي مطبق، اشتركنا كلنا فيه، أعني أولئك الذين قبلوا بهذا النمط التحديثي، ودافعوا عنه وسوقوه نظريا وكتابيا.
ومن هنا كانت الحركات التحررية العربية غير ثورية إلا في ظاهر دعواها، وكان تحويل قيم الثورة والحرية والوطنية لتكون في خدمة الزعيم/الأب، الذي هو الفحل الاجتماعي المتمثل لنموذج الفحل الشعري، في القديم وفي الحديث. وهو النموذج الذي لم تنتقده الحداثة ولم تخرج عليه، بل تمثله ومثلته أشد تمثيل.
لذا كيف نتوقع حداثة اجتماعية وفكرية إذا ما كان النموذج المحتذى هو نموذجا شعريا/فحوليا/رجعيا. يقوم على إحلال فحل محل فحل، كما هو لب الدعوى الأدونيسية، ويضع الشاعر في الأصل محل الشعر، كما يقرر أدونيس، وكأنما يضع الزعيم المحل محل الوطن، ويضع الذات محل الموضوع، ويقول صراحة: أنا الشاعر، إذن: أنا الثورة، ويضع الحق من الشعر، ويضع الشكل محل السؤال.
وهذا كله مؤشر على المنظومة النسقية التي جعلت الثورة هي الفرد واختصرت التاريخ والمكان في اسم طقوسي، لا يختلف فيه الشاعر، بصفاته النسقية عن الطاغية السياسي والاجتماعي، في الفردية المطلقة والقطعية، والاثنان زعيم أوحد، وهذا يستنسخ نموذج ذاك.
5-3- يبلغ إيمان أدونيس بالشعر كقيمة مطلقة حدا مخيفا فعلا، إذا ما تمعنا فيه، بعيدا عن الانفعال الشعري، كما هي عادتنا الموروثة عن الذات المتشعرنة، وأخذنا في مبدأ النظر النقدي الثقافي. وكم كنا نتغنى بكوننا الأمة الشاعرة، وهي الصفة التي راح أدونيس يتباهى بها في خطبة له عصماء شعرية ألقاها في أمريكا، حيث جعل الشعر هو الجوهر وهو الكون.
ومن ثم صرنا في زعمه أكثر تقدما من أمريكا، وصرنا في صفوف الأمم المتقدمة لأننا شعراء وأسياد كلام، حسب ما تقول كلماته، ولا ينسى هناك أن يضع نفسه في الذي يسميه (هذا الموت العظيم الذي يلازمنا خلية خلية)، وهو الشعر والسحر، وهذا عنده هو المجد الأعظم، وهو الحضور الساحق الغامر، الذي لا يغلب ولا يرد.
يقول هذا بعد سنوات من حزيران 67، وكأن الشعر ليس فقط لم يتغير بل إنه ما زال يملأ عقل الشاعر مثلما يملأ عقل السياسي بالوهم الجميل (…؟!)، أو لنقل بالموت العظيم، كما سماه عراف الحداثة ذات الخطاب السحراني، خلاب العقول..!.
هذه الروح المتشعرنة التي لا تسمح للذات بأن تنمو من فوق ظرفها، ولا تسمح لها بأن ترى بعين ناقدة لذاتها، هي نفسها لدى صاحبها، وكما رأينا أن نزار قباني ظل على مدى خمسين سنة هو هو لم يتغير، وظل يكرر أخطاءه التي ظل يسميها بذنوبه الجميلة، فإن أدونيس، أيضا، ظل هو هو يقول ويدور حول نموذجه النسقي، مع تغييرات لا تتجاوز الشكل واللفظ، وانظره في مطلع حياته يقول.
صدري مع الشمس، فأي الذرى مر بها صدري ولم تكبر؟
ما لي أنا؟ والفجر محفورة عيناه في حقلي وفي بيدري
وتخطر الشمس ولولا غدي لم تطلع الشمس ولم تخطر
هذه أبيات لو بحثنا لها عن قائل آخر غير أدونيس لو جدنا آلاف الشعراء ممن يمكن أن ننسبها إليهم، حتى ليمكننا أيضا أن ننسبها لأي واحد حتى ولو لم يكن من الشعراء الرسميين، مما يعني أنها نص يخرج من أعماق المضمر النسقي. وهي لا تعدو أن تكون شعارا مكررا نرى أمثاله في كلام الزعيم الأوحد الذي يؤمن بأنه عماد الكون وأنه ضروري لاستمرار الحياة في دورتها، وأن لا سواه، ولا آخر بإزائه.
هذا هو النموذج الفحولي شعريا واجتماعيا، يتساوى في ذلك الخطاب الحداثي مع الخطاب التقليدي. وكما أن أدونيس ابتدأ حياته نسقيا، فإنه ظل يكرر نسقيته طول حياته، بصيغة أو أخرى إلى أن وصل إلى صيغته النهائية في (مفرد بصيغة الجمع) حيث نطق الفحل بحكمته النسقية وأعلن تفحيل الحداثية، ومن ثم تهميشها وعزلها عن مجال الفعل.
وهذه الأبيات لأدونيس لا تنتسب للذات القائلة بقدر ما تتكلم بلسان النسق، حالها كحال أبيات لليلى الأخيلية، إذا قرأناها سنرى أنها لا يمكن أن تصدر عن امرأة، أو تتحدث عن أنثى بقدر ما تتحدث عن حس فحولي صارخ، ومنها قولها:
نحن الأخايل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مشهورا
تبكي الرماح إذا فقدن أكفنا جزعا وتعلمنا الرفاق بحورا
ولنحن أوثق في صدور نسائكم منكم إذا بكر الصراخ بكورا
وهذا شعر من الممكن نسبته إلى أي شاعر فحل، في حين يصعب تصور صدوره عن امرأة، مما يعني أن الشعر تعبير عن الشرط النسقي أكثر مما هو تعبير عن الذات الشاعرة، تماما كما هي الحال في الأبيات السالفة عن أدونيس، وسائر الصيغ النسقية التي أشرنا إليها في هذا البحث.
5-4- ومن استخلاص النموذج الشعري الذي تفضي إليه مقولات أدونيس نستطيع أن نحدد السمات التالية لهذا النموذج الأدونيسي:
أ مضاد للمنطقي والعقلاني.
ب مضاد للمعنى، وهو تغيير في الشكل ويعتمد اللفظ
ج نخبوي وغير شعبي
د منفصل عن الواقع ومتعال عليه
ه لا تاريخي
و فردي ومتعال، ومناوئ للآخر
ز هو خلاصة كونية متعالية وذاتية
ح يعتمد على إحلال فحل محل فحل، سلطة محل سلطة
ي سحري، والأنا فيه هي المركز.
هذه سمات شعرية استخلصناها من مقولات أدونيس في توصيفه لنموذجه الحداثي، وهي سمات شعرية خالصة الشعرية، وقد تصنع شعرا جميلا وخلابا، لكنها لا تضيف شيئا جديدا جدة جوهرية إلى الثقافة العربية، ذلك لأن الشعر مذ معرفة الإنسان به يقوم على هذه الأسس، وهي أسس خالصة الشعرية.
ولقد تشبعت الذات العربية بها منذ الأزل، وهي في عرفنا ما أسهم في شعرنة الشخصية العربية، وصبغها بالصبغة الشعرية، حتى لصار النموذج الشعري هو الصيغة الجوهرية في المسلك والرؤية، مما سمح للنسق الفحولي التسلطي والفردي بأن يظل هو النهج والخطة.
وبما إن أطروحة أدونيس تدور حول هذا النموذج النسقي وتصدر عنه فإنها لا يمكن أن تكون أساسا للتحديث الفكري والاجتماعي. وملاحظة أدونيس على غياب الحداثة في البعد الاجتماعي والفكري صحيحة بالضرورة، والسبب فيه وفي نموذجه الذي هو نموذج مغرق في رجعيته، وإن بدا حداثيا، وادعى ذلك.
إنها حداثة في الشكل وحداثة فردية متشعرنة، فيها كل سمات النموذج الشعري، بجماليته من جهة، وبنسقيته من جهة ثانية. إنها تعيدنا مرة أخرى إلى كائنات بلاغية، تعيش الموت العظيم الذي يلازمنا خلية خلية، كما يقول أدونيس بصدق غير شعري، هذه هي الحداثة: الموت العظيم، الموت في البلاغة والجماليات، واعتماد الذات مركزا، والحق مع السيد الأب، والشاعر فوق الشعر، وأنا الحجة والداعية.
وما كان مشروع أدونيس إلا مشروعا في تغيير المجاز، فحسب، ولم يغير في (الحقيقة)، وقد ظلت الحقيقة الشعرية عنده كما هي نسقيا لم تتغير، ولقد أشار أدونيس إلى أن أبا تمام لم يخرج على الأصول الشعرية القديمة، وأن ثورته كانت ثورة في أشكال التعبير فحسب، وكذلك أشار إلى تجربته هو ويوسف الخال بأنها عودة إلى الأصول الجاهلية تحديدا، وأنها أصل يتوازى مع تلك الأصول.
وهذه خلاصة تضاف إلى مستخلصاتنا عن المشروع الأدونيسي بخطابه السحراني، خلاب العقول. الذي لن تخفى علينا أسباب بقائه على هامش الحياة العربية، وعدم تأثيره في تحديث الفكر والمجتمع، كما قال أدونيس، مذ كان خطابا مضادا للمنطقي ومغرقا في فرديته وتعاليه، ومتشبثا بمجازه السحري.
هذا هو الخطاب السحراني المتضاد مع العقلاني والرافض للمنطقي..! هذا هو خطاب الحداثة. فأي حداثة هذه…؟؟!














