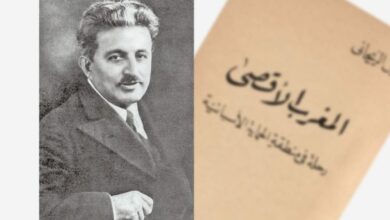نقد
هل ينبغي أن أقرأ لطه حسين؟

دعك من لقب (عميد الأدب العربيّ)، ومذهبه إلى من هو حقيقٌ من أدباء العصر الحديث بأن يتقلَّدَه بجدارةٍ واستحقاقٍ؛ فالرّافعيّ عميدٌ، والعقّاد عميدٌ، وأحمد أمين عميدٌ، والزَّيّات عميدٌ، والبشير الإبراهيميّ عميدٌ، وعليٌّ الطّنطاويّ عميدٌ، وسيّد قطب عميدٌ، ومحمود محمّد شاكر شيخٌ من شيوخ العربيّة، وحامل من حملة لوائها ورايتها، وعميدٌ من عمدائها مثل هؤلاء جميعًا، وإن تميَّزَ بعضهم عن بعضٍ، وزاد بعضهم على بعض في فضل الجهاد وموقف النِّفاح.
وكلّ من أحسنَ إحسانَهم إلى العربيّة، وسلك مسلَكهم في الدّفاع عنها، وأثرى إثراءهم لمكتبتها فهو عميدٌ من عمداء الأدب العربيّ؛ وإن لم يُقلَّد اللّقب، ولم يُدع به في المحافل والمجامع، فهذا اللّقب (عميد الأدب العربيّ)، وما سواه من الألقاب ليس مقصورًا على أحدٍ، وإنّما يستحقّه من اتّسم بشروطه، واتّصف بصفاته؛ فالتّدافع والتَّزاحُم عليه، والانشغال به عن حقائق الأشياء صنفٌ من الغفلة والنّسيان، وجنسٌ من التعلّق بالصّورة دون الجوهر، والتّشبُّث بالسّطح دون الحقيقة، بل إنَّ العلماء عبر العصور لم يدَّعوا لأنفسهم الألقاب التي أُطلقت عليهم.
أما بعدُ؛ فإنَّ طه حسين عميدٌ من أولئك العمداء المعدودين، فقد ألّف في الأدب، ونقد شعره ونثره، وألّف معتزًّا ببعض رموز الإسلام، وهو من النُّقّاد الذين يُرجع إلى آرائهم، ويُحتكم إلى أفكارهم، فيؤخذ منها ما يُؤخذ، ويُردُّ منها ما يردُّ بالحجَّة والدّليل، وقد أحسن في مواطن، والتوى به قصد السّبيل في مواضع جعلت أناسًا يسيئون به الظّنون، ويتدسَّسون في نيّاته وبواعثه، ويوغلون في ذلك إيغالًا، فينسبون إليه كلّ مثلبة، ويجرّدونه من كلّ منقبةٍ، مع أنَّه الأديب النّاقد المثري للمكتبة العربيّة بكتاباته الإبداعيّة والنّقديّة، المخرّج في الجامعة المصريّة لأجيالٍ من الأدباء والنُّقاد كان لهم القدح المعلَّى في الدّفاع عن العربيَّة، والتّحقيق لتراثها، والتّأليف في أدبها ونقدها.
فهل خطأ طه حسين في حكمه على الشّعر الجاهليّ، وما تفرّع عن الحكم دليلٌ على أنّه لم يكنْ إلّا حذاءً ملوَّثًا من أحذية الحرب الشَّعواء على اللّسان العربيّ؟ وهل نظراته التي قدَّمتها في كتاب (مستقبل الثّقافة في مصر) كافيةٌ لننفض أيدينا من شخصه، ومن كلّ كتبه، ومن جميع مقالاته، ومن آرائه كافّة، ثمَّ نقرأ عليه سلامَ مبغضٍ موغلٍ في البغضاء والمقت لا يميّز الخبيث من الطّيّب؟ وهل كلُّ كتب طه حسين سَمومٌ، وسُمومٌ، وظلٌّ من يَحْمُوم؟ فننهى الصّغير والكبير عن الاقتراب من تراثه كي لا يكتوي بناره، ونمنع كلَّ طالبٍ راغبٍ في المعرفة من الاستفادة من مواطن الإجادة والإحسان، التي أحسن فيها طه حسين إلى إلى الإسلام، والأدب، والعربيَّة عمومًا؟ وهل تراجع طه حسين عمّا أساء فيه من الأفكار؟ كيف نعرف ذلك وأين؟!
إنَّ الرّدَّ الكافي على هذه الأسئلة المتتابعة يستدعي إسهابًا لا يحتمله هذا الموضع الموسوم بالاختصار والإيجاز، ولكنَّ ذلك لا يمنعنا من إشاراتٍ تضيء الطّريق، وتسدُّ منافذ الشّكّ والرّيب؛ وما دام العلّامة محمود شاكر عرف طه حسين، وأعجب بحديث الأربعاء الذي كان ينشره، ودرس على يديه حينًا من الدّهر، وحصل بينهما ما حصل، مع ثقتنا فيه، وعلمنا ببعده عن التّدليس والمداجاة، فلنتَّجه إليه ليردَّ على بعض أسئلتنا، ثمَّ نردُّ على سائرها كيفما تيسَّر إن شاء الله.
يقول الأستاذ محمود شاكر في معرض ردِّه على أخطاء طه حسين في الشّعر الجاهليّ، وما عُزِيَ إليه من تُهَمٍ بلقاءَ جارفة، يقول: “لقد لقيَ طه حسين يومئذٍ ما لقيَ، ونُسب إليه ما أقطع بأنَّه بريءٌ منه (تأمَّل هذه العبارة؛ فهي عزيزةٌ جدًّا)، والدَّليل على براءته عندي؛ أنّه مذ عرفتُه في سنة 1924م، إلى أن توفّي في 28 أكتوبر 1973م، كان – كما وصفتُه في أوّل حديثي – محبًّا للسانه العربيّ أشدَّ الحبّ، حريصًا على سلامته أشدَّ الحرص، متذوّقًا لروائعه أحسن التّذوُّق، فهو قطُّ لم يكن يريد باللّسان العربيّ شرًّا، بل كان من أكبر المدافعين عنه، المنافحين عن تراثه كلّه إلى آخر حياته. ومحالٌ أن يُحشر من هذه خصالُه في زمرة الخبثاء ذوي الأحقاد من ضعاف العقول والنّفوس، الذين ظهروا في الحياة العربيّة لذلك العهد، بظهور سطوة الاستعمار، وسطوة التّبشير، وهما صنوان لا يفترقان”. (الجمهرة، ج2، ص 1044).
ويقول عن طه حسين أيضًا: “عرفتُه محبًّا لعربيّته حبًّا شديدًا، حريصًا على سلامتها، متذوّقًا لشعرها ونثرها أحسن التّذوُّق، وعلمت هذا الحرص، وهذا الحبّ كان ثمرة من ثمار قراءته على المرصفيّ”. (الجمهرة، ج2، ص 1048). فطه حسين، حسب محمود شاكر المعروف بحرصه على العربيّة، لم يكن خبيثًا حاقدًا، ضعيفًا في عقله ونفسه، ولم يكن يريدُ شرًّا باللّسان العربيّ فيما أخطأ فيه من أحكام، ولم يكن بوقًا للاستعمار والتّبشير كما هو شائعٌ عنه عند بعض النّاس، كما أنَّه لم يكن رجلًا جاهلًا، وهذا كلام رجلٍ عالمٍ ثقةٍ عرف طه حسين، وعايشه، ودرس عليه، وقارعه وردَّ عليه؛ ففيه حجَّة بالغةٌ فيما نرى.
وهذا الكلام وحدهُ كافٍ لتبرئه ساحة طه حسين من الظُّنون الفاسدة التي ترمي عن قوس عقيدته، وتقوّله ما لم يقلْه، وهذا عجيبٌ كلَّ العجب، وأنَا تأمَّلتُ كثيرًا، ونقّبتُ مرَّةً بعد مرَّة، فألفيتُ أكثر الرَّازين على طه حسين لم يطالعوا من مؤلَّفاته إلّا (الأيَّام)، ثمّ كلماتٍ يسمعونها عن آرائه في الشّعر الجاهليّ من خلال كتاب (تحت راية القرآن) لمصطفى صادق الرّافعيّ، وكان أولى بنا أن نعلم أنَّ لطه حسين واحدًا وثلاثين كتابًا غير كتابي (في الشّعر الجاهليّ) و(مستقبل الثّقافة في مصر)، أحسن فيها إلى العربيّة، ودافع عن الإسلام، وردَّ على الدّعاة إلى استبدال الفصحى بالعامّيّة في الأدب العربيّ، بل إنَّ لطه حسين كتابًا مختصرًا بعنوان: (الحياة الأدبيّة في جزيرة العرب) يدافع فيه عن دعوة الشّيخ محمّد بن عبد الوهَّاب في جزيرة العرب!
هذا؛ ويجب على من يريدُ معرفة طه حسين معرفةً بعيدة عن مرارة الخصومة، وجور الدّفاع، أن يقرأ كتابًا عُرف صاحبُه بالمعدلة والإنصاف، ووقف سدًّا منيعًا أمام دعوات التّغريب، وهو الأستاذ محمّد عمارة رحمه الله؛ فقد ألّف كتابًا نفيسًا بعنوان: (طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام)، وكانت رسالة الكتاب هي الإنصاف من أنصار طه حسين وخصومه جميعًا، وقد رصد الكتاب المراحل الفكريّة المختلفة التي مرَّ بها طه حسين في حياته، وخلاصة قول الأستاذ محمّد عمارة أنَّ طه حسين من الأدباء الكبار، أحسن في كثيرٍ، وأخطأ في مواضع، وتراجع، واستغفر، وأحسن في مغرب حياته!
وقد اجتهد الأستاذ محمّد عمارة في تقسيم الحياة الفكريّة لطه حسين إلى أربع مراحلَ ضخمةٍ: أولاها (1908-1914م) هي المرحلة التي سبقت رحلة طه حسين إلى فرنسا، وكان في هذه المرحلة رافضًا للعلمانيّة، وداعيًا إلى ضرورة نشر الإسلام وإصلاح المرأة وفق ثوابت الدّين، وثانيتها (1919م -1930م) هي المرحلة التي انبهر فيها بالغرب بعد عودته من فرنسا، فألّف كتابه في الشّعر الجاهليّ، وفي مستقبل الثّقافة في مصر، فردَّ عليه الأدباء من كلّ فجٍّ، ومن أبرزهم مصطفى صادق الرّافعيّ، والشّيخ محمّد خضر حسين، وثالثة المراحل (1932-1952م) تمثّل تراجع طه حسين عن أكثر أفكاره التي أذاعها في المرحلة الثّانية، حتّى رُميَ بالتّناقض والتّضادّ، فكتب في الإسلاميَّات، ووقف أمام التّنصير والمنصّرين في صحيفة كوكب الشّرق.
والمرحلة الأخيرة (1952-1960م) تحتضن عودة طه حسين وإيابه الجليّ الحازم إلى أحضان العروبة والإسلام، فحجَّ، وزار قبر المصطفى صلّى الله عليه وسلّم، وابتهل، ودعا، وبكى، بل دافع في تلك المرحلة عن الإسلام أمام الفرعونيّة، وكان يمثّل بابن تيميه وأمثاله في كتاباته، ومن أراد من ذلك شيئًا فليقرأ كتابيْه: (مرآة الإسلام) و(الشّيخان). ويدلُّ هذا التّفصيل الواضح على تراجع طه حسين، كما أراه دليلًا دامغًا لمن يقول: هل أعلن تراجعه عن أفكاره الهدَّامة؟ ولأيّ باحثٍ أن يقرأ كتاب محمّد الدّسوقيّ الذي لازم طه حسين في آخر حياته، فألّف كتابًا مؤرَّخا بالمكان والزّمان والسّياق، بعنوان: (أيَّام مع طه حسين)، سيجد فيه أنحاءً طاهرةً من حياة الرَّجل لم يكن يعلمُها، فيها الدّفاع عن الإسلام، وعن العربيّة، وعن الشّعر العربيّ، وفيها سخريَّة واستهزاء بدعاة التّغريب.
أتخلّص ممّا سبق قائلًا: نعم؛ اقرأ لطه حسين، واستفد من أسلوبه الرّشيق، ومن نقده الدّقيق، وضع هذه المراحل الأربعة نصب عينيْك، وإذا كنت طالبًا مبتدئًا فلا تقرأ كتاب (في الشّعر الجاهليّ) الذي نقّحه ثمّ سمّاه: (في الأدب الجاهليّ)، ولا تقرأ كتاب (مستقبل الثّقافة في مصر) حتّى يقوى عودك، وتعرف موقع قدمك، واعلم أنَّ الرّجل كان عبقريًّا أعمى البصر، ولم يكن كافرًا أعمى البصيرة كما يقولون.