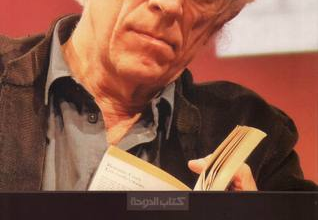الدين وانتحال الشعر: أثر مسألة الجن في الفكر الديني والأدب عند العرب والغرب

بدأ صاحبهم فصل «الدين وانتحال الشعر» بقوله: «فكان هذا الانتحال في بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صحة النبوة وصدق النبي» ص٦٩.
وقال في ص٧٠: «وفي القرآن سورة تسمى «سورة الجن» أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن، فلانت قلوبهم، وآمنوا بالله ورسوله … فلم يكد القصاص والرواة يقرءون هذه السورة وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب، واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع».
ونحن لا نتعرض — ولا نريد أن نتعرض — لما في هاتين النبذتين من المغامز الماسة بشخص النبي وصحة نبوته، فإن كانت تلك النبوة حقّا، فلا تحتاج في تأييدها إلى الباطل الذي يدعيه المؤلف، وهي في اعتقادنا حق، ولا نعلم شيئا عن اعتقاد الآخرين.
ولشدَّ ما وددنا أن يحترم هؤلاء الآخرون عقيدة معاصريهم ومشاركيهم في الجنس واللغة والوطن، فإن كل بحث علمي أو اجتماعي أو تاريخي يمزج بالدين يحدث له التواء وفساد، ويذهب نفعه، ويُرمى صاحبه بالتقليد الأعمى والغرض الذي يعمي ويصم.
ولعمرك لا ندري ما هذه الحكة التي عند مؤلف الشعر الجاهلي، بل ما تلك القرحة التي تنز في صدره ضد عقيدة الآخرين، فمتى يبرأ منها؟ فإن كانت عيشة باريس لم تشف بعضنا من داء التعصب، فأي دواء يشفي من هذا الداء؟ وماذا يطفئ ما ببعضهم من ظمأ الانتقام من هؤلاء المسلمين الذين لا ذنب لهم إلا عقيدتهم؟ وإلى متى يبقى هذا البعض جامحا خروطا يركب رأسه بدون معرفة؟ وهل تسفيه أحلام العلماء الأعلام والنيل من كرامة السلف الصالح كفارة مفروضة عليه يساق إليها كرها؟
فلماذا إذا عنَّت له فكرة مهما كانت تافهة خسيسة خطب فيها، كأنه أحد أنبياء بني إسرائيل، ونفسه تحدثه أنَّ واحدا من المعاصرين لا يقدر أن يفش وطب فخفخته؟ فمن قول المؤلف: «لو أنَّ لدينا من سعة الوقت وفراغ البال ما يحتاج إليه هذا الموضوع للهونا وألهينا القارئ بنوع من البحث، وهو أن نضع تاريخا لهذا الانتحال المتأثر بالدين» ص٦٩، ثم يقول في ص٧٢: «فالقرآن يحدثنا بأن اليهود والنصارى يجدون النبي مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
وإذن فيجب أن تخترع القصص والأساطير وما يتصل بها من الشعر؛ ليثبت أنَّ المخلصين من الأحبار والرهبان كانوا يتوقعون بعثة النبي، ويدعون الناس إلى الإيمان به». وقال في ص٧٢ أيضا، وهو لا يخشى في هذه الخطة الخاطئة لومة لائم: «فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم، وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف، وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي، وقريش صفوة مضر، وعدنان صفوة العرب، والعرب صفوة الإنسانية كلها».
وغاية المؤلف من هذه النبذ ظاهرة، ونحن لا نضيف إليها شرحا ولا نزيدها بيانا. وقارئها يظن أول وهلة أن المؤلف يعيش في عصره، وكأنه ليس من أهل عصره، وأنه يجهل أترابه ولداته وأبناء زمانه، وأنه يسخر من الناس جميعا، ولا يبالي أن يرمي بالحقائق في الوحل، ولا يمكن أن نعتذر له بأنه لا يزال في سن الاستخفاف أو نعتذر له بالبلادة،
وكان يخلق بمثله أو بمن هو أقل منه سنّا وعقلا ومكانة قبل أن يكتب مثل هذه الأقوال أن يتدبرها طويلا، ويوازن بين المانع والمقتضي، وللناس صغارهم وكبارهم أن يتساءلوا: أين يجد هذا الكاتب وحيه؟ وهل هذه قريحة من عنده أو طريقة أُوحي إليه أن يتبعها؟ وماذا حلَّ بالدنيا حتى نجدنا حيث نحن على شفا الفوضى الأدبية والاجتماعية؟
أما مسألة الجن وذكره في القرآن وفي الشعر العربي، فلا تقتضي تلك الحملة الشديدة المنكرة، لا نتعرض لما جاء في القرآن كما تعرضت أنت؛ لأن بحثنا علمي محض، ونقتصر على النظر في الآداب، فهذه الإلياذة براعة الاستهلال فيها استمداد المعونة من ربة الشعر، وفي النشيد الأول ذكر أبولون وأثينا آلهة الحكمة، وثيتيس إحدى بنات الماء، وزفس أبي الآلهة وهيرا زوجته، والإلياذة كلها محشوة بأسماء الكائنات الخيالية والأرواح الخيرة والشريرة.
ولم ينفرد اليونان بهذا بل حذا الرومان حذوهم، كقول فرجيليوس كبير شعراء اللاتين في مطلع ملحمته: Musa, Mihi causas memora ولما انتشرت النصرانية في أوروبا ظل فريق منهم يستمد عون ربات الشعر والأغاني، ويذكر الجن في شعره ونثره، كما فعل تاسو في فاتحة منظومته «أورشليم المحررة»، وكما افتتح ميلتون الإنجليزي ديوان «الفردوس الغابر» Sing Heavenly muse! فالأوروبيون الأقدمون والمحدثون يعتقدون في الجن.
أما العرب في جاهليتهم فلم يكونوا على شيء من التزلف إلى معبوداتهم، ولا إلى جنيات الشعر اللاتي كنَّ في زعمهم يوحين إليهم، كما يقول المؤلف ص٧٠: «فأنت تعرف قصة عبيد وهبيد، وأنت تعرف أنَّ الأعراب والرواة قد لهجوا بعد الإسلام بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعدها.» فليس القرآن إذن هو الذي أوجد اعتقاد العرب في الجن.
ولم يكن شاعر الجاهلية يستنشد إلا سليقته مستحثّا فطرته الشعرية ليس إلا. فإن امرأ القيس وقف موقف المنشد والمستنشد بقوله:
وهكذا يقال في استهلال طرفة:
تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
أما الإفرنج في أوروبا الحديثة، فقد ساروا على سنة أسلافهم في ذكر الجن في كتبهم ودواوينهم.
وهذا كتاب فوست أشهر مؤلفات غوته أكبر شعراء ألمانيا وأدبائها، وقد يكون أكبر شعراء أوروبا، بطلُهُ من الجن واسمه مفستوفيليس، وحديثه الذي سارت به الأخبار في كل مكان ونظمه الشعراء، وتغنى به الممثلون والممثلات، وعقدت لمعانيه أدوار الموسيقى على أجمل الأنغام.
إنه استهوى الشيخ الحكيم فوست واشترى منه قلبه بثمن بخس، وهو الشباب والحب والجمال، وأوقعه في غرام مرغريت العذراء المفتونة، وكان ينقله من مكان إلى مكان بقوة لا يملكها إلا الجن، ويطلعه على أمور لا تخفى على الجن، ويطوف به أماكن يسكنها الإنس والجن.
ووضع ويليام شكسبير — قبل غوته — كبير شعراء إنجلترا قصة همليت التمثيلية، وهي تدور على ظهور الجن لهمليت في صورة أبيه الملك المقتول، وقد رآه الأمير ونفر من أصدقائه وعاهدوه على الثأر له، وأقسموا أمام هذا الشبح أو الجن أو الروح على السيف بأمره.
وإن كان شاعر أو مؤرخ نسب إلى الجن النطق بأبيات من الشعر العربي فابتهج مؤلف الشعر الجاهلي، واتخذها وسيلة للطعن في بعض العقائد والتشهير بها والسخرية من أصحابها، فقد أنطق اليونان والرومان والإنجليز والألمان والطليان قبل العرب وبعدهم الآلهة والأرباب والربات والملائكة والجن والشياطين بقصائد مطولة،
ولم ير الشيخ حسين في ذلك بأسا، ولعله سمع بالقصص التي وضعها الألماني جريمه وقلده في التأليف على منوالها كثيرون من الأوروبيين ويسمونها Histoires des fées أو Fairy tales؛ أي قصص الجنيات، فهل يتخذ من هذه القصص مطعنا في عقائدهم أو عقولهم أو علمهم أو فطنتهم، أم أنَّ مطاعنه وَقْف علينا وعقائدنا وعقولنا وعلومنا وفطنتنا ولا تتعدى سوانا؟
إنَّ روح التهكم في كلام المؤلف عن الجن ظاهرة، ونحن لا نتعرض لاعتقاده أو اعتقاد سواه في الجن، وليست غايتنا من هذا الكتاب — الشهاب الراصد — تقويم اعوجاج الاعتقاد، إنما غايتنا البحث العلمي في تاريخ الشعر الجاهلي، ولا نستطرد إلا تبعا لاستطراد المؤلف، ولا نتجاوز حدود الموضوع إلا للرد عليه فيما جاوزه مجاوزة ظاهرة.
يقول في ص٧٠: «فلم يكد القصاص والرواة يقرءون هذه السورة (سورة الجن)، وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه.»
وقد نقل المؤلف من أحد كتب الخرافات التي لا تخلو منها آداب أمة شرقية أو غربية أبياتا من الشعر، وحرص الحرص كله على مراجعه، فلم يذكر لنا اسم الكتاب ولا مؤلفه ولا عدد الصفحة؛ ليحجب عن القارئ أدوات البحث التي يستبين منها صحة النقد، قال في ص٧١: «رووا (؟!) شعرا قالته الجن تفتخر فيه بقتل سعد بن عبادة.»
قد قتلنا سيد الخز
رج سعد بن عباده
ورميناه بسهمي
ن فلم نخطئ فؤاده
وكذلك قالت الجن شعرا رثت فيه عمر بن الخطاب:
أبعد قتيل بالمدينة أظلمت
له الأرض تهتز العضاه بأسوق
نقول: إننا — وكل من له إلمام بآداب العرب — نقرأ الكثير من الشعر المروي عن الجن والإنس، ولم يخطر ببالنا يوما أنَّ المقصود به أنَّ الجن قالته حقّا وصدقا، وأنها تنشد باللغة العربية والأوزان العربية شعرا عربيّا في أمور دينية أو سياسية، ولكننا مذ قرأنا وأدركنا نعلم أنَّ هذا الشعر يتضمن فكرة الشاعر المعلوم أو المجهول الذي نظمه ولم ينسبه لنفسه،
وأنَّ الجن ليست إلا وسيلة لروايته، كما فعل شعراء الإفرنج، مثل غوته وشكسبير ودانتي وميلتون، فقد أنطقوا الجن في دواوينهم بالشعر والنثر، وزاد دانتي وميلتون بالخوض في وصف الجنة والجحيم، ورويا لنا من شعر الملائكة والأبالسة ما لم يخطر على قلب بشر، فهل صدقنا أنَّ الملائكة والشياطين والجن قالت هذا الشعر حقّا؟! وهل يؤمن المؤلف بشاعرية الجن كما يصدق الطفل حديث «عقدة الإصبع» أو «قصة أليس في أرض الجن»؟ بل نعد الشعر الذي نسب إلى الجن في مقتل سعد بن عبادة ورثاء عمر بن الخطاب من النوع التمثيلي الفطري الذي لم تنضج مواهب العرب في بابه؛ لأنهم وإن لم ينظموا شعرا تمثيليّا، فإن خيالهم اتجه نحو هذا النوع من الأدب،
وقد ألَّف اليونان قطعا تمثيلية قوامها شخصيات خيالية أمثال ديونيس وجوبتر وباكوس وبروموتيه، فلا عجب إذا نظم شاعر عربي في مقتل سعد بن عبادة على لسان الجن، فإذا خفي القصد الفني عن المؤلف، فلا يلومن إلا ذوقه، وإن كان يدرك القصد ويخفيه عن قرائه، فليرجعن إلى ذمته وضميره، والدليل على صدق تفسيرنا للمقصود من نسبة هذا الشعر أو غيره للجن أنَّ مرثية عمر بن الخطاب، التي قوامها خمسة أبيات، قد أضيفت إلى الشماخ بن ضرار من فحول الشعراء،
فلو أنَّ مؤلفا قوي الخيال أو مغاليا في تكريم عمر نسبها للجن ليدلل على مكانة عمر بن الخطاب في عالم الإنس وعالم الجن، فليس هذا حجة على العرب وعقلهم وعلمهم بعد الإسلام، وليس السبب في ذلك سورة الجن،
فقد كان العرب يعتقدون في الجن في جاهليتهم، وكان بعض شعراء الجاهلية يزعمون أنَّ لهم شياطين تلقي عليهم الشعر، وأنَّ اسم شيطان الأعشى «مسحل»، واسم شيطان المخبل «عمرو»، ولا عجب، فقد ذكرنا أنَّ شعراء اليونان والرومان وبعض الأوروبيين أمثال تاصو وميلتون كانوا ينسبون تجلي الجمال والبهاء إلى فعل أرواح أخرى تمتزج بالنفس، يطلقون عليها اسم الموز ويفسرونها بآلهة الشعر وينادونها، ويستنجدونها في مطالع قصائدهم.
وقد أطلق الأوروبيون في كل لغاتهم كلمة genius جنيوس أو جني على الشخص المتميز بالنبوغ والمواهب، وأصل هذه التسمية يرجع إلى كلمة الجن، جاء في قاموس لاروس ص٣٥٧: «Génie من اللاتيني Genius شيطان مساعد، روح كان يعتقد الأقدمون أنه يشرف على حياة الإنسان وحظه، ومنها الموهبة أو النبوغ في أرقى درجاته، وأعلى ما يصل إليه العقل البشري.» ا.ﻫ. القاموس الفرنسي.
وأصدق تفسير لكلمة Génie بالعربية كلمة عبقري نسبة إلى عبقر، ومن الغريب أنَّ عبقرا كما جاء في معجم أقرب الموارد ص٧٣٩ «موضع تزعم العرب أنه كثير الجن»، ومنه قول لبيد: «كهول وشبان كجنة عبقر»، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه أو من جودة صفته وقوته، فقالوا: «عبقري»، والإفرنج والعرب نسبوا الامتياز والتفوق إلى قوة غير بشرية، فلماذا كفر العرب وآمن الإفرنج؟ ولماذا نسب إلى العرب الجهالة والسخافة والخرافة، ووصف الإفرنج بالعلم والعقل والحصافة؟ على أنَّ علماء الغربيين وشعراءهم قد استفادوا من أخبار العرب وأشعارهم، وصاغوها في أجمل قالب،
ولم ينتقدوا العرب لأنهم رووها عن جن أو كاهن أو ساحر أو عفريت أزرق أو أحمر، ولكن عنايتهم انصبت على القصة أو القصيدة من ناحية جمال الفن وحسن السبك، وسيدهش مؤلف الشعر الجاهلي إذ يعلم منا أنَّ ويليام شكسبير أعظم شعراء الإنجليز مد يده في رفق واحترام إلى قصة عربية، فتناولها بيراعته وبراعه، ثم أخرجها للناس قطعة تمثيلية نادرة بعد أن سماها باسم بطلها مكبث، وبعد أن نقل حوادثها ومواقفها من اليمن إلى سكوتلاندا، قال نيكلسون ص٢٥ من تاريخ آداب العرب: «إنَّ ما وقع لتبع أسعد كامل وكنيته أبو كريب في الحديث الذي جرى بينه وبين الساحرات الثلاث يذكِّر كل قارئ ببعض مواقف «مكبث»،
وإنَّ في تاريخ ابنه حسان حادثا يشبه سير «غابة برنام» في قصة مكبث، فإنَّ قبيلتي طسم وجديس لما اقتتلتا أفنت جديس طسما، ولم ينج من طسم إلا رباح بن مرة، فلجأ إلى تبع حسان بن أسعد فأوعز إليه أن يحارب جديسا، وكانت أخت رباح متزوجة من رجل من جديس واسمها زرقاء اليمامة، وكانت ترى الجيش من مسيرة ثلاثين ميلا، فلما قربوا من مسافة نظرها،
قالوا: كيف لكم بالوصول مع الزرقاء؟ فاجتمع رأيهم على أن يقتلعوا شجرا تستر كل شجرة منها الفارس إذا حملها، فقطع كل واحد منهم بمقدار طاقته، وساروا بها، فأشرفت الزرقاء كما كانت تفعل، فقال قومها: ما ترين يا زرقاء؟ وذلك في آخر النهار، قالت: أرى شجرا يسير، فقالوا: كذبت أو كذبتك عينك، واستهانوا بقولها، فلما أصبحوا صبَّحهم القوم، فاكتسحوا أموالهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة،
ثم إنَّ حسانا هذا تآمر عليه زعماء حمير — كما يحدث في قصة مكبث — وحملوا أخاه عمرا على اغتياله، فطعنه بخنجر، ثم صعد على العرش بعده، ولكنه عوقب عقاب القاتل بالأرق والذعر، كما يحدث لمكبث بعد مقتل ابن عمه، ثم صرعه الندم، فأوقع بشركائه في المؤامرة الواحد بعد الآخر، ولم ينجُ من بطانته من القتل إلا ذو رعيان؛ لأنه كان نهى عمرا عن قتل أخيه حسان، وقيَّد النهي في شعر نظمه ووضعه في حرز مختوم، وسلمه إلى عمرو، فلما حاول عمرو اغتياله طالبه بالحرز، وأقنعه ببراءته من دم أخيه.» ا.ﻫ. المنقول عن نيكلسون.
فأنت ترى أنَّ ويليام شكسبير علم بهذه القطعة من الأدب العربي عن الملوك والساحرات والحرب والمؤامرة والجريمة والندم، فلم ينظر إليها نظر الطفل المبهوت بين مصدق ومكذب، إنما نظر إليها نظر الشاعر المتفنن الواسع الخيال، ونقل الحوادث بتحوير طفيف في الأسماء والأشخاص إلى بلاد إيقوسة، ونسج عليها إحدى قصصه المحزنة الشهيرة.
يريد مؤلف كتاب الشعر الجاهلي أن يخدع القارئ، ويوهمه أنَّ كل ما ورد في الأدب العربي من نثر وشعر عن الجن ووجودها وأخبارها، إنما وُضع بعد الإسلام وضعا لتبرير سورة الجن التي جاءت في الكتاب المنزل على أفصح العرب، ويدَّعي أيضا بأنَّ المسلمين وضعوا على النبي ﷺ نفسه أحاديث، لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه، وأنَّ كل ما نُسب إلى العرب في أدبهم من هذه الناحية إنما اصطُنِع اصطناعا مجاراة للعقيدة التي اقتضتها هذه السورة القرآنية.
والحقيقة أنَّ عرب الجاهلية كانوا يعتقدون بالجن، ونظموا شعرا جاهليّا كثيرا عن علاقة الجن بالشعر والشعراء، وذكرنا بعضه في [ماذا يقصد بالجاهلية؟] من هذا الكتاب، وقد عللنا الأدب الخاص بالجن بما فيه الكفاية من الوجه الفني، ونقول: إنَّ الشعر الذي زعم الأعراب أنه للجن والأخبار التي عقدوها لها، وتناقلتها عنهم الرواة، إنما هو من قبيل الخيال الشعري.
ولم تكن أمة سامية أو آرية تخلو من الاعتقاد بالجن أو الأرواح الخيرة والشريرة. كتب الأستاذ ماسبيرو الشهير في عدد أول مارس ١٨٧٩ من المجلة المصرية ما يؤيد اعتقاد المصريين القدماء بالجن.
وقال سبنسر في ص١٧٣ من ج١ من كتابه مبادئ علم الاجتماع: «إنَّ اليونان الأقدمين كانوا يعتقدون بالجن وأنهم يقطنون «هاديس»، وإنَّ للجن في اعتقاد اليونان أشباحا تكاد تكون مادية، وإنها تشرب دماء الذبائح، وتخشى القتل، فتمكن عولس Ulysses من تخويفها بسيفه.»
وفي إلياذة هوميروس كلام كثير عن الجن، وكان الإسرائيليون يعتقدون في الجن — ص١٧٤ من الكتاب نفسه — وأن بعض قبائل الهنود تعبد الجن — راجع ص٧٨٥ و٧٨٧ من الكتاب نفسه — ومعظم الأمم الحديثة تعتقد في الجن، وتروي عنها الأخبار والنوادر، وهؤلاء جميعا من أقدمين ومحدثين لا يعتقدون بالقرآن، ولا يعرفون سورة الجن، ولم يخطر ببالهم أن يدوِّنوا تلك الأخبار ويرووها ليستغلوا سورة الجن أو يروجوها، أو يخلقوا جوّا صالحا للاعتقاد بصحتها وصدق ما جاء فيها،
ولم يصل التواطؤ بينهم وبين علماء الصدر الأول للإسلام إلى هذه الدرجة، وربما كان اعتقاد بعض الأوروبيين في تداخل الجن في حياة البشر أضعاف ما يعتقده بعض المسلمين، ولكن المؤلف يأبى إلا أن يضع كل ما يظنه شاذّا أو مخالفا للعقل في نظره على كاهل الإسلام وعلماء الإسلام!
ومما يصح الاستشهاد به مما لم يصل إلى علم المؤلف أنَّ بعض أدباء العرب حاولوا تعليل الشعر الذي زعم بعض الأعراب أنه للجن، ومنهم أبو إسحاق المتكلم أحد أصحاب الجاحظ قال: «إنَّ أصل ما يذكره بعض الأعراب من عزيف الجنَّان وتغوُّل الغيلان أنَّ الأعراب لما نزلوا ببلاد الوحش عملت فيهم الوحشة، ومن انفرد وطال مقامه في الفلاة والخلاء والبعد من الأنس استوحش،
ولا سيما مع قلة الاشتغال والمذاكرين والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى وبالتفكير، والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة وقد ابتلى بذلك غير حاسب، وإذا استوحش الإنسان مثل له الشيء الصغير في صورة الكبير وارتاب وتفرق ذهنه، وانتقضت أخلاطه فيرى ما لا يرى، ويسمع ما لا يسمع، ويتوهم على الشيء الصغير الحقير أنه عظيم جليل، ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا تناشدوه وأحاديث توارثوها، فازدادوا بذلك إيمانا ونشأ عليه الناشئ، وربي به الطفل، فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس.
فعند أول وحشة أو فزعة وعند صياح بوم ومجاوبة صدى تجده وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور، وربما كان في الجنس وأصل الطبيعة نفَّاجا كذابا وصاحب تشنيع وتهويل، فيقول في ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة، فعند ذلك يقول: رأيت الغيلان وكلمت السعلاة، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: قتلتها. (انظر شعر تأبط شرّا في قتل الغول [الشعر الجاهلي وفطرة الشعب العربي] من كتابنا هذا الشهاب الراصد).
ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: تزوجتها … ومما زادهم في هذا الباب وأغراهم به ومدَّ لهم فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابيّا مثلهم وإلا غبيّا (كذا) لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يوجب التكذيب أو التصديق أو الشك، ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط.» ا.ﻫ. كلام أبي إسحاق.
والعجيب في هذا الكلام أنه كما لو كان موجها إلى الأستاذ مؤلف الشعر الجاهلي نفسه، وعندنا أنَّ المؤلف لو قرأ هذه النبذة وتدبرها لأطال التفكير والمحاسبة قبل أن يكتب ما كتب لو كان حسن النية في التأليف.
ومما يؤيدنا في رأينا عن تنبه أهل الأجيال السالفة من المسلمين لكل دقيق وجليل من الأمور، أنَّ شاعرا عربيّا قوي الخيال ممن ينطبق عليهم بعض وصف أبي إسحاق اسمه أبو السري سهل بن أبي غالب الخزرجي من فحول أواخر القرن الثاني وضع كتابا في الجن وأنسابهم وأشعارهم وحكمتهم، وادعى بأنه عاشر الجن، فقال له الرشيد بعد سماع شعره وأخباره: «إن كنت رأيت ما ذكرت، فقد رأيت عجبا! وإن كنت ما رأيته فقد وضعت أدبا …»
على أنه يجب على مؤلف الشعر الجاهلي نفسه أن يعتقد بالجن والشياطين والأبالسة اعتقادا راسخا وثيقا اتباعا لرأي أستاذه وإمامه الفيلسوف رينيه ديكارت، ولا يجوز للمؤلف أن يأخذ ببعض المذهب ويترك البعض، قال الفيلسوف ديكارت في التأمل الأول ص١١٢ من فلسفته: «سأحسب إذن أنَّ الله — وهو الخير كله والمصدر الأعظم للحقيقة — لم يرد أن يخدعني،
وأنَّ شيطانا شريرا لا يقل دهاؤه وخداعه عن قوته قد استعمل كل حذقه وسعة حيلته ومكره في خداعي، وسأفتكر أنَّ السموات والرياح والأرض والألوان والأشكال والأصوات وكل الأشياء الظاهرة، ليست سوى أوهام وخيالات وصور كاذبة استخدمها هذا الجني الخبيث ليؤثر في اعتقادي.
فأين أيها الأستاذ جن العرب بأشعارها الضئيلة في رثاء عمر بن الخطاب أو في مقتل سعد بن عبادة من هذا الجني الكرتيزي العظيم الذي سخر صور الطبيعة في خداع ديكارت؟ قل لي بذمتك وضميرك! هل كان ديكارت يعتقد بسورة الجن، وهل كتب هذه النبذة ليستغلها ويروجها كما صنع علماء المسلمين؟ وبعبارة أوجز وأوضح: هل تواطأ ديكارت مع علماء الصدر الأول للإسلام؟».