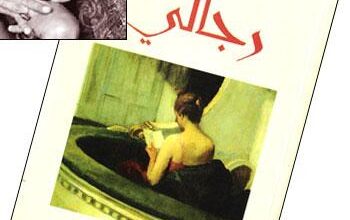تجلّيات التجريب في الرواية المعاصرة

التجريب، هو حالة معرفية تجلّت إبداعياً في الرواية العربية منذ دخول مجتمعاتنا على التوالي مرحلة الحداثة وما بعدها بكلّ ما حملتاه معاً من وعي جديد وقيم جمالية وأفكار فلسفية تواشجت مع الثقافة العالمية، وكانت الانطلاقة الفعلية لهذه الرواية قد بدأت في مصر في بدايات القرن العشرين مع محمد حسين هيكل وتوفيق الحكيم وطه حسين وعلى تعاقب الأجيال بعدها في الخمسينيات والستينيات ودخول مجتمعات جديدة في نهج الحداثة والعصرية لتتبوأ الرواية العربية صدارة الأجناس الأدبية وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة ودخولها المبكر مرحلة ما بعد الحداثة بفكرها واقتصادها وانماط عيشها والانفتاح والتواصل الإنساني مع العالم بكلّ ثقافاته وجنسياته التي تتعايش فيها كنموذج عالمي متقدّم.
وبذلك فإن الرواية باعتبارها جنساً غير منته في تكوّنه هي الأكثر قدرة على التعبير عن هذه المرحلة جمالياً، ففي “المول” يتجاور العالم بمنتجاته وثقافاته، وفي الرواية تتجاور حكايات وتوظّف تقنيات وتناصات شعرية أو فلسفية وغيرها، إنها إذاَ سيرورة التقدم من جانب المجتمع والتطوّر في الفن السردي من جانب الروية.
- في الرواية العالمية والعربية
الرواية باعتبارها وعياً فكرياً وجمالياً يسعى الروائي لتجاوز النمط المعتاد ما أمكنه، والحلم بالحديد المدهش مشروع لكلّ من يخترف الكتابة الإبداعية سواء كانت رواية أو قصّة قصيرة أو غيرهما من الفنون المعروفة بما يؤكّد حضور التجريب بهذه النسبة أو تلك حتّى لو لم يغامر الكاتب في فضاءات واسعة، فالتحريب مهارة فنية ترتبط بخاصية الإلهام التي تميّز هذا الروائي عن ذاك، ولعلّها البصمة الإبداعية التي نلتمسها لدى كلّ كاتب نصّ سردي تمتاز بالفرادة في الشكل والمضمون.
ومن هنا فإني أرى أن كلّ رواية دخلت غمار الحداثة وفي أي زمان ومكان هي مشروع تجريبي يسعى الكاتب لإنجازه بما استلهمه من حراك الواقع أو الحلم والعلم والفلسفة والتاريخ وسواها، ثم قام ببنائه على الورق كعمارة شاهقة تتعايش فيها الشخصيات وتتصارع، وفي الوقت نفسه تتطلع للمستقبل بأحلام صغيرة أو كبيرة. والتجريب إلى ذلك حاضر في العنوان..
في اللغة والبلاغة السردية والبنية المشهدية السينمائية والوصف المتقصّي، بل حتّى في التكرار وفق أسلوب هوميروس في الإلياذة أو كاتب الأسطورة الرافيدينية الينوما إيليش وجلجامش وألف ليلة وليلة. فالتكرار هنا هو نوع من الاشتغال للاستحواذ على ذاكرة المتلقّي وإبقائه في أجواء الحدث ولمتابعة ما سيضيفه من حكاية أو معلومة في ذات القالب السرديّ الذي تتفرّع عنه الكثير من الحكايات و الاستطرادات المتنوّعة.
ومن تكرار الوصف أو الحدث إلى تعدد الرواة أو الأصوات، بل تعدد الشخصية الواحدة في النصّ الروائي الواحد، ونموذجه من الأدب العالمي رواية “عام وفاة ريكاردو ريس” لجوزيه ساراماجو حيث نكتشف القارئ أن “ريكاردو ريس” هو أحد الأسماء المستعارة للشاعر البرتغالي “فرناندو بيسوا 1888 ـ 1935 وإضافة إلى اسم ريكاردو ريس كتب بيسوا شعراً بأسماء أخرى مثل: البرتو كايرو وألفارو دي كامبوس، وبرناردو سواريس، وكان كلّ اسم من هذه الأسماء يمثّل مرحلة من حياته على حدّ تعبير دارسيه.
و أن هذه الأسماء لم تكن مجرّد أسماء مستعارة، وفق ما جاء في مقدمة الكتاب، وإنما “هي “دليل على الشخصيات المتعددة التي نمتلكها جميعاً، وهي بمثابة أوجه ومظاهر متغايرة للنفس البشرية” على حدّ تعبيره. وفي السياق نفسه كتب أنطونيو تابوكي الروائي الإيطالي المعروف والمختص بأدب بيسوا رواية قصيرة أسماها “هذيان – أيام فرنادو بيسوا الثلاثة الأخيرة”ـ فبينما هو راقد في المستشفى يُحتضر تزوره هذه الشخصيات الشبحية وفق بنية استعادية، حيث جاء كلّ واحد منها من زمان ومكان مختلف لوداعه، وربّما أتى بها تابوكي لكي يخبر قارئه أن تلك الشخصيات ما زالت حيّة ولها حضورها الإبداعي.
أما ساراماجو فإنه قام بتمديد حياة الشخصية المستعارة ريكاردو ريس، لمدة تسعة أشهر إضافية بعد وفاة بيسوا 1935، فأتى به من البرازيل حيث كان مهاجراً أو منفياً لمدّة 16 عاماً، لتبدأ أحداث الرواية بلقاء الشخصية المستعارة ريكاردو ريس مع فرناندو بيسوا الشخصية الحقيقية للشاعر فيمضيان هذه الأشهر التسعة حياة حافلة بالحبّ والمناقشات فقد كان بيسوا يخرج من قبره كلّما زاره ربس كي يكشف عن التناقض داخل شخصية الطبيب الشاعر.
وإلى جانب هذه الحبكة عمل الروائي على إبراز الجانب الثقافي لريس من خلال المحاورات الفلسفية والسياسية بينه وبين بيسوا، ليكشف عن نقاط التقارب والاختلاف في المفاهيم بين الشخصيتين اللتين هما واحدة في الأساس. وكأنهما شخصيتان مستقلتان ولكلّ منهما مفاهيمه ورؤيته للفن والحياة.
وعلى الصعيد العربي، فإنه لا تخفى على أحد التجربة الروائية لتوفيق الحكيم في ثلاثينات القرن العشرين مع “عودة الروح و يوميات نائب في الأرياف وعصفور من الشرق و غيرها وكذلك في اعمال نجيب محفوظ التي تتمايز عن بعضها من عمل لآخر ولا يصحّ أن نطلق على أدبه بانه واقعي أو تقليدي كما هو شائع، ومثل هذا ينطبق على أعمال حنا مينة ففي كلّ رواية لهما يمكننا اكتشاف الجديد.
بمعنى أن التجريب ليس ولم يكن مقصوراً على جيل الشباب فالمحترفون الكبار بدورهم جرّبوا في زمانهم ولعلهم ما زالوا يفعلون ذلك كما فعل وليد اخلاصي وصنع الله ابراهيم وابراهيم أصلان وهذا الرأي مختبر من قبلي فقد قرأت وتناولت نحو 50 رواية عربية وإماراتية صدرت في الأعوام الأربعة الأخيرة، فوجدت أن الأعمار متفاوتة ما بين الثلاثين والستين بل ربما السبعين بما استخلصته أن التجريب لا يرتبط بجيل وإنما بالمرحلة ووعيها وأنماط عيشها في التجمعّات والمشتركات الإنسانية.
ومن هنا فإن التجريب لا يرتبط بالشكل الفنّي فقط وإنما هو وعي فكري جمالي ارتبط بتقنيات سرد الحداثة وما بعدها. والتجريب إلى ذلك حقّ مشروع لكلّ روائي وقاص وشاعر و سواهم.
وإذ تنبني الشخصية في الرواية لمجابهة واقع أو ضرورة ما خارجية أو داخلية، ذاتية أو موضوعية إنما هو بحدّ ذاته تجريب لممكنات الفوز أو الخسارة، فهو هنا يخضع لسلطة المؤلّف التي ستدفع به نحو وجاهات مغايرة لأفق التوقع.
والتجريب يرتبط أيضاً بثقافة التلقّي في إطار جدلي كلما ارتقت ذائقة المتلقي كلما ارتقت التجربة ولكن ذلك يقتضي جهداً متواصلاً لأجل تقديم مقترح جمالي مختلف ومغاير ذي خصوصية أشبه بالبصمة الوراثية.
- في الرواية الإماراتية
نخن نقول التجربة الشعرية للشاعر والتجربة القصصية وهلم جرا ولذلك فإني لا أرى أن ثمة حدوداً تفصل ما بين جيل روائي وآخر كما وضّحت أعلاه ولاسيّما في الإمارات، فكل جيل عاش زمانه وعبّر عنه بما اجترحه من الزمكان الفني وما يتخلله من صراع أو معاناة وسوى ذلك،
وهذه القضايا قد لا تكون مهمة لدى الجيل اللاحق بمعنى أن مفاهيم وقيم ما قبل الحداثة لا بد وأن تختلف في زمان الحداثة، وبطبيعة الحال في زمان ما بعد الحداثة، بمعنى أنّ التحريب في رواية “الديزل” لثاني السويدي يختلف بالضرورة عن التجريب في “سلايم” و “زينة الملكة” لعلي أبو الريش، وبدورهما يختلفان في “اسبرسو” أو “شقّة زبيدة” لعبد الله النعيمي أو عن “ميد إن جميرا” لكلثم صالح مع أن هذه الأعمال جميعاً تجريبية
ولكنها تختلف من حيث الشكل والمضمون في زمان ما بعد الحداثة حيث بات المول بديلاً عن الفريج وأيام الغوص والنوخذا ونموذجاً متقدّما لقيم التعايش والتثاقف وسواها بالرغم من رومانسية الفريج، ومع ذلك فإننا لن نعدم من يفضّل الفريج وحياة الصيد عن كلّ هذه المدنية الإسمنتية والمعلبة أكثر من اللزوم كما في زاوية رؤية “سيح المهب” لناصر جبران ورؤيته لمدينة ما بعد الحداثة.
وبالعودة إلى مقولة “الرواية جنس أدبي غير منته في تكوّنه” فإن الروائيين سيجربون باستمرار لتطوير وتقدّم هذا الجنس الإبداعي لأجل تجاوز التقنيات المعروفة في الزمان الخطّي وفي المونولوج والبنية المشهدية، ومن نماذجه “قوس الرمل” للروائية لولوة المنصوري في توظيف الأساطير والحكايات والثقافة الشعبية في البنية السردية فضلاً عن سعيها لإشراك القارئ باستكمال روايتها وإلى جانب ذلك الخيال الجامح في بناء النصّ السردي ومن هنا فإن الرواية حيّز مفتوح حتى اللانهاية.
مع رواية “الديزل” لثاني السويدي 1994 دشنت الرواية الإماراتية عهدها بالتجريب، إذ فاجأت هذه الرواية المشهد الثقافي بما قدّمه من أسلوب حداثي بشر بولادة جيل جديد له قيمه ومقترحاته الجمالية في إطار التجريب.
حيث عمل ثاني السويدي على توظيف المرويات الشفاهية على شكل حكايات متجاورة من مثل علاقة الإماراتي بالبحر وما استجد بعدها من انعطافة مع اكتشاف النفط وأثره في الحياة الاجتماعية.
يجمع هذه الحكايات إطار عام يتكاثف ما بين حياة البحر وحكاياته وحياة الديزل وحكاياته ومن ذلك على سبيل المثال: “كان ماء البحر دافئاً والقمر يلقي خطبة حول ذروة جسدها، أحسّت أن ماء البحر الدافئ يثرثر بين فخذيها، أغمضت عينيها فترة طويلة، شيء ما ينزف منها، نظرت إلى أسفل قدميها، وجدت كومة من الأسماك تدور حولها، ظنّت أن هذه الأسماك أطفالها، خرجت من البحر حاملة أضلع فرحها، تصرخ: يمكنني أن أتزوّج أيّ شيء على وجه الأرض، لأني مختلفة عن نساء العالم، لأنني ألد من دون أن أحمل.. ثمّ نظرت إلى البحر، فرأته أباً مستقيماً، فهمست له: سأهزمك.”
وكما نرى في هذا المجتزأ ذي الطبيعة الفانتازية المستمدة من التراث الشعبي وتعدد أنماط الخطاب بما يتشاكل مع السارد في مسرحية يجلس في حيّز افتراضي وإلى جواره رجل أبكم، ومع إضاءة المكان، ستتراءى بلدة بحرية صغيرة شيئاً فشيئاً، وعندما تركّز الإضاءة على السارد، يشير بيده نحو المكان ويقول للشخصية الأخرى: “إنني هنا منذ ولدت” وهي عبارة مفتاحية قد تعني مكاناً،
وقد لا تعني ذلك أيضاً، طالما قلنا أن الحيّز المكاني هو حيّز افتراضي الزمكان فيه نسبي، وكذلك الأمر بالنسبة للأحداث التي ستجري فوق هذه الخشبة، واقعية كانت أو خيالية أو بين بين. إنه بعبارة أخرى مشترك مكاني لشخصيات ستظهر لحظة وتختفي، دون أن تفرض على المتلقّي خيار المقايسة الواقعية لعالم يمكن تمثيله رمزياً ودلالياً ب “عالم” خارج من الحياة يتمثّل في موت الأب، و”عالم” يدخلها للتوّ مع “الديزل”، وما بين العالمين المرصودين مسافات كبيرة ستسعى الرواية لتفصيلها.
والإحالة الموفقة هنا لطقسية “الخروج والدخول”، يمكن اعتبارها اللحظة السردية الأولى، التي سيقف فيها “الديزل” منتصب القامة، معلناً عن بداية زمنه،
وربّما سيتجول قليلاً على الخشبة مستعرضاً مهاراته وإمكاناته كراوٍ مهيمن ووحيد، فيسارع إلى رواية نصّه دون أيّ معارضة، نظراً لأن سامعه الوحيد أبكم.
ومن روايات الشباب التي اعجبتني جرأة مقترحاتها الجمالية في الشكل والمضمون رواية “حيّ على الحياة” لزهرا موسى الروائية الإماراتية التي تفاجئ قارئها بوعي استثنائيّ في تناول مدينة ما بعد الحداثة وبتقنيات ومقترحات سرديّة مبتكرة عبّرت عنها روايتها الجميلة “حيّ على الحياة” للكشف عما استجد في حياة الجيل الإماراتي الشاب، ومدى ارتباطه بثقافته المحلية والثقافة العالمية سواء بتعلّم اللغة الإنجليزية أو من خلال التواصل مع رموزها عبر الإنترنت ومواقعه الشهيرة ك تويتر وفيسبوك فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الذكية، والأهم من كل هذا إمكانية التعبير عن هذا العالم روائياً ككاتبة واعدة.
في هذه الرواية تسمّي زهرا موسى بطل الرواية “سقراط”، وهو شاب إماراتي سبب له الاسم متاعب جمّة، وفيما يبدو أن والده، الذي توفي منذ أيام قليلة، كان معجباً بالفيلسوف اليوناني أشد العجب، فقد احتلت صدر غرفته صورة للوحة “موت سقراط” للفنان الفرنسي الشهير جاك لوي دافيد من القرن الثمن عشر، فضلاً عن مجموعة من التماثيل، ومنها نسخة من تمثال “الوطن الأم ينادي” المشهور عالمياً أيضاً كأعلى نصب في العالم للنحّات الروسي “يفغيني فوتشيتيتش.
تقدّم زهرا تناصاتها ومتفاعلاتها النصّية بذكاء وإدارة تحسب لها، فلا تسرف فيها إلاّ بما تتطلبه اللحظة السردية الشبيهة بالومضة تاركة أمر التفهّم والاستيعاب لقارئها الذي يفترض به أن يكون على سوية ثقافية مناسبة لاستقبال عمل من هذا النوع من سرديات ما بعد الحداثة، فضلاً عن حضور المكان وتفاعل الثقافات فيه.
والد سقراط المهتم بالفن والفلسفة والذي أربكه بهذا الاسم، واظب على إرباكه بموته المبكّر من جهة واكتشافه أنه ترك له أخاً غير شقيق من زواج سرّي. واسم هذا الأخ “يوسف” أو “جوزيف” وفي العاشرة من عمره، لتتطلق الأحداث على نخو شائق وماتع، تتخللها بعض الحكايات المتفرّعة وبعض الاستطرادات المعبّرة عن الثقافة الدينية والاجتماعية ولعلّها مقصودة لتعريف القارئ الأجنبي بتقاليد الدفن والعزاء والعمرة وسواها.
وفضلاً عن ذلك تحضر تفاصيل المدينة ورموزها الجديدة ومفردات الحياة المعاشة من حيث المقاهي والأطعمة وسواهما على غرار ما فعلته كلثم صالح في رواية “ميد إن جميرا” وفي ذات الأجواء التي عاينها عبد الله النعيمي في روايته “اسبرسو” لمدينة دبيّ ومجتمعها المعولم تعبيراُ عن الحياة الجديدة المعاشة وتقديم بعض النماذج من مثل “مول دبي” الذي يحتوى الأسماء والماركات العالمية الشهيرة فضلاً عن المقاهي والمطاعم والمكتبات العالمية.
وسط هذا العالم المتعولم وصخبه الكبير سنعثر على سقراط وبعض شخصيات الرواية الشابة في المكتبة يتجولون بين أرففها بحثاً عن الكتب، وكأن ذلك الصخب في الخارج بات معتاداً ولا يعنيهم في شيء.
ولعلّ هذا الإقبال من قبل سقراط على الكتب يعود إلى رغبته وفضوله لمزيد من التعرّف على الفيلسوف سقراط الذي سمّي باسمه، غير أن الساردة العليمة كانت بدورها تبحث عن كتاب لعباس محمود العقّاد، وأعتقد أن سبب هذا الاهتمام المستجد بين الشباب مرتبط بالحياة الافتراضية التي يعيشونها في مشتركي “فيسبوك”، وتويتر” الثقافيين، لتأكيد حضورهم الافتراضي كشخصيات منسجمة ومتفاعلة مع ما يكتب من نصوص أو تغاريد “تويترية”.
ومن الروايات التي توقّفت عندها مقارناً ما بينها وبين رواية “حي على الحياة” لزهرا موسى من حيث الفضاء الروائي والتجوّل في مولات دبي ورصد الحركة اليومية لجيل الشباب هي رواية “جميرا.. Made in” بعنوانها اللافت حيث دمجت فيه اللغتين بالإنجليزية والعربية مع صورة لفتاة عصرية ترتدي ثياباً لماركات عالمية مع المحافظة على غطاء الرأس، مما يعطيان انطباعاً سريعاً عن المحتوى في المدينة الكوزموبوليثية دبي.
وهذا التجريب في العتوان أشبه بمفتاح دلاليّ عن خصوصية مدينة دبيّ التي امتازت بازدواجية لغتها ما بين العربية ولإنجليزية، تبعاً للعدد الكبير من الجنسيات التي تعيش فيها كمدينة مستقبليّة امتازت بحراكها التجاريّ وازدهار اقتصادها ومدنيتها، وإلى ذلك فإن مدينة الجميرا هي البوّابة الكبيرة التي ستدخل منها الساردة وشخصياتها لتكشف عما تريد إيصاله،
وذلك وفق عدّة تقنيات اتّبعتها منها: المذكرات، والاستهلال الوصفي التعريفي بالمكان. وفي ذهنها قارئ افتراضي قد لا يعرف جغرافية المنطقة، لا سيما وأن الشخصية الساردة تصف المكان كفضاء ما بعد حداثي ضمّ مركز (ميركاتو) الذي يمكن وصفه بالعالمي تتردد إليه باستمرار وتعتبره من أكثر المراكز حميمية بتصميمه المستمد من عصر النهضة الأوربية، ومركز (بالم ستريب) لكونه أقرب إلى القلب ولا سيما محل البوظة “هاجن داز” الذي يتميز في صناعتها.
كما تعتمد تقنية التداعي والفلاش باك للعودة إلى زمان المراهقة: المدرسة، الجامعة والمغامرات الشبابية وأفلام السينما، لتكشف الساردة عن آليات التفكير لمجتمع الفتيات المحاصر بالعادات والتقاليد، بالتفكير الخرافي وحكايات العفاريت وغير ذلك، إلى أن يتمّ التخرّج فتبدأ معاناة جديدة لكنّ الشخصية الساردة تدخل مرحلة النضج و وعي وجودها ومحيطها سواء في مسألة الصداقات أو مسألة التضامن الأسروي وأهميته لمواجهة وتذليل العقبات جميعا.
إنها في الخلاصة تجريب ما بعد حداثي وظفت فيه تقنيات رواية ما بعد الحداثة من مثل تجاور الحكايات باعتبار أن الساردة وجدت دفتر مذكرات لامرأة أَضاعتها في الحافلة التي تقلّ طالبات الجامعة من مدينة العين إلى دبيّ فضلاً عما ابتكرته من تقنيات ذكرناها أعلاه.
وعن المدينة ذاتها كمركز عالمي كتب عبد الله نعيمي روايته التي اشتهرت شهرة واسعة في أوساط الشباب والنقّاد ” اسبريسو، وهي رواية (تويترية) كما نوّه مؤلّفها، معلناً بذلك استجابته للمتغيرات الجارية في التجريب ما بعد الحداثي،
وهي على حدّ تعبيره “نتاج سنوات من تبادل الحوار مع آخرين على (التويتر) وبذلك يمكننا تصنيفها كرواية اجتماعية تعكس هموم الشباب وتطلّعاتهم في هذه المرحلة التي قرّبت ما بين الناس ودفعت لمناقشة واقعهم ومستقبلهم ومدى افتراق تقاليد الأمس عن اليوم المتّسمة بانفتاح الأجيال وتجاوز الحياة التقليدية بحكم العلاقات التي فرضها المجتمع الجديد المتميّز باختلاط الجنسين وحواراتهم الصاخبة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول ثنائية ذكورة / أنوثة ومدى تفهم الطرفين للواقع الجديد ومدى قدرته على تجاوز قيم الأمس النابذة وذلك وفق أطروحة المؤلّف وشخصياته العديدة التي تفاعلت مع بعضها لتمنحنا جانباً مما تفكّر فيه، لا سيما وأن مدينة ما بعد الحداثة نصرت المرأة ووقفت إلى جانب تحررها.
ينهض السرد على سارد متماه بمرويه يتماس مع قارئه عبر موضوعية الكشف عن الذات والموقف من الآخرين، ونضيف إلى ذلك الروح النقديّة للمحيط والعالم، وبذلك يمكننا الاستنتاج أن السارد/ الشخصيّة اختطّ لنفسه منهجاً حياتياً وثقافة خاصة استلهمت إيجابيات الثقافة الإنسانية إضافة إلى القيم العربية والإسلامية، ويمكن للقارئ تلمّس ذلك في سلوكه اليومي وعلاقته بالآخرين، أو من خلال أقواله على النحو التالي: “رائع جداً أن تكون إنساناً بلا حدود، وجميل أن تكون سحابة ماطرة تنثر قطراتك دون أن تمعن النظر في الوجوه والألوان والحدود والجغرافيا.”
وخلاصة الرواية أن وليد أحبّ نادلة مقهى عصري اسمها سوسن، غير أن الصراع سرعان ما ينشب بين القلب والعقل، فالقلب ينتصر للسوسن، بينما العقل يرفض النادلة، معلناً أن ثمة تقاليد لا يمكن تجاوزها، فيصوّر السارد هذه اللحظات الصراعيّة في ذات الشخصية، ولن تخلو المونولوجات من براعة في الكشف عن ذات المحبّ وتجاوزه للمنطق الاجتماعي. علماً أن عبد الله النعيمي واصل الكتابة الروائية وأصدر بعد “اسبريسو” روايتين، “بانسيون” و “شقّة زبيدة” التي فازت بجائزة معرض الشارقة الدولي للرواية الإماراتية، بما يؤكّد تطوّر تجربته الروائية بما اختطه لنفسه من نهج مغاير له خصوصيته.
ولعلنا في مسك الختام نتوقّف عند المغامرة الروائية للمبدعة لولوة المنصوري في روايتها الكبيرة “قوس الرمل” ببنيتها ما بعد الحداثية ونمط سردي ذي خصوصية من الواقعية السحرية إذ تذهب بقارئها إلى تاريخ المنطقة بهمّة الباحث الأنتروبولوجي في نظام التفكير المجتمعي وطرائق عيشه ومعتقداته كجماعة بشرية استوطنت مكاناً محدداً، وأهله يتناقلون حكاياتهم في أودية تلك الجبال الفاصلة ما بين الإمارات وعمان، الناس البسطاء الطيّبون، وما توارثوه من حكايات خزّنوها في الذاكرة.
تتألّف الراوية من أربعة فصول أو كما تسمّيها “مصبّات” بما تنطوي عليه دلالاتها المائية، و كما للماء أساطيره فللصحراء أساطيرها وأوّل هذه “المصبّات” حكاية “عام الدود” وتتألف من 16 مقطعاً ويمتاز باستهلاله اللطيف حيث تبدأ الأحداث ونتعرّف إلى الشخصيات، ومن أهمها الحاجة حليمة التي نصادفها واقفة، ويداها ممدودتان للسماء، أشبه بصلاة استسقاء خاصة تقيمها، ثم يليها مطر وانقشاع الغيوم عن طيور سوداء تملأ السماء وليهبط أحدها على رأس حليمة ويبدأ بنقره، ويستغرب السارد إن كانت فزّاعة فعلاً، سؤال مفاجئ ينفتح على القارئ هل هي فاقدة للحسّ أم أنها في حالة خطف؟
تشويق أوّلي يجذب القارئ بذكاء وحرفيّة عالية، ولكنّ المفاجآت سوف تتوالى عندما يفكّر السارد بالذهاب إلى حليمة وتخليصها من الوتد المقيّدة إليه، فيكتشف أنه بدوره مقيّد إلى وتد.
مشهد بصريّ كأنه انتزع للتوّ من فيلم “الطيور” لهيتشكوك، فزّاعتان في العراء وطيور سوداء تهاجمهما بعنف وتستحلي نقر الرأسين بمناقيرها، وفيما بعد سيتّضح أنه مجرد كابوس داهم السارد في المنام، وقد أيقظه صوت أمّه وهي تناديه: ” انهض يا ولدي.. لقد أكل الدود زوج حليمة”!
وبهذا الاستهلال الغرائبي تبدأ حكاية “عام الدود” عبر فصول تنطلق من الصحراء ومرويّاتها اعتماداً على ذاكرة رواة من العائلة، ولا تخلو من إشارات ذات دلالة نحو مدن وممالك قديمة سيكون لها حضور مهم في النص كـ “إرم ذات العماد” حيث يأتي حليمة زوجها الميت في المنام يحمل تاجاً بين يديه ورائحته عذبة ويخبرها بأنه عائد من “إرَم” وهذه رائحة ملوكها.
إرم” تلك المدينة التي “لم يخلق مثلها في البلاد” كما ذكر في القرآن الكريم، وتتأزم حليمة بينما هي ترقب الدود الذي يهاجمها ليلاً ويختفي نهارا، والتغريب في هذه الحكاية مقصود لذاته، فالسارد يعلم أنه يروي حكاية وأمامه مجموعة من الخيارات في طرائق عرضها، ويخبر قارئه بمقاصده وأسباب اعتماداً على رواة ثقات رووا له حكاية النبع المختفي تحت الرمال، فالرواة يؤكّدونها، والسارد يرى بأنها أحجية وهمية تعمّدها لتشويق قارئه بما يشبه اللعب.
ولكنّ حكاية النبع تظل حاضرة في الوجدان الجمعي بالرغم من نفي السارد، فقد أقسم كثيرون أنهم رأوا نهراً يتفجّر قريباً من واحة بيرين، ولكه ما يلبث أن يختفي مع الفجر، ولا ندري ما السرّ في ظهور الدود والنهر ليلاً واختفائهماً فجراً، ولعلّ هذا التناوب ما بين الليل والنهار هو ذلك الخيط الواهي ما بين الواقعي والمتخيّل المؤسطَر.
فلنقل إنها مجموعة حكايات لمدن على أطراف الصحراء العربية، تعززها تناصات مستمدة من المأثور الثقافيّ لمجتمع تهيمن الحكاية فيه كنتيجة طبيعية لعزلته في تلك الصحراء الشاسعة وجبالها الغامضة، لتأتي هذه الحكايات على شكل إطارات فرعية تستغلّها الروائية في عرض شائق يذكرنا دائماً برواية “مئة عام من العزلة” بماكوندو وعالمها،
وربّما على نحو أكثر إدهاشاً فيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما استندت إليه الروائية من تراث يمتدّ لآلاف الأعوام من تاريخ المنطقة ما زال حاضراً على شكل مرويّات شفاهية أو كنصوص أسطورية ترجمت عن ألواح بابل ودلمون وماري وسواها، فضلاً عمّا ذكرناه من تناص قرآني يستعيد حكاية “إرم” والمدن الشبيهة، ونحن في هذا المقام لا نودّ الذهاب بعيداً في المقارنة بين الروايتين، وإنما للتذكير بأنه لكل مكان ثقافته وعوالمه السحريّة المؤسطرة للناس والأشياء،
ويصعب على الدارس استعراض هذه المتجاورات السردية والمشهدبات العجائبية التي ساقتها الروائية على ألسنة شخوصها المأخوذين بالعوالم السحرية آن البحث عن النبع أو النهر المختفي تحت الرمال، ولكن لا يمكن تجاوز تفسير حليمة المرتبط بـ “عام الدود” والصحراء التي تدفن الموتى على هيئة دود يخرج من جوف الأرض على شكل موجات بهدف الإشارة إلى الجفاف العام الذي طال الطبيعة. وباختفاء الماء كمصدر إحيائيّ يحضر نقيضه الجفاف أو الموت.
وإذا كان هذا الاستنتاج حقيقة موضوعيّة إلاّ أن الإبداع السردي يذهب بها نحو الإدهاش لما اجترحته الروائية من فنون السرد الشائق وخيال آسر معزز بلحظات درامية تتصاعد حيناً ثمّ ما تلبث أن تغيب تبعاً للاجتراحات السردية التي تعمل الروائية لموضعتها في المتن على شكل فصول أو مقاطع مرقّمة، وليس بالضرورة أن يبدأ كلّ مقطع من حيث انتهى الآخر،
بمعنى أنها اعتمدت تفتيت الحبكة الأساسية وبعثرة أزمنتها ذهاباً إلى الماضي وإياباً وهذا ترافق بالذهاب إلى الأسطورة ومن ثمّ العودة إلى الواقع، وما بين الحقيقة العلمية والأسطورة خيط وهمي يمكن للشخوص عبوره دائماً وصولاً إلى ظهور النفط ليبدو للقارئ أن التنبؤات بوجود الماء تحت الصحراء كانت صادقة إلى حدّ ما إذ بدلاً منه وجد النفط وهو بدوره سائل،
وهذا ما عنينا به الخيط الوهمي ما بين الأسطورة والعلم بمعنى آخر البحث الأنتربولوجي الذي يتقصّى كلّ شيء في حياة الجماعة البشرية ويقدّمها لقارئه في قالب سرديّ ممتع بما يشير بوضوح إلى مهارة الروائية وخبرتها الإبداعية الملهمة في الوقت نفسه.
- ختاماً
مع مرور الزمن بدأ مفهوم التجريب يتوطّد ويتقدّم مع الأجيال المثقفة التي استفادت بلا شك من منجز الجيل الذي سبقها مغامرين بوعي ناقد وإبداع مغاير يعكس مقدار التفاعل مع المتغيّرات التي طالت المدينة الإماراتية، في مرحلة مفصلية وذات خصوصية وزمن انفتاح الثقافات على بعضها، وبذلك فإن الجيل الجديد سيتخفف من أعباء الخوض في المرحلة الانتقالية التي عبّر عنها جيل الروّاد من الكتّاب والكاتبات، وسيتناول قضايا جديدة ترتبط بالمرحلة المعاشة في مدينة ما بعد الحداثة.
قدمت هذه الدراسة في ندوة “الرواية الإماراتية من سرد الصحراء والماء إلى سرد الإنسان” التي أقامتها دائرة الثقافة في الشارقة في 13 /9 /2021.