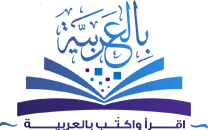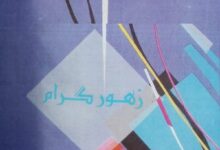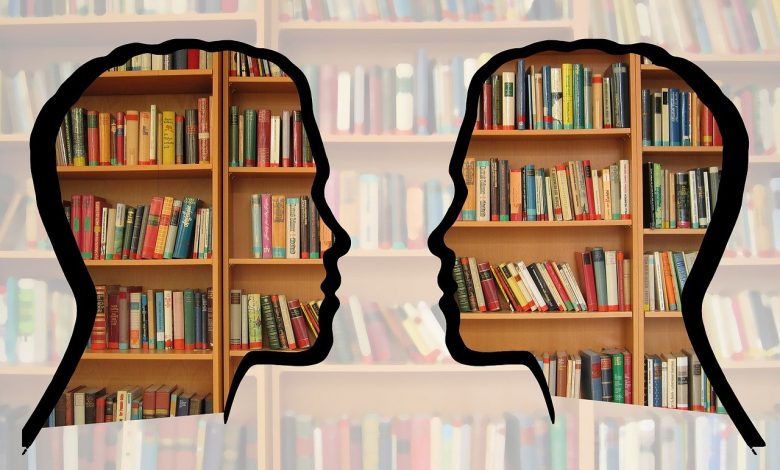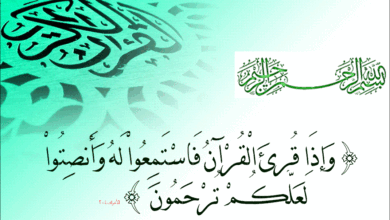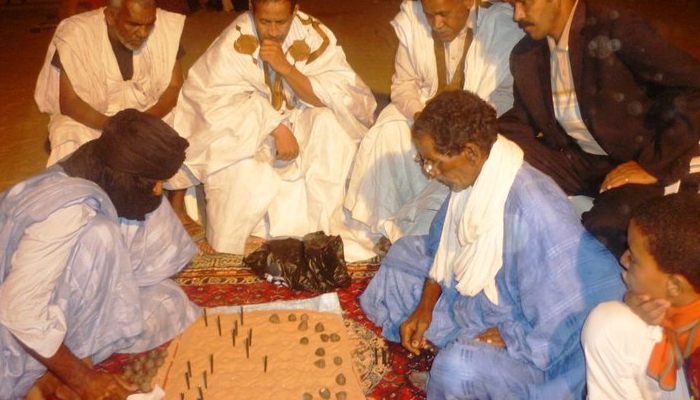الزمنية القرآنية

كنت وأنا صغير، تستوقفني بعض الآيات المتصلة بالزمن، مثل: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا» (العنكبوت، 14) فأتعجب كيف يعيش شخص كل هذا العمر؟ وما كان يذهلني أكثر: «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ» (السجدة، 5).
وقوله تعإلى: «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» (المعارج، 4). كان كل ذلك يزيد من حيرتي، فأبدأ أقارن زمان يومنا، فلا أكاد أتحمل المقارنة، ويسرح بي الخيال؟ أما ما كان يصيبني بحيرة لا نهاية لها فهو القول بالخلود: «خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» (البقرة، 163).
الزمنية تجلِّ لتصور للزمن كما يتحقق في مختلف الأزمنة في الماضي والحاضر والمستقبل. وهي تتشكل في مختلف النصوص بصور متعددة. لكن القرآن الكريم يقدمها لنا بصورة مختلفة. فهي تبدأ مع الخلق وتمتد إلى الخلود. بداية محددة، ومستقبل لا نهائي. وهي تتجلى في الآية الكريمة: «كيف تكفرون بالله، وكنتم أمواتا، فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون؟» (البقرة، 28).
إنها صورة لتعاقب الموت والحياة، لتنتهي في حياة مفتوحة على اللانهائي. ويمكننا اختزال هذه الزمنية القرآنية في مفهومين مركزيين من القرآن الكريم نفسه، هما الغيب والشهادة. ويفرض علينا تحليلها النظر إليها من خلال محورين: أفقي وعمودي. المحور الأفقي خطي يبدأ مع حياة يعقبها موت، فحياة أخرى. وهو يقع في عالمين متعاقبين: الدنيا والآخرة. يتصل الأول بعالم الشهادة، والثاني بالغيب.
أما المحور العمودي، فنقسمه إلى ثلاثة أقسام: يرتبط الأول بعالم الغيب وقد غدا متصلا بماض سحيق (قصة الخلق، وقصص الأنبياء والرسل والأمم والشعوب الغابرة). أما الثاني، فبعالم الشهادة، من خلال قصة بعث الرسول (ص) وما جرى له مع من بعثه الله إليهم من وثنيين وأهل كتاب.
وفي القسم الثالث عودة مرة أخرى إلى عالم الغيب مع نهاية العالم الدنيوي، وما يظهر من أشراط الساعة، وهو ما كان يدخله المسلمون مفسرين ومؤرخين بالملاحم والفتن، ثم العالم الآخر.
اعتبرنا القسم الأول داخلا في نطاق عالم الغيب، من خلال سرد أخبار الأمم السالفة على الرسول (ص): «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» (آل عمران، 44) ونجد هذا أيضا في سورتي هود، 49، ويوسف، 102.
ما يدخل هنا في عالم الغيب هو ما يعمل علماء الآثار والتاريخ على استكشافه وتخمين ما وقع فيه من أحداث ووقائع. أما ما يخص قصة البعث، فقد دونه جامعو السيرة النبوية والمؤرخون والمفسرون. وما سيجري في المستقبل يدخل بدوره في عالم الغيب.
ولعل ما اهتم به المؤرخون، وحاولوا تقديم مؤشرات عنه لنهاية العالم الدنيوي (قيام الساعة) فنجده مستمدا من النصية القرآنية، وهي تؤكد تلك النهاية: «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ؟». (محمد، 18).
إذا كان المحور الأفقي خطيا، فإن المحور العمودي دائري. فكل المادة الحكائية المتصلة بخلق آدم، والنزول إلى الأرض، وتعاقب الأنبياء والرسل، فليس سوى «قصة واحدة» تتواتر أحداثها على نسق واحد: بعث أنبياء ورسل لهداية الناس وتوحيد رؤيتهم، واختلافهم وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين.
وإن اختلفت المادة الحكائية حسب الأمم والشعوب والرسل والأنبياء، فإننا نجد أنفسنا بصدد التواتر السردي، على الصورة التي حللها جيرار جنيت (1972) وإن ضبطنا صورا أخرى مختلفة سنفصلها لاحقا. لذلك يمكننا استخلاص أن المادة الحكائية واحدة، لكن الخطابات التي تقدم إلينا من خلالها متعددة.
ولما كانت القصة الواحدة تتقدم إلينا من خلال شذرات متفرقة في عدة سور (قصة موسى مثلا) نتبين أن كل بنية نصية خاصة تتضمن خطابا خاصا بها، وإن كانت القصة مشتركة. وهذه واحدة من بين الخصائص القرآنية التي دفعتنا إلى اعتبار النص متعاليا على الأجناس والأنواع.
إن قصة الرسول (ص) مع قومه ليست سوى تأكيد لقصص كل الأنبياء والرسل مع أقوامهم (البعد الدائري). ولهذا السبب زخر القرآن الكريم، من خلال التواتر الزمني، بما يؤكد هذه النصية والزمنية. ومن هنا تأتي أهمية سرد وقائع عالم الغيب، الذي تحقق في الماضي: «وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» (هود، 120).
وليست هذه القصص، أيضا، سوى دعم لعلاقة الرسول بغيره من الرسل والأنبياء الذين بعثوا قبله، وما أنزل عليه تصديقا لهم. ونتبين من خلال ذلك أن قصة عالم الغيب في الماضي، أو في المستقبل ليست سوى قصة عالم الشهادة، وما يمكن أن يتولد عنه مع الزمن في ضوء الدعوى النصية الكبرى التي اختزلنا من خلالها الزمنية القرآنية.
تهدف الزمنية القرآنية إلى بلورة معنى للزمن الإنساني لتحقيق إنسانيته الموحدة له باعتباره إنسانا.