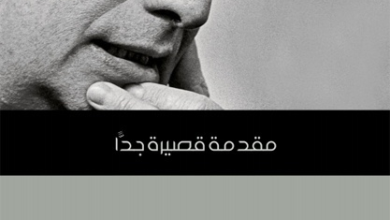تجديـد الدّراسـة الأدبيـة

لطالما ارتفعت الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني، تحت تأثير الظروف التي عرفها الوطن العربي منذ أواخر القرن الماضي، وبداية هذا القرن. لكن لا تتحدث دعوات أخرى، بالحدة نفسها، عن «تجديد» الجامعات العربية، وما تتضمنه من كليات وأقسام. يستشعر الجميع أننا انتهينا إلى الطريق المسدود، وعلى المستويات كافة. ولا بد من إعادة التفكير في تجديد مختلف أشكال الوعي والممارسة لفتح منافذ جديدة لبدايات جديدة. ولن يكون ذلك إلا باعتماد رؤية مختلفة لما اشتغلنا به في المدرسة والجامعة والكلية والقسم.
نظرا لكون أقسام اللغة وآدابها تحظى بمكانة خاصة في السياسات اللغوية والأدبية والثقافية للأمم، إذ هي الدالة على خصوصية المجتمع ومتطلباته، يمكن للمشتغلين في أقسام اللغة العربية وآدابها في الوطن العربي أن يعيدوا النظر فيها لأهميتها، ويطرحوا الأسئلة حول المآل الذي انتهت إليه. لقد صرنا نسمع أحاديث عن عدم جدواها، بل ذهب أحد المسؤولين مرة إلى حد القول بإمكانية إغلاق كلية الآداب، أو على الأقل اعتبارها غير ذات قيمة بالقياس إلى كليات أو شعب أخرى. ومن بين المبررات المقدمة لتهميشها، وعدم اعتبارها، عدم إقدام الطلاب على التسجيل فيها، وأن الذين يتابعون دراساتهم فيها لا يجدون لهم منافذ للشغل، نظرا لعدم اتصالها بما يحتاج إليه المجتمع.
إن مثل هذه الدعوات نجد لها أصداء داخل هذه الأقسام، وتخبطا في التفكير في إعادة مدها بدماء جديدة، عن طريق تجديد المواد، أو التحفيز على التسجيل فيها، أو عقد «شراكات» تخفف من معاناتها. وفي كل الأحوال يظل التفكير في تجديدها مؤسسا على مقاربات تقنية سرعان ما يتم البحث عن غيرها بعد اعتمادها لمدة من الزمن، لتجريب غيرها، وتظل كل الدعوات تؤكد ألا فائدة ولا جدوى من التجديد أو التطوير.
منذ أن أسست أقسام اللغة العربية وآدابها في أول جامعة عربية في مصر، وقد صارت النموذج المحتذى عربيا، ونحن نشتغل بما تكرس في تلك البدايات بتصور محدد. وبقيت صورة هذا التصور مهيمنة إلى الآن، رغم إدخال بعض التعديلات على عرَض بعض المواد أو تسميتها، لكن بدون المساس بجوهرها. يمكننا تلخيص ذاك التصور في كلمتين اثنتين: أولاهما الخطية، وثانيتهما الكمية. تبرز الأولى في كوننا نقدم مقررات اللغة والأدب، حسب تطور الفصول، من منظور تاريخي يميز بين القديم والحديث، من جهة أولى. وهو التمييز الذي يجعل الرؤية المتحكمة في التعامل مع المادتين مبنيا على الانتقال من القديم إلى الحديث، من جهة ثانية. حين يسجل الطالب في قسم اللغة العربية وآدابها يبدأ في الاطلاع على الأدب في العصور القديمة، وكلما تطورت الفصول وجد نفسه في العصر الحديث. هذه هي الخطية التاريخية التي تفضي بالتكوين إلى أن يصير متصلا في النهاية بالعصر الحديث، ومنقطعا عن الماضي.
كانت مسوغات هذا التصور كامنة في أن التلميذ في الثانوي (قبل الثمانينيات) يدرس الأدب خطيا من العصر الجاهلي إلى الحديث، وقد وزع حسب السنوات الثلاث. لكن حدث تغيير في تدريس الأدب في الثانوي، بعد الإجماع على تجاوز تدريسه حسب تطوره التاريخي، باعتماد مقاربة أخرى تقوم على محاور ومواضيع أدبية تنتقى من خلالها النصوص المدروسة، ولذلك صار هذا الطالب عندما يسجل في الأدب في الكلية تغيب عنه أشياء كثيرة لم يطلع عليها. لكن الدرس الجامعي ظل يعتمد المقاربة التقليدية التي تقوم على أساس الخطية من القديم إلى الحديث. لا تنسجم هذه الخطية الزمنية مع واقع عصر الطالب الجديد، الذي لم يدرس اللغة ولا الأدب بما يؤهله ليكون طالبا في قسم العربية وآدابها، وعلى أي مستوى من المستويات. وحين يبدأ مسيرته الجامعية بمواد تتصل بالقديم لا يجد نفسه إلا أمام صعوبات جمة، فهو بلا خلفية لغوية أو أدبية تمكنه من التفاعل مع يقدم إليه. وبما أن المطلوب منه، تبعا للخطية إياها، أن يراكم المعلومات (الكمية) حول كل مادة من المواد، كان يقبل أن يشحن بما يقدم إليه عن طريق الحفظ لضمان النجاح، وحين يتخرج بعد الإجازة يجد نفسه عاجزا عن الانخراط في أي عمل. ولا يتفوق من الطلبة إلا من كان على اتصال باللغة أو الأدب من خلال اهتماماته الخاصة، أو إمكانياته الذاتية، وهؤلاء يشكلون نسبة قليلة جدا.
ماذا لو اعتمدنا تصورا آخر، يجعل الطالب منذ الفصل الأول متصلا بما هو معاصر بقضاياه النظرية والعملية، فنجعله يطلع على الاختصاصات الجديدة، مثل اللسانيات والبلاغة الجديدة، ونظرية الأدب، والسيميائيات والسرديات وتحليل الخطاب، ومنها ننتقل إلى التاريخ ليطلع على كيفية اشتغال القدماء بالنحو والصرف والبيان والمعاني، أو كيف أبدعوا أو فكروا في الأدب في تجلياته النوعية المختلفة، بذلك نجعل الطالب ملما أولا بطرائق التفكير الحديثة ومناهجه، وثانيا ندفعه إلى الاطلاع والبحث في القديم من زاوية جديدة ومحددة علميا، بدون التمييز بين قديم وحديث، في ضوء المعرفة المتحصل عليها، وبذلك أخيرا نجعله قادرا على التفكير وعلى الارتباط بالعصر.