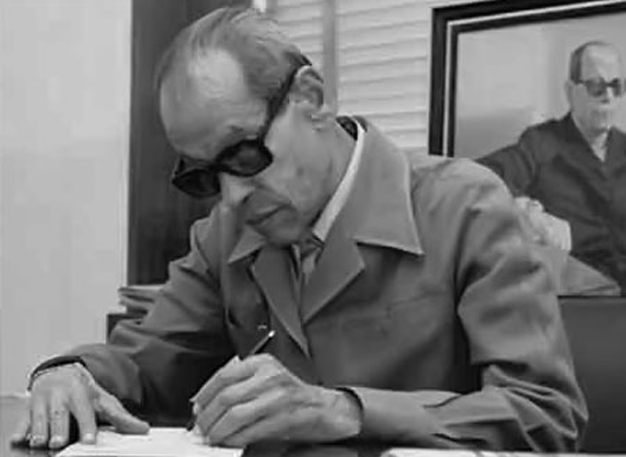دعوات تجديد الخطاب الديني في مصر – المفهوم والغاية
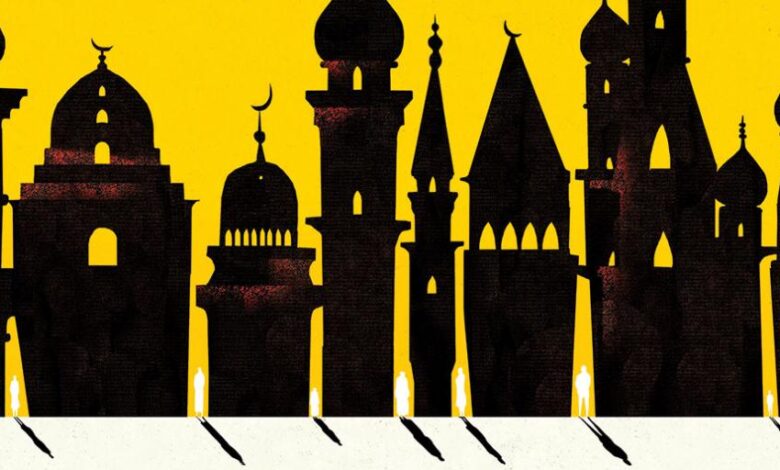
مفهومُ تجديدِ أو إصلاحِ أو تطويرِ الخطاب الدّيني؛ مفهومٌ مُلتبِس، فضفاض وغير مُنضبط، كما تُعوِزُه الأدوات الإجرائية الموصِّلة إلى هذا (التجديد)، ويَكْمُنُ المشكل الأكبر في هذا التجديد في الجهات التي يمكن أن تحمِل هذا العبء وتنهضَ بهذه المسؤولية.
وُلِدَ مصطلح تجديد الخطاب الديني بمفهومهِ الحديث من رحِم الكنيسة، حين انبثقتْ كنيسة إصلاحية جديدة _البروتستانتية_ مِن رحم الكنيسة الكلاسيكية المحافظة _الكاثوليكية_ في القرن السادس عشر الميلادي في أوربا الغربية. وتم استيرادُه في العقود الأخيرة للدلالة على تنقية الخطاب (الإسلامي) من الأفكار والموضوعاتِ التي تَحثُّ على التطرف والعنف وإلغاء الآخر.
وهذا التحديد فيه قصورٌ كبير، إذ ينطلق من محدِّدٍ واحد، دون ربطِه بالسياقات الأخرى المتعالِقة والمتداخلة والمساهِمة في إنتاج هذه البيئة المتطرفة. وأهمُّها الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والحريات. ويمكن أن نجمع هذه العناصر في مصطلح واحد هو (الديمقراطية). وعندما ننظر إلى البيئات التي يعشش فيها التطرف والعنف سنجدُها بيئات لكلِّ مظاهر الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإعلامي و…، وبالتالي فتجديد القراءات والتأويلات وتنويع النظريات في الخطاب الديني وحدَه؛ لن يكون الحل.
ونشير هنا إلى المعنى الآخر للتجديد الديني؛ والذي ظل ملازِما للخطاب الإسلامي منذ القرن الأول للبعثة النبوية إلى اليوم، وهو في رأيي المتواضع؛ المفهوم المعقول لتجديد الخطاب الديني، والمتمثل في تنقية هذا الخطاب من الخرافات والأساطير والأباطيل، وهي حركة تجديدية تبدوا وتختفي من حين لآخر؛ لكنها لا تموتُ أبدا.
وتقوم أساسا على العِلم والفِكر والمعرفة والفلسفة (إعمال العقل)؛ وليس النَّقل والتأويل والرأي فقط. (طبعا دون أن يُلغي النقل العقل) مع فتح هامشٍ مُهمٍّ للمساءَلة والتَّقصي والتمحيص وتصحيح مغالطات التاريخ.
لقد تطور الخطاب الديني طيلة القرون الماضية تَبَعًا لتطور الدولة الإسلامية؛ بدءًا بالفترة الأموية ثم العباسية، كما تراجع وانحصر هذا التطور بشكل آلي عندما توقَّفَ المجتمع عن التطوُّر. وكان أبرزُ تجلٍّ لهذا التجديد؛ ما قام به ابن رشد. بَلْ إنَّ المصطلح العلمي الذي أطلقَه ابن رشد على هذا التجديد هو “الاجتهاد” من خلال كتابِه “بداية المجتهِد ونهاية المقتصد”.
وظلَّ هذا التجديد موجوداً ولكن بشكل ثاوٍ، وله تجلياته اليوم في محاولات تفسير النص القرآني تفسيرا عِلميا؛ أي من خلال العلوم التجريبية (المختبر)، وتنقية التراث من كثير من الخرافات والأساطير والأباطيل التي عَلِقتْ به.
المسألة الأكثرُ أهمية في موضوع تجديد الخطاب الديني (الإسلامي)؛ تتعلق بالجهات المخوَّلَة لهذه المهمة الصعبة والثقيلة. كما أشرنا؛ فإن أيَّ تجديدٍ أو اجتهادٍ أو تطويرٍ أو تحديثٍ؛ لابدَّ أن يأتي من داخل المؤسسة نفسِها وليس من خارجِها.
- دعوة النظام في مِصر إلى تجديد الخطاب الديني لمؤسَّسة الأزهر.
إنَّ مفهومَ تجديد الخطاب الديني هكذا مُجملاً (في مصر)؛ يُحيل مباشرةً على كلِّ الأديان التي تَدِينُ بها مصر (إسلام، مسيحية وما يتفرّع عنهُما من مذاهب واتجاهات وفِرَق)، ولكن النظام يقصد بهذا المصطلح؛ الخطابَ الإسلاميَّ فقط. وسنَنْطَلِقُ من هذه الأسئلة الموضوعية البسيطة عَلَّها تُسعِفنا في فَهْمِ طبيعة هذا التجديد المُرادِ في مِصر وهي:
o لماذا يريد النظام تجديد الخطاب الديني؟.
o ماذا سيُجدِّد النِّظام في الأزهر؟ هل القرآن؟، أم (السُّنة / التراث)؟ أم الاجتهادات الفقهية؟ أم المُقرّرات الدراسية وعلوم الدين؟
o هل يمتلِك النّظام أدواتِ هذا التجديد وهذا التغيير؟
o ومن سيتصدى لهذا التجديد؟
o وهل يمكن لهذا التجديد أن يَحدُثَ خارج مؤسسة الأزهر؟
o وهل يُمْكن إلباس الأزهر خطابا مُجدَّداً فُصِّلَ خارجَ مؤسسة الأزهر؟
o ألا تحتاج الكنيسة أيضا إلى تجديد خطابِها الديني؟
o ما علاقَة الأزهر بالتفجيرات والهجمات الإرهابية التي يتعرَّض لها الأفراد والمؤسسات في مصر؟.
o ألا يُعدُّ الخطاب الديني لمؤسسة الأزهر من أكثرِ الخطابات وسَطيّةً واعتدالا؟
o أليس التجديد المطلوبُ يقبع بعيدا جدا عن مؤسسة الأزهر وخطابها الديني؟.
كلّ هذه الأسئلة وغيرُها كثير؛ ستساعدُنا الإجابةُ عليها أو على بعضِها على الأقل؛ في فهم الكيفية والغاية من وراء هذه الدعوات المتكرر في مصر لتجديد خطاب الأزهر.
عندما نُراجع تاريخ تجديد الخطاب الديني، سنجد أن هذا التحديث يأتي من داخل المؤسسة أو النَّسَق الديني نفسِه وليسَ من خارِجِه، والأمثلة في هذا الباب كثيرةٌ جداً؛ بدءًا بابن رُشد وصولا إلى جمال الدين الأفغاني. والأمر نفسُه حدث مع الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر (كما أشرنا قبلا) حين خرجتْ من رحِمها الكنيسة البروتستانتية (الحركة الإصلاحية المسيحية).
ويحدث مع كل المؤسسات وفي كل الخطابات الأخرى (الخطاب السياسي- الأدبي- الإعلامي- الديني – القانوني …) بل ويحدث مع الأنظمة نفسِها (تحول الملكيات إلى جمهوريات/ والجمهوريات إلى فيدراليات وكونفيدراليات)، لأن التطور والتجديد سِمَة وسُنَّة كونية ماضية على كلّ شيء.
بقي أن نعرف مقصود ومدلولات وغايات السلطة (العسكرية) في مصر من تجديد الخطاب الديني (الإسلامي)، هل هو الإقصاء؛ لِكون النظام الشمولي لا يقبل سلطة موازيةً ولو كانت رمزية، أم للاستعمال وفق أجنداتٍ موضوعة وجاهِزة، أو شماعة لتعليق الخيبات والفشل المركَّب الذي يتقلب فيه النظام، وسواءً كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة؛ فإن للغايات الثلاثة معاً مفعولاً سلبيا؛ بل وعكسيًّا كذلك.
في رأيي المتواضع؛ لا يَملك النظام (العسكري) في مصر تجديدَ ولا تطويرَ أيّ شيء؛ لا الخطابَ الديني ولا السياسي، ولا حتى الخطاب الإعلامي الذي انحدرَ إلى الدرك الأسفل، وصارَ سُبةً ومطية لكلِّ مَن أرادَ أن يتندَّرَ أو يَتسلى أو يستهزئ؛ بسببِ الانحطاط الذي وصل إليه. كما لا تملك هذه السلطة (العسكرية) القدرة على تحقيقِ أي إنجازٍ أو مُعالجَةِ أي مُشكل خصوصاً ما يتعلَّقُ باقتصاد البلاد المنهار.
إن ما يحتاج التجديدَ حقا في مِصر؛ هو الوعي المدني، والوعي السياسي بما يُفضي إلى الوعي بالفعل السياسي، من خلال البقية الباقية من الأصوات الإصلاحية الخافتة، وصولا إلى الوعي بالدولة المدنية وطرحِها كمشروع وطني لا مجيد عنه، والقطع مع الفعل الانقلابي الذي عمَّر لستين سنة، حجَّم فيها الدولة في شخص الرئيس؛ ولخصّ الحكم في الزي العسكري، وقرن السلطة والاقتصاد بالجيش حصرا. ففسدت الحياة السياسية في مصر؛ وفسدَ معها كلُّ شيء، وصارت مصر دولة يملِكُها الجيش وليس دولة تملِك جيشا.
إن أزمةَ مِصر الحقيقة، ليستْ الخطاب الديني وهاجِسَ تجديدِه، وإنما هي أزمة أنظمة شُمولية غير ديمقراطية، وما يترتب عنها مِن انغلاق الأفُق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسَلْبِ الحريات وانعدامِ المساواة والعدالة الاجتماعية والمحاسبة. إن ما تعيشُه مصر اليوم؛ نتيجةٌ طبيعيةٌ لانتكاسة ثورة يناير وإفشال التجربة الديمقراطية الناشئة، وسيطرة الثورة المضادة والتمكين من جديد للنظام القديم بصورة أكثر دموية وشمولية.
الأزمة في مصر؛ لست أزمة إرهاب ولا عنفٍ ولا تطرف، وإنما أزمة الظروف التي أنشأتْ البيئة التي ساهمت في نمو وتكاثر هذه المظاهر الشاذة التي تتبنى العنف شعارا وممارسة، إنها أزمة ديكتاتوريةٍ وانقلابٍ وقتلِ الأفق السياسي لمصر، ما أنتج كلَّ الكوارث والمشاكل التي يعيشُها المصريون بدءًا بإفشال أول تجربة ديمقراطية نزيهة في دولة عربية كبيرة (ديمغرافيا)، وانتهاءً بسلسلة الاخفاقات الاقتصادية؛ وصولا إلى انسدادِ الأفق أمام المصريين وتهديد اللُّحمة والنسيج الاجتماعي للبلاد.
نعم؛ تحتاج مؤسسة الأزهر ومعها كلُّ المؤسسات الدينية في العالَم الإسلامي إلى تجديدٍ يأتي من داخِلِها ليُلغِي الكثير مما علِق بخطابِها الديني من أخطاءٍ وخُرافاتٍ وأساطيرَ وتأويلات وتفسيرات قاصرة غير مواكِبة، وتطويرِ علومِ الدين لتستجيب لحاجات العصر؛ ولتتماهى مع الثورة العلمية للعلوم التجريبية غيرِ المسبوقة.
وألاَّ تبقى قابِعةً في سراديب النَّقْل واجترارِ كثيرٍ من الاجتهادات التي كانت في وقت مُعيَّنٍ تجديدا وتطويرا، وهي أحوجُ ما تكونُ اليومَ إلى اجتهاد وتطوير وتجديد آخر أكثر علمية وواقعية. ولكن؛ كما قلنا قبلا، أن ينبَعِثَ هذا التجديد ويَخرجَ ويُولَدَ مِن رحِم المؤسسة نفسِها؛ لا بأيدٍ خارجية تبتغي شعار التجديد لأغراض وظيفية.
بقيَ أخيراً أنْ نُشير إلى أن شماعة الإرهاب التي يُعلّق عليها النظام إخفاقاتِه المتتالية، وإيهام المصريين بِقُرب دُنُوِّ عام الوفرة والبذخ الذي سيعقُبُ هذه السنوات العِجاف التي دَشَّنها عبد الناصر وتوارثَها العسكر إلى يوم الناس هذا؛ لا يمكن أبدا أن تَمْنَح الشرعية لنِظام انقلب على ديمقراطية فتية وناشئة كانت ستنقُل مِصر نقلةً نوعيةً على جميع المستويات. وسيظل هاجس الشرعية يُطارِدُ هذا النظام ألا شرعي. وما بُني على باطل فهو باطل.