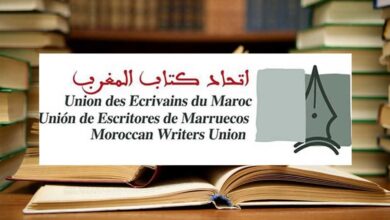لماذا كلّ هذا الحقد النقدي ؟

تفتح الجوائز الأدبية شهية النقاد وغير النقاد ليلتفتوا إلى الأعمال الأدبية الفائزة من أجل قراءتها أو التعليق عليها، ولذلك، فإنّ أهم ما في مخرجات تلك الجوائز هو زيادة مقروئية العمل الأدبي الفائز والتعريف بصاحبه من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تستهدف العمل الأدبي وتسليط الأضواء النقدية حوله ليتصدر المشاهد الثقافية كلها.
ومع ذلك، نادرا ما تجد أن هناك إجماعا على عمل أدبي فائزٍ، مهما كانت سويته الأدبية، فكل عمل أدبي من هذه الأعمال يفتح شهية “الحقد النقدي” على مصراعيها، بحق وبغير حق، وتشعر أن مهمة هؤلاء المنتقدين مكرسة فقط لإثبات أن هذا العمل المتوّج لا يستحق الفوز، وأنه عمل رديء، ويجمع ذلك “الفريق” كل مقدرته السحرية؛ ليثبت أن ذلك العمل غاية في الرداءة، في فكرته، وفي أساليبه، وفي صوره الشعرية، وفي تركيبته العامة،
لتكون النتيجة العامة أن اللجنة التي اختارت هذا العمل، لجنة خاطئة ومخطئة، وتمارس خطايا ثقافية كبرى في حق الأدب والأدباء، وربما تعدى ذلك إلى حد اتهام تلك اللجان بأنها تحارب الأدب الجيد وتعمل على تغييبه، وتكرّس حالة عامة من الرداءة المقصودة، كما كتبت إحداهنّ، ذات مرة، معلقة على الموضوع، وهي غير فائزة بواحدة من تلك الجوائز.
ولا يظنّ ظانّ أن من يمارس هذا النوع من النقد هم من صغار الكتّاب أو النقاد أو مجرّد هواة للنقد والانتقاد، بل تجد أن هذا الفريق مكوّن- عدا الفضوليين والحمقى- من مجموعة من الكتاب المشهورين، والنقّاد المعروفين، ينشرون آراءهم التحقيرية تلك في المنابر الكبرى، من المجلات الثقافية العريقة، والصحف الذائعة الانتشار، والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي،
لتصبح المسألة أكبر من نقد أدبي، وتتعداه إلى نوع من التشهير والفضيحة الثقافية التي لا يفتأ صاحبها من بثها في كل نادٍ وموقع، ويساعده على انتشارها كل من لامست في نفسه شيئا من دغدغة أمراضه التي تهرش روحه، ليتحرش بالأدب وأهله، ولذلك فإنها تنتشر انتشارا كبيرا تحت مدعاة “الجرأة” وعدم النفاق، والاتسام بالموضوعية،
وقد لا يكون وراءها إلا السمّ الزعاف، ومن هذا الباب يزداد خطرها النفسي والثقافي على القراء من الوسط الثقافي، لاسيما المهتمين بالأدب، والمتلقين له؛ الذين يكوّنون آراءهم بناء على آراء أولئك الكتاب المشهورين الثقاة في أعينهم، فتتخلّق قناعاتهم بناء على ذلك، وقد لا تتاح لهم قراءة تلك الأعمال أصلاً، فلا يعرفونها إلا بما قرؤوه عنها، وفي هذا ظلم وتعدٍ كبيران.
وجدت ذلك بشكل فظّ في تعامل فريق من المتلقين مع الشاعرة عائشة السيفي؛ الفائزة بجائزة أمير الشعراء الإماراتية للعام 2023، وذلك الكم الهائل من السيل النقدي الحاقد الذي جرّد الشاعرة من كل ميزة إبداعية، وأجده كل عام مع فائزي جائزتَيِ البوكر وكتارا للرواية العربية، ومع الفائزين بجائزة شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجائزة ملتقى القصة القصيرة،
بل إن فائزي نوبل للأدب لم يسلموا من هذا الحقد، فتجد كثيرين يعيبون هذه النتائج، إلى حد اليقين النقدي الثابت الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، إلى درجةٍ تسأل فيها نفسك من أين تأتيهم هذه اللغة اليقينية الصخرية التي يتحطم عليها كل فائز، وتتفتت على سطحها كل الأعمال الأدبية، فلا نرى إلا أعمالا مفككة، ولا جديد فيها، وتغصّ بالأخطاء من كل لون، كما يزعمون.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هؤلاء الحاقدين نقديا على بعض الفائزين من المبدعين، يتخذون حيالهم استراتيجية لا أخلاقية؛ تقدح في شخصيتهم النقدية، فيستثنونهم من مقالاتهم، ولا يشيرون إليهم، ولا إلى أعمالهم الأدبية ألبتة، ولو كان من المناسب الإشارة إليهم، ويستدعي الموضوع هذه الإشارة أو تلك الإحالات، بل قد يغضبون لو تم تذكيرهم أن فلاناً له فضل في مسألة ما، فيتملصون من المسألة، وكأنهم لم يسمعوا.
إنّ هذه المسألة مختلفة اختلافا بيّناً عن تتبع الرداءة في الأعمال الأدبية والكتابة عنها، إذ إن الدافع للكتابة مختلف في الناحيتين، فالعمل الرديء، رديء لأنه لا تتحقق فيه الشروط الأولى للإبداع، أما ما يحدث مع تلك الأعمال المعلن عنها أنها جيدة بعد تمحيص وتدقيق، فهو تسفيه للأعمال الفائزة، ليقوم الناقد بليّ عنق النص ليستخرج عيوبه، بل يؤوّل ما يمكن اعتباره من جماليات النص إلى مجرد عيوب ونواقص،
ولا يكاد يَرى فيه جانبا واحدا مشرقا أو إبداعيا، على الرغم من أنه لا يوجد عمل أدبي خالٍ من المزايا الإبداعية، كما أنه لا يوجد عمل أدبي كاملٌ كمالا مطلقاً، معجزا، لا تمس بعض جوانبه ملامح من الضعف والركاكة أو وجهة النظر النقدية الانتقادية في قليل أو كثير، فكل عمل إبداعيّ فيه من الجانبين، بل يمكن أن يُؤَوّل أي جانب من هذين الجانبين إلى النقيض حسب الناقد أو المتلقي، وما يتحكم به من ثقافة أو ميول أو اعتبارات أيديولوجية أو سياسية.
إن هؤلاء الحاقدين نقديا، إذ يفعلون ذلك، فإنهم لا يعرفون الديمقراطية الثقافية، ولا يقدّرون وجهات النظر المتعددة حول العمل الأدبي، ولا يحترمون الرأي الآخر، ويتعاملون بمنطق الدكتاتورية في أبشع صورها، ويسعون بدافع “الحقد” الشخصي المرَضي، فيحسدون الناس على ما آتاهم الله من نعم ومواهب، ولا يقدّرون ما بذله أصحاب تلك الأعمال من جهد في الكتابة والتنقيح وهموم النشر، وقلق انتظار النتائج، وما إلى ذلك مما يكابده المبدع الباحث عن مكان له بين آلاف المبدعين المكرّسين، خاصة أولئك الداخلين الجدد إلى نوادي الكتّاب والمؤلفين.
إن ذلك الفريق النقدي التطفلي أشبه بكائنات لا تتقن سوى بث الطاقة السلبية فتسمم الأجواء، وتفقد الناس الثقة في الإبداع والمبدعين والمقيّمين، ولا تساهم إلا في تكريس حالة من الخواء والسقم المعرفي والأدبي في الوسطين العلمي والثقافي، ويزيد من إحساس القارئ العربي بالدونية، وهامشية الأدب، وأن كل هؤلاء الأدباء لا يكادون يحسنون أدبا وثقافة،
ما يعزز نزعة العزوف عن قراءة الأدب العربي المعاصر، والبعد عن صُنّاعه المعاصرين، ما يدفع هذا القارئ إلى احتقار الأدب العربي وأدبائه، ويرمي بالقرّاء أخيرا في أحضان الأدب الأجنبي باللغات الأصلية أو المترجم ما يرسّخ غربة القارئ العربي عن لغته، وعالمه، ومحيطه، وقضايا مجتمعه، وما يبدعه أدباء قومه، فينشأ بذلك جيل لا يعرف عن اللغة العربية والأدب العربي إلا تلك الصورة السوداء التي يسوقها أتباع “الحقد النقدي” الذين لا يدركون تماما ما فعلته أيديهم،
ولا إلى أيّ مدى وصلت إليه مساوئ أعمالهم التي فاقت في سلبيتها أثر قصيدة غير موفقة أو رواية جانَبَ صاحبها التوفيق. إنهم لم يتركوا الأدب ليحيا حياته العادية الطبيعية؛ فيموت من تلك النصوص ما يموت، ويخلد منها ما يستحق الخلود.
كان من الواجب- على أقل تقدير- أن يبحث الناقد- إن كان ناقداَ- عن حسنات العمل الأدبي، وميزاته الإبداعية التي أهلته ليكون عملا فائزا، وليس العكس، فنتائج الجوائز تكون مستندة إلى عدة مقررات فنية وموضوعية لفوز ذلك العمل، وتكون اللجان المُعيّنة قد عاينت تلك الأعمال عن كثب، وعاشت معها، وغاصت في فكرتها، وانتبهت لأسلوبها، واختبرت عناصرها المكونة لها، ولاءمت مدى صلاحيتها وفنيتها، وتأكدت من ترابطها لتقديم ذلك العمل على هيأته التي طُبع فيها.
هذا الجهد النقدي الاختباري الكبير يغيب عن ذلك الفريق النقدي الحامل أفكاره السلبية عن اللجنة المحكّمة والفائزين وأعمالهم الأدبية، وهنا ثمة فرق بين الفريقين؛ فريق يتعامل مع الأعمال الأدبية ليختبر صدقها الفني وتجليات إبداعها بمحددات موضوعية ومقررة وثابتة، تقوده المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية والثقافية، وبين فريق تدفعه أحقاده الشخصية ليثبت فشل الحالة الثقافية،
وما فيها من مثقفين ونقاد وكتّاب وما تنتجه من كتب وثقافة، فريق لا يستشعر الرقابة الخلقية لأنه بطبيعته حرّ، لا يخضع لمؤسسة، لكنه رضي أن يتنازل عن أخلاقه الإنسانية المتوازنة الداعمة والمعززة لكل بارقة أمل في هذا الوطن المنكوب بالكوارث من المحيط إلى الخليج، فلا يعني أنك حر، أن المجتمع لا ينتظر منك أن تكون إيجابيا وعامل بناء، لا عامل هدم.
لعل هؤلاء قد عَمُوا وصَمّوا، وهم لا يريدون أن يروا أن كل عمل من تلك الأعمال التي فازت، وتلك التي لم تفز، مرّ على لجان قراءة وتقييم متعددة، وكل فرد من أفراد تلك اللجان كانت له نظرة، وكان له تقييمه، وكانت له اعتباراته المنهجية أو التذوقية، ليحكم من خلالها على تلك الأعمال، وكان له جهدُه واجتهاده اللذان يتحمل المسؤولية الأخلاقية عنهما، ولا يُعقل أن يكون كل هؤلاء خُلْواً من المعرفة والذائقة المدربة القادرة بحدسها الفني المصنوع بخبرة المعايشة والنظر.
كما لا يعقل أن يكونوا بهذه الدرجة من التفاهة والبلادة أو “اللاشيء”، أو أن يتمتعوا بتلك العدمية واللامسؤولية التي يحاول فيها أصحاب منهج “الحقد النقدي” أن يبينوها- مباشرة وغير مباشرة- للقراء والمتابعين والأصدقاء والأشياع الذين يتماهون مع هؤلاء الحاقدين، فيعومون على عَوْمهم، ويدفعون معهم بالاتجاه نفسه،
لتكون النتيجة جوقة من القطيع المؤيد لصاحب النظرة السوداوية تلك، وكم كنت أتمنى أن أجد معترضا واحدا من هؤلاء الأشياع القاعدين في ذيل الحساب الإلكتروني على ما يقول أحدهم من أصحاب هذا الاتجاه السلبي. إنما تجد- كلهم- متوافقين ومنسجمين انسجاما تاما، كأنّ روحاً واحدة تجمعهم ليكونوا موحدين في الردح على صعيد واحد.
وعليه، لا يصح أن يلغي هذا الفريق بفذلكاته النقدية وتمحُّلاته التأويلية وجوقته “المُطبّلة” التاريخَ الشخصي لأولئك المبدعين، ولأولئك الأفراد المساهمين بالتقييم على مدار أيام طويلة من القراءة والمراجعة والرصد والموازنة والمقارنة، فثمة- بلا شك- جهد قد بذل، علينا احترامه وتقديره حق قدره. لاسيما وأن هذا الفريق بمجمله من النقاد المتربصين ليس له مصلحة في فوز أحدهم، كما أنه ليس له مصلحة في فشل الآخرين وإفشالهم إلا إذا كان هؤلاء المحطّمون فقط يعبرون عن “حسد” فطري بطبيعتهم، وكرههم للمبدعين والإبداع، ولا يحبون أن يروا الفرحة مرسومة على وجوه الفائزين.
فماذا عليهم لو أنهم باركوا للفائزين صنيعهم، وتمنوْا لهم الخير، ألم يكن ذلك أفضل من أن يجندوا الشياطين الراكدة على جنوبها لتصنع أحابيل النقد الهدّام الذي لا يقدم شيئا في مسيرة الإبداع والمبدعين، وما هو في حقيقته إلا سفاهة يتقيأها أصحابها لينفّسوا عما يعتمل في نفوسهم من حقد تجاه كل من يحوز تقدما في هذه الحياة؟
هذا ما يخص التعامل مع الفائزين الذين يجب علينا جميعا، قراءً ونقاداً وإعلاميين دعمهم، فهم منّا، وإبداعهم يَؤُوْل إلينا وإلى أبنائنا، ويساهمون في صنع تاريخ ثقافتنا لأيامنا القادمة، وهذا بطبيعة الحال لا ينفي الجدل الخاص بأهمية الجوائز ومنطقها وأجنداتها الخاصة، وما يسجله بعض الدارسين من ملحوظات عليها وعلى أعمالها، علما أنه لا أديب يفوز بجائزة إلا وهو يستحقها على وجه من الوجوه، شئنا ذلك أم أبيناه، وسواء آتفقنا مع تلك اللجان أم اختلفنا معها،
وسواء أأحببنا الكاتب وما يكتب أم كرهناه لسبب ما، فعلينا أن نقاوم شهوة أنفسنا في رفض نجاح الآخرين، بالإنصات إلى صوت الضمير، ولنضع أنفسنا في المحل ذاته، ومن يدري لعلنا في قابل العمر نكون في المكان الذي هم فيه الآن، فما نحن صانعون إذا ما رجمَنا الآخرون بحجارة حقدهم؟ تذكّروا ذلك، وتذكّروا أن المواقف تتغير بتغير المواقع، فلنحسن القراءة والتأويل، فكلنا مسؤولون، ليس عن الحاضر وحسب، بل عن المستقبل أيضاً.