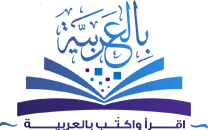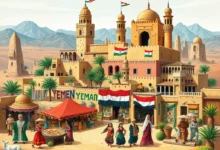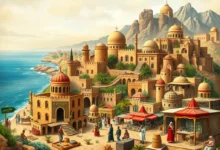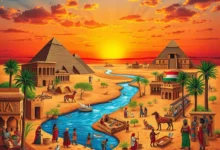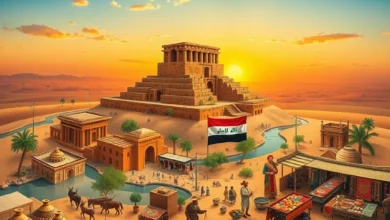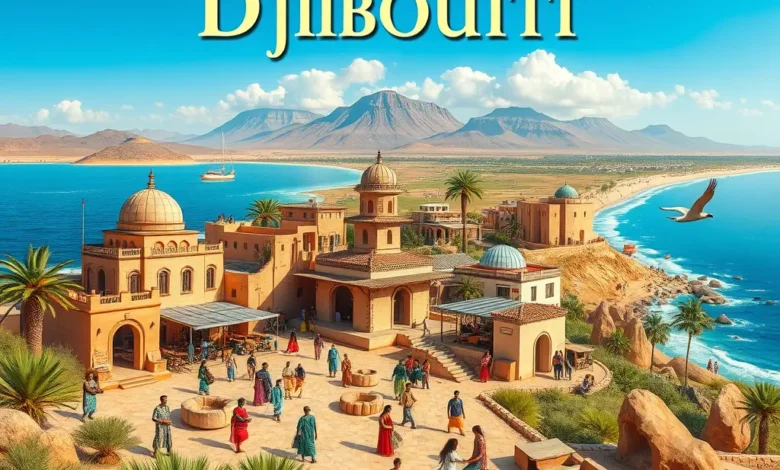
- توطئة
جيبوتي، دولة صغيرة تقع في القرن الأفريقي، تتميز بموقع استراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وفقًا لتعداد عام 2024، بلغ عدد سكانها 1,066,809 نسمة، مع تركّز 72.8% منهم في العاصمة جيبوتي.
جيبوتي عبر التاريخ: من الحضارات القديمة إلى النفوذ الإسلامي
- البدايات الأولى: الروابط المصرية والجزيرة العربية
يعود تاريخ جيبوتي إلى العصور القديمة، حيث تشير الأدلة إلى أن قدماء المصريين كانوا من أوائل من أقاموا علاقات مع هذه المنطقة. ففي الألف الثالث قبل الميلاد، خلال حكم الفرعون بيبي الأول، أرسلت مصر بعثات بحرية إلى سواحل القرن الأفريقي لاستكشاف الموارد وتعزيز التجارة. ومع ذلك، كانت الروابط بين القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية أكثر عمقًا واستمرارية من الاتصال المصري.
عبر مضيق باب المندب، انتقلت قبائل سامية من جنوبي الجزيرة العربية إلى مناطق القرن الأفريقي، حيث اندمجت مع السكان المحليين، ما أدى إلى نشوء حضارة أكسوم. وقد كان عرب الجزيرة العربية، خصوصًا من اليمن وحضرموت وعُمان، من أوائل المستكشفين والتجار الذين عبروا المضيق واكتشفوا سواحل شرق أفريقيا، من بلاد الدناكل في الشمال إلى موزمبيق وجزيرة مدغشقر في الجنوب.
- التجارة والتواصل الحضاري: الدور العربي في شرق أفريقيا
لعب التبادل التجاري دورًا رئيسيًا في بناء العلاقات بين عرب شبه الجزيرة العربية وسكان شرق أفريقيا. ساعدتهم الرياح الموسمية والموقع الجغرافي الاستراتيجي في إنشاء مراكز تجارية على طول الساحل الأفريقي، حيث أقاموا محطات لتموين السفن وتخزين البضائع القادمة من داخل القارة.
هذه المراكز التجارية أسهمت في نشوء مستوطنات حضرية، مما ساهم في تطور البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
في هذه الفترة، كانت الإمبراطورية الحبشية، وهي دولة مسيحية قبطية، تسيطر على المرتفعات الإثيوبية ولها نفوذ في مناطق القرن الأفريقي. ومع ذلك، فإن التأثير العربي والإسلامي كان في تصاعد مستمر، ليحدث تغييرًا جذريًا في تركيبة المنطقة الثقافية والدينية.
- دخول الإسلام: من القرن الثامن إلى العاشر الميلادي
مع ظهور الإسلام وانتشاره السريع في الجزيرة العربية، أصبحت جيبوتي إحدى المحطات الأولى لتوسع الإسلام في شرق أفريقيا. بحلول القرنين الثامن والعاشر الميلاديين، انتشرت الدعوة الإسلامية في المنطقة عبر التجار والدعاة، مما أدى إلى تشكيل سلطنات وممالك إسلامية قوية. ومن بين هذه الممالك، برزت إمارة عدل، التي يفخر بها أهالي جيبوتي باعتبارها إحدى الإمارات الإسلامية التي تعكس تاريخ أجدادهم.
لعبت هذه السلطنات الإسلامية دورًا بارزًا في تعزيز الثقافة الإسلامية واللغة العربية، فضلاً عن تطور التجارة والعلاقات السياسية مع بقية العالم الإسلامي. ومن خلال هذه الإمارات، تم ترسيخ الطابع الإسلامي في المنطقة، ما ساهم في تحولها إلى مركز تجاري وحضاري حيوي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط.
- جيبوتي بين الماضي والحاضر
منذ العصور القديمة، كانت جيبوتي نقطة تلاقٍ للحضارات والتجار والمستكشفين. فبفضل موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب، شكلت جسراً بين الثقافات الأفريقية والعربية، مما أثرى تاريخها وأعطاها طابعًا فريدًا. واليوم، لا تزال جيبوتي تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية، لكنها تواجه تحديات تنموية كبيرة تحتاج إلى استثمارات قوية لتأمين مستقبل اقتصادي مستدام.
يعتمد اقتصاد جيبوتي بشكل رئيسي على تقديم خدمات الموانئ، خاصة لدولة إثيوبيا المجاورة غير الساحلية. في عام 2023، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 6.7%، مدفوعًا بزيادة الطلب الإثيوبي على الخدمات اللوجستية.
تعاني البلاد من عجز غذائي مزمن، حيث تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية. تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة أقل من 1,000 كم² من إجمالي مساحة البلاد البالغة 23,200 كم²، مع معدل هطول أمطار سنوي قدره 130 ملم.
على الرغم من النمو الاقتصادي، لا تزال جيبوتي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية. في عام 2019، انخفض معدل الفقر إلى 17%، مقارنة بـ22.3% في عام 2013. ومع ذلك، بلغ معدل البطالة 27.9% في عام 2022.
يعيش حوالي 30% من السكان في المناطق الريفية، حيث تسهم الزراعة بنسبة 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. نظرًا لشح الأراضي الصالحة للزراعة، تعتمد الأنشطة الزراعية بشكل أساسي على الرعي.
يُعد تحسين الوصول إلى المياه أولوية للمجتمعات الريفية لزيادة الإنتاج الحيواني، مما دفع الحكومة إلى التركيز على استغلال المياه الجوفية واحتجاز المزيد من المياه السطحية.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه جيبوتي تحديات مالية، حيث ارتفعت مستويات الدين العام بسبب القروض بشروط غير ميسرة، وبلغت المتأخرات 6% من إجمالي الناتج المحلي في منتصف عام 2023.
على الرغم من هذه التحديات، تواصل جيبوتي العمل على تعزيز اقتصادها وتحسين الظروف المعيشية لسكانها من خلال استراتيجيات تنموية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين البنية التحتية.
- مقدمة
جيبوتي، الدولة الصغيرة ذات الموقع الاستراتيجي في القرن الأفريقي، تحمل في طياتها تاريخًا حافلًا بالصراعات والتحديات. فمنذ أن أصبحت أرضًا تسكنها الجماعات العرقية الصومالية والعفرية في القرن التاسع، إلى أن استحالت مستعمرة فرنسية في القرن التاسع عشر، وصولًا إلى الاستقلال عام 1977.
مرت جيبوتي بمراحل تاريخية صعبة شكلت واقعها الحالي. ورغم أنها اليوم مركز لوجستي رئيسي بفضل موقعها الحيوي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، تعود جذورها إلى مرحلة الاستعمار والتنافس الجيوسياسي عليها.
- الحقبة الاستعمارية: من النفوذ العثماني إلى السيطرة الفرنسية
قبل وصول الفرنسيين، كانت منطقة جيبوتي تحت تأثير الإمبراطورية العثمانية، التي بسطت نفوذها على سواحل البحر الأحمر. ومع تراجع النفوذ العثماني، برز الاهتمام الأوروبي بالمنطقة، خاصة من قبل فرنسا، التي أدركت أهمية جيبوتي كميناء استراتيجي يمكن أن يخدم مصالحها التجارية والعسكرية في شرق إفريقيا.
في عام 1862، وقّعت فرنسا اتفاقية مع زعماء العفر للحصول على موطئ قدم في المنطقة، واشترت ميناء أوبوك، مما شكل بداية النفوذ الفرنسي الرسمي في جيبوتي. ثم توسع هذا النفوذ ليشمل تأسيس مستعمرة “أرض الصومال الفرنسية” عام 1888، وجعلت فرنسا من مدينة جيبوتي عاصمة لها عام 1894.
كان الهدف الفرنسي من استعمار جيبوتي يتمثل في إنشاء ميناء بديل لبيربيرا في الصومال البريطانية، وخدمة خطوط الشحن البحري المرتبطة بقناة السويس التي افتُتحت عام 1869. وفي هذا السياق، استثمرت فرنسا في البنية التحتية، مثل بناء خط سكة حديد جيبوتي – أديس أبابا، مما عزز أهمية المدينة كمركز تجاري، لكنه جعلها تعتمد بشكل شبه كامل على التجارة مع إثيوبيا.
- الطريق إلى الاستقلال: بين الاستفتاءات والاضطرابات
خلال القرن العشرين، بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بالاستقلال عن فرنسا. وفي عام 1946، تم منح جيبوتي وضع “إقليم فرنسي ما وراء البحار”، مما منحها تمثيلًا محدودًا في البرلمان الفرنسي، لكنه لم يحقق تطلعات السكان المحليين بالاستقلال التام.
في عام 1958، أُجري أول استفتاء حول الاستقلال، لكن الأغلبية صوتت لصالح البقاء تحت الحكم الفرنسي، ويرجع ذلك إلى الضغوط الفرنسية القوية، إضافة إلى التوازن العرقي بين عيسى والعفر، حيث فضلت مجموعة العفر استمرار الحماية الفرنسية.
أعيد الاستفتاء مرة أخرى عام 1967، وكانت النتيجة ذاتها تقريبًا، ليتم تغيير اسم الإقليم إلى “إقليم عفار وعيسى الفرنسي”، في محاولة لطمأنة الطرفين.
مع ذلك، تصاعدت الاضطرابات، خصوصًا مع تزايد المد القومي في إفريقيا. وجاءت اللحظة الحاسمة عام 1977، عندما أُجري استفتاء ثالث، أدى أخيرًا إلى استقلال جيبوتي في 27 يونيو من ذلك العام، وانتُخب حسن غوليد أبتيدون كأول رئيس للبلاد.
- ما بعد الاستقلال: الصراعات الداخلية وبناء الدولة
ورثت جيبوتي عند استقلالها تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الاقتصاد، وانعدام البنية التحتية الكافية، إضافة إلى التركيبة السكانية المعقدة. كان التحدي الأول أمام الحكومة الوليدة هو الحفاظ على توازن القوى بين العفر والصوماليين من عيسى، وهو ما حاول غوليد تحقيقه من خلال حكومة تضم ممثلين عن الطرفين.
لكن بحلول أواخر السبعينيات، بدأ ميزان السلطة يميل لصالح عيسى، وهي المجموعة العرقية التي ينتمي إليها الرئيس، مما أثار استياء العفر. ونتيجة لذلك، اندلعت حرب أهلية في أوائل التسعينيات بين الحكومة التي يسيطر عليها عيسى، وجبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، وهي حركة معارضة تمثل العفر.
استمر الصراع لعدة سنوات، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام عام 1994، تلاه اتفاق آخر أكثر شمولًا في عام 2001.
- جيبوتي اليوم: بين الاستقرار والتحديات الاقتصادية
رغم تجاوز الصراعات الداخلية، لا تزال جيبوتي تواجه تحديات كبرى، خاصة في المجال الاقتصادي. فرغم أن ميناءها يعد شريان الحياة للبلاد، حيث يوفر أكثر من 70% من الإيرادات الوطنية، إلا أن جيبوتي تعتمد بشكل كبير على إثيوبيا، التي تستخدم ميناءها الرئيسي لتصدير واستيراد البضائع.
كما تعاني جيبوتي من نسبة فقر مرتفعة، حيث يعيش أكثر من 23% من السكان في فقر مدقع، خصوصًا في المناطق الريفية، التي تشكل حوالي 30% من إجمالي السكان. كما تسهم الزراعة بنسبة ضئيلة (4%) من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات الغذائية.
على الصعيد السياسي، ورث الرئيس إسماعيل عمر غيله، الذي تولى الحكم عام 1999، نظامًا استبداديًا إلى حد كبير، حيث يسيطر حزبه على المشهد السياسي، مع وجود معارضة محدودة. كما استفاد غيله من الأهمية الجيوسياسية لبلاده، حيث تستضيف جيبوتي قواعد عسكرية لفرنسا، الولايات المتحدة، الصين، واليابان، مما يضمن لها تدفقًا مستمرًا من المساعدات الخارجية.
- جيبوتي بين الماضي والمستقبل
منذ الاستقلال، استطاعت جيبوتي تجاوز العديد من العقبات، سواء كانت داخلية مثل الحرب الأهلية، أو خارجية مثل تأثير القوى الإقليمية والدولية عليها. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع جيبوتي تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تجعلها أقل اعتمادًا على القوى الخارجية، أم أنها ستظل رهينة لموقعها الجغرافي ومينائها الاستراتيجي؟ الإجابة على هذا السؤال ستعتمد على السياسات التي ستتبعها الحكومة في السنوات القادمة، ومدى قدرتها على استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.