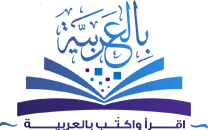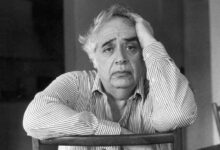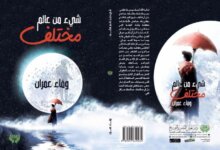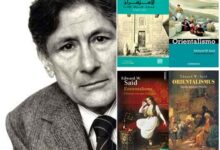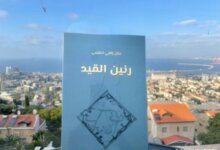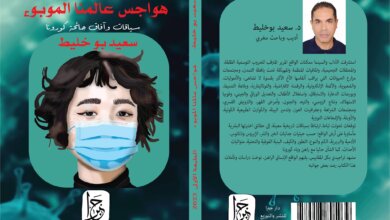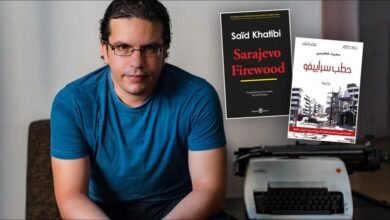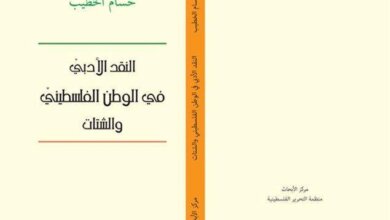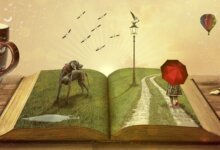تفوق النقاد المغاربة عربيا .. حُكم نقدي أم إشكالٌ مُفتعل؟
بعد فوزهم بكثير من الجوائز وحضورهم على الساحة العربية
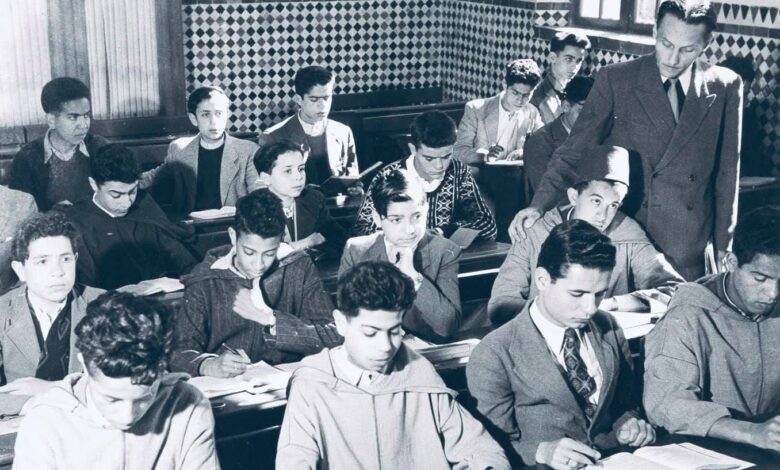
تزايد الحديث، في السنوات الأخيرة، عن المنجز النقدي المغربي، بعد الحضور اللافت لعدد من النقاد المغاربة على الساحة العربية، وحصد عدد منهم لجوائز عربية رفيعة، الشيء الذي جعل البعض يعيد الدفع بسؤال المفاضلة بين المشرق والمغرب، وصولا إلى الحديث عن نوع من التفوق المغربي على الشقيق المشرقي في مجال الدراسات النقدية، بشكل خاص، وبالتالي عن نوع من التناوب على المركزية والمحيطية.
وفي الوقت الذي لا يرى فيه عدد من الأدباء، مغاربة ومشارقة، إشكالا في مناقشة القيمة التي صارت للمنجز النقدي المغربي، بل وانتصار بعضهم لقيمة هذا المنجز، عند مقارنته بالمنجز النقدي المشرقي، يرى آخرون أن المقارنة «إشكال مفتعل»، مع تشديدهم على أن للفكر انشغالات «أعمق» و«أفيد»، من مثل هذه «الحيثيات البسيطة».
- إقلاع نقدي مغربي
يرى الناقد المغربي نجيب العوفي أن المغرب الثقافي «شهد حَراكا نقديا دؤوبا وموصولا منذ سبعينات القرن الفارط إلى الآن، عبر محطات وأجيال مُتمرْحلة مسكونة بسؤال النقد، متنقّلة بين سواحله، ومُجدّدة لظواهره وطُروحاته»؛ معتبرا مرحلة السبعينات «محطة الإقلاع النقدي الحداثي في المغرب، ومُنطلق الأوراش النقدية المفتوحة على المناهج والنظريات الغربية الحديثة، وبخاصة منها، البنيوية، والبنيوية التكوينية، والألسنية، والسيميائية، والإحصائية، والتيماتيكية.
هذا إلى نظريات التلقي وعلم النص.. إلخ»؛ مشيرا إلى أن المغرب كان «سبّاقا إلى انتهاج وافتراع هذه المناهج الحداثية وفتْح آفاق جديدة للخطاب النقدي والمقاربة النقدية بحكم مُتاخمته الجغرافية والتاريخية لأوروبا، على مرْمى بصر»، وأن «هذا ما غيّر وبدّل نقديا، من موازين القوى، وثُنائية المركز والمحيط السائدة عبر التاريخ، حيث أضحى المغرب مركزَ إشعاع نقدي، فاعلا ومؤثّرا، من حيث أضحى المشرق، محيطا متأثرا ومتلقّيا ومستمعا للمغرب، قبل أن ينخرط في غِمار الحداثة في نسختها الأنجلوساكسونية، ويُدلي بدِلوه فيها».
ويتحدث العوفي عن «أجيال الجامعيين المغاربة»، على نحو خاص، التي «ظلت مولعة ومسكونة بأسئلة النقد كما سلف، ومتبارية في حلَبته. خلَفا عن سلف»، مستحضرا، في هذا السياق، رأيا للمفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي، ذهب فيه إلى أن المغرب تاريخيا ذو نزعة فقهية أكثر منها إبداعية، وكيف أن النقد هو «تجلّ ومظهر حداثي للفقه»، ويستدرك بالقول: «لعل هذا ما يفسر هذا الحراك النقدي المغربي على قدم وساق، كما يفسر تبَعا هذه الجوائز العربية التي يفوز بها المغاربة، في مجال الخطاب النقدي. وهم أهل لذلك بكل تأكيد. وجزاء وِفاق لأعمالهم واجتهاداتهم».
يتعرض العوفي إلى سؤال المقارنة بين المنجزين، المشرقي والمغربي، فيقول: «هل يشير هذا الوضع، إلى تراجع أكاديمي ونقدي في المشرق العربي؟ أم إلى تفوق المغاربة؟ لا هذا ولا ذاك. بل هي صيرورة طبيعية في جدلية النقد العربي، وفي ثُنائية المركز والمحيط. أو قل هي لحظة تناوُب على المركزية والمحيطية. وتلك الأيام النقدية، نُداولها بين الناس.
وفي ظنّي، أن الشرق العربي الذي أصبح الآن جوادا جريحا، بفعل الحروب والخُطوب والمؤامرات الأهلية والدولية منذ خُرافة «الربيع العربي». هذا الشرق الجريح لم يعد مجالا حيويا ملائما، لازدهار الخطاب النقدي المشرقي، على سجيّته وديْدنه. لم يعد مجالا حيويا ملائما لانتعاش الأدب والفكر».
ويشير العوفي أيضا إلى أن معظم الجوائز العربية التي يفوز بها مغاربة هي ذات طابع خليجي، وأن «هذا ما يشجّع بلا شك، على هجرة النقاد العرب بعامة، مغاربة ومشارقة، لأداء «العُمرة النقدية»، وأنه «مهما تتعدّد القراءات والتأويلات في هذا الصدد، يبقى فوز المغاربة بهذه الجوائز العربية الوازنة في مجال الخطاب النقدي، ظاهرة أدبية واعتبارية تستحقّ كل تنويه وتقدير،
وخصوصا أن هذه الجوائز تأتي من عمق المشرق العربي وخليجه، وبتزكية علمية من لجان محكّمة، تضم أسماء محترمة من كل فجّ عربي»، الشيء الذي يؤكد، من وجهة نظره، اعترافا مشرقيا بالنبوغ المغربي، مشيرا إلى أن المغرب كان يُعتبر هامشا ثقافيا مغمورا، وأن المشرق يرد الآن، بعض الدّين للمغرب.
- ثنائية ضيقة
ينطلق الشاعر والناقد المغربي محمد الصالحي من وجهة نظر مغايرة لما بلوره وانتهى إليه العوفي، متحدثا عن «إشكال مفتعل»، هو، في أصله، «غير ذي قيمة وغير ذي جدوى، الخائضون فيه لن يقنعوننا بأهمية وضرورة ما يخوضوه فيه»، متحدثا عن وجود «فدلكات ومسكوكات رددناها ولاكتها ألسننا لغير ما سبب، وليس لغايات فكرية»، مشددا على أن للفكر «موضوعات وانشغالات أعمق وأفيد من هذه الحيثيات البسيطة»، مستحضرا، في هذا السياق، نقطة أساسية، تؤكد أن «هذا النقاش لم يفضِ قط إلى نتائج».
ويستشهد هنا بالحوار الشهير الذي جمع بين محمد عابد الجابري وحسن حنفي، على صفحات «اليوم السابع»، والذي «كان حوارا جيدا، قبل أن يسقط في هذا المطب»؛ مشيرا إلى أن «مفكرين بارزين، من هذا الطراز، كان الأجدر أن يوجها سهام فكرهما إلى موضوعات أهم، لأن حنفي والجابري حين يفكران لا يفكران من منطلق أن أحدهما مشرقي والآخر مغربي، بل يتناولان الإشكالات والقضايا بغض النظر عن ثنائية مشرق ومغرب.
وبالتالي؛ فالمسألة ليست أفقية بل عمودية». وزاد الصالحي، موضحا وجهة نظره، بالقول إنه عندما يقرأ كتابا ويشده إليه لا ينتبه إلى ما إذا كان قد كتب من طرف مشرقي أو من طرف مغربي، بل إن كان ممتعا، مكتوبا بلغة عربية راقية ويثير قضايا فكرية أوسع من «ثنائية ضيقة».
يذهب الصالحي أبعد، ليقول إن «هذا الحوار المفتعل قد ظهر بعد خفوت الأسئلة الكبرى، التي ورثناها عن فكرة النهضة العربية، فبعد الهزائم أمام إسرائيل، صارت هناك عقدة ذنب في الفكر العربي، فصارت كل منطقة تتهم الأخرى، إما بشكل صريح أو بإثارة قضايا جانبية وهامشية، من قبيل ثنائية المشرق والمغرب»؛ قبل أن يستدرك، بالحديث عن وجود «إشكال أفظع»، يتمثل في سؤالي «أين يبدأ المشرق وأين ينتهي؟ وأين يبدأ المغرب وأين ينتهي؟».
ولاحظ الصالحي أن «هذا الموضوع قد طفا على السطح منذ سبعينات القرن الماضي، لأسباب تتعلق ببروز حركية غير معتادة في بعض الهوامش، من قبيل المغرب وتونس والخليج، في وقت كان هناك حديث مكرس عن عواصم للثقافة العربية، خصوصا القاهرة وبيروت، وقبلهما بغداد ودمشق»؛ وكيف أن «هذا المعطى جعل بعض المغاربة، من مفكرين وكتاب، يتحدثون عن ريادة مغربية ما».
مشيرا إلى أنه يبحث عن هذه الريادة من دون أن يعرف ما هي، وما هي تمظهراتها، مع أن «كل ما في الأمر أن المغرب وتونس برز فيهما، ربما أكثر أو أوضح، مقارنة مع باقي المناطق، بعض سبق ما إلى استيعاب وتطبيق بعض المناهج النقدية الغربية، خصوصا مع البنيوية وما بعدها».
ويختتم الصالحي أجوبته على أسئلتنا بالقول: «هذا المعطى الذي نتحدث عنه ليس كافيا للحديث عن تفوق مغربي أو مشرقي أو إثارة هذه الثنائية أصلا، لأن تونس أو المغرب إذا ما برزا فبروزهما ليس على حساب المراكز الفكرية الكبرى كالقاهرة وبيروت»، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن «أجمل ما يكتب على مستوى تحقيق التراث العربي يأتي من العراق وسوريا ولبنان ومصر، كما أن أجمل ما يكتب في تاريخ الفلسفة والترجمات وتمحيص المدونة النقدية الأدبية الفكرية العربية القديمة يأتي من هنا ومن هناك».
ومع ذلك، يشير الصالحي إلى أسماء مغربية كثيرة برزت في مجال الفكر كمحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وفي مجال النقد كسعيد يقطين وعبد الفتاح كيليطو، ممن «قدموا قراءات فكرية ونقدية عميقة أبعد من الثنائية المفتعلة»، وكيف أن «المشارقة وجدوا فيها طرحا أعمق لقضاياهم الذاتية العامة أكثر مما وجدوها في كتابات المشرق، والعكس صحيح»، ليختم وجهة نظره بالإشارة إلى مصطلح «العقل المستقيل» الذي أطلقه الجابري، ليعبر (أي الصالحي) عن خشيته من «أن يكون العقل العربي قد استقال من القضايا الفكرية الحقيقية، وصار ينتبه إلى قضايا هامشية وجانبية».