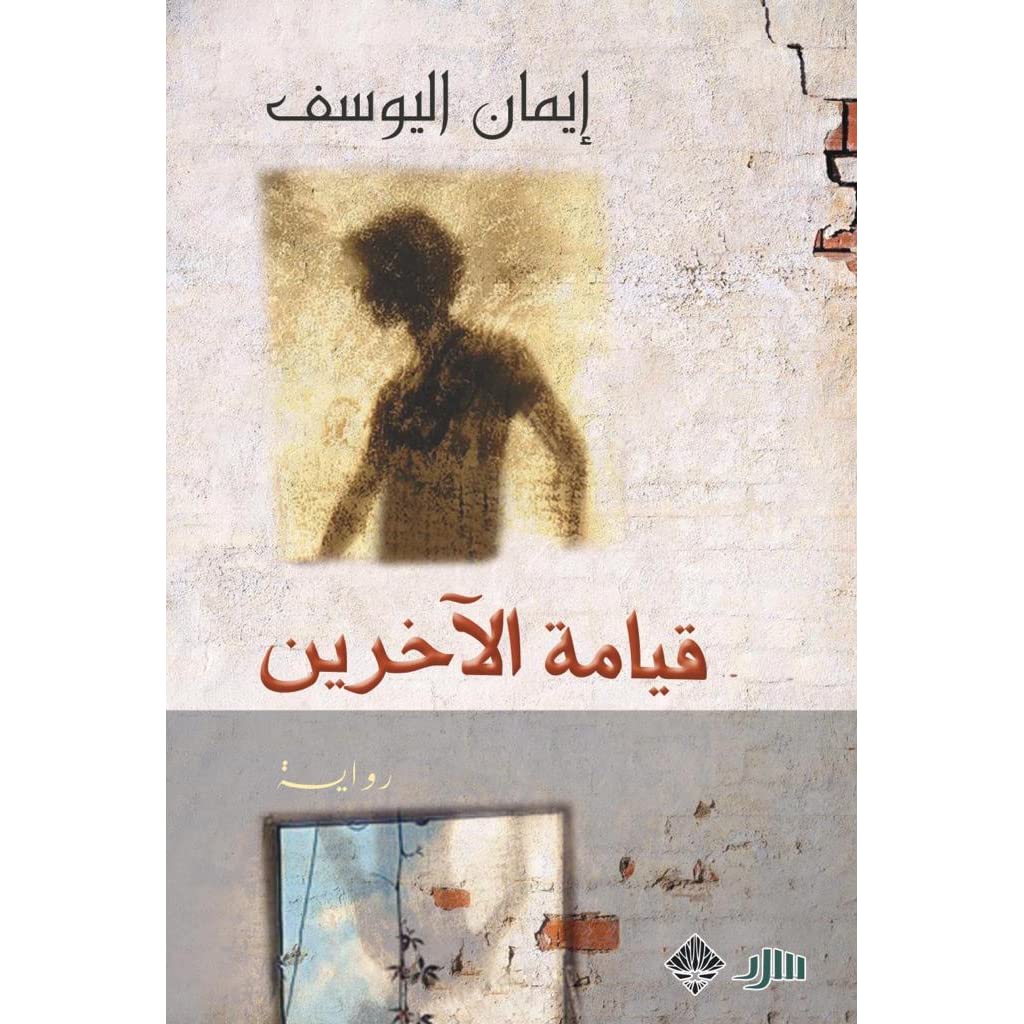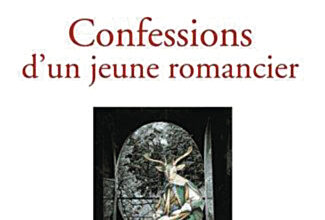الهذيان العربي

استعرت هذا العنوان من كتاب داني ـ روبير دوفور الذي يحمل عنوان «الهذيان الغربي وآثاره الحالية على الحياة اليومية (العمل، الترفيه، الحب)»، والصادر سنة 2014. ينطلق الكاتب من السؤال عن الخذلان والتعاسة التي يعيش فيهما الغربيون حاليا، متخذا أصول هذا الهذيان في فكر ديكارت العقلاني، وبيكون التجريبي،
مرورا بالحربين الأولى والثانية في القرن العشرين، وبالأنظمة الشمولية النازية والفاشية والستالينية، وما صاحبها من حروب استعمارية، وصولا إلى اللحظة الحالية التي أمسى يتساءل فيها الغرب عن واقع الحلم بالسعادة والرفاه.
موضحا أن كل ما آل إليه الغرب لا علاقة له بالهجرات الإفريقية، ولا بإرهاب المتطرفين الإسلاميين، وإنما هو وليد «ليبيرالية الخلاعة» التي عالجها في كتاب آخر له، ونتاج البورجوازية المترابطة ماليا، والمتولدة عن العولمة، والتي لا تفكر إلا في مصلحتها الخاصة.
لا يمكن لقارئ هذا الكتاب إلا أن يستشعر عمق الدراسة وما تتأسس عليه من معطيات وإحصاءات وبيانات يستقيها من أبحاث مدققة وما تقدمه وسائل الإعلام ذات المصداقية في الإخبار والنقد والتحليل. كما أن القارئ العربي الذي لم تتح له فرصة العيش في أوروبا مع بداية الألفية الثالثة ستصدمه الحالة التي يعرضها الكتاب.
وهو يقدم له صورة مختلفة عن المتخيل الذي تشكل لديه عن الغرب الذي صار فيه المرء منشغلا بالتفكير في العمل، أو في وقته الثالث، أو في العلاقات الاجتماعية بصورة عامة.
وعندما يرى المرء بلدا مثل فرنسا حكمه شخص مثل ساركوزي، أو مثل إيطاليا تحكم فيها برلسكوني بسلطة المال والإعلام، وهو يتابع صعود اليمين المتطرف، أو ما تقدمه الآن أمريكا ترامب، لا يمكنه إلا أن يفهم التطورات التي وصل إليها الغرب بصفة عامة والذي أدت بالكاتب إلى استخلاص «هذيان» هذا العقل.
إذا كان دوفور يرجع كل هذا المآل إلى بداية تحول أوروبا مع ديكارت وبيكون، فإنه يؤكد أن دعاوى هذين الرجلين، وهما وليدا حقبة تحول كبرى، كانت تصب في مجرى واحد: الهيمنة على الطبيعة من أجل تسخيرها واستغلالها لفائدة الإنسان.
ولقد نجم عن ذلك الوصول إلى الدمار الشامل الذي لحق بالبيئة، وما تعيشه البشرية جمعاء مع التلوث الذي تعرفه هذه الطبيعة ليس سوى وليد ذلك الطموح.
إن آثار هذا التدمير واضحة في الحياة اليومية في مختلف جوانبها. ويؤكد ذلك من خلال كون اثنين وتسعين في المئة من الغربيين الذين كانوا غير راضين على مستقبل بلدانهم، في بداية الألفية الجديدة، قد انتقل إلى سبعة وتسعين في المئة في سنة 2013م،
موضحا أن معدلات الدخل الفردي التي تقدم لا تعكس الواقع النفسي المعيش: فتلك الإحصاءات لا تقيس جمال الشعر الغربي ولا الثقافة ولا الحكمة. إنها على العكس من ذلك، تقيس كل شيء إلا ما يجعل من الحياة قابلة لأن تساوي المعاناة التي يحياها المواطن الغربي.
أثارني الكتاب، وأنا أنظر إلى العالم العربي ـ الإسلامي وما يتخبط فيها من مشاكل تتعالى على الهذيان، فإذا كانت محاور الكتاب تركز على الشغل والترفيه والحب، فهل تكفي هذه المحاور الثلاثة لنختزل من خلالها هذيانات «العقل» العربي المركبة والبالغة التعقيد؟ فإلى جانب تلك المحاور يمكن أن نضيف الإحساس بالذات، والحرية، والكرامة، والانتماء والخوف من المستقبل، وهلم جرا…
ماذا يمكن أن نسمي «حرق الذات»، ونسب العنوسة والطلاق، ومستويات الاكتئاب والتفكير في الهجرة والاغتراب وفقدان الثقة؟ ناهيك عن البطالة والتهجير والتقتيل والتجويع، وتدهور الصحة والتعليم والسكن؟ ماذا نعتبر الصراعات العربية ـ الإسلامية بين الأشقاء؟ ماذا نعتبر التفرقة والشنآن الظاهر والمضمر بين الحاكم والمحكوم؟ فهل يمكن إرجاع ذلك إلى القرآن والسنة وهما دستورا العرب والمسلمين،
كما فعل دوفور وهو يعيد هذيان العقل الغربي إلى ديكارت وبيكون؟ أم نرجعهما إليهما معا من خلال ما قام به ذاك العقل منذ القرن التاسع عشر مع الاستعمار، وما يضطلع به الغرب حيال الوطن العربي والإسلامي حاليا مع تحكمه في الواقع والمصير من خلال الدوائر المالية والاقتصادية والسياسية العالمية؟
لا أعتبر بيكون وديكارت مسؤولين عن هذا المآل. لقد ناديا فعلا بتحويل النظر إلى الطبيعة من أجل سعادة الإنسان، وكانت نتائج ما أقدم عليه البحث العلمي في ضوء ذاك التحول، كثيرة وهي تصب مجتمعة في مصلحة الإنسان. لكن الصيرورة التي عرفتها التطورات العلمية، وتحكم الآلة العسكرية والمالية هي التي أدت إلى شقاء الإنسان وبؤسه.
وهل الإسلام بمختلف مكوناته مسؤول عن حالات التردي التي يتخبط فيها هذا «العقل»؟ هذيانات العقل العربي كثيرة ومتشعبة، وجزء منها يعود إلى العقل الغربي نفسه منذ أن تدخل في الحياة العربية. لكن الجزء الأكبر منها يعود إلى الإنسان العربي ذاته.
منذ عصر «النهضة» والعقل العربي «يفكر»، ويطرح الأسئلة عن آليات الخروج من الوضع الذي وجد فيه نفسه. وبرزت من خلال ذلك تصورات لا حصر لها. يمكننا استجماع تلك المحاولات في اتجاهين متقاطبين ما يزالان يفرضان نفسهما إلى الآن بصور جديدة. يرى الاتجاه الأول أن المستقبل موجود في الماضي، ويراه الثاني كامنا في الحاضر كما يعيشه الغرب.
وظل الصراع بين التصورين قائما على التجاذب، فلم يفلح التقليديون ولا الحداثيون في وضع العقل العربي على المسار الذي يمكن أن يشق فيه طريقه مجيبا على مختلف المعضلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العربية ـ الإسلامية.
وما تزال، إلى الآن، كل الأسئلة التي طرحت في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين مطروحة بل إنها لا تزداد مع الزمن إلا تعقدا وتشابكا.
كانت كل التصورات المقدمة تعبيرا عن هذيان يقوم على محاكاة النموذج، وليس على التفكير في إبداع نموذج خاص يتأسس على فهم الذات وفهم الآخر. كانت المحاكاة دالة على التخبط والتيهان، فلا يمكننا الحديث رغم كل هذا التاريخ لا على فهم عقلانية ديكارت، ولا تجريبية بيكون، ولا على فهم روح القرآن ولا السنة.
لو انطلق المسلمون فقط من قوله تعالى: «قل سيروا في الأرض، فانظروا كيف بدأ الخلق»، لتمسكوا بروح البحث العلمي، والسؤال العقلي. ولو استوعبوا جيدا قول الرسول الكريم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، لجعلوا القيم مبدأ أساسيا في الحياة والعلاقات فيما بينهم وبين غيرهم.
يمكن تلخيص هذيان العقل العربي، وفهم كل التداعيات التي نعيشها الآن بسببه، والتي تجعلنا من أبأس الخلق في هذا الكون، إلى تغييب فكرتين جوهريتين: تتصل أولاهما بالزمن، وقوامها التقدم. والثانية بالعلم، وركيزتها العمل على فهم العالم.
إن الزمن صيرورة لا يمكن استرجاع ما فات منها كيفما كان نوعها، كما لا يمكن اتخاذ أي نموذج قدوة، فالتجارب التاريخية القديمة والحديثة لا يمكن أن تتكرر بالكيفية عينها، لأن فكرة التقدم تتشكل في سياقات مختلفة ومتباينة. ويمكن هنا تقديم مثالي اليابان والصين.
كما أنه بدون جعل العلم والبحث العلمي أولوية من خلال تطوير الإنسان عبر التعليم، لا يمكن إلا أن نظل نتخبط في الجهل بكل ما في الكلمة من معنى.