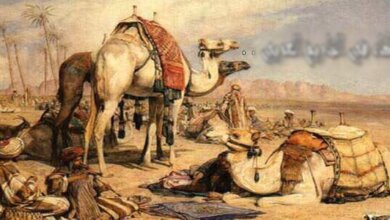أهمية الموروث الثقافي وطرقُ حمايتِه

يكاد لا يخلو أي مجتمع أو تجمع إنساني، في أي مكان من هذا العالم، من موروث ثقافي ناتج عن تفاعل الإنسان مع الإنسان أو تفاعل الإنسان مع بيئتهِ المحيطة به سابقا، هذا الناتج الذي يأخذ صورا متنوعة ومختلفة، فكرية كانت كالمعتقدات واللغات، بلهجاتها، والعادات والتقاليد والطقوس والفلسفة الخاصة بأساليب العيش والتفاعل المجتمعي؛ أم مادية كانت، كمنتجات ومخرجات يد الإنسان من آلات وأدوات وأبنية وكافة المستلزمات المادية، الضرورية للعيش والداخلة في التفاعل الحياتي اليومي ضمن بيئات متنوعة وأزمان مختلفة؛ وبما أن الموروث الثقافي العالمي هو كل المواد المادية (الملموسة)،
وغير المادية (غير الملموسة-الفكرية)، التي تناقلتها الأجيال وحافظت عليها بصورةٍ جيدةٍ من الماضي إلى الحاضر، والاهتمام بنقلها إلى الأجيال القادمة بصورةٍ جيدةٍ أيضا، فضلا عن الموروث الطبيعي، كالنباتات المعمرة والتلال والجبال والبحيرات الطبيعية والأهوار وغيرها من المواقع الطبيعية، فإنهُ بمجملهِ يُعّد السجل الأساسي للأنشطة البشرية الماضية وتفاعلها مع بيئتها؛ وبالتالي هي سجل تاريخ البشرية ومصدر أصالتها وقوتها المعنوية الدافعة للسير نحو المستقبل.
هناك أشياء من الضروري حفظها وإيصالها سالمة إلى الأجيال القادمة، وهذه الأشياء قد تكون مهمة بسبب قيمتها المادية أو المعنوية، الحالية أو المحتملة، وبسبب رمزيتها تولّد فينا إحساسا معينا، كما تجعلنا نشعر بالانتماء إلى شيءٍ ما، مثل وطن أو مكان أو صلات أو تقاليد أو نمط حياة. وقد تكون هذه الأشياء من النوع الذي يمكن حمله أو قد تكون معالم عمارية ثابتة أو أقاصيص تستحق أن تروى.
ومهما كان الشكل الذي تتخذه هذه الأشياء فهي تمثل جزءا من موروثٍ ما، وهذا الموروث يتطلب منا بذل جهدٍ فعال من أجل صونه وحمايته. وبما أن الموروث الثقافي هو ذاكرة للأفراد والأمم ومصدر انتماءها لماضيها وتركتها لجيل المستقبل فأن أمر حمايته والحفاظ عليه يُعّد أمرا بالغ الأهمية. ولأجل ذلك تتسابق الدول في الحفاظ على موروثها الثقافي،
وتستحدث له من الوسائل والسياسات والإمكانات ما يحقق لها صيانة مستدامة لتاريخها وتراثها؛ ولم تعد الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف مقتصرة على المؤسسة الحكومية الرسمية فحسب، بل اتسعت رقعتها لتشمل كل المؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، من جامعات ومعاهد ومنظمات ومراكز وحتى مجاميع تطوعية.
إن فكرة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه ليست بالحديثة، بل تعود إلى عهود وعصور سحيقة في القدم؛ إذ حاول الإنسان أن يُخلد منجزاتهِ وحضارتهِ بشتى الطرق ويصونها لنقلها إلى الأجيال اللاحقة؛ كما أن تلك الأجيال حافظت على ذلك الموروث ومررته إلى الأجيال اللاحقة لها.
وهكذا عبر الزمن انتقلت إلينا الكثير من تركة الماضي الثقافية، ولنا في الحضارة العراقية القديمة مثالا على ذلك، عليه فإنه من الضرورة مراعاة التعامل مع الماضي واستيعاب قيمّهِ التي تحمل الثقافة الإنسانية على امتداد الزمن.
تتعدد أشكال وأنواع الحماية وصون التراث الثقافي على المستوى الدولي والمحلي، فالقوانين والتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية المختصة بالتراث الثقافي، يصاحبها الجهود الأكاديمية والفنية والإدارية، الحكومية وغير الحكومية، كلها تكّون سلسلة مهامٍ ومسؤوليات تقوم مقام السور الحامي الذي يعمل على صون وحماية التراث الثقافي.
ففي ظل التطورات السياسية والاجتماعية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، وما نتج عن هذه التطورات من صراعاتٍ ونزاعاتٍ مسلحةٍ، عملت على تدمير الإنسان أولا وكل ما يربطهُ بترابهِ من ماضي وحاضر ومستقبل ثانيا؛ وما ورثهُ من نتاجاتٍ، ماديةٍ كانت أم غير مادية، من أجداده وأبناء جلدته ثالثا.
ونتيجة لذلك فقد أحدثت تلك الظاهرة خسارات ونقصا خطيرا جدا في الموروث الثقافي العالمي، تلك الخسارات التي لم تُشاهد منذ الحرب العالمية الثانية، ظهرت مرة أخرى بطرقٍ لا يمكن التنبؤ بها في السيناريوهات السياسية العالمية.
ويعود ظهور هذه الظاهرة إلى الكراهية التي لا يمكن تفسيرها والتعصب الكامل للأوساط الأصولية، بهدف القضاء على أي تعبيرٍ عن ثقافةٍ “مختلفة”. هذا النوع من التدمير المتعمد قد تحقق بالفعل مع خسائر فادحة، خلال الحروب الأخيرة في مناطق الشرق، ومنها العراق، وخلال هذه الصراعات، التي عادة ما تكون أزمة داخلية في بلدٍ ما، تؤدي إلى حروب أهلية، تنتهي ربما بتدخلات مسلحة من قبل القوات النظامية وغير النظامية من القوى الوطنية أو الأجنبية المساندة.
وللأسف أصبحت جرائم تدمير الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة أمرا شائعا جدا في السنوات الأخيرة، كذلك حدوث انتهاكات متكررة فظيعة للقواعد القانونية الدولية القائمة والرامية إلى صون الموروث الثقافي للبشرية جمعاء. وتحفز هذه الجرائم المجتمع الدولي للانتباه إلى الحاجة الملحة لتشجيع وضمان تنفيذ اتفاقية لاهاي 1954، وبروتوكولها الثاني لعام 1999، فضلا عن النظام الدولي الشامل فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية.
إحدى طرق تدمير التراث الثقافي سواء، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، هي الاحتلال العسكري أو الاحتلال المدني أو الاحتلال الفكري. إذ يعمل الاحتلال العسكري، عن طريق النزاعات المسلحة، على تدمير التراث الثقافي بشكله المادي ويشجع الانفلات الأمني مما يتسبب في ظهور عمليات الإتجار غير المشروع بالتراث الثقافي.
ويمكن أن يظهر تأثير ذلك خلال مدة زمنية قصيرة، وأفضل مثال على ذلك هو الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق في 2003، واحتلال عصابات داعش لبعض مدنه في 2014، كذلك دخول الأطراف العسكرية المتنازعة في سوريا وليبيا واليمن وغيرها إلى مواقع التراث الثقافي.
بينما يعمل الاحتلال المدني، حينما تطغى فئة تمثل ثقافةٍ معينة على فئةٍ أخرى مغايرة لها بالثقافة، خصوصا إذا كانت الأخيرةُ ذات أصالةٍ ثقافيةٍ ضعيفةٍ وهشة، على تشويه الموروث الثقافي غير المادي، عن طريق خلط وتشويه ثقافة مجتمعٍ ما وتغيير إرث العادات والتقاليد واللهجات، من خلال محاولة فرض ثقافةٍ جديدةٍ على مجتمعٍ ما؛ أو كذلك عن طريق الانفتاح المفاجئ على الثقافات العالمية بالنسبة لمجتمع كان مغلق؛
وفي هذه الحالة يأخذ التأثير والتأثر مدة زمنية طويلة نسبيا، ومثال على ذلك هو عمليات الهجرة من الريف إلى المدينة أو العكس، أو عمليات الهجرة بين بلدين مختلفين في الثقافة واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد، حيث تعمل هذه الهجرات على تشويه وتحريف كلا الثقافتين حين دمجهما في مكانٍ جديد وتعمل على نشوء ثقافةٍ هجينةٍ مشتركة تعمل على خلط الموروث الفكري مستقبلا.
أما الاحتلال الفكري، فيتمثل بسيطرة فكرٍ أو توجهٍ معين على مجتمعٍ ما بمدة زمنية طويلة، يتيح أو يعمل هذا الفكر على تعبئة الجماهير ضد إحدى عناصر الموروث الثقافي؛ فيكون بذلك التدمير ناتج عن شأن داخلي وعلى يد المجتمع (المؤدلج) بأيدلوجية معينة، كأن تكون عنصرية أو قومية أو سياسية أو عقائدية دينية، وهذه الأخيرة هي الشائعة نسبيا، تُثبت في عقلية الناس ضد تراثهم. بما أن الموروث الثقافي بطبيعته ضعيفا خلال فترات الاضطرابات والنزاعات، فإنه يمكن الوصول إليه والتماس المباشر معه والتلاعب به،
لذا تتعمد بعض الجهات والجماعات باستهداف الموروث الثقافي وتسيس وأدلجة عملية تدميره والتلاعب بالرأي الدولي. والتاريخ الإنساني، القديم والحديث، حافل بالعديد من الأمثلة التي كان سببها التوجهات السياسية والعنصرية والدينية الأيديولوجية في عملية تدمير العديد من الممتلكات الثقافية وتشويهها. وخير مثال على ذلك كان رجال الدين الإسبان الذين واجهوا ثقافة المايا في شبه جزيرة “يوكاتان” (Yucatán) في القرن التاسع عشر،
قد دمروا في الكثير من نصوص المايا المقدسة، لأنهم كانوا يخشون من أن تعيق تلك النصوص الدينية، الخاصة بشعب المايا، انتشار المسيحية وتجعل مهمتهم التبشيرية أكثر صعوبة. كذلك الحال مع تدمير التراث الثقافي في أفغانستان حيث أعتبر بعض السكان هناك بأن التراث الثقافي العائد بتاريخه إلى ما قبل الإسلام وغير الدين الإسلامي، هو غير مهم ولا شأن لهم به،
وفي بعض الدول أعتبره أصحاب ذات الفكر بأنه من المحرمات والوقوف عنده شرك وكفر؛ ومثال ذلك أيضا الفكر الخاص بداعش، الذي عليه أستندت هجماتهم التدميرية ضد الموروث الثقافي بأنواعه.
على مدى العقود الأخيرة، انتقل الشأن الثقافي إلى خط المواجهة في الحروب، وذلك كأضرار جانبية وكهدف مباشر للمتحاربين الذين يستخدمون تدمير الثقافة كوسيلة لتعزيز المزيد من العنف والكراهية والانتقام. وللأسف يمس هذا التدمير صميم المجتمعات على المدى القريب والبعيد، فيؤدي إلى إضعاف أسس السلام وعرقلة المصالحة عند انتهاء الأعمال العدائية؛ إذ باتت جرائم التدمير المتعمد للموروث الثقافي ومواقعه هو مظهر من مظاهر الحرب الثقافية الشاملة.
وقد أثبتت النزاعات الأخيرة في العراق وليبيا واليمن وسوريا، أو حتى في تركيا وأفغانستان ويوغسلافيا ومالي، أن حماية الموروث الثقافي لا يمكن فصلها عن حماية أرواح البشر. وأضحى تدمير الموروث الثقافي جزءا لا يتجزأ من استراتيجية عالمية للتطهير الثقافي، الذي يسعى إلى القضاء على جميع أشكال التنوع الثقافي.
إن عملية الحفاظ على التراث الثقافي من قبل الحكومات والمؤسسات سواء المحلية أو العالمية لا يعتمد فقط على توقيع اتفاقيات أو معاهدات تنص على الحفاظ عليه فحسب، بل يجب أن يكون هناك تبني واضح لعملية الحفظ، بجدية ومهنية، ويجب أن تكون هناك أُسس وخطط موضوعة لتحقيق ذلك من خلال تفعيل دور القوانين وتدريب المختصين على طرق الحفظ ونشر التوعية العلمية بأهمية الموروث الثقافي وأهمية التعاون ودعم الجهود العاملة في مسألة حفظه.
إن الحماية، بحسب النظم والأحكام الثقافية والأكاديمية السائدة في المنظمات العالمية والإقليمية والمؤسسات العلمية والثقافية، تعني العمل اللازم لتوفير الظروف الملائمة التي تساعد على بقاء عناصر الموروث الثقافي بأشكالها المختلفة والحفاظ عليها. ويستخدم هذا المفهوم عادة فيما يتعلق بالحماية المادية لمواقع الموروث الثقافي لضمان تأمينها من السرقة والتخريب والعبث.
أما الحماية القانونية التي تستند إلى التشريعات والأحكام التشريعية فهي الحماية التي تدافع وتضبط مسألة الاحتكاك والتماس المباشر وغير المباشر مع عناصر الموروث الثقافي، وضمان صونه والدفاع عنه من خلال فرض العقوبات على كل من يسيء ويتعدى على مواقعه ويعبث بها.
يمكن حصر أشكال وطرق حماية التراث الثقافي بالمحاور التالية:
1 – الحماية القانونية: وهي على ثلاثة مستويات من الحماية: المستوى الدولي، والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي، ولن تتحقق الحماية الفعالة إلا بتطبيق هذه المستويات والتنسيق بينها وتوازنها والعمل بها معا؛ ذلك لأن الموروث الثقافي بمختلف أشكاله في النهاية لا يعني هوية وحضارة دولة بعينها، بقدر ما يعني حضارة الأمة والإنسانية جمعاء.
وهذا يستدعي أن يتعاون المجتمع الدولي لحمايته وملاحقة من يقوم بتهريبه وتدميره وسرقته والإتجار به. كما ينبغي أن يغطي نطاق حفظ البلد حماية الأصول الثقافية والطبيعية التي توثق المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لجميع مستويات المجتمعات التي تشكلت وعاشت في جميع الأوقات في ذلك البلد.
2 – الحماية الإدارية: وتتمحور هذه الحماية حول طبيعة التنظيم أو الكيان الإداري المعنّي بشكلٍ رئيس بإدارة الموروث الثقافي، وما تتضمنه هذه الإدارات من إجراءات تختلف من بلدٍ إلى أخر بحسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية والمؤثرات الخارجية التي يتعرض لها كل بلد.
3 – الحماية التقنية: أسهمت التقنية الحديثة المتمثلة بالأدوات والآلات وأجهزة التحكم بالحرارة والرطوبة، وغيرها في حماية الموروث الثقافي. كما أسهمت المعلومات الإلكترونية في حفظه وبتسجيله وتوثيقه بالمعلومات والصور والفيديو وبعدة طرق، كما عملت أجهزة الإنذار والمراقبة على الحفاظ على المقتنيات من السرقة والتدمير والحرائق؛ هذا إلى جانب التقنيات العلمية الحديثة التي تستخدم في الترميم للحفاظ على الأثر واستدامته.
4 – الحماية الأمنية: وهي ترتكز على ثلاث مستويات: الدولية والإقليمية والمحلية؛ إذ لابد من وجود جهات متخصصة تقوم بالحماية من خلال إصدار أنظمة توضح العقوبات المترتبة على جرائم المساس السلبي بالموروث الثقافي.
5 – الحماية الفنية: ومن جانب أخر، إذا ما كان يتم الحفاظ على الموروث الثقافي بأنواعه، من خلال عمليات الحفظ الأصيل (preservation) أو عمليات الحفظ الممنهج والذي يعتمد على طرق علمية في الحفظ (conservation)، فكيف نستطيع إذن حماية وصون وإدارة تراث يتغير باستمرار، كالتراث الثقافي غير المادي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من «ثقافة حية» دون تشويهه أو تهميشه؟ إذ تواجه بعض عناصر التراث الثقافي غير المادي خطر الفقدان أو الاختفاء إن لم يُسرع لإنقاذها.
وتركز عملية الصون على عمليات نقل تلك العناصر أو إيصالها، من جيل إلى جيل، بدون تحريف أو تشويه. ولضمان حماية هذا النوع من التراث فإن الأمر يتطلب عمليات توثيق (Documentation) دقيقة بشكلٍ كتابي ومرئي شامل لكل أنواع الموروث الثقافي، ومنه غير المادي أيضا، لضمان عائديته وأصالته فضلا عن ضمان عدم تحريفه وإيصاله بصورته الأصلية إلى الأجيال اللاحقة.
6- الحماية الميدانية: إن أهم أنواع الحماية هي الحماية الميدانية للموروث الثقافي ومواقعه، من خلال عمليات التنقيب الآثارية، التي تُعّد عمليات حماية استباقية وقائية، تشخص وتستخرج وتوثق وتحفظ عناصر الموروث. فضلا عن عمليات الصيانة والترميم الآثارية التي تعمل على حماية عناصر الموروث الثقافي من التلف والتآكل. وقد ظهر مؤخرا تخصص علم الآثار الوقائي (Rescue Archaeology) الذي يهدف إلى استباق عمليات حفظ الموروث الثقافي وصونه قبيل حدوث خطر يهدد وجوده.
7- الحماية المتحفية: تلعب المتاحف دورا كبيرا في عملية حماية الموروث الثقافي بأنواعه، من خلال حفظه وصونه والعمل على استدامته. إذ تهيئ المتاحف أوساطا أمنة لاستقرار التراث الثقافي وعرضه بأفضل صورة إلى الجمهور، والعمل على تعزيز التوعية الخاصة بالحفاظ عليه وإتاحة فرص استدامته.
عمر جسام العزاوي / باحث في علم الآثار – العراق