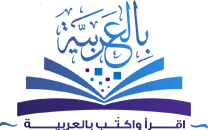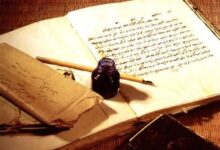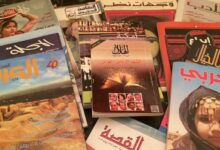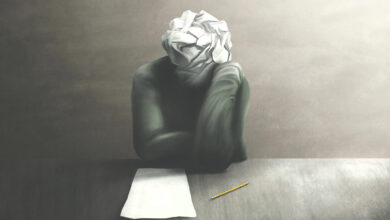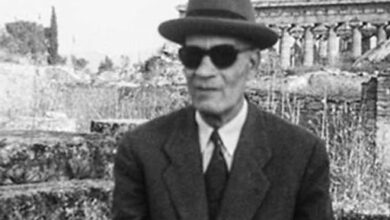محمد الخمار الكَنوني: رماد هسبريس

ذَكَّرنا الناقد إبراهيم الخطيب منذ أسبوعين بذكرى ميلاد الشاعر المغربي محمد الخمار الكَنوني، الذي مرّت عليه ثمانون عاما (1941) وبذكرى مرور ثلاثين سنة على وفاته (1991).
في غمرة جريان الزمن، وفي غفلة عنا ومنا، بتنا لا نعرف كيف تمر الأيام سراعا، ولا ننتبه إلى أنفسنا وهي تهرول في لا اتجاه.
فصرنا لا ندري كيف نتذكر موتانا، أو نوطد صلاتنا مع بعضنا، وكأن ما يجري من حولنا لا يسهم إلا في دعوتنا إلى التناسي، وممارسة التباعد الثقافي، الذي لا علاقة له مع التباعد الاجتماعي الذي فرضته الجائحة.
لا إعلام سمعي بصري أو ورقي أو إلكتروني يتذكر الأموات، أو يذكُر الأحياء، أو يوطد الصلات. لا يسعى الكل إلا إلى البحث عما يفرق، أو يعمق الجراح، وكأن في ذلك انتصارا على الزمن، وجريانا نحو اللانهاية.
ما أسهل الإعلان عن موت «الأشياء» الرمزية، وما أصعب نفث الروح في تلك الأشياء نفسها. لكننا مهما دربنا أنفسنا على النسيان، تأتي لحظات الذكرى دافقة فتكون استعادة الأشياء الذي طواها التناسي قوية وكأنها وليدة أمس.
ثلاثون سنة مرت على فراق الشاعر المغربي، تبدو لي وأنها لم تحدث إلا منذ بضعة أيام؟ وهكذا صرنا غير قادرين على حساب السنين المتباعدة إلا بالأيام القريبة. وصار لسان حالنا يقول: «لبثنا يوما أو بعض يوم».
جعلتني قراءة تذكير الخطيب مشكورا، أعود إلى بداية السبعينيات عند كنت أحترق شعرا، وأتابع كل قصيد أينما تربع على صفحة بيضاء في جريدة، أو مجلة أو ديوان.
وكان ما يصدر عن محمد الخمار الكَنوني، على ندرته، من شعر يثير التأمل، ويدعو إلى التفكير، وينتهي بالاستحسان وتقدير صوت شعري نادر ومتميز.
كان رائدا من رواد القصيدة المغربية الحديثة. كما كان يمثل مع أحمد المجاطي فرسي رهان القصيدة المغربية والعربية الحديثة، وكلما ذكرت الكَنوني، إلا واستذكرت المجاطي.
كانا يشتركان في أشياء كثيرة، فإلى جانب التوتر والقلق الإبداعيين، كانا مجددين لا يصيران على منوال، ولا يقلدان نموذجا.
كانت ثقافتهما تجمع بين القديم والجديد. أكاديميان أصيلان، ومُقلاّن حتى أنه يمكن عدهما من «عبيد الشعر». لم يصدر لكل منهما سوى ديوان واحد: «رماد هسبريس» و»الفروسية» وفي سنة واحدة (1987) وماتا معا وهما في الخمسينيات من العمر.
أحببت الرجلين على ما بينهما من اختلاف ظاهر وباطن. درّساني معا طالبا في فاس، واشتغلت معهما زميلا في الرباط. وظلت العلاقة معهما قوية والمحبة متبادلة.
حياة الكَنوني بسيطة وعادية، يبتعد كثيرا، ولا يحب الظهور.. لا يجالس إلا من يراهم جديرين بالمجالسة. يبدو لك هادئا في حديثه، ومعاملاته، لكنه كان بركانا يغلي من الداخل.
في أواسط السبعينيات تعرفت على الكَنوني، وشدني إليه بلطافته وإنسانيته النادرة، أستاذا يدرسنا العروض سنة، وفي أخرى الشعر الإسلامي. لماذا كان الأساتذة حريصين على إقحامنا في عوالمهم عكس ما يجري حاليا؟ كان رحمه الله ذا ثقافة واسعة بالقديم والحديث، وعالما بالتحقيق.
لم يدرسنا الشعر الإسلامي كما كنا نجده في كتب تاريخ الأدب، طلب من كل واحد منا قراءة أحد دواوين الشعر الإسلامي، واستخراج ما ورد فيه من مصطلحات دينية، وفضاءات، وأسماء أعلام وقبائل، وحيوانات، كان يريدنا، أن نقرأ الديوان أولا، ولكي نقرأه بشكل جيد، دفعنا إلى الوقوف على كل بيت، وكل كلمة لتصيد مفردة تدخل في نطاق ما نحن بصدد استخراجه، ووضع مسرد لكل كلمة وفق تصنيف محدد.
كانت الجدية نفسها مع المجاطي حين درسنا الشعر العربي الحديث في السنة الثانية، طلب منا عروضا حول ظواهر شعرية، وأنجزت معه عرضا حول «شاعرية العقاد» الذي كنت متحمسا له. وبعد إلقاء العرض ناقشني بروح تدل على عمق ودراية. ومنذ ذلك الوقت وعلاقتي به جيدة ودائمة.
عرفت في كل منهما تقدير الجاد والمجتهد. أتيحت لي فرص كثيرة للجلوس مع الكَنوني في مقهى في حسان، وفي مقهى السفراء في الرباط، وفي كل جلسة أكتشف مثقفا من عيار ثقيل، لكنه كان يحس بأنه لا يحظى بما يستحقه من العناية، بالمقارنة مع من هم دونه مكانة وقيمة.
أنجزت معه بحث الإجازة حول الشعر المغربي في الستينيات، وتناولت فيه الشعراء الذين لم يدرسهم منهم محمد بنيس. لم يعترض على المتن، ولا على طريقة التحليل، وأعطاني نقطة دارت حولها نقاشات، باعتراض عبد الله الطيب عليها، فطلب منهم قراءة البحث وتقويمه. هكذا كانت علاقته مع طلبته.
يبذل قصارى جهده لإفادتهم، والمحافظة على العلاقة بهم. كان في خدمة الطلبة وفي تقديم المساعدة لهم، سواء بالنصيحة، أو النقد الإيجابي، أو باقتراح المواضيع.
حياة الكَنوني بسيطة وعادية، يبتعد كثيرا، ولا يحب الظهور.. لا يجالس إلا من يراهم جديرين بالمجالسة. يبدو لك هادئا في حديثه، ومعاملاته، لكنه كان بركانا يغلي من الداخل.. يتابع بشكل جيد ما يجري في الساحة الثقافية والسياسية، وعنده رؤية ثاقبة إلى الأمور.
كان يغرد خارج السرب، ولأنه لم يكن متحزبا، ظل بعيدا عن الأضواء. إعادة قراءة «رماد هسبريس» تبين أنه «حتى هنا يمكن أن تكون شاعرا» كما قال أدونيس. فمن منكم لا يتذكر رماد هسبريس؟