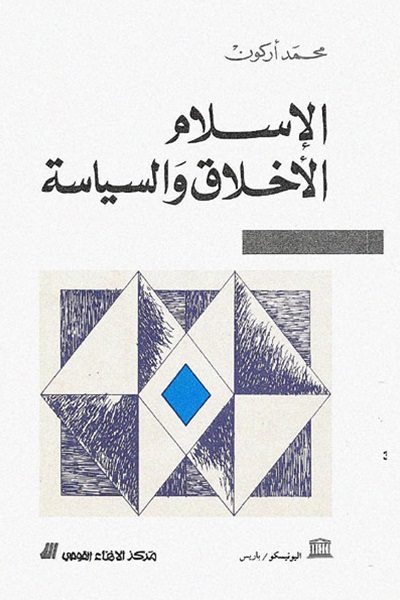حسن حنفي ورفاقه – هل يمكن التعامل مع القرآن ككتاب فكر وفلسفة؟
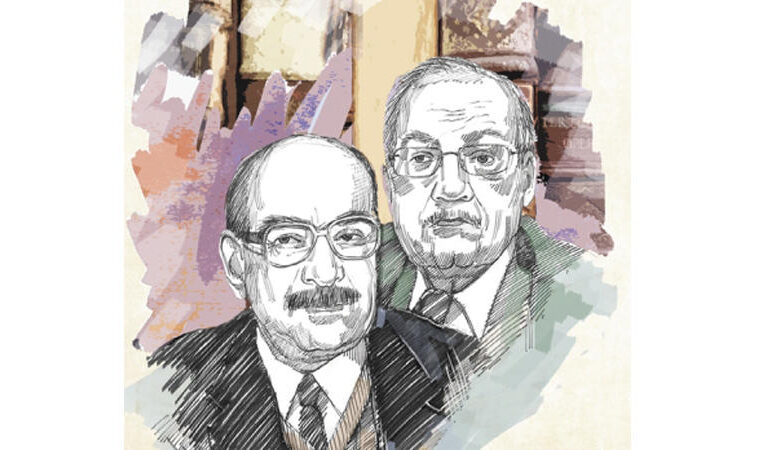
غيّب الموت، أمس الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول، المفكر المصري حسن حنفي، عن عمر ناهز 86 عامًا. ويعد حنفي أحد أبرز منظري تيار اليسار الإسلامي، وأحد رواد ما يُعرف بـ”المدرسة الفرانكفونية العربية”،
وهي تيار حداثي عربي معاصر يعمل على إعادة تأويل التراث الإسلامي باستلهام المناهج الفكرية الفرنسية، والتوسع في استخدام العقل في تفسير النصوص الشرعية واستنباط معانِ جديدة منها.
في هذا المقال، نتعرف على أهم أفكار حنفي والمدرسة الفرانكفونية، وكذلك أهم الانتقادات الموجهة إليها.
“بتنا اليوم وكأننا نشهد إعادة تقييم جذرية وشاملة تمس العناصر الجوهرية لرؤيتنا الفكرية.. لقد تم إنزال التراث من كابينة القيادة إلى قفص الاتهام!”
(إبراهيم السكران)
في أواخر القرن الثامن عشر، كانت القارة الأوروبية على موعد مع أكثر مراحلها المحورية خلال التاريخ، فقد كان للثورة الفرنسية عام 1789م وما لحقها من تغيرات جذرية في طبيعة العلاقة بين الدين والعقل، نتيجة للتداخل الوثيق السابق بين الاستبداد السياسي والسلطة الكنسية، لتدخل القارة العجوز في معترك طويل استبدلت معه الحاكم الديني بالحاكم العقلي، والذي أعاد تقنين الأمور كلها وفقا لرؤيته.
وعلى مسافة زمنية من الزلزال الفكري الأوروبي، برزت في الشرق الإسلامي مجموعة من المدارس الفكرية التي تتناول التراث بالمذهب العقلي/الحداثي ذاته القائم في الغرب، على الرغم من اختلاف السياق الذي نشأت فيه كل من الحداثة الغربية والعربية، بما في ذلك من جدلية مستمرة حول العقل والنقل وتقديم الأول على الثاني في بعض الأحيان تحت اسم التأويل.
وكانت المدرسة الفرانكفونية التي “تأسَّسَت بشكل فِعلي مع انسحاب قوَّات فرنسا”[1]، مالكة لقسم لا بأس به من هذا الجدال، على خُطى فرنسا نفسها في أوروبا، فيرى المفكر المصري حسن حنفي، بوصفه واحدا من المتوافقين مع النهج الفرانكفوني، أن “العقل يجب أن يكون مرجعية مطلقة”.
كما يشير إلى أن ابن تيمية حسم هذا الخلاف مبكرا في التاريخ الإسلامي بقوله إن “النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح” رغم ما وضعه ابن تيمية من محاذير بشأن إعمال العقل في مسائل الحديث النبوي الشريف مثلا، وتقديمها على العقل[2].
هذا التوجه (الفرانكفوري)، حسب إبراهيم صديق، قدَّم العديدَ من المشاريع في عالمنا الإسلامي؛ لإعادة قراءة نصوص الشريعة وتفريغها من مضامِينها، وإحلال معانٍ جديدة فيها[3]، أو ما يطلق عليه الباحث السعودي إبراهيم السكران فصل الكلي عن الجزئي[4]، وفيما يلي عرض موجز للنقد المُقدّم لهذه العلاقة التراثية الفرانكفونية ومنهجية تعامل الثاني مع الأول.
 المفكر المصري “حسن حنفي”
المفكر المصري “حسن حنفي”- الفرانكفونية والتراث
على مستوى التعريف، فإن الفرانكفونية تمتلك دلالات متقاربة لمصطلحها، فقد استُعملت بإحالة وصفية خالصة منذ 1880م على يد الكثير من الجغرافيين، إلا أنها في معناها البسيط والمباشر تعبّر عن المنظمة الدولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية “كلُغة رسمية، أو لغة منتشرة”[5].
وقد تأسست المنظَّمة بشكل فِعلي مع انسحاب قوَّات فرنسا، لتُمرر، حسب الباحث المغربي إدريس جنداري، أهدافَها عبر قِيم الحداثة والتنوير وأخواتها[6].
لكن، بتعريف أكثر عمقا، يرى إبراهيم السكران أن الفرانكفونية في الأصل مفهوم يُطلق على الدول الناطقة باللغة الفرنسية، غير أن استعماله قد اتسع بحيث أصبح “التزاما أيديولوجيا” لإشاعة وترويج اللغة والثقافة الفرنسيتين، فهي “تعبير عن تيار حداثي عربي معاصر يعمل على إعادة تأويل التراث الإسلامي باستلهام المناهج الفكرية الفرنسية، بما يعني تطويع الثقافة المقروءة لصالح الثقافة القارئة”[7].

الأمر الذي يؤكّده المفكر المغربي محمد عابد الجابري، بوصفه ممن ينتمون للفرانكفونية، حين يقول: “الملاحظة التي أبداها أحد الزملاء حينما قال إن الإبستمولوجيا الفرنسية حاضرة أكثر فيما كتبت، فعلا.. هذا صحيح، وهو راجع إلى عدة أسباب، ذاتية وموضوعية، فأما الأسباب الذاتية فهي أننا في المغرب مرتبطون بالثقافة الفرنسية أكثر مما نحن مرتبطون بالثقافة الأنجلوسكسونية”[8].
كما يظهر التأثّر ذاته جليا في أدبيات المفكر الجزائري محمد أركون حين يتكلم عن القصص القرآني بوصفه “بنية أسطورية”[9] على حد تعبيره، ليشرح مقصده من لفظ “أسطورة” “بأنه لا ينطلق من اللغة العربية.
بل من اللغة الفرنسية التي لا تحمّل “الأسطورة” أي دلالة سلبية، بل تُحمّلها معنى مفاده: الخيال المجازي الخلاق الجميل، الذي يعمر الأذهان ويُشكّل مخيالهم الجماعي، المليء بالصور الزاهية عن فترة معينة، كفترة الرسول عليه الصلاة والسلام”[10].
فهو هنا يستبعد الدلالة العربية لمصطلح “الأسطورة” في التعامل مع القرآن، والذي يحمل في طياته دلالة سلبية مفادها: حكايات قديمة ذات طابع خرافي”[11]، ويستبدلها بالأداة الفرنسية في التعبير، بما يُبرز السؤال حول تناسب أداة لغوية غريبة عن النص الأصلي لتأويله أو التعامل معه.
خاصة مع قول أركون أيضا في موضع آخر: “المنهجيات التي أطبقها على التراث العربي الإسلامي هي المنهجيات نفسها التي يطبقها علماء فرنسا على تراثهم اللاتيني المسيحي أو الأوروبي”[12].
فأركون هنا، كنموذج على المدرسة الفرانكفونية، يُظهر إشكالية تناولها العديد ممن رصدوها بالنقد والتمحيص، وهي التعامل مع التراث الشرعي الإسلامي بأدوات حداثية غربية دخيلة على تحليله، فيرى الباحث خالد السيف.
على سبيل المثال، أن الخلاف مع من يتبنّون هذا المنهج في التأويل التراثي “خلاف في المقدمات قبل أن يكون خلافا في النتائج”[13]، فليست الأزمة في تعبير أركون الإيجابي عن “البنية الأسطورية” (النتائج)، وإنما -حسب مقولة السيف- الأزمة في استعمال كلمة “أسطورة” نفسها في حديثه عن القصص القرآني (المقدمات)، فكيف يمكن فهم كتاب عربي مبين بكلمة عربية ذات دلالة فرنسية؟
- بين المنهج والتأويل
 المفكر الجزائري محمد أركون (مواقع التواصل)
المفكر الجزائري محمد أركون (مواقع التواصل)في كتابه “جوهر الإسلام”، يرصد المفكر المصري محمد سعيد العشماوي هذا النسق الفرانكفوني في التعامل مع العلوم الشرعية، فيقول إن عددا من المفكرين العرب ممن تمذهبوا بالفرانكفونية في مجال قراءة التراث، أمثال محمد الجابري، وعبد المجيد الشرفي، وحسن حنفي، وأركون.
قد تبنوا محاولة لتغيير فهم النصوص الشرعية على نحو إنساني/عقلاني حتى آل الأمر، وفقا للعشماوي، إلى التعامل مع الشريعة كروح خالية من الأحكام (ثنائية الكلي والجزئي عند السكران).
وقد نرى ما عبّر عنه العشماوي ظاهرا بشكل كبير في قول الجابري: “نادَيْنا منذ الثمانينيات من القرن الماضي بضرورة استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفِكر العربي وتعويضه بشعارَي: الديمقراطية، والعقلانية”[14]، وهو ما أثار، على الجانب الآخر، النقد الشديد عند السكران لتلك المنهجية العقلانية/الحداثية في التعامل مع التراث، أو أنسنته إذا شئنا التدقيق.
فيقول إن “المدرسة الفرانكفونية/المغاربية أعادت تشكيل منطقها تماما، وأعادت صياغة نمط تفكيرها وطريقة تعاطيها للأمور وأسلوب نظرها للوقائع وتقييمها للأحداث، من خلال امتصاص أدواتها الخاصة للقراءة والتفسير والملاحظة، وإعادة ترتيب الهرم الداخلي للقيم، وإعادة رسم الجدول الذهني للأولويات”[15].
من هذا المدخل، عرج الباحث خالد السيف[16] في رسالته للدكتوراه على تحليل تلك الظاهرة التأويلية الحداثية، مشيرا إلى التطور الحادث في مفهوم التأويل، بداية من الهرمنيوطيقا التي ارتبطت نشأتها بالنصوص المقدسة المسيحية، فيسرد التتبع الفلسفي الذي انتهجه مفسرو التراث إنسانيا، أو ما يمكن تسميته بتتابع المراحل الثلاث: مرحلة المؤلف، ومرحلة النص، ومرحلة القارئ[17].

بداية من التناص الذي يتعامل مع النص بوصفه نتيجة لمجموعة من النصوص المتداخلة، وهي مرحلة المؤلف “التي يتم التركيز فيها على خلفيات النص وسياقه الذي يتحرك فيه”[18]، ثم البنيوية التي تذهب لموت المؤلف وتحليل بنية النص بعزله عن أي نسق تاريخي أو اجتماعي.
وهي مرحلة النص، وانتهاء بالتفكيكية التي تهدف إلى إيجاد فجوة بين النص وما يخفيه، فلا يمكن فيها أن يتوصل لقراءة نهائية، فكل تأويل هو مادة بحد ذاته لأن يوضع فوق المشرحة[19].
ويقوم مشروع أركون النقدي، كنموذج فرانكفوني عربي، “على تطبيق الأدوات والمفاهيم النقدية الغربية المعاصرة على الدين والتراث والإسلامي، والغاية التي يهدف إليها عبر مشروعه هي: إعادة صياغة التراث الإسلامي بصورة تسمح باندماج المسلم المعاصر في فضاءات الحداثة الغربية”[20]، كما يتمحور مشروعه في علمنة الإسلام، على حد تعبير عماد الدين إبراهيم، عبر مسعيين اثنين.
أولهما يتمثل في فصل الإسلام عن الحياة الاجتماعية، وثانيهما، كما ورد في كتابه “الفكر العربي”، يتمركز حول التعامل مع التراث “وفق آليات جديدة، هي ما انتهى إليه العقل الغربي من أدوات، كاللسانيات والعلوم النفسية والاجتماعية والأنثروبولوجية، وقراءة النصوص الدينية على هديها، باعتبارها وحدها هي القادرة على تجاوز الشحنة العاطفية من جهة والمقدس من جهة ثانية لتتناول الموروث الديني بغير خلفيات مهما كانت”[21].
- أنسنة التراث وتبديل المركزية
يمكن تعريف الأنسنة، كمفهوم متفجر نتيجة لعصر النهضة الأوروبي، على أنه وضع للإنسان كمقياس للأشياء، أو “كما يعلق كرين برينتون أن الإنسانيين هم الذين آمنوا بأن الإنسان معيار كل شيء، وأن كل إنسان معيار ذاته. أما جورج هيدلي فيعتبر الأنسنة في حقيقتها استبعادا للتفسيرات التي تقدمها أديان الوحي، والنظر إليها كونها ضربا من الأوهام، أي إننا يمكننا قراءة النصوص المقدسة قراءة رمزية إنسانية”[22].

وبالتقاطع بين هذا المفهوم والتراث الإسلامي، فإن التفسير الإنساني للتراث يمكن فهمه على أنه “إعادة تفسير التراث وولادة مفاهيمه الجوهرية، وحراكها الداخلي، تفسيرا تستبعد فيه أي دوافع أخلاقية أو دينية أو قناعات ذاتية، ويبحث فيه عن الدوافع المادية -سواء كانت سياسية، أم اقتصادية، أم عرقية، أم غيرها- عبر التوسل بالجهاز المفاهيمي الأنثروبولوجي تحت شعار التسلح بأدوات العلوم الإنسانية”[23].
بمعنى أن تُفسر تشكلات الصراع على أنها مدفوعة بصراع سلطوي سيادي، جماهيري، أو أغراض اقتصادية، وهو ما يراه السكران، أي قراءة نصوص الوحي والتراث قراءة مدنية، تحويلا للوحي من حاكم على الحضارة إلى مجرد محامٍ عن منتجاتها يبررها ويُرافع عنها ولا يُقبل منه غير ذلك![24].
ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك في المدرسة الفرانكفونية هو مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، إذ يقول الباحث المغربي يوسف هريمة إن الجابري أكد على نقطتين أساسيتين، “أولاهما ضرورة القطيعة مع الفهم القائم للتراث، وليس مع التراث ذاته.
وهذا يعني إعمال العقل والنقد. كما أكد ثانيا على ضرورة الفصل بين القارئ العربي وتراثه، أي أن ينظر القارئ إلى التراث بموضوعية وعقلانية وتاريخية من خلال المكتسبات المنهجية للعلوم المعاصرة”[25].
ونرى على النهج ذاته محمد أركون من خلال مشروعه في قراءة التراث بأدوات العلوم الإنسانية، إذ يذكر في كتابه “الإسلام.. الأخلاق والسياسة” أن أحد أهداف مشروعه النقدي “تأسيس نظرية جديدة في التعامل مع التراث تقوم على نقد بنيته التكوينية وآلياته المعيارية، ثم إخضاعه للنموذجية الغربية في التفكير”[26].
وكذا هدف مشروعه النقدي لبناء “إسلاميات تطبيقية” عن طريق تطبيق المنهجيات العلمية على القرآن الكريم، كتلك التي طُبِّقت على النصوص المسيحية، وهي التي أخضعت النص الديني لمحك النقد التاريخي المقارن والتحليل اللساني التفكيكي”[27].
كما يرى نصر حامد أبو زيد، كواحد من المتأثرين بالفرانكفونية، أن الهيرمنيوطيقيا/إعادة تأويل النصوص عبارة عن “نقطة بدء أصيلة للنظر إلى علاقة المُفسر بالنص لا في النصوص الأدبية وحسب، بل في إعادة النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرآن”[28].
في النهاية، قد يرى البعض أن أحدا من المفكرين السابقين “لا يدعو لنقد الدين ذاته، وإنما يركزون على إشكالية التأويل والعقلانية في مواجهة النقل، بخصوص ما يتعلق بنصوص الشرع”[29].
لكن السكران يجد، من خلال عمله النقدي “مآلات الخطاب المدني”، أن هذا الخطاب قد تحول إلى “صورة تلفيقية باهتة تعاني في تركيبها الداخلي من هشاشة معرفية عميقة نتيجة كونها تعتمد على الانتقائية والتغييب دون منهجية أو معايير واضحة يمكن التحاكم إليها”.
بمعنى أنها أصبحت “خليطا من النتائج القابلة لإثبات العكس”[30]، كما حدث بشكل مكثف فيما يختص بتقنيتي التسييس والتوفيد اللتين سبق وأن تناولهما هو نفسه في كتابه “التأويل الحداثي للتراث”، ويمكن الرجوع إليهما في تقريرنا السابق (التأويل الحداثي للتراث الإسلامي.. كيف خلعوه عن سياقه؟)، كمثالين لاستعمال التقنيات الغربية في تأويل التراث ونتيجتها.