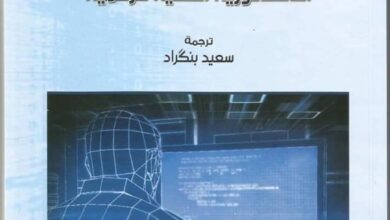جمع بصيغة المفرد: قراءة في ألبوم “مغاربة” لداود أولاد السيد

سنقدم في هذا الفصل قراءة سميولوجية لمجموعة من الصور التي يشتمل عليها ألبوم فوتوغرافي من إنجاز مصور فوتوغرافي مغربي معروف هو داود أولاد السيد، وسنتعامل مع هذا الألبوم باعتباره يشكل وحدة منسجمة لها امتدادات في ذاتها من خلال عناصرها المكونة، وهو بذلك يشتغل كنص يحيل، كما تحيل كل النصوص، على كون أو أكوان دلالية محدودة في الزمان وفي المكان.
والتحليل الذي سنقدمه هنا ليس كليا ولا نهائيا، ولا يمكن أن يكون كذلك في جميع الأحوال، إنه نتاج زاوية نظر معينة، أو هو نتاج فرضية مسبقة للقراءة قادتنا إلى عزل سيرورة ضمن سيرورات أخرى يشتمل عليها الألبوم بالتأكيد، والتعامل معها باعتبارها النبراس الذي سيقودنا إلى خلاصات بعينها.
فتنظيم العناصر الأيقونية والتشكيلية وفق هذه الفرضية هو الذي يبرر النمط التأويلي الذي انتهجناه في استنطاق مكنون الصور، وهو الذي يفسر الخلاصات الدلالية التي وصلنا إليها في نهاية التحليل.
- 1 – ” مغاربة “: جمع بصيغة المفرد
فلقد بدأت أتأمل هذه الصور بكثير من الحذر والريبة، فهي قد تحولت من خلال “حجم الكتاب” *ومن خلال ” العنوان” و”الناشر” و”التقديم” إلى نص يحيل بالضرورة والاحتمال والتواضع على كون دلالي بالإمكان رسم معالمه وتحديد عمقه وامتداده.
وكل شيء كان يدعو إلى ذلك، فالأمر لا يتعلق بصورة أو صور معزولة لا رابط بينها، بل هو “ألبوم ” في صيغة كتاب يروي، عبر ” معجزات ” الآلة، ” لحظات حضارية ” في حياة هذا الشعب، كما يدل على ذلك عنوان الألبوم: مغاربة.
هؤلاء مغاربة، قد يتعلق الأمر بكل المغاربة أو بجلهم أو ببعضهم فهذا لا يهم، فالأهم هو ما تحيل عليه التسمية. والتسمية – في جميع الحالات – تعيين وتحديد وتمييز وميثاق وانتماء: انتماء إلى الفصيلة والأرض والزمن والتاريخ والقيم.
فهذا العنوان هوالمدخل وهو الموحد، وهو الضمانة الأساس على تناسق وانسجام هذا الكون الذي ترسمه عدسة الفنان وعينه. مغاربة، إنه عنوان ووصف وتعريف:
– إنه عنوان، وكل عنوان حكم، أي زاوية نظر تلخص المعطيات الموصوفة في الألبوم، وتوجه وترسي قواعد للقراءة والتأويل وإنتاج المعاني.
– وهو أيضا وثانيا وصف، إنه يصف، أي ينشر – عبر عرض “موضوعي ومحايد” – معرفة تتصل بأشياء وفضاءات وكائنات في أوضاع وحالات متنوعة: “هؤلاء نحن” ، وتلك “أراضينا وجبالنا” وتلك “وجوه مألوفة لدينا”.
– وهو ثالثا تعريف، والتعريف تقليص لزاوية النظر، فمنه ينبثق التحديد والتخصيص. وكل “عنوان “يروم الكشف عن دلالات صاغ التاريخ و”النص الثقافي” حدودها ومعالمها. فلا “شيء” في الألبوم يدل من تلقاء ذاته، ولا شخصية تحيل، من خلال ملامحها أو لباسها أو أشيائها، على كون يخص هويتها في تفردها. فتلك الوجوه والنظرات هنا لكي تدل على انتماء لأرض ووطن وتاريخ.
تلك كانت بعض المداخل الأولى التي يثيرها العنوان منذ اللحظة الأولى، وفي ضوئها نلج عالم “الألبوم”. فنحن لا نكتشف داخل هذا الألبوم صورا وأشياء ممزوجة بالحزن والحنين والاندهاش فحسب، بل نتوق، عبر هذه الوجوه والأشياء والفضاءات إلى الإمساك ب “الأنا” المجردة فيما تقدمه “الأنا” المصورة.
فهذا “القول البصري” ليس مباشرا ولا عفويا ولا محايدا، إنه يشيد نفسه في مقول منسجم ومتماسك من خلال إحالاته الثقافية المباشرة منها وغير المباشرة. فلا وجود لمعطى من معطيات الألبوم قادر على التدليل استنادا إلى عناصره الذاتية، إنه يقوم بذلك من خلال العالم المتخيل الذي تحيل عليه هذه الصور مجتمعة: إن الأشياء المحسوسة.
وكذا الوجوه وأجساد النساء والرجال والنظرات قد تنازلت عن عمقها الفردي (تنازلت عما يميزها) في أفق بناء هُوية جماعية هي أقرب ما تكون إلى النموذج التمثيلي العام الذي يقوم بتجسيد “حالة حضارية” لأمة أو شعب: نمط خاص في العيش .. طريقة في اللباس وفي الأكل وفي التعاطي مع ” وافد الحضارة ” الجديد من أشياء (السيارات، والدراجات والطرق المعبدة، وأشياء كثيرة للترفيه: السيرك والصور….)، ومن تنظيم للفضاء (المنازل ونوافذها وسياجها والبحر والاستحمام …) .
إن ما تلتقطه آلة الفنان ليس ” كشفا للظاهر” ولا هو وعي خارجي مجسد في كائنات تدب في الأرض منتشية بتفردها وخصوصيتها في الوجود. إن هذا الوصف الخارجي للوجوه والأشياء والحالات الحياتية يفقد قوته التخصيصية بمجرد ما يقيد ويوضع تحت لواء تسمية (عنوان) تتحول – بقوة ميثاق التلقي ومنطقه- إلى مفتاح لفهم وتأويل كل المعطيات التي تحبل بها الصور.
فهؤلاء ” الأطفال المزهوون بلعبهم” (ص 46)، وتلك “المرأة المكبلة بالملابس والرزم ونظرات الرجال”، (ص 70 – ص – 25…) وتلك “النساء المحشوات داخل ثوب أسود ويسرن في دروب لا نهاية لها ويدرن ظهورهن للحياة ” (ص 25)، كل هذه العناصر (أو هذه الصور) ليست سوى ممر مجسد نحو خلق عوالم تتجاوز، في إحالاتها الرمزية، المعطىات المحسوسة وتعطل قوتها التمييزية، لاستشراف المجرد والغريب والمدهش.
وربما يتعلق الأمر هنا أيضا بصور تنسج، بطريقتها الخاصة، > حكايات ذاكرة حية مليئة بالوقائع والمآثر والبصمات < كما جاء في التقديم الذي خص به عبد الكبير الخطيبي هذا الألبوم.
فأين تقع الفواصل بين “الظاهر” و”الباطن” في الصورة، وما الرابط بين المعطى المرئي والموحى به ؟ ومن أين تستمد اللقطة – المحدودة في الزمان وفي المكان – قدرتها على تجاوز موضوعها في اتجاه خلق سلسلة من الحالات ” الثقافية ” الخاصة بمجموعة اجتماعية – ثقافية بعينها ؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة -استنادا إلى تصورنا لفعل التدليل وطبيعته – هي السبيل إلى ولوج عالم الألبوم والكشف عن أسراره.
وبالإمكان فعل ذلك من خلال البحث عن معادلات مشخصة للاختيارات الثيمية والفنية الضمنية لدى هذا الفنان. فالقراءة المتأنية لعناصرالألبوم (الصور) هي وحدها الكفيلة بتحديد الوحدات الدلالية التي بإمكانها السير بنا في اتجاه بناء عالم دلالي منسجم يوحد بين كل معطيات الألبوم.
- 2 – ذات للتصوير وأخرى للتجريد
إن عين الفنان تنتقي موضوعاتها، و”الصورة تولد لحظة التحام النظرة بالعالم ” (1). فهذه العين تبني نظرتها انطلاقا من قاموس إيقونوغرافي (2) به تهتدي ووفقه تنتقي موضوعاتها ووضْعاتها (poses) وزواياها.
إن كل ما يمكن أن يتجسد من خلال هذا الشكل، أو من خلال تلك الوضعة أو من خلال زاوية ما لن يكون سوى تحيين لهذا القاموس الذي يكثف داخله مجموع التمثلات البصرية التي تختزنها الذاكرة وتحتمي بها درءً للذوبان والضياع وفقدان الذات. ذاك هو نبراس الفنان وهذا ما تؤكده مجموع الصور. وهو أيضا السبيل إلى فهم اختيارات اولاد السيد الثيمية والفنية على حد سواء.
فبما أن اللقطة وطبيعتها ودلالاتها تستند إلى المسافة القائمة بين العدسة والموضوع الممثل لكي تنتج عالمها الخاص، فإن البحث عن دلالات هذا الاختيار لا يمكن أن يتم إلا من خلال تحديد حجم هذه المسافة ذاتها. فعلى أساسها سيتم استيعاب دلالات “الأشكال” و”الخطوط” و” الوضعات” و” التأطير” و” زاوية النظر “. فالتركيب هو صيغة من صيغ إعداد المساحة القابلة لاستيعاب معطيات الصورة عبر أشكال خاصة من التأطير.
وبناء عليه، فإن الذهاب بالصورة في اتجاه خلق حالة إنسانية (3) بقيم وإيحاءات ثقافية خاصة، كما هو الحال في الألبوم، هو الذي يفسر الغياب الذي يكاد يكون كليا لأي تأطير يجعل من الوجه المفرد أو الجسد المفرد محورا للعدسة والعين المشاهدة. وهذا له أكثر من معنى.
ف” التأطير المحوري” (cadrage axial) بدلالاته الخاصة يقود النظرة إلى الالتحام بموضوعها ضمن علاقة حميمية تركز على موضوعها وتقصي من المشهد كل ما يحيط به، استنادا – في غالب الأحيان -إلى كل الإيحاءات الخاصة بالوضعة المواجهة.
” فهذه الوضعة تقوض دعائم فضاء التمثيل لكي تقيم علاقة تبادل إنساني: إنها “أنا” تتوجه إلى “أنت” ضمن علاقة يحكمها التفوق والسلطوية “(4). ففي هذه الحالة تأتي الخصوصية، على غرار ما يحدث في الصورة الإشهارية، من الموضوع المبأر وخصائصه وليس من العلاقات والروابط التي ترسي عناصر هويته.
قد يكون هذا الغياب مبررا، وقد لا يكون القصد، هنا، سيئا، إلا أن الاستعاضة عن اختيار باختيار آخر يخالفه في الآثار والتمثيل، لا يمكن أن يكون بريئا، ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى خلق كون دلالي مختلف عما يولده الاختيار الأول.
فإذا كان ” المنظور” يأتي دائما إلى الصورة وفق ما يشتهيه الناظر، أي وفق استراتيجية إيقونوغرافية ضمنية أو صريحة، فإن اختيار هذا الشكل الفني أو ذاك لا يمكن أن يخرج عن متطلبات الثيمي. وفي الحالة التي نحن بصددها كان اللجوء إلى التأطير المقطعي (cadrage séquentiel) من أجل تجاوز كل ما يمكن أن يقود إلى الخصوصية في التمثيل والعرض.
ذلك أن هذا النوع من التأطير يتميز بقدرته على خلق حركة في العين وفي النظرة والإدراك. حينها تتحرر العين من قيود الموضوع الممثل وحرفيته. فالنظرة، في هذه الحالة، لا يستوقفها الشيء ولا يأسرها الوجه ولا الجسد في كليته، إنها تجوب الفضاء الممثل في الصورة وفق حركة انسيابية تقود من نقطة بدئية إلى أخرى نهائية وفق تسلسل يفرضه نظام الصورة وتركيبها.
وهو ما يعني أن الصورة، في هذا النوع من التأطير، تستهويها العلاقات أكثر مما يستهويها العنصر المفرد، وتشدها الروابط بين الموضوعات الممثلة، ولا تكاد تلقي بالا لما يعزل ويفصل ويخصص.
إن هذه الحركة – أو النفس القصصي كما سنرى لاحقا – المتولدة عن هذا النوع من التأطير هي ما يميز فضاء التمثيل وكذا الأشياء الممثلة داخله. فالعالم الموصوف في الصورة عالم لا يكف عن الحركة، وكل شيء داخله يوحي بذلك.
إنها حركة آلية أولا. إنها مجسدة في السيارات والحافلات والدراجات والزوارق الخ … فكل هذه العناصر الميكانيكية الأصل تحتوي في داخلها على إيحاءات تشد الرائي إلى فعل التنقل في الفضاء. ومجسدة كذلك في الوجوه والأجساد العابرة للطرقات أوالمتسكعة في الدروب الضيقة أو المستحمة في البحر.
استنادا إلى هذا، فإن التركيب الداخلي للملفوظ البصري يقصي الوجه المفرد ولا يمنحه أي امتياز خاص. إن حضور الوجه ومعه النظرة وأشكال الجسد حضور مشروط بعلاقات تستوعبه وتستوعب انفعالاته. وكل صورة تحيل على علاقات في غاية التنوع، فهي تمس:
– علاقته بأشيائه: (الأهالي والسيارات، الأهالي والحافلات والزورق…).
– علاقته بنظيره: العلاقات الإنسانية الممكنة: علاقة المرأة بالرجل، علاقة الكبير بالصغير، علاقة الرجل بالرجل.
– علاقته بفضائه: الفضاء العائلي والفضاء العام، فضاء العلاقات الخاصة وفضاء التواصل الاجتماعي.
إن الأمر يتعلق ببساطة بمحاولة استجلاء ” الحالة الإنسانية” التي يتوق إليها اولاد السيد من خلال رسم حدود “الإنساني” فيما يحيط به. وهذا معناه أن استيعاب الطاقة التعبيرية للقطة يتم من خلال نشر الانفعال الذي يختزنه الجسد الإنساني في الوجوه المصاحبة له، أو في الأشياء التي تؤثث كون الصورة.
وفي الحالة الأولى كما في الحالة الثانية، فإن العين لا تقوم بعملية رصد ثابت للأشياء، بل تؤلف العلاقات وتنسج الروابط وتوصل المرئي بالمتواري، وتقرأ المحتمل في المتحقق.
وهذا ما يدرك من عملية التأطير وانعكاساته. فالتأطير يخرج في أحيان كثيرة، عن ” ضوابطه” و” تقنياته” ليخلق حالة تواصلية تربط” الداخل” ب”الخارج” . فالألبوم حافل بالصور التي تقدم كونا “مكتظا” بالكائنات والأشياء التي تغطي المساحة الممثلة فيما يشبه الاقتطاع الاعتباطي لما مُثِّل داخل الصورة ولما بقي خارجها.
وبهذا تنمحي الحدود والفواصل بين ما يوجد داخل الإطار وما يوجد خارجه. وربما يعود هذا “الخرق” إلى الرغبة في التعبير عن عملية اختراق اللحظة “العرضية” للمتصل الزمني ” الثابت “.
وهذا ما يدفعنا إلى القول إن اولاد السيد كان يعرف بالضبط جوهر ما هو مقبل على إنجازه. لقد كان يشتغل وفق تصور محدد ودقيق وواضح. وضمن هذا الاختيار الفني بلور رؤاه الثيمية وصاغ تصوره لما يسميه ب “الإنساني” ومحيطه. إنه لم يحفل بما يمكن أن تمنحه قسمات وجه أوتثيره تضاريس جسد أو انفعالات نظرة.
لقد كان همه منذ البداية هو تقديم ” مواقف” و”حالات” خاصة ب”المغاربة” . وكان عليه أن ينتقي وأن يقصي، أن يضم وأن يحذف. وكان عليه – من أجل الوصول إلى ذلك – أن يبني موضوعه ضمن اختيار لا يقبل التعدد ولا يقود إلى تشويش اللقطة.
فلكي يحافظ على ” سلامة ” الصورة و”نقائها” وصولا بها إلى أقصى درجات التمثيلية، كان عليه أن يختار، أي أن يقوم بإرساء قواعد للانتقاء. قواعد ستقوده إلى تأسيس تناظر كلي منه تنطلق كل الممكنات التدليلية وإليه تعود.
وتجسد الاختيار الأول في الانتقاء الصارم والعنيف، والاستفزازي أحيانا، لوجوه وأشياء وفضاءات خاصة خدمة لاستراتيجية بعينها (الصورة الأولى التي تتصدر الألبوم تمثل منظرا عاما لمدينة فاس معطى في الواجهة الخلفية للصورة، في حين يتصدر الصورة قطيع من الماعز فوق هضبة في حالة فرار من شيء أو يبحث عن كلأ أو ماء …
وينتهي الألبوم بصورة تمثل لفضاء عدواني خال من أي وجود إنساني: لا كائنات ولا أشجار ولا عشب ولا ماء). إنها استراتيجية تبحث عن وجوه وأشياء وكائنات تنمو خارج الفضاء المألوف للعين ” الحديثة “. وراحت عينه وآلته تبحثان عن “الفضاء البكر” وعن ” الجيوب ” التي لم يكتسحها بعد التمدن العميق أو المصطنع على حد سواء.
وبديهي أن يكون الانتقاء إقصاء أيضا، فأن تنتقي معناه أن تحذف، وأن تقذف بأشياء إلي الأمام وتدفع بأخرى إلى التراجع إلى الخلف، أي إلى خارج الإطار. ولذلك لا يمكن لوجود الحد الأول (الانتقاء) أن يستقيم دون وجود الحد الثاني (الإقصاء). بل يمكن القول إن وجود أي كون دلالي منسجم ومحكوم بغاية تفصل بين أوله وآخره لا يمكن أن يتأسس إلا انطلاقا من لعبة الاقصاء والانتقاء هذه.
من زاوية النظر هذه يقدم لنا داوود اولاد السيد “أشكاله” و”أشياءه” و”أجساده ” و”وجوهه”: صورا لوجوه ليست كالوجوه ولا تحيل على وجوه بعينها. إن صورة الوجه، و” الوجه ميزة للإنسان وحده ” (D . Le breton) (5)، ليست – في هذا الألبوم – تمجيدا للفرد ولا احتفاء به ولا إعلاء لهويته الخاصة. إن الفرد غائب والنوع حاضر.
لذلك فهذه الوجوه تحيل على “الوجه الممكن”، أي وجه يخص “النوع”: نوع بلورته الجغرافيا والمناخ والتاريخ والثقافة أيضا. إن إلغاء النسخة لصالح النوع هو إلغاء للهوية الفردية لصالح الهوية الجماعية: من سيسأل عن أسماء تلك النساء وعن أسماء هؤلاء الرجال؟ ومن سيسأل عن محل سكناهم وعن ماضيهم وحاضرهم ؟
ألا يمكن القول في هذه الحالة إن البحث عن ” مغرب الأعماق ” هوالذي قاده إلى الانتقاء القطعي: انتقاء “الجماعي” على حساب “الفردي” و”العام” على حساب “الخاص” و”الشعبي” على حساب “العصري”؟ بلى، وربما لهذا السبب، نادرا ما نعثرعلى صورة يتم التركيز فيها على وجه لرجل أو لامرأة ضمن شروط تحقق لهذه المرأة تفردها، أو تصوغ “بورتريه” مستقلا بذاته ومفصولا عما يحيط به.
ولهذا الاختيار ما يبرره. فالسنن الذي يستند إليه من إجل إنتاج دلالاته يأبى ذلك ويرفضه. فعوض الفرد كانت هناك الجماعة، وعوض الفضاء الخاص تم تثمين الفضاء العمومي، وعوض اللقطة الكبيرة كان اللجوء إلى اللقطة العامة.
وحتى عندما حدث ذلك، وتم التقاط صورة لشخص واحد (وكان الوجه وجه امرأة، ولهذا دلالته أيضا)، كان الناتج عكس النية. فعوض أن تثير هذه المرأة حولها اهتماما خاصا، تحولت إلى ذريعة للغوص في أعماق أشياء تفوقها قوة وعمقا وتأثيرا.
لقد قدمت لنا الصورة، ضدا على “تقاليد” البورتريه ومقتضياته – وجها ضائعا ومذعورا ومثقلا برزمة تغطي الرأس، والعينان كانتا مفتوحتين دهشة واستغرابا من هذا الزائر الذي يصطاد الصور. لقد قدم لنا من خلال هذه اللقطة وجها يستوعبه فضاء لا حدود له: الرمال والشمس وطريق وعر ولا هوية له سوى أنه أخدود في وجه صحراء كبيرة لا ترحم.
ونعثر على نفس الشيء في صورة أخرى (الصورة رقم 23)، رغم اختلاف عناصر التمثيل. حيث يقدم لنا الألبوم صورة – عبر لقطة عامة -لفضاء واسع يتحرك داخله عجوز – كما يتبين ذلك من الهيئة العامة لجسده- يركب دراجة هوائية، ولا نتبين من ملامحه وقسمات وجهه ونطراته أي شيء.
ففي غياب لقطة قريبة تفصح عن هوية الوجه والملامح، يكون الأدعى للتأمل ليس الوجود الإنساني في ذاته، بل الفضاء الذي يستوعب هذا الوجود. فالسور والنخيل والمظهر الطيني للكون وسكون لا يقطعه أي شيء وعجوز يبدو من بعيد، أقرب إلى النفس من قسمات وجه أو نظرة حزن على محيا.
تلك بعض النماذج التي توضح اختيارات هذا الفنان الثيمية والفنية على حد سواء. فماذا يعني هذا الاختيار وما هي نتائجه، وإلى أي شيء سيقود إقصاء الوجه وخصوصيته: ما يعود إلى النظرة وشكل الجسد وقسمات الوجه ؟.
لقد أُريد لهذه الوجوه – التي هي من طبيعة كونية (والوجه في جميع الثقافات والسياقات بوابة للجسد وخزان لانفعالاته) – أن تكون سندا لمضامين “محلية” تبلورت داخل نظام ثقافي خاص. فما كان للصورة أن تولد خارج هذا النظام وخارج إرغاماته. لقد تم كل شيء وفق معاييره. فمن خلاله تأتي القراءة ويأتي التأويل ويتم الكشف عن الرمزي والموحى به والمشار إليه.
ومن خلاله أيضا يتم توزيع كل ما يؤثث فضاء الصورة. فلا وجود للوجه المستقل بذاته، فكل نظرة وكل وضعة إنما تتم انطلاقا من وجود ” شيء ما ” أو “وجه ما” أو “فضاء ما” يسند دلالات هذه الوضعة. ولا وجود للشيء إلا في حدود ارتباطه بنظرة أو وضعة تبرر وجوده. وفي هذه الحالة فإن الصورة لا تصف الأشياء ولا الوجوه ولكنها تحتفي بالعلاقات الموجودة بينهما.
وكان الاختيار الثاني استجابة لإرغامات الاختيار الأول: فمن أجل الوصول إلى رسم حدود هذا المضمون، لم يكن هناك بد من القيام بمسح للذاكرة الجماعية وتنقيتها من كل العناصر التي قد تشوش على تقديم صورة مثلى لعالم ” غفل ” لم تلوثه بعد “الحداثة” و”التمدن”وكل ” موبقات ” العصر الحديث.
إن التخلص من هذه العناصر والاحتفاظ ب” جوهر أصلي ” لهذا العالم يستدعي تخليص الصورة من كل معوقاتها الداخلية والخروج بها من دائرة أنماط بعينها للتدليل إلى ما يستجيب لمضمون مسبق تختزنه العين وتبحث له عن منفذ في أشياء ووجوه بعينها.
ولهذا كان على الصورة أن تتجنب التمثيل المباشر لكل عنصر من الممكن أن يثير حوله اهتماما خاصا. استنادا إلى هذا، فإن الخطاب الخاص يجب أن يخلي السبيل أمام القصة العامة، وعلى الجماعي أن يتقدم على الفردي. وهذا ما سنحاول توضيح أمره في الفقرات التالية.
- 3- المشهد السردي وانسياب النظرة
في ضوء الملاحظات السابقة يمكن فهم واستيعاب ما يقدمه الألبوم، وفي ضوئها أيضا يجب النظر إلى العنوان ووضعه ضمن خانته الطبيعية: إن الأمر يتعلق ب محدد أولي يقوم بتثبيت المتغير ضمن المطلق الزمني. ففي احتفائنا بالمتحقق العيني (صور لمغاربة من كل أصقاع الوطن) نكون في واقع الأمر ننسج خيوط ” صورة ” (بالمفهوم المزدوج للكلمة: الذهني والبصري) توحدنا إن لم يكن ذلك أمام أنفسنا فليكن ذلك إذن أمام الآخر.
أويتعلق الأمر بطريقة أخرى للقول إننا أمام رغبة دفينة في احتلال موقع ما داخل الذاكرة البصرية التي تعج بها رفوف التاريخ، إنها وجوه أخرى تضاف إلى الوجوه السابقة ضمن فضاء هو نفس الفضاء القديم ولكن ضمن شروط جديدة هذه المرة.
ألا يمكن القول إذن إن كل صورة هي في الأصل حكاية تختفي في ثنايا ما يؤثث هذه الصورة ويشكل وحدتها ؟ وإن كل نظرة وكل وضعة وكل حركة إنما هي ” ممكن سردي” قابل للتحقق فيما يمكن أن تنجزه عين الرائي (المشاهد) ؟ بلى، إن الأمر يتعلق بتكثيف عميق وعنيف أحيانا، لقصة لا يظهر منها سوى ” فصل ” يعد في نهاية الأمر نقطة داخل مسير حكائي طويل ومركب اقتطعت منه النظرة أقوى لحظاته.
إنها تلك “اللحظة الحاسمة” التي يحضر فيها كل شيء باعتباره تعبيرا عن كينونة متعالية ومجردة وعامة وقادرة على الانتقال من الإحالة الذاتية إلى ” التمثيلية ” المطلقة ” للنوع. إنها اللحظة التي “تحيل” و”توحي” و”تكثف” و”ترمز” وتقود القارئ نحو توقع ما يمكن أن يحدث، وقد تسعفه في تصور كل الأشياء التي حدثت. وقد تكون تلك اللحظة أيضا هي المنفذ نحو فهم الصورة وقراءتها وإنجاز كل التأويلات حولها.
إن الأمر يتعلق بالقدرة على استيعاب الجوهري الثابت عبر اللحظة التي تحيل، في عمقها، على العرضي والزائل. > فإذا كانت كل صورة إنما هي صورة للعالم، فإنها تحمل في داخلها كل الشروط المولدة للحكاية < (6).
فالصورة تستحوذ على أجزاء من الحياة لتُعِدها وتنظمها وتوزعها بشكل يؤدي إلى إنتاج مشهد سردي يخلص النظرة من إسارها، ويحولها إلى طاقة تعبيرية تقوم بتحويل الوجه المخصوص والجسد المخصوص والشيء المخصوص، إلى صورة تقرأ فيها كل الوجوه وكل الأجساد وكل الأشياء:
– “صورة” الخادمة هي قصة كل الخادمات
– “صورة” المرأة والسياج والرجل تحكي قصة العلاقة بين الرجل والمرأة
– “صورة” حفل الزفاف تحيل على كل حفلات الزفاف الممكنة
– “صورة” الصحراء والضياع، تروي حياة البدو وصراعهم مع الرمال والظمأ.
– “صورة” المرأة والماء والجلباب
فمن خلال هذه الصور تغيب خصوصية الفرد وتغيب معها خصوصية وجهه وجسده وأشيائه، ليتصدر المشهد وضع نمطي خالص، أي وضعية عامة تمثل في عمقها نموذجا تمثيليا يستوعب داخله مجمل العناصر التي نسجتها عبر تاريخ طويل قصة “الخادمة”، وقصة “الوجه المنهك بالمتاعب والمآسي” وقصة المرأة مع الرجل ومع نفسها وجسدها ولباسها، وقصة ” الأهالي” مع أشياء الحداثة والتمدن.
وهكذا، فإن كل صورة تطلق العنان لنظرة تقود من المرئي المباشر إلى ما يوجد خلفه أو في ثناياه. إنها لا تستوعب داخلها ” قيمة دلالية ” معزولة (الحزن أو الفرح أو التحدي أو الاستسلام وما إلى ذلك …) يمكن اعتبارها معادلا مجردا لمعطى حياتي مشخص من خلال الوضعة أو معطيات الوجه أوالجسد.
إنها، على العكس من ذلك، وانطلاقا من نفس المعطى البصري، تخلق لحظة للانفعال المؤسس للقيم عبر تسريد هذه الوحدات: تقديم حد أدنى من العناصر التي تقود العين إلى الانسياب فوق وجه الصورة وفق تسلسل يدل على تماسك ووحدة وانسجام الصورة (انظر ما قلناه في الفقرة السابقة عن نوعية التأطير ودوره في إنتاج النفس القصصي).
وذاك ما يمكن استخلاصه من قراءة سريعة للصورة رقم 16 من الألبوم -(ملحق رقم 1: الصورة رقم 16) ونحن نتعامل مع هذه الصورة باعتبارها نموذجا ضمن نماذج أخرى – (انظرالصورة التوضيحية رقم 1). فهذه الصورة تشخيص أمثل ل” لقاء يومي” يتم في الدروب الضيقة للمدن العتيقة. وهكذا فهي تقدم لنا ” لقاء الصدفة ” هذا من خلال فتاتين في مقتبل العمر متجهتين (أو عائدتين) إلى الفرن، فكل منهما تحمل في يدها اليسرى صينية مليئة بالحلوى.
ويؤكد “الحالة الوظيفية” للفتاتين جلباب عتيق في شكله التقليدي القديم، ومنديل ” بلدي” باهت يغطي شعر الفتاتين. وخلفهما يمتد درب طويل يتخلله بابان عتيقان يدلان على نمط خاص في المعمار . وهو المعمارالذي يميز المدن العتيقة المغربية كمدن فاس ومكناس ومراكش . (انظر الصورة رفقته(.
تلك لعمري بعض العناصرالأساس المكونة للصورة. وهي عناصر تتصل بالأشياء والكائنات ضمن فضاء مليئ بالإيحاءات الثقافية المتنوعة. ومع ذلك فإن الوصف ترك جانبا مجموعة أخرى من العناصر الهامة كالوضعة وتعابير الوجه والجسد واليدين وموقع كل فتاة من صاحبتها، وذلك، كما يدرك كل محلل للصورة، أساس وجود الصورة وركيزة البناء الدلالي داخلها، وهذا ما يجب العودة إليه.
إن إعادة تنظيم العناصر المشار إليها أعلاه وفق زاوية جديدة، سيقودنا إلى اعتبارهذه العناصر مجتمعة تحيل على دائرة مفهومية مركزية واحدة: وجود الشيء ونظيره ضمن دائرة تشبه الانعكاس المرآوي. فكل شيء داخل فضاء الصورة له نسخة تشبهه من حيث الحجم والوظيفة والنوع. وهذا الطابع المرآوي هو ما يؤسس مفهوم النمطية: فالانتماء إلى شريحة أو فئة ما يمر عبر المظهر الخارجي أيضا.
والنمطية بدورها هي ما يشكل العماد الذي تقوم عليه القصة بمفهومها العام، أي تكثيف الفعل الإنساني المتنوع في بنية مجردة وعامة تحتوي داخلها مجمل الأفعال الممكنة.
فإذا أخذنا الفتاتين كنقطة مركزية حولها تتأسس كل الدلالات فإننا سنلاحظ أن “أشياء” الصورة و”كائناتها” تمْثُل على شكل أزواج:
– الجلباب: كلتا الفتاتين تلبس جلبابا من نفس النوع ومن نفس الحجم واللون وكذا أسلوب الخياطة.
-الباب: (بابان من نفس النوع ويدلان على نمط واحد في البناء والمعمار. وأن يكون أحدهما مفتوحا والآخر مغلقا، فلن يغير ذلك من الأمر شيئا، فالأمر مرتبط بموقع الفتاة، التي تدير ظهرها للكاميرا من الباب، فهي تهم بالولوج إلى المنزل).
– المنديل: تضع كل فتاة منديلا على رأسها يغطي الشعر وجزء من العنق .
– الصينية: في اليد اليسرى لكل فتاة صينية حلوى.
– القامة: تتشابه الفتاتان من حيث القامة.
– اللون: الفتاتان سمراوان.
ويمكن الدفع بهذا التطابق إلى مداه الأقصى من خلال التركيز على وضعة الفتاتين ودلالتها داخل البناء العام للصورة. وهكذا نلاحظ أن إحداهما تدير ظهرها للكاميرا، ولذلك فنحن لا نتبين من وجهها وقسماته وتعابيره أي شيء. أما الأخرى فقد منحت نفسها للنظرة، فهي توجد في وضعة شبه مواجهة (إنها لا تنظر إلى الكاميرا ولكنها تحس بها وتعبر عن ذلك من خلال ابتسامتها في وجه صديقتها)، وعلى محياها ابتسامة في العينين والفم واليدين.
إن الثانية تعيد إنتاج الأولى، فهي من خلال هذه الوضعة، ومن خلال موقعها المواجه للرائي تتحول إلى مرآة نرى فيها الفتاة الثانية، وعبرها أيضا تتحدد الموجودات الأخرى. فكما أن الباب بابان، وكما أن الجلباب جلبابان، والصينية بمحتوياتها نسختان، وكذلك الأمر مع المنديل واللون والقامة، فليس غريبا أن يكون ” هذا الذي يحمل هذه الأشياء أو يسند وجودها” هوالآخر نسخة في غيره.
ويصبح لهذا التطابق أبعاد أخرى إذا نحن قمنا بتقليص زاوية الرؤية، وتحولنا بالتحليل من الفضاء الواسع للصورة إلى ما يشكل بؤرتها الأصل. والأمر في حالتنا يتعلق بجسد كل فتاة على حدة. فالجلباب – في شكله التقليدي القديم – ألغى هوية هذا الجسد وغطى على أنوثة تنمو – في حالة فتاة تنتمي إلى شريحة من هذا التنوع – في غفلة عن الناظرين.
لذلك فهو جسد، كما يبدو لنا نحن على الأقل، خاليا من أية تعبيرية أو إغراء. فكومة القماش التي تغطيه لم تترك له أي حظ للإفصاح عن نفسه إثارة أو إغراء. فسيان أن تأتيها “النظرة” من دبرها أو تأتيها من قبلها، فقد تكفل الجلباب بطمس معالم جسد مقموع يركن في مكان ما بعيدا عن وقاحة الآلة. (7)
فعلى ماذا يدل هذا التطابق في كل شيء؟ وماذا يعني وجود الشيء وعديله ضمن فضاء واحد؟ من الناحية التجريدية، يشير هذا التطابق، إلى ارتباط النسخة العينية بالنوع المولد لها. أو هو ، بعبارة أخرى، التعبير عن النوع المجرد من خلال تجسيده في نسخ متنوعة. إن هذا التحول من الأصل إلى النسخة يستدعي خلق وضعية تتوفرعلى كل العناصر المؤدية إلى بلورة ” صورة” تعد تجسيدا كليا للنوع المراد تمثيله.
إن طمس الملامح الدالة على خصوصية الفرد الواحد، سيقود إلى نحت صورة عامة للفئة التي ينتمي إليه هذا الفرد. وعلى هذا الأساس، فإن الصورة التي حاولنا قراءة بعض عناصرها تقدم لنا – عبر لقطة قوية وغنية يجب الاعتراف بذلك – نموذجا إنسانيا من خلال الاستناد إلى أسنن تقود، في مجموعها، إلى الإحالة على قصة كل ” الخادمات ” في البيوت رمزا أو مجازا. ويمكن تحديد بعض هذه الأسنن من خلال العناصر المؤثثة للكون الذي تتحرك داخله هذه الشخصيات:
– الفضاء: الدروب الضيقة والدور الفخمة التي تحتويها المدن العتيقة وتقاليد “الخادمات” وثقافتهن.
– الوظيفة: الصينية التي تحملها كل فتاة في يدها اليسرى كإحالة على ما يمكن أن تقوم به هذه “الخادمة”.
– اللباس: الجلباب والمنديل والمظهرالعام للفتاتين كلها عناصر تحيل بشكل مباشر على وضع طبقي متواضع.
– الجسد: ملامح الوجه والبسمة وطريقة الوقوف هي أيضا عناصر تشير إلى نمط معين من المواقف الخاصة بهذا الصنف الاجتماعي.
ولهذا السبب، (وربما لهذا السبب وحده، ذلك أنه بالإمكان عزل صورة واحدة عن مجموع الصور التي تكون الألبوم ودراستها وفق مقاييس أخرى للتدليل) يمكن القول إن الصورة لا تكشف عن طبيعة الأشياء ولا عن هوية الكائنات. إنها تحدد – وتلك ميزة كل الصور المشكلة للألبوم – طبيعة امتلاك النظرة لهذه الكائنات وللأشياء المحيطة بها.
إن الصورة في حالتنا هذه لا تمتلك الوجه المفرد ولا الجسد المفرد ولا الفعل الخاص، إنها تسرب – في كل لحظة – الوضع الذي يحتوي هذه العناصر. ويتم هذا من خلال إدراج عين ثانية، عين يتشكل من خلالها “الملفوظ البصري” باعتباره كونا صغيرا مكتفيا بذاته. إنها عين جديدة منبثقة من العدسة: عين الرجل ” الساهرة على حرمة المرأة “، وعين “الطفلة/الخادمة “، وعين “الطفل التي تطل من الشباك على وجه عجوز هدته السنون”.
إن هذه ” العين الوسيطة ” لا تلغي النظرة المؤسسة (نظرة الفنان المبدعة للصورة) ولكنها تمتح منها مشعل طاقتها التعبيرية لتفجرها في ثنايا العلاقات التي تنسجها الأشياء والأجساد والعيون فيما بينها. إنها تمتزج بعين العدسة لتمنحها نَفَسها القصصي. فهي تطلق العنان للنظرة لتنتشر في فضاء الصورة وفق تسلسل زمني يربط بين عناصر الصورة: بين الظاهر والباطن، بين الماضي والحاضر، بين المرئي والموحي به.
ويمكن القول في ختام هذه الفقرة، إن كل صورة إنما تقوم بخلق وضعية تحيل على موقف نمطي يمكن تعميمه على كل الوضعيات الممكنة.
- 4 – عودة إلى المفرد
ماذا بعد كل ما قلناه ؟
وكيف سنتحدث من جديد عن المفرد وهو ما حاولت الآلة نكرانه بكل الوسائل ؟
هل بإمكاننا الآن تجاوز ما أشرنا إليه في الصفحات السابقة عن “الهوية الجماعية” والتمثيل الحكائي للوقائع المفردة، لكي نتحدث عن حمولة دلالية خاصة بكل صورة ؟ وهل يمكن الحديث عن خصوصية ما تمس نمط التمثيل وتركيبه؟
بعبارة أخرى، هل بالإمكان رصد “الجوهر” خارج معطيات الظاهر؟ وهل بإمكان “المجرد” و”العام “و”الجماعي” أن يتسامى على كل استقطاب قيمي بالسلب أو الإيجاب ؟ كيف يمكن ل”الإنساني” أن يتبلور خارج ما يرسمه الفعل الخاص كحدود تفصل بين القيم والمواقف من جهة وبين ” الأنماط الكبرى” للوجود من جهة أخرى؟.
يمكن القول إجمالا إن العام لا يمكن أن يولد من نفسه، كما لا يمكن للقيمة المتحققة أن تخرج عن دائرة النسق المولد والمنمذج. فالخاص أسبق في الوجود عن العام، وعبر العام وداخله تولد النسخ المتحققة.
وعلى هذا الأساس، فإن القدرة التي تمتلكها أداة ما للتمثيل – لفظية كانت أم صورية – على إثارة الوقائع الكبرى، هي نفسها التي تصوغ المواقف والقيم الخاصة المؤسسة للعام والكوني. ف “الإنساني” العام لا يمكن أن يثني العين عن البحث – في ثنايا هذا الإنساني نفسه – عما يخصص ويحدد ويدقق.
فعندما تتخلص العين من “وهْم “العام والكوني والإنساني لتلتحم بالمفرد والخاص، ستجد نفسها في حضرة معنى يستعصي على الطمس. إنه معنى ينمو في جميع الاتجاهات، لينتشر في “الأشياء” و”الوجوه” و”الوضعات” و”النظرات”.
لحظتها ستتوحد النظرة بالمنظور ويتوحد الرائي بالمرئي بعيدا عن كل “قاموس” قبلي وعن كل توجيه مسبق. فلا شيء يمكن أن يتجاوز دائرة المُمَثل والقابل للتمثيل: هؤلاء “مغاربة” بلباسهم وفضائهم وأراضيهم وجبالهم، وهم أيضا مغاربة بقيمهم وبؤسهم وشقائهم.
من زاوية النظر هاته، تعود الصورة من جديد إلى أصلها الأول، بؤرة للمفرد والخاص، أي مصفاة تسرب مضامين ثقافية عبر الأشكال والوجوه والأشياء. ذلك أن كل صورة إنما هي كون دلالي مستقل بذاته قد يحمل في داخله آثار ثيمة تنتشر في صور أخرى، أو يعيد إنتاج الثيمة ذاتها أو يحيل عليها بالسلب. وفي جميع الحالات، فإن الضمانة على استقلالية هذا الكون هي التركيب الداخلي الخاص بكل بصورة.
ويكفي أن نشير إلى بعض الثيمات الرئيسة التي تحيل عليها الكثير من الصور لينجلي الأمر عن وضع إنساني خاص ، وضع يتخلله بؤس ينتشر في الفضاء والمباني والأشياء والوجوه والطقوس الوظيفية منها والمتعية.
وقد يكون هذا الوضع “مألوفا” أو “متعارفا عليه”، وقد يثير عند “البعض” نوعا من الغرابة والدهشة والمتعة السياحية. إلا أنه هو الوضع الذي يُرفض ويُدان ويُستهجن عند البعض الآخر. فهل يعني “الإنساني” شظفا في العيش وفي الملبس والقسمات والنظرة ؟
تلتقط عدسة الفنان وضعيات في غاية العمق والقوة والغرابة أيضا: وضعيات تضع الرجل والمرأة ” وجها لوجه”، وأخرى تضع المرأة مع الماء وجها لوجه، وثالثة تجسد دهشة “الأهلي” أمام الآلة الحديثة. إنها وضعيات تقدم ” المغاربة “- أو مغاربة هذا الفنان على الأقل- من زاوية خاصة تركز على الغرابة والدهشة والبؤس.
إنها زاوية ترصد قساوة في الطبيعة والوجوه والنظرات. إنها تمثل أيضا ل” خجل” المرأة وانكسارها النفسي والجسدي. فنساء الألبوم ليست سوى عيون تطل من خلف” شاشات” لا متناهية: الخمار والقناع والشباك والسياج وأعين الرجل التي لا تغفل.
وما تقدمه الصورة رقم 32 (ملحق رقم 2: الصورة رقم 32) بعض من ذلك. إنها صورة في غاية الروعة والجمال والقوة الإيحائية. فهي تعبر بشكل فني سامي عن ” توافق استبداي” بين المذكر والمؤنث، حيث يتم توزيع كل شيء في الصورة وفق موقع كل منهما داخل صرح الفضاء الاجتماعي.
تقدم لنا الصورة وضعا إنسانيا في غاية البساطة والدقة والشيوع أيضا. إنه وضع يعيد ترتيب العلاقات الإنسانية ويكثفها في ” زوج” يملك ترسانة لا تعد من الإحالات الرمزية. ففي الواجهة الأمامية للصورة تجلس امرأة مسنة على أرائك تقليدية، واليدان تلتفان حول البطن في وضع يحيل – كما هو متعارف على ذلك إيقونوغرافيا- على الاستسلام والتخلي عن المقاومة ومجابهة المصير في استسلام رهيب.
عيناها مصوبتان إلى أعلى حيث يوجد الرجل واقفا في الواجهة الخلفية للصورة، وراء شباك غليظ لنافذة وعيناه تطلان عليها من عل. تجلس المرأة في هدوء واستسلام تحول مع السنين إلى “حنين” و”رحمة “و”تسامح”، وفي المقابل يقف الرجل خلف الشباك المسيج بأسلاك حديدية وفي عينيه التملك والتحكم والحركة، إنه خارج السلطة ، فهو وراء الشباك واقفا ، حرا طليقا تميد الأرض تحت أقدامه، وأمامه تجلس المرأة مقعدة عن الحركة وفي عينيها نداء مليء بالدلالات.
وكل شيء داخل الصورة يفصح عن ذلك. فالعيون – عيناه وعيناها- تقول كل شيء عن الحاكم والمحكوم، والسيد والمسود، والمالك والمملوك، تماما كما هي دلالات الشباك غنية وقوية. هناك أولا دلالة موقع الرجل والمرأة من هذا الشباك: فالرجل خارجه والمرأة داخله.
وهناك دلالته في ذاته ثانيا، فهو ما يفصل وما يعزل، وهو الأسر والحجز والحجر، وهوالوقاية والخوف من خطر داهم. وهناك الداخل والخارج، وهناك المحدود في الفضاء والمنطلق داخله. كل هاته العناصر تولد دفعة واحدة من نقطتي إرساء الصورة: المذكر والمؤنث لكي تحيل على عالم دلالي بعينه. وهو نفس المضمون الذي تحيل عليه أيضا وضعة كل منهما.
فالأول (الرجل) ينظر من أعلى إلى أسفل فيما يشبه الإطلالة الممزوجة بالقوة والزهو، في حين تتطلع عيناها إلى أعلى فيما يشبه التوسل أو التذمر أو الاستغاثة. وهذه الوضعة في حد ذاتها تدعم المضامين السابقة وتؤكدها.
وبالإمكان، في هذا المجال أيضا، الإحالة على مجموعة أخرى من الصورالتي تعيد تمثيل نفس الثيمة بطرق متعددة وضمن وضعيات مختلفة. فلكي لا تحيد العين عن النهج الذي ارتضته لنفسها منذ البداية، تعيد، من نفس الزاوية، صياغة وتمثيل وضعيات متعارف عليها رمزيا وإيقنوغرافيا بشكل يقوض دعائم السجلات التي يحيل عليها هذا الرمزي والإيقونوغرافي: أرقام عوض الوجوه (الصورة 13)، نساء يدرن ظهورهن للكاميرا يتقدمن بشكل خجول في البحر وقد رفعن اللباس وكشفن عن بعض من سيقانهن (الصورة 53) رجال بجلاليب يقفون وسط الماء (الصورة 51)
إنها صور تنتج ” الإنساني الغريب ” حقا، وتنتج، في ذات الوقت، السجل الإيقونوغرافي القادر على استيعابه. صور لمغاربة في وضع خاص وبنظرة خاصة وبغايات خاصة. ومع ذلك ، لكل مغاربته وللعين أن تختار.
ملحق رقم 1: الصورة رقم 16
ملحق رقم 2: الصورة رقم 32
ملحق رقم 3 الصورة رقم 25
- الهوامش
*- أصدر داود اولاد السيد “ألبوما” فوتوغرافيا سنة 1989، واختار له عنوان: Marocains
عن دار النشر (contrejour/belvisi)
1 – Schaffer: L’image précaire, Du dispositif photographique , éd Seuil , Paris 1987 , p 182
2 – انظر ما يقوله عبد الكبير الخطيبي – في سياق قد يكون مخالفا لسياقنا – في المقدمة التي خص بها هذا الألبوم.
3-أكد داود اولاد السيد في استجوابات كثيرة أنه كان يريد تقديم “حالات إنسانية” لا “وجوه خاصة”. انظرعلى سبيل المثال: Vision , 90 – n 3 – Mai 1990 و: Almaghrib , Dimanche 31 – 12 1989 – 1 – 01 – 90
4 – Martine Joly: L’image et les signes , Approche sémiologique de l’image fixe , éd Nathan Universite , 1994 , p 121
5 – Le breton (David): Des visages , essai d’anthropologie , éd metaillé, Paris 1992 , p
6- Pierre Fresnault Deruelle: L’éloquence des images , Images Fixes III , éd P U F, Paris 1993, p . 185
7- نفس المشهد تقدمه الصورة رقم 25: قماش أسود يستر كائنات تدير – في لامبالاة- ظهرها للكاميرا. كائنات بنفس الحجم والقامة والوضع الوظيفي يحملن فوق ظهورن جرارا.