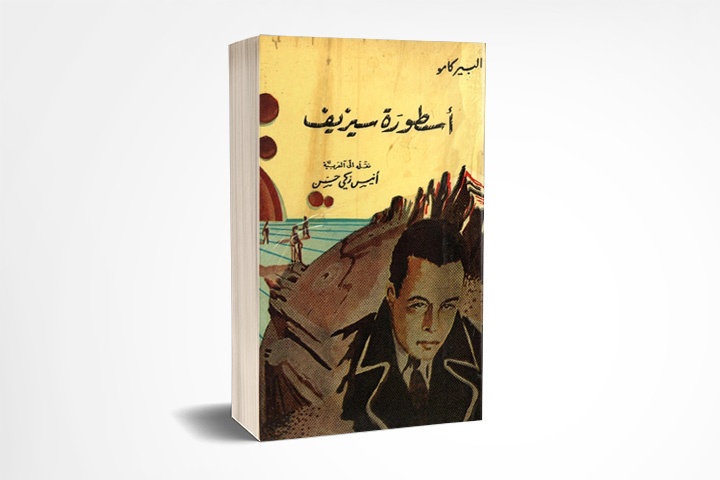الفلسفة والكورونا: من معارك الجماعة إلى حروب المناعة

- تقديم: الفيروس لا هوية له
في سنة 1892، تمّ اكتشاف “الفيروسات” ودخلت الإنسانية تاريخا جديدا لمعنى الحياة. إنّ “منطق الكائن الحي” الذي من جنسنا قد تغيّر بلا رجعة، لكنّ النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو بعامة قد شهد أيضا جملة من الأحداث الطبّية (اكتشاف الميكروبيولوجيا حيث بدأت دراسة الخلية والفيروس والبكتيريا والميكروبات…).
والتكنولوجية (الهاتف والتلغراف وسرعة الضوء والطيران والسينما والإشعاعات…) التي يمكن قراءتها بوصفها تشكّل متوالية ميتافيزيقية مثيرة هي بمثابة تدشين مفاجئ وغامض لعصر لم يعشه البشر من قبل هو “عصرنا” الوحيد إلى حد الآن.
إنّه في خضمّ هذا الزخم من الاكتشافات العلمية والتقنية، أعلن نتشه عن “موت الإله” الأخلاقي بوصفه ظاهرة رمزية قد اجتاحت الوعي الأوروبي بنفسه وبمصيره في العالم، وإنّ أهمّ سمة مثيرة لهذا العصر الجديد هو أنّه شهد أحداثا هي بمثابة إعادة اكتشاف لما كان يسمّى منذ أفلاطون “العالم المحسوس”.
لقد انخرط العلماء في إعادة رسم خارطة العالم المحسوس من خلال سياسة جديدة للمرئي واللامرئي، حيث إنّ “اللاّمرئي” لم يعد “كائنا عقليا” أو “خياليا”، بل صار مساحة “طبيعية” تبعثر مفهوماتنا التقليدية عن المكان والزمان والحركة والمادة والحياة، علينا اكتشافها والدخول في علاقة معرفية وتكنولوجية وأخلاقية معها لم يعشها البشر من قبل.
قد يُقال: ولكن ما العلاقة مثلا بين اكتشاف “الفيروس” وإعلان “موت الإله”، حتى وإنْ صادف أنْ حدثا في فترة واحدة؟ – إنّه الإيحاء المزعج بأنّ قصة “آدم” (المخلوق على “صورة الله” التوحيدي) قد تزعزعت أو فقدت شيئا من حبكتها السردية: أنّ “البشر” مجرّد مساحة بكتيرية أو فيروسية عابرة للأجسام الحيوانية، وليس “صورة” إلهية مطبوعة على صلصال مقدّس.
إنّ الفيروس مثل الهاتف أو السينما أو الطيران أو “موت الإله” التقليدي، هي أحداث ميتافيزيقية تعيد ترتيب العلاقة مع “المحسوس” بما هو كذلك،
وذلك بأن تتجرّأ لأوّل مرة على الدخول في علاقة تكنولوجية مع “اللاّمرئي” بوصفه جزءا لا يتجزّأ من مادة الكينونة في العالم كما تنفعل بها أجسامنا. إنّ المحسوس لا يوجد خارجنا، لأنّ “الخارج” الأنطولوجي لا وجود له.
إنّ المحسوس هو مساحة عابرة تخترق الأجسام، مثل مادة بلا حدود مرئيّة نحو الداخل كما نحو الخارج، لم يعد “الجسد” الإنساني (أي “الجسم” الذي له شحنة وجدانية) يمثّل منها سوى “مجرّد” حلقة عضوية في سلسلة خلويّة سابقة إلى حدّ لامتناهي الصغر.
لكنّها تعبر حدود الجسم المرئية أو الخارجية إلى “عدوى” الأجسام “الأخرى”، والتي لم تعد “أخرى” إلاّ تجوّزا نتيجة إرث أخلاقي صار باهتا.
إنّ “الآخر” قد تلاشى طبيّا وصار مجرّد ادّعاء أخلاقي ينتمي إلى ثقافة علاجية انتهت صلاحيتها بعد اكتشاف قارة اللّامرئي الحيوي (الخلوي والبكتيري والفيروسي) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
من أجل ذلك، نحن لا يمكننا اليوم أن “نفهم” فيروس الكورونا الذي يهدّد باجتياح العالم، إلاّ عندما ننجح في استفهام اكتشاف الفيروس منذ 1892 بوصفه انقلابا في السياسات “الوبائية” الكبرى للحداثة، بوصفها يمكن أن تُقرأ على أنها سيرورة وبائيّة انتقلت من عصر الأمراض التقليدية (حيث لا يزال للناس “أجساد” خاصة.
وبالتالي هويات صحّية مستقلة يمكن حمايتها أخلاقيا) إلى عصر الفيروسات (حيث يصبح “الجسم” العضوي مساحة عدويّة مفتوحة لا معنى فيها لأيّ احتياط أخلاقي). يبدو “الوباء” بمثابة لحظة ترجمة فارقة في سردية “الجسد المريض” المعاصر بوصفه نموذجا مهمّشا للاستشكال الأساسي “من؟” الذي أخذ يشتغل منذ القرن التاسع عشر.
- المرض يغيّر من دلالته
ما الفرق بين أن يمرض إنسان، وأن يمرض حيوان أو نبات ما؟ أم إنّ المرض اختراع أخلاقي خاص “بنا”، “نحن” الممضين عرضاً تحت النوع البشري؟ إلى أيّ مدى يمكننا الادعاء بأنّ الإنسان وحده يمرض؛ أي يتمثّل معنى المرض بوصفه حالة تمسّ هويتنا.
في حين أنّ الحيوان أو النبات هو بالمعنى الحرفي اللاتيني الذي تحدّرت منه كلمة “malade” في الفرنسية والإيطالية والإسبانية؛ أي “male habitus” – “في حالة سيّئة” وهو مرادف “للبرودة”؟ ومن ثمّ فتصنيف “حالة” ما بأنّها “مرض” هو فعل اجتماعي أملته ثقافة تحمل تصوّرا مخصوصا عن مفهوم “الصحة”، وليس توصيفا بيولوجيا محايدا. وأبعد من ذلك، أن يسقط “حجرٌ” ما مريضًا.
يمكن اختبار هذا الافتراض من خلال فحص تأويلي لمصطلح “الوباء” كما تقوله اللغات الغربية من الجذر اليوناني: “epidemic” (Ἐπιδήμιος) من “Epi”؛ أي “على أو فوق”، و”démos”؛ أي “الشعب”، الذي هو غريب عن معنى “وباء” العربية (من وَبَأَ المتاع عبّأه وهيّأه، ووبأ إليه أشار ووَمَأَ).
إنّ ما يجلب الانتباه هو أنّ مصطلح “الوباء” هو في أصله يشير إلى مرض البشر، لكنّه في اللغة المعتادة يُستعمل للإشارة أيضا إلى المجموعات الحيوانية، على الرغم من أنّها تملك مصطلحا خاصا بها هو “zoonosis” (أي “المرض الحيواني”) أو “epizootic” (أي “الوباء الحيواني”)، مثل أنفلونزا الطيور.
ثمّة مركزية أنثروبولوجية تختفي وراء المصطلح: يشعر الإنسان أنّه مركز العالم أو الحياة، ومن ثمّ فمرضه هو نموذج للصحة أو براديغم طبّي للحكم على مدى تمتّع أيّ حيوان “آخر” (هل هناك آخريّة في المرض؟) بصحّته.
ومع ذلك، يبدو أنّ صفة “الوباء” لا تُطلق على النبات الذي يمتلك مصطلحا خاصا به هو “Épiphytie” أي “المرض النباتي”؛ النبات “يمرض” لكنّه لا يشكّل “وباء” بالنسبة إلينا؛ وحده “الحيوان” يمكن أن يكون مساحة “عدوى” تصيب البشر.
ومن ناحية فلسفية، هذا تذكير ميتافيزيقي بأنّ انفصال البشر عن عالم الحيوانات هو ادّعاء أخلاقي صار مضرًّا أكثر من أيّ وقت مضى.
ذلك أنّ “الفيروس” (virus) الذي يكمن وراء المرض في كل مرة، أكان الجسد حيوانيّا أو “بشريّا”، إنّما يسخر من كلّ هذه التصنيفات الأخلاقية، ويصيب كلّ أشكال الحياة بوصفها مجالا حيويّا خاصا به. “فيروس” من أصل لغوي هندو-أوروبي يعني في اليونانية القديمة “ἰός” أي “السم”.
وذلك طيلة ألفي سنة (حيث إنّ أوّل استعمال للفظة virus في معنى “سائل صديدي وقيحي” يعود إلى فيرجيل الذي مات سنة 19 ق. م.)، وذلك قبل اكتشاف “الفيروسات” بالمعنى الحديث سنة 1892، أثناء البحث في مرض يصيب نبتة التبغ.
لكنّ المشكل هنا ليس وجود الفيروسات التي هي “معدية” دوما، بل إنّ نوعا قليلا منها فقط هو عامل حيوي “مسبّب للمرض” (pathogen) ينقل الأثر من مستوى الجسم المرئيّ إلى الطبقة المجهرية من الجسد داخل الخلية أو خارجها.
فجأة لم يعد الإنسان المعاصر -منذ نهاية القرن التاسع عشر- جسماً يدّعي أنّه مساحة أخلاقية لا يزال يمتلك الوصاية الاجتماعية عليها تحت عنوان “الصحة”، بل هو قد تحوّل بسرعة مرعبة إلى دوائر حيويّة لا متناهية من “إمكانيات المرض” لا يرى منها سوى طبقتها الخارجية فقط.
إنّ حدود أو تخوم الجسد قد تغيّرت بلا رجعة، سواء نحو الداخل (في اتجاه الخلية) أو نحو الخارج (في اتجاه الأجسام الحية الأخرى)، وفجأة غيّر مفهوم “المرض” من دلالته. إنّه لم يعد خطأ صحّيا (ناتجا عن “حمية” غير مناسبة) ولا هو ضرورة بيولوجية تحت مفعول العمر (مثل الموت).
بل هو مساحة “فيروسية” لا نراها، بل هي عصيّة حتى على المجاهر العادية. -إنّ هوية أجسادنا إذن لا توجد بين أيدينا، في مساحة أخلاقية مرئيّة، يمكننا أن نسيطر عليها، بل هي قد أصبحت توقيعات وراثية تتخطى الادعاء الأخلاقي للبشر من أجل أن تعيدهم إلى التركيبة الخلويّة التي يشتركون فيها مع النبات والحيوان-، تلك التي أقامت الإنسانية التقليدية لفترات متطاولة انفصالها الأخلاقي أو الميتافيزيقي عنها.
إنّ الفيروس إذن يهدم الجدران الثقافية التي بناها الإنسان التقليدي من أجل أن يفصل “نفسه” (ادّعاءه الهووي) عن بقيّة الكائنات “الحية” حسب ترتيب أخلاقي لم يعد له اليوم ما يبرّره.
ولأوّل مرة، في عصر الفيروسات، صار الجسم البشري هدرا عضوّيا أمام كل أنواع الهجومات الحيوية، من منطقة “خارجة” بمعنى ما، دون أن يكون “الخارج” (outside) خارجيا (exterior) دوما.
- الفلسفة والكورونا
لو ألقينا الآن بأنفسنا الخائفة بشكل “ما-بعد-حديث”؛ أي الخوف من مساحة الوباء غير المرئية المختبئة في أجساد الآخرين التي تحوّلت فجأة إلى دوائر حيوانية تنفث عناصر العدوى دون أي حواجز أخلاقية أو أمنيّة غير “شعور المسافة”، لو ألقينا بتلك “الأنفس” التي تمّ اختزالها منذ الآن في مجرد “”امتدادات جسدية” تحمل فرديّتها مثل لعنة بيولوجية خرساء، في أفق “فيروس الكورونا” (Coronavirus) الجديد.
الذي هو الآن بصدد تهديد البشر بالتهامهم في أتون “وباء” (epidemic) عابر، مثل وحش هارب من المخابر تحت الأرضية، يتجاوز مجرد “المرض المتوطن” (endemic) في بلد دون غيره، مثل مرض الهزال المزمن أو مرض الحُماق في المملكة المتحدة، ويهدّد بالتحوّل إلى “جائحة” (pandemic) تهدّد بالتهام الملايين كما فعل أسلافها من قبيل الطاعون الأسود أو الإنفلونزا الإسبانية.
من أجل ذلك، نحن لا يمكننا اليوم أن “نفهم” فيروس الكورونا الذي يهدّد باجتياح العالم إلاّ عندما ننجح في استفهام اكتشاف الفيروس منذ 1892 بوصفه انقلابا في السياسات “الوبائية” الكبرى للحداثة، بوصفها يمكن أن تُقرأ على أنها سيرورة وبائيّة انتقلت من عصر الأمراض التقليدية (حيث لا يزال للناس “أجساد” خاصة.
وبالتالي هويات صحّية مستقلة يمكن حمايتها أخلاقيا) إلى عصر الفيروسات (حيث يصبح “الجسم” العضوي مساحة عدويّة مفتوحة لا معنى فيها لأيّ احتياط أخلاقي). يبدو “الوباء” بمثابة لحظة ترجمة فارقة في سردية “الجسد المريض” المعاصر بوصفه نموذجا مهمّشا للاستشكال الأساسي “من؟” الذي أخذ يشتغل منذ القرن التاسع عشر.
ومن ناحية فلسفية، يمكننا أن نواجه التحدّي البيو-تكنولوجي والبيو-سياسي الذي يرفعه فيروس كورونا في وجه الإنسانية الراهنة من طرق عدة يمكن ارتسامها على الأنحاء التالية:
أ- أن نحاول تنزيل الفيروس داخل تاريخه الخاص: تاريخ الأوبئة التي اصطدمت بها الأزمنة الحديثة، سواء كانت أوروبية أو انتقلت إليها من المستعمرات عن طريق تجارة “الأجسام” السمراء المستعبدة، منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر، مثل الطاعون والحمى الصفراء والكوليرا.
هنا يمكن الاستضاءة بطريقة فوكو في كتابة تاريخ وباء الطاعون بوصفه ورشة “بيو-سياسية” لدراسة نشأة العلاقة بين المعرفة والسلطة التي مثّلت الوجه الخفي لواقعة “الحداثة” الأوروبية. والفكرة الهادية هي أنّ الصلة التاريخية بين الحداثة والأوبئة هي ليست عرضية،
بل هي جزء أصيل من هويتها الأخلاقية: أنّ “المعايير” القانونية داخلها قد كانت تبرّر نفسها دوما بالاستناد إلى ترسانة من “الخطابات” التي تقدّم نفسها على أنّها “معارف” مبنية على البحث عن “الحقيقة” في العلوم.
إنّ ما يشعر به الملاحظ عندئذ وقد أخذ يتجوّل في شوارع مدينة “ووهان” (Wuhan) الصينية، مدينة الطلبة الأقدم من بكين، التي يزيد عمرها عن 3500 سنة، وهي تحت كارثة فيروس الكورونا، وقد باتت مقفرة من أيّ قدم بشريّة، وحيدة مثل جحيم ميتافيزيقي، هو تخيّل “فوكو في ووهان”[1].
هناك حيث صارت مهمّة الدولة البيو-سياسية هي “المراقبة والاحتواء”. إنّ ما يحدث مع فيروس كورونا يشبه ما شخّصه فوكو في كتابه المراقبة والمعاقبة (1975) عن طريقة الدولة في معالجة وباء الطاعون بوصفه نموذجا سائدا لمنطق الحجر الصحي: إخلاء الشوارع والساحات من البشر، حيث لا يحقّ التجوال إلاّ للشرطة أو الجيش.
هاهنا تصبح الصحّة مشكلا أمنيّا لا علاقة له بأيّ أخلاق أو دين. قال فوكو واصفا التدابير التي يجب القيام بها عند تفشي الطاعون في مدينة ما:
“في بادئ الأمر حصر فضائي صارم: إغلاق، بالطبع، في المدينة وفي ملحقاتها؛ منع الخروج منها تحت طائلة الإعدام، القضاء على الحيوانات التائهة؛ تقطيع المدينة إلى أحياء منفصلة بحيث تقام في كل حي سلطة لمشرف.
كل شارع يوضع تحت سلطة إداري؛ يتولى مراقبته؛ فإذا تركه تعرض لعقوبة الموت. في يوم معين، يطلب إلى كلّ أن يغلق باب بيته على نفسه: ويمنع الخروج تحت طائلة الإعدام.”[2].
لا يفعل فوكو هنا سوى وصف المستقبل البيو-سياسي للجموع ما بعد الحديثة حين تحل الكارثة: تلك التي تنقل الناس من معارك “الجماعة” إلى حروب “المناعة”.
ب- أن نعمد إلى نقد طريقة “الغربيين” اليوم في توريط الصين (العالم غير الغربي) في وحل فيروس كورونا، بوصفه خطأ هيكليا في سياسة الحياة داخل مجتمع آسيوي “غير حرّ”. ويمكن الاستفادة هنا من مقالات سلافوي جيجيك[3] حول الكورونا بوصفه فيرويا “إيديولوجيا”[4]؛
ذلك أنّ التهديد الوبائي ليس تهمة عنصرية يمكن إلصاقها بالعدوّ المنفصل عنّا، سواء بشكل هووي أو بشكل جغرافي. إنّ الجديد، كما يقول جيجيك هو هذه الواقعة المرعبة: “نحن على نفس الباخرة”[5] ولا مجال لأن يدّعي أيّ جزء من الإنسانية أنّه معفى من العدوى التي لا تفرّق بين الهويات أو الثقافات أو الأديان.
ومن ثمّ، فهستيريا الغرب من عدوى الكورونا كأنّه اختراع وراثي “صيني” هو حسب جيجيك أمر لا يخلو من نزعة “عنصرية”[6] وجدت طريقها إلى التعبير الإعلامي. إنّ نشر الخوف يمكن أن يتحوّل إلى سلاح وبائي ما بعد حديث ضد الجموع يختزلها في مجرّد مساحات للعدوى بلا أي نوع حقيقي من الحماية.
وبذلك تسترجع الدولة الأمنية كلّ نجاعتها البيو-سياسية التي فقدت شطرا واسعا منها باسم قيم الديمقراطية.
ج- أن نناقش كونيّة المعايير التي تتمّ بمقتضاها سياسة الحياة التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، وانتقال العدوى التي أحدثها في عالم “معولَم” بشدّة، وذلك في ضوء ما كتبه هابرماس عن “مستقبل الطبيعة البشرية”[7].
نعني في نطاق أسئلة “بيو-تكنولوجية” تفرض على “المعاصرين” (نعني فقط، مجموعة الأطراف القادرة على أن تشكّل جزءا من النقاش عن مستقبل الحياة على الأرض.
وليس المجتمعات أو الشعوب التي لا تزال في خصام هووي مرير مع ذاكرتها المحنّطة مثل حالنا) طريقة مناسبة (غير أداتية، بل تواصلية) في آداب الخطاب حول مشاريع “الأوجينيا” أو “تحسين النوع البشري”.
إنّ المشكل البعيد هو: ما هي العلاقة المأمولة مع قدرة المخابر البيو-تكنولوجية على تصنيع الحياة: هل هي مجرد توصيف قانوني أم هو استشكال أخلاقي لا يزال ملتبسا؟
إنّه لم يعد يمكن، حسب هابرماس، حماية الجسد البشري من عصر التقنية بواسطة الوصايا الأخلاقية. لكنّ تحسين النوع البشري يطرح مشكلا أخلاقيا وقانونيا غير مسبوق لم يعد يمكن تأجيله.
وعندئذ علينا أن نسأل: هل من الجائز افتراض نيّة بيو-تكنولوجية لتحسين النوع البشري من خلال تصنيع فيروس كورونا واختباره بوصفه يستند بوجه أو بآخر إلى سياسة بيو-سياسية تتلاعب جينيّا أو وراثيّا بالطبيعة البشرية، سواء أن كان ذلك بشكل مقصود (في المخابر) أو غير مقصود (بسبب سياسات سيّئة في الصحة أو الغذاء أو البيئة..)؟
إلى أيّ مدى يمكننا أن نفترض هروب الفيروسات من المخابر (وهو احتمال يتم تكذيبه إلى حد الآن[8]) وتحوّلها، مستقبلا، إلى تهديد يطول كل مساحة “المناعة” الجسدية، ولا تصمد أمامه أيّ حدود هووية للـ”جماعة” مهما كان شكلها؟
- خاتمة: الفلسفة والصحة
أشار نتشه ذات مرة، إلى أنّ “أيّ عالم نفساني لا يعرف سؤالا جذّابا بقدر السؤال عن العلاقة بين الصحة والفلسفة، وفي حالة ما إذا صار هو نفسه مريضا، فإنّه سوف يجلب معه كلّ فضوله العلمي في صلب مرضه”[9].
تقع الصحّة دوما على حافة معركة مع مرض ما لا نراه أو صار بمثابة مقياس غير مرئي لما نريد أن نفكّر فيه. والسؤال عن “العلاقة” بين الصحة والفلسفة ليس هو نفسه السؤال عن العلاقة بين الفلسفة والصحة: فالصحة ليست مجرّد “موضوع” محايد للبحث الفلسفي،
بل هي الورشة الخلفية لظهور الفلاسفة واختيار أدواتهم، إذْ يفترض نتشه أنّ مجرّد أن يكون الإنسان “شخصا” هو لن يمتلك بالضرورة إلاّ “فلسفة شخصه (die Philosophie seiner Person)”[10]؛ ذلك أنّ كل فلسفة هي تاريخ “الجسد المريض” (der kranke Leib) الذي أملى على “الروح” أن تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك.
إنّ المرض يجرّد الروح من كبريائها ويحوّلها إلى كائن ينتظر، وكل ما دافع عنه الفلاسفة هو حسب نتشه مجرد وعود أخلاقية لأجسادهم المريضة، مثل “الصمت” و”اللطف” و”الصبر” و”الدواء” و”الراحة” بأيّ شكل.
وهو ما تتمّ ترجمته في مفاهيم “السلم” و”السعادة السالبة” و”الغاية النهائية” وكل مطلب جمالي أو ديني يصبو إلى شيء يقع “جانباً” (Abseits) عنّا أو “ما وراء” (Jenseits) وجودنا أو “خارجاً” (Ausserhalb) أو “فوق” (Oberhalb) عالمنا[11].
في كل هذه المرات، يبدو المرض بمثابة ذاك الشيء الذي “يلهم” (inspirirt) الفلسفة دون أن تدري. وتحت كل “فكرة” يوجد سبب “فسيولوجي” لا يتكلم. وهكذا، فإنّ “الفلسفة إلى حدّ الآن لم تكن دوما غير تفسير للجسد وسوء فهم للجسد (ein Missverständniss des Leibes)”[12].
حين نفسّر لا يعني أنّنا نفهم، بل فقط أنّنا نستجيب لنداء ما لا نراه. إنّ نداءات الجسد المريض تفرض استجابات معيّنة لا يمكن لنا أن ندّعي أنّها الإجابات المناسبة؛ كل تفسير هو استجابة لتوجيه أخرس يجذب “الروح” نحو جهة ما،
لكنّه يظل دوما بلا مضمون، وليس المرض غير الحالة التي تضع الجسد في منطقة التفسير، أو هي التي تخلق الحاجة إلى تفسير ما. ولكن لأنّ التفسير يقول دوما ما أومأ إليه الجسد المريض دون أن يملك اللغة المناسبة لقوله، فهو يتأسس في كل مرة على “سوء فهم” أساسي لهذا الجسد. ما يبحث عنه الجسد المريض هو علاقة جديدة أو أخرى بالمكان.
لذلك، هو يطالب دوما بأن نغيّر اتّجاه الروح نحو جهة تقع “جانبا” أو “خارجا” أو “ما وراء” المكان. إنّ الجسد قطعة من المكان الذي يضيق به المكان. وليست الفلسفة غير جهد حثيث ومحموم لإعادة اختراع العلاقة بالمكان، إلاّ أنّها لا تفعل ذلك من أجل بناء علاقة موضوعيّة بالمكان، بل فقط استجابة لنداء غير منظور يطلقه الجسد المريض في كل مرة تحت وطأة علاقة موجعة بالمكان.
يبدو الجسد بمثابة مجموعة لا متناهية من الأمكنة التي تجمّعت دون سبب واضح في موضع واحد. وكوّنت “فردا”. ولذلك، فإنّ خطورة المرض وطرافته الحادة، إنّما تكمن في كونه شروعاً أخرس في هدم المكان، ومن ثمّ في تعطيل فكرة “الفرد” من الداخل. عندئذ يعود الفرد ليس إلى قفص الجماعة الهووية، بل إلى محيط المناعة الحيوية التي تخترقه مثل نبتة خرساء في سلسلة وراثية لا تراه.
[1]- Cf. Octave Larmagnac-Matheron, «Surveiller et contenir : Foucault à Wuhan», in: Philosophie Magazine. https://www.philomag.com/lactu/resonances/surveiller-et-contenir-foucault-a-wuhan-42463 Mis en ligne le 07/02/2020
[2] – ميشال فوكو، المراقبة والمعاقبة. ولادة لسجن. ترجمة علي مقلد (بيروت: دار الإنماء القومي، 1990)، ص 206
[3]- Cf. Slavoj Zizek, «My Dream of Wuhan», in: WELT, Kultur: Veröffentlicht am 22.01.2020 https://www.welt.de/kultur/article205630967/Slavoj-Zizek-My-Dream-of-Wuhan.html
[4]- Slavoj Zizek, «Coronavirus: le virus de l’idéologie», in: BiblioObs. Publié le 06 février 2020
https://www.nouvelobs.com/idees/20200206.OBS24500/coronavirus-le-virus-de-l-ideologie-par-slavoj-zizek.html
[5]- Slavoj Zizek, «We’re all in the same Boat now – and it’s the Diamond Princess», in: WELT- Kultur. Veröffentlicht am 06.02.2020. https://www.welt.de/kultur/kino/article205828983/Slavoj-Zizek-We-re-all-in-the-sam
[6]- Slavoj Zizek, «Clear racist element to hysteria over new coronavirus», in: RT- Question More. 3 Feb, 2020
https://www.rt.com/op-ed/479970-coronavirus-china-wuhan-hysteria-racist/
[7]- Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001
[8]- Cf. Louis Baudoin – Laarman, Julie Charpentrat, «Non, le coronavirus détecté en Chine n’a pas été créé en laboratoire puis breveté», in: https://factuel.afp.com/. Mis à jour le Mercredi 29 janvier 2020
[9]- Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft (“la gaya scienza”). Vorrede zur zweiten Ausgabe, 1887, § 2.
[10]- Ibid.
[11]- Ibid.
[12]- Ibid
الدكتور ؛ فتحي المسكيني / كاتب ومفكر تونسي، أستاذ التعليم العالي في الفلسفة المعاصرة في جامعة تونس.