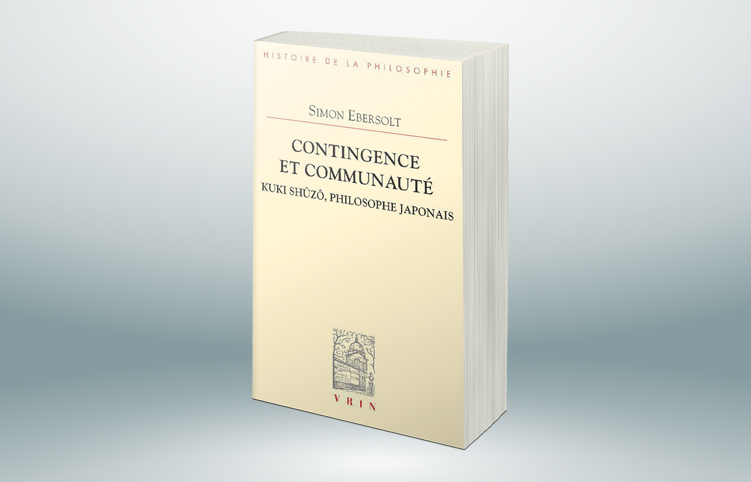الثقافة العربية والنص

الثقافة العربية ليست فقط ما يعبر عنه باللسان العربي بل مضمون هذا التعبير من نظم أخلاقية وعادات اجتماعية ورؤى سياسية أي تصورات للعالم تجدد قيم العربي وتعطيه معايير للسلوك القويم. والعربي هو كل من تكلم العربية حتى لو لم يكن في مولده عربيًّا أو كان مستعربًا.
العروبة هي اللسان. فكل من تكلم العربية هو عربي. فالعروبة صفة للسان والثقافة والحضارة. والحضارة هي الثقافة المتراكمة عبر التاريخ في الوجدان العربي.
والنص المقدس هو النص الديني؛ القرآن والحديث، ويمد السلفيون التقديس إلى كل ما أنتجه السلف من علوم شرعية كأن التاريخ لا تتغير عصوره. والمجتمعات لا تتغير مطالبها وأحكامها. والرؤى لا تتعدل طبقًا للزمن.
وقد يمتد التقديس إلى كل نص ديني، أشعري أو صوفي أو فقهي. فالسلف خير من الخلف (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا). وقد يمتد التقديس إلى كل نص رئاسي يوجب التسليم والطاعة حتى لو كان رئاسيًّا سياسيًّا أو قبليًّا من شيخ القبيلة أو أسريًّا من الأب أو الأخ الأكبر أو أكبر الأعضاء سنًّا أو قولًا عاميًّا يتداوله الناس فيما بينهم للفرح أو الحزن،
للبعث أو الاستكانة. ويُلْجَأ إلى النص حين يعجز العقل عن التفكير. ويسرع في تكوين الخطاب. فالنص هنا يغني عن البرهان.
وخطورة الاستشهاد بالنصوص هو تضاربها وتعارضها، سواء كانت نصًّا مقدَّسًا أو قولًا رئاسيًّا أو مثلًا عاميًّا. فمن يُرِدْ أن يثبت عجز الإنسان عن فعل شيء يقوم على إعمال العقل وحرية الإرادة يستعملْ: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ).
ومن أراد أن يثبت العكس وهو مسؤولية الإنسان عن أفعاله واختياره الحر يستشهد بنص آخر: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)، و(كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا).
هل تستطيع كثرة النصوص أن تثبت صحة الرأي الأول أو الثاني؟ ويحدث الشيء نفسه في القول الرئاسي عندما يُقال بضرورة ربط الأحزمة على البطون في هذا الجيل حتى يسعد الجيل القادم. وفي الوقت نفسه يقول:
إنه من الصعب حل مشاكل مصر المتراكمة في جيل واحد، وإن ربط الأحزمة على البطون لا بد أن يستمر عدة أجيال. ويظهر هذا التضارب في الأمثال العامية حين يقرر مَثَلٌ «الأرزاق على الله» ومَثَل آخر «اسعَ يا عبد وأنا أعينك».
فمن أين يأتي الرزق؛ من الإرادة الإلهية أم من كدّ الإنسان وعَرَقِه؟ والنصوص متشابهة؛ أي تحتمل التأويل على جهتين لأنها لغة. والتشابه جزء من منطق اللغة.
- الجانب المرغوب في النص
فالنصوص بها حقيقة ومجاز، ظاهر ومؤول، مُحْكَم ومُتشابه، خاص وعام، مُجْمَل ومبين. ويُفْهَم النص من الجانب المرغوب فيه. وذلك مثل: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) لا يمكن أن يؤخذ على أنه حقيقة وإلا وقع التفسير في التشبيه أو التجسيم. بل لا بد أن يُفهَم مجازًا.
فاليد تعني القوة وليست اليد ذات الأصابع الخمس. وكذلك الأمر في القول الرئاسي عندما يقول رئيس مشيرًا إلى المعارضة «سأفرمهم». فإنه لا يعني التقطيع الجسدي بل يعني سيعاقبهم بالسجن أو الاعتقال، وربما التعذيب.
والمثل العامي: «يا داخل بين البَصَلة وقشرتها ما ينوبك إلا تقطيعها» لا يعني عدم التدخل بين الحاكم والمحكوم في صف المحكوم أو بين الظالم والمظلوم في صف المظلوم أو بين الغني والفقير في صالح الفقير أو بين الأبيض والأسود من أجل التفرقة العنصرية لصالح الأسود حتى تتم المساواة بين البشر من دون تفرقة في اللون، وأفضلية لون على آخر.
«الأسود جميل» شعار المضطهدين السود. والأسود ملك الألوان في ملابس السهرة عند النساء. والمثل العامي: «إن كان لك حاجة عند الكلب قول له: يا سيد» الذي يدعو إلى الطاعة والرضوخ ومثل آخر: «كلنا ولاد حوا وآدم» الذي يدعو إلى المساواة بين البشر.
فالنصوص بها الشيء وضده. ويُختار منها ما يُراد إثباته. وكلاهما صحيح. وما أسهل من حل هذا التعارض بالرجوع في النص المقدس إلى أسباب النزول أو سياق القول. فلكل خطاب سياق. وهو لا يقل أهمية عن معاني الألفاظ.
ينقص الثقافة العربية اعتمادها على الذات، وصياغة خطاب برهاني يقوم على دليل العقل ومعاييره مثل الوضوح والبداهة كما فعل ديكارت الذي نقل الفكر الغربي في القرن السابع عشر من دليل النص إلى دليل العقل.
وهو ما فعله المعتزلة قديمًا عندنا في الاعتماد على العقل دون النقل، وإذا عارض النقلُ العقلَ يؤخذ العقلُ ويؤوَّل النقلُ بحيث يتفق مع العقل. وهو أيضًا ما قاله ابن تيمية صراحةً في «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». وهو ما يعتبره السلفيون المعاصرون قدوتهم.
وهو ما عبّر عنه الفلاسفة في رواية «حي بن يقظان» عندما اتفق صاحب العقل الطبيعي مع صاحب النقل المنزل على نفس الحقائق.
وقد فرّق ابن رشد والمناطقة معه القولَ إلى ثلاثة أنواع: القول الخطابي، والقول الجدلي، والقول البرهاني. فالقول الخطابي هو ما يستعمله الوعاظ في المساجد والدعاه في نشر الإسلام لأنه آخر الأديان ومُتمِّمها.
والقول الجدلي هو ما يستعمله المتكلمون في جدل الفرق الكلامية. وهو ما يحدث أحيانًا على مستوى شعبي في الحوار بين المسلمين والمسيحيين حول التوحيد والتثليث.
أما القول البرهاني فهو الذي يعتمد على ذاته في بنيته؛ مقدمات ونتائج واستدلالات. ليس فيه تأويل لنصوص متشابهة ولا اختيار بين نصوص متعارضة مثل قول رئيس «الرأسمالية جريمة» وقول خليفته «الرأسمالية ليست جريمة».
فمَنْ يُصدِّق الشعبُ؟ وليس فيه اختيار نص مقدس لتبرير نظام استبدادي أو لتكميم أفواه المعارضة بدعوى الطاعة لأولى الأمر أو رفض الرأي الآخر بدعوى الإجماع الوطني.
- البرهان عقليًّا وتجريبيًّا
وليس البرهان عقليًّا فقط ولكنه يكون أيضًا تجريبيًّا حسيًّا كما طلب إبراهيم الدليل على قدرة الله. فأمره بتقطيع طير أربعة أجزاء وفي كل اتجاه جزء {ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا}، (لذلك يطلب القرآن التفكير والتفكر) }لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}.
وفي الوقت نفسه النظر في الطبيعة والعالم، في الأشجار والأنهار. وهذا هو المعنى المزدوج للفظ «آية» يحمله الكثيرون على أنه النص أي الآية القرآنية.
والآية أيضًا الحس والعقل) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(. ويكون الفهم الصادق هو اجتماع معنى النص الديني مع دلالة الظاهرة الطبيعية. المعنى اللغوي وحده للنص الديني قد لا يصيب نظرًا لاشتباه اللغة. ومن ثَم لا بد من اتفاقه مع دلالة أخرى تأتي من الحس والمشاهدة.
لذلك سأل الله إبراهيم (قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي). المعنى العقلي يأتي بالدليل المنطقي. وهو ناقص دون الإحساس الوجداني.
لذلك جمعت الظاهريات «الفينومينولوجيا» بين العقل والشعور أو كما أراد السهروردي صاحب «حكمة الإشراق» بين العقل والقلب، بين النظر والذوق. العقل وحده لا يكفي دون حس ووجدان، وإلا وقع في التجريد. والحس وحده لا يكفي دون عقل ووجدان وإلا وقع في المادية.
والوجدان وحده لا يكفي دون حس وعقل وإلا وقع في العاطفية والانفعالية. وهذا كله هو مكونات التجربة الإنسانية، الفردية والجماعية، الذاتية والذاتية المشتركة. فإذا تراكمت تحولت إلى تجربة تاريخية تكون رصيدًا للوعي التاريخي وهو مصدر التجربة المعرفية.
وما أكثر الاتهامات التى وُجِّهت إلى إعادة بناء الثقافة العربية دون الاعتماد على حجة القول؛ قال فلان، وقال علان. فالقول ليس حجةً؛ نظرًا لتضارب الأقوال وسوء تأويلها. فالعقل ليس ضد النقل. والبرهان ليس ضد القول. والثقافة المستقلة المعتمدة على ذاتها خير من الثقافة المعتمدة على غيرها. المصادر الداخلية خير من المصادر الخارجية.
العقل يقبله الجميع أما النص فكثيرًا ما يؤدي إلى حرب النصوص أو التشكيك في صحة النص المخالف أو تأويله أو إخراجه عن سياقه. قد تنشأ حرب النصوص ولا يمكن لأنصار أولوية النص على الأقل الاحتكام بأن أول سورة نزلت في القرآن الكريم هي سورة «اقرأ»، ورد الرسول «ما أنا بقارئ» فكان جواب القرآن: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ).
فالقراءة هنا تعني التفكر في مظاهر الطبيعة وأولها الإنسان وثانيها نشأة الإنسان أي التاريخ. فالإنسان والتاريخ هما محورا التفكير. وهما الغائبان في الثقافة العربية المعاصرة لحساب السلطة. وربما غابا أيضًا في الثقافة العربية القديمة.
وهنا تأتي خطورة الترجمة عندما تتراكم في ثقافة. فيتصور القارئ الذي يقرأ نصًّا مترجمًا أنه مثقف مع أنه مجرد ناقل لمعلومات وضعها غيره بعد تفكير وتأمل وبحث ونظر.
وصاغها في النص. ونحن نترجم النص من دون أن نبدع نصًّا مثله عن طريق التأمل والتفكير والنظر. فأصبحت الثقافة العربية موطنًا لحمل ثقافة الآخرين خاصة الثقافة الغربية التي ما زالت هي المركز ونحن أطرافه.
والمعلومات، وليس العلم، ينتقل من المركز إلى الأطراف فنظل تابعين ثقافيًّا إلى الأبد؛ نظرًا لبُعد المسافة الزمنية بين المبدِع والمستهلِك. وبالتالي يكون التحدي أمام الثقافة العربية أن تتحول من النقل إلى الإبداع، ومن النص إلى الواقع، ومن التبعية الثقافية إلى الاستقلال الثقافي إكمالًا لحركة التحرر الوطني واستقلال الشعوب.