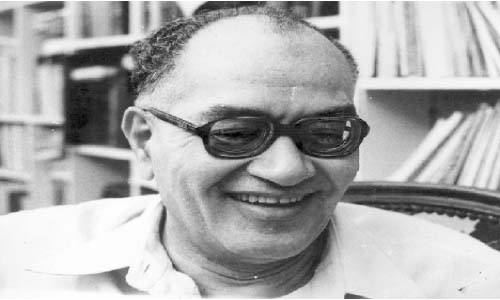مع محمود درويش في منفاهُ الأجمل

كانت مرحلة العامَين 1972/ 1973، وعلى الأقلّ حتّى ربيع الأخيرة، مرحلة هدوء نسبيّ، وربّما ترقُّب في تاريخ المنطقة. الهدوء الذي يسبق العاصفة. وكانت تلك هي المرحلة التي وصل فيها محمود درويش إلى بيروت قادماً من القاهرة ليعيش منفى جديداً من مَنافيه الكثيرة، سيقول عنه دائماً إنّه كان أجمل منافيه وأقساها. جاء محمود من القاهرة التي استقبلته وأحبّته واحتضنته وقد وصلها من موسكو رافضاً أن يعود إلى فلسطين التي يطارده مُحتلّوها.
أحبّته القاهرة (التي كان كبير نقُّادها رجاء النقّاش، بين آخرين، احتفى بشِعره المُجدِّد في كِتابٍ تأسيسيّ ولافت)، إلى درجة أنّ محمّد حسنين هيكل أفرد له مَكتباً في “الأهرام” جوار نجيب محفوظ ويوسف إدريس وعائشة عبد الرّحمن وغير بعيد من توفيق الحكيم. وبهذا كان الأصغر سنّاً بين كُتّاب “الأهرام” الكِبار. في القاهرة تعرّف إلى محمّد عبد الوهّاب والأبنودي ودنقل وعبد الحليم حافظ وكلّ أبناء جيله من الشعراء، وتنقَّل في أحيائها كمَن يتجوّل سعيداً في زوايا روايات نجيب محفوظ وفتحي غانم وغيرهما. لكنّه ذات لحظة عرف تماماً أنّ الحداثة هي في مكان آخر: في بيروت. من هنا ما برح بعد عامَين من وصوله إلى القاهرة، أن بارحها إلى بيروت.
تعرّفتُ إليه حينها وسط حدثٍ “تاريخي” أنا الذي كنتُ أقرأ أشعاره منذ سنوات وأحفظها عن ظهر قلب: كان ذلك في بيت الشاعر أدونيس في منطقة الأشرفيّة “المسيحيّة”، في جلسةِ طعامٍ وثرثرة أقامها أدونيس في بَيته مُعلِناً أنّ درويش سيوافينا هناك فَور وصوله من القاهرة. كان الخبر مُفاجئاً، لكنّ الجلسة كلّها كانت عامرة بمفاجآت مُدهشة. فيها تعرَّفنا للمرّة الأولى على الشاعر السوري سليم بركات الذي لم نكُن سمعنا باسمه من قبل. وفيها التقَتْ الصحافيّة اللّبنانيّة المُقيمة في أميركا راغدة درغام أدونيس للمرّة الأولى، مُعلِنة حبّها له وسط “استياء” خالدة سعيد.
كنّا كثراً من كتّاب وفنّانين تشكِّل بيروت خيمَتنا معاً. وكنّا قد بدأنا نتلهّف للقاءِ محمود درويش. وهو منذ وصوله أدهشنا بدماثته ولطفه وثقافته، بل حتّى معرفته بنا واحداً واحداً، بما في ذلك سليم بركات الذي سوف يُصبح من أقرب أصدقائه إلى قلبه منذ تلك اللّحظة، والذي قرأ له أدونيس قصيدة رائعة هي “دينوكا بريفا.. تعالي إلى طعنة هائلة”. كانت قراءة أدونيس لقصيدة بركات أوّل دخول لهذا الأخير الذي جلس متكوّماً على الأرض كقطٍّ متأهِّب، في حلقتنا الثقافيّة. لكنّ المُفاجأة أنّ محمود درويش كان يعرف القصيدة. كيف؟ من أين؟ لم نعرف أبداً. وكان بركات أوّل المُندهِشين.
منذ تلك اللّحظة الربيعيّة في العام 1973، صار درويش وبركات معاً جزءاً أساسيّاً من حياةٍ ثقافيّة بدت استثنائيّة في حياة لبنان، وربّما المنطقة العربيّة بأسرها. حياة لن تطول أكثر من عشر سنوات أنهاها الغزو الإسرائيلي للبنان وبيروت في العام 1982 واضطّرار درويش ومعظم الآخرين لولوج منافٍ جديدة.
- سنوات بيروت
لاحقاً في باريس سيقول لي محمود درويش إنّ سنوات بيروت كانت أغنى سنوات حياته، وربّما أقساها أيضاً (على الأقلّ حتّى وصوله إلى العاصمة الفرنسيّة التي سوف تكون آخر مَنافيه). لكنّها كانت كذلك السنوات التي أحدثت فيه وفي شِعره أعمق تبديل يُمكن أن يُطاول شاعراً. كان تغيّره في بيروت نوعيّاً على كلّ الصعد. لكنّه كان كذلك تغيّراً نحو ما هو أسوأ: أفقدته سنوات بيروت يقينيّاتٍ كثيرة كانت تراكمت لديه، على المستوى الفلسطيني والعربي.
أفقدته تسامُحاً ما مع ستالينيّة كان يراها عابرة ويُمكن التهاوُن معها؛ مع قوميّة عربيّة كانت ترسّخت لديه في فلسطين المحتلّة على الرّغم من شيوعيّته التي سهّلت عمله الثقافي والمُناضِل مع الحزب الشيوعي الإسرائيلي “كوسيلة وحيدة للنضال ضدّ المُحتَلّ الإسرائيلي” في تلك الأزمنة المُبكّرة؛ ومع بعض جوانب الحياة الثقافيّة العربيّة التي كانت صورتها لديه زاهية من بعيد.
ولئن كان محمود درويش قد اعتبر دائماً سعيد عقل واحداً من “أساتذته” في الشعر، فإنّ انكشاف فاشيّة هذا الأخير وعدائه للفلسطينيّين، كان واحدة من خَيباته الكبرى، حتّى وإن كان كلّ ما بدر من عقل، ولاسيّما خلال الاحتلال الإسرائيلي لبيروت عام 1982، لم يُبدِّل من اقتناعه بأنّ الشاعر اللّبناني العجوز يبقى أعظم شعراء العربيّة في القرن العشرين “رغم أنفه ورغم فاشيّته”، كما كان يقول ضاحكاً خلال أُمسياتنا الباريسيّة.
مهما يكُن، لا شكّ أنّ ظروف الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان، والذي كان قد بدأ يتفاقم مع تدفُّق التنظيمات الفلسطينيّة المُسلَّحة إلى لبنان ومع انهيارها إثر “أيلول الأسود” في الأردن (خريف 1970)، عقّدت الأمور كثيراً بالنسبة إلى شاعرٍ كان يرى الأمور أكثر بساطة. فمحمود كان يرى أنّ بيروت قد صارت “مِلْكَ كلّ مَن يحلم بنظامٍ آخر في مكان آخر، واتّسعت لصياغة فوضى ذات جانب تعويضي حلّت في كلّ غريب عقدة الغربة. وصارت شرعيّة الانتماء إلى بيروت انعكاساً لشرعيّة المُعارَضة لنظام البطش العربي، فلم يعُد على اللّاجىء إلى بيروت واجب مُراعاة نظامها المفكَّك، بل أباح لنفسه حقّ التحالُف الداخلي لمُواصَلة تفكيكه خدمةً لمشروعٍ ديموقراطي يُخاطب خارج بيروت أكثر ممّا يُخاطِب داخلها…” بحسب ما كتبَ شاعرنا لاحقاً في صفحات كِتابه البديع “ذاكرة للنسيان” الذي نقرأ فيه أيضاً نصّاً درويشيّاً مدهشاً كتبه الشاعر عن “صناعة فنجان القهوة الحقيقيّة”.
غير أنّ هذا الوعي لم يكُن ماثِلاً لحظة الوصول، ولا خلال أولى السنوات البيروتيّة التي تحوَّل فيها محمود من شاعر المُقاوَمة الصاخبة إلى شاعر القضيّة وعمقها الإنساني. ففي تلك السنوات توسّعت اهتمامات صاحب “حبيبتي تنهض من نومها” لتشمل العديد من الأمور التي لم يكُن كثير الاهتمام بها سابقاً، من كرة القدم إلى السينما ومن فنّ صناعة القهوة التي لم تعُد أمّه هناك لتعدّها له، إلى المرأة التي ازداد حضورها كثافةً لديه وكفّت العلاقة بها عن أن تكون مجرّد فعل رومانطيقي، وكفَّت هي عن أن تكون رمزاً لفلسطين!
في بيروت أصبح درويش أكثر واقعيّة، حتّى وإن كان بعض شِعره قد أضحى أكثر تجريبيّة (راجع “سرحان لا يشرب القهوة في الكافيتيريا” التي أحدثت نقلة نوعيّة في شعره بأسره) ،هو الذي بات حينها في طريقه ليُصبح واحداً من كِبار الشعراء العرب مُنسحباً من التيّارات والمجموعات ليُصبح مُتفرّداً.
لن يفوتني هنا أن أُذكّر كم أنّ السينما التي اكتشف محمود درويش أهميّتها الفائقة في بيروت، لعبت دَوراً كبيراً في تبدّلاته. وفي هذا السياق لا بدّ من استعادة مُشاركته الدائمة والدائبة في عروض “النادي السينمائي العربي” الذي كنتُ أنشّطه في صالة كليمنصو البيروتيّة مدعوماً من الحزب الشيوعي اللّبناني ومنظّمة فتح والجبهة الديمقراطيّة وعرضنا فيه لسنتَين ونيّف بعض أروع أفلام تيّارات “سينما المؤلّف”.
كان محمود دائماً أوّل الواصلين ليجلس دائماً بين المرحوم حسين مروّة الذي كان بدَوره مُثابِراً على الحضور وبين المُناضل كريم مروّة. كانت عروضاً لا تُنسى، ولاسيّما حين يشارك محمود وحسين وكريم في النقاش بملاحظات مُدهشة (منها مثلاً تعليقات من الثلاثة في غاية العُمق على اقتباس الإيطالي فيسكونتي لرواية توماس مان “مَوت في البندقيّة”). وفي سياق السينما أيضاً أذكر كيف قال لي محمود مرّة في باريس في معرض تذكّرنا تلك الأيّام: أشد ما أذهلني أوّل وصولي إلى بيروت عجزي عن الحصول على بطاقة لمُشاهدة فيلم لبرغمان في صالة تجاريّة لبنانيّة بعد ظهر يَومٍ عادي!
- ضَيف دائم على حفلات منزلي
مُشاركتي في أوّل استقبال لمحمود درويش في بيروت، ثمّ انضمامه إلى نادي السينما، عزَّزا حينها من علاقتي به، فصار ضيفاً دائماً في الحفلات التي كنتُ أقيمها في منزلي لمناسبات مُختلفة. وهناك عندي كان محمود يلتقي شعراء الجنوب والتقى مارسيل خليفة وخالد الهبر وتعرّف إلى الأغنية السياسيّة على الطريقة الحزبيّة اللّبنانيّة، واستمعَ من الشاعر حسن عبد الله إلى القصيدة الجديدة التي كَتبها هذا الأخير تحيّةً لابنتي رلى لمناسبة عيد ميلادها الأوّل ليستمع إليها في العام التالي مغنّاة من خالد الهبر بلحنٍ صاغه زياد الرحباني.
وفي تلك الأثناء صار محمود شبه عرّاب لعملنا الثقافي في جريدة “السفير” – أنا كرئيسٍ للقسم، وزملاء آخرون لي كمُحرّرين مثل محمّد العبد الله ونجاة حرب وعدنان مدانات وغيرهم. وحتّى وإن كان سيشعر بالمرارة لاحقاً من خلال فتحي صفحات “السفير” لشعراء لبنانيّين راحوا يُهاجمونه، وهو أمر لم يغفره لي أبداً!، بكلّ هذا صار محمود درويش ضميراً حيّاً لنا. وكان ينهل من كلّ ما يُكتب ويُناقِش كلّ فكرة جديدة في وقتٍ صار فيه فتىً مُدلَّلاً لدى كثيرٍ من اللّبنانيّين بمن فيهم مثقّفون وسيّدات مجتمع ينتمون إلى يمينٍ لبناني يكاد يكون عنصريّاً.
لقد عاش درويش بيروتيّته بزخمٍ وقوّة. وهو لئن كان سيتخلّى عن ذلك كلّه ويُغادر بيروت في العام 1982 تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي لبيروت، فإنّه سيبقى على حبّه لهذه المدينة التي عاشها بكلّ زخمها في سنوات الحرب ثمّ عاشها مُختبئاً متنقّلاً من زاوية إلى أخرى خلال الاحتلال الإسرائيلي… وفيها كما عنها كتبَ أجمل وأقوى أشعاره، وربّما أيضاً نثريّاته، وذاق بنّ قهوتها الذي سيعتبره أطيب بنّ في العالَم. ولعلّ خير دليل على هذا أنّ محمود درويش سيتحدّث عن بيروت لاحقاً، وهو في باريس، وكأنّها فردوس آخر مفقود بالنسبة إليه فقْده لفلسطين.
ومن هنا حين عاد درويش إلى بيروت بعد سنوات من مُغادرته لها ليُقيم حفل إلقاءٍ شعري صاخب، فوجىء بالمدينة تستقبله بحبّ ودهشة، كما تستقبل ابناً من أبنائها وأكثر، بيد أنّه كان من الصعب عليه أن يدرك أنّ بيروت إنّما استقبلته ذلك الاستقبال لأنّها، وكما سيقول له جوزف سماحة مراراً وتكراراً في العديد من المناسبات، كانت تحتاجه أكثر ممّا هو يحتاجها. فالمدينة التي كانت قد كفَّت في تلك الأثناء عن أن تكون “العاصمة السحريّة الغرائبيّة للثقافة العربيّة” بحسب توصيف درويش القديم لها، وَجدت في الشاعر، وقد عاد لزيارتها عابراً، نَوعاً من ربطٍ لحنينٍ بات الآن وَهْماً لا أكثر وقد تعرّت المدينة من عروبتها الجميلة.
في اختصار، كان درويش يرى، وكنّا نرى معه أيضاً، وإنّما في فترة لاحقة، يُمكن أن تكون قد تأخّرت بعض الشيء، أنّ بيروت كان لها تأثيرها الذي لا يُضاهى في حياته وفي شعره، هي التي نقلته من بداياته المجيدة على أيّ حال كشاعر مُقاوَمة مُبدِع وصاخِب، إلى مراحله الباريسيّة الأخيرة كشاعرٍ إنساني كبير، تمكّن وهو في أوروبا من رفْع صورة القضيّة الفلسطينيّة إلى مصافّ التراجيديّات الإنسانيّة الكبرى، التراجيديّات اليونانيّة الملحميّة التي ظهَّرت أروع ما في النفوس وأثْمن ما في الكائنات البشريّة، والتي سيقول كثرٌ من النقّاد الفرنسيّين والغرباء الآخرين المُقيمين في فرنسا، إنّ شعر محمود درويش، ولاسيّما في مراحله الأخيرة، قد بات يبدو وكأنّه جزء منها، ويقيناً أنّ الشعر والنثر اللّذَين كتبهما في بيروت كانا دائماً في أساس تلك النقلة.
إبراهيم العريس / كاتب من لبنان
————