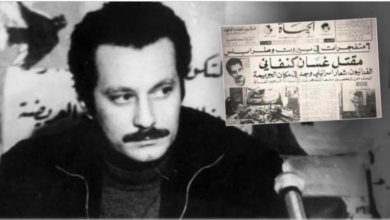عن تظاهرات ثقافية عربية

يبدو لي أن العالم العربي بات أحوج ما يكون لصرخة من طراز صرخة الفنان التعبيري النرويجي إدفارد مونك (1863 ـ 1944) التي أطلقها في عام 1893، عبر لوحته الأشهر “الصرخة”، تاركًا لمختلف ممكنات التعبير والغضب واليأس والرفض داخل جوّانيّاته أن تفور وتنطلق وتدوّي ملء هذا السديم الذي يحيطنا ولا يترك لنا إلا مساحة ضئيلة، محدودة وشبه معدومة، من خيارات المعنى، والوجود، والتجلّي.
ورغم أن تفاصيل اللوحة لا تتناسب مع الصرخة التي أنشدها، لكنها تشكّل، على الأقل، مدخلًا لنقدٍ (مرفوضٍ) متعلِّقٍ بهذا الكم المتراكم بلا طائل من التظاهرات العربية المُدْرَجة تحت عناوين ثقافية وفنية وأدبية ورياضية وسياحية، وغيرها من عناوين تظاهرات (مهرجانات وملتقيات ومؤتمرات ومسابقات) موسمية سنوية، تتسابق البلدان العربية على قضم حصتها منها.
أما لماذا مرفوض، فذلك أن التأزّم العربي وصل مَدَيات متورّمة من ضيق الأفق، ورفض الاختلاف، وإغلاق أبواب المراجعة الموضوعية الحقيقية، ما جعل أصحاب قرار إقامة كل هذه التظاهرات يرفضون أي نقد مهما بدت ملامحه حسنة النوايا، صادقة في بحثها عن روافعِ تطويرٍ وتصويبٍ وتحديدِ بوصلات.
إننا في أوج هشاشة ستجعل أي نقد كفيل بتلاشي فكرتنا من أساسها، وتذرّي مفاعيلنا مع من حولنا، وانبتات وجودنا من جذوره.
- تنميط الخواء..
من دون أي تأنيب ضمير، يمكن وصف كثير من التظاهرات العربية بأنها تنميطٌ سنويٌّ للخواء. فالأصل في أي شيء، أو معنى، أو إحداثية، أن تسبقها رؤية، وأن تتصل تلقائيًا بأهداف ومسوّغات، وأن تحمل تلك الرؤية، وهاتيكم الأهداف، مشروعية ذات أبعاد تنموية حقيقية ومستدامة، وقيمًا متصالحة مع عموم القيم المجتمعية الممثلة لهذه الدولة المنظمة لتظاهرة ما، أو تلك.
والسؤال المباشر الذي يصعد إلى وجدان أي متابع لأي تظاهرة عربية هو: ما الذي تريده هذه التظاهرة؟ إلى ماذا تهدف؟ من هي الشرائح المحلية المستهدفة؟ إلى أي حد تعكس تظاهرتها تلك قيم مجتمعها وأعرافه وأحلامه وتطلعاته؟ أي قيمة مضافة تنطوي عليها تلك التظاهرة؟ هل يشبه هذا الغناء، أو ذاك، ترانيمنا، تراتيلنا، مجسّات طربنا، فرحنا، أنغام ليلنا، وآمال نهارنا؟ هل يطرق أي باب من أبواب روحنا؟ وحتى إن لم تكن تجمعنا روح واحدة، فهل في بال أي تظاهرة من تلك التظاهرات، أي روح من أرواحِ سَكينتنا؟
ليست الأسئلة هنا من دون إجابات عنها، ولكنني لن أحتكر الإجابات وحدي، فهي في سياق التحريض على عصفٍ ذهنيٍّ جمعيٍّ عميقٍ حقيقيٍّ رشيد.
الخواء أن ننتصر للزائف. أن ننحني لغياب مقاييس الجودة، ونكرّس تركها وراء ظهورنا. أن نعمّق الشقّة عربيًّا بين طبقة المستفيدين من التظاهرات، المتكسّبين منها، المقتاتين عليها، المنفوخين بصيحات نفاقها، المتسابقين على كعكتها، المتريقين (الهاجمين بشراهة) على بوفيهاتها، وباقي طبقات الشعوب العربية جميعها. الخواء أن لا نتأمّل ولا نتدبّر ولا نتريّث، وأن نسير كالمضبوعين، أو أشد عماء. الخواء أن نجرّب المجرّب، ونمعن في تخريب المعنى، ونرتاح لمجاملة من يضحك علينا كي يظل يستفيد من خوائنا.
الخواء أن لا نتدارس بصدق ما الذي تحتاجه مجتمعاتنا العربية من قياداتها وأصحاب القرار فيها، فهي في أمس الحاجة اليوم لمن يحترم وجدانها، لمن يرفض بقاءها في خانة المهزومين عسكريًّا واقتصاديًّا وتنموياً وعروبيًا. لمن ينتصر لهويتها مهما بدت، هذه الهوية، مختلفة عن هويات العالم أجمع، ومهما تعاظمت شروط تمثيل هذه الهوية. والهوية هنا ليست مجرّد ارتداء الزي الفولكلوري بدعوى تمثّل التراث، فهو، في معظم التظاهرات التي تصرّ عليه، صار أقرب لزِيٍّ بهلوانيٍّ فاقد لأي محتوى، أو دلالة، أو قيّمة، أو إيمان جاد بمعناه ومرجعياته.
في تظاهراتنا نحتفي بالسينما ونحن لسنا أفضل من يمثّل هذا الفن. نحتفي بالمسرح وهو، إن لم يكن من نوع “الكباريه السياسي” المباشر التنفيسي، فلا تتفاعل معه، في معظم الأحيان، مجتمعاتنا. نحتفي بالشعر وقد بات المنبريّ منه، الصادح بالوزن والقافية في ذيل قائمة المشاركة. نحتفي بالقصة فإذا بأحد لا يسمع أحدًا. نحتفي بالغناء فإذا بنا نسترشد، هنا، برأي مقاولين، ونستضيف من يمعن أكثر بالاستهتار بحدائقنا الوارفة منه. نحتفي بالفن التشكيلي فإذا بلوحات التظاهرة منه لا ترتقي لأن تكون فنًّا.
الخواء غياب الجمهور الحقيقي، والإبداع الحقيقي، والاختلاف الحقيقي، والريادة الحقيقية، والابتكار الحقيقي.
وكل ما تفعله تظاهراتنا أنها تنمّط هذا الخواء، فإذا به متوالية من التنميط الممجوج، والتكرار غير المدروس، والانحدار غير المكبوح.
- تأطير الولاء..
تكاد كثير من التظاهرات العربية تتمثّل بوصفها منبرًا مضافًا من منابر الولاء السخيّ، بلا ضابط، ولا كياسة، ولا ذكاء.
وفي حين أن كثيرًا من مظاهر الولاء فوق أرض واقعنا المبتلى به تعاني من تمدد أفقي غير مضبوط الإيقاع، فإن مهارة التظاهرات أنها تؤطّر الولاء، فيصبح مؤسسة سنوية، وحفلًا بوهيميًا لممارسته بشكل جماعيٍّ محتشد باللامعنى. وتصبح تراتبيّته ممضة إلى أبعد الحدود، فلا يعود الولاء مقتصرًا على الزعيم الأوحد الملهم المُمجد المتمدِّد المتجدِّد، بل يصبح الولاء للمدير التنفيذيّ ضرورة، وللوزير والوزيرة شرطًا، وللأعلى، درجة عليا من درجات الإيمان والإحسان. لن أزيد هنا، فالأمر في هذا السياق لا يحتاج إلى مزيد.
- حقلُ فسادٍ لا ينضب
إن كانت بعض حقول النفط العربية معرضة للنضوب، فإن التظاهرات العربية حقل فساد لا ينضب. وأما الأمثلة فلا تعد ولا تحصى، وكما منذ مستهل المقال لم أستشهد، فسوف أمتنع هنا عن الاستشهاد كيلا يفهم أنني أقصد تظاهرة من دون أخرى، أو بلدًا عربيًا من دون آخر. يكفي أن نقول إنه كان يا ما كان في حديث العصر والأوان، مدير مهرجان، وجدوا عنده عندما اقتحموا بيته المال تحت البلاطة، كي لا يقول له قائل لو واظب على إيداعه في البنك: من أين لك هذا!!
وكلّه ينتهي في أرضه، لعيون فلان، وخاطر علّان، هذا ما قالته لي قارئة الفنجان.
- أين التنمية المستدامة؟
بحسب أدبيات الأمم المتحدة، فإن في مقدمة أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر؛ القضاء التام على الجوع؛ طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ العمل اللائق؛ نموّ الاقتصاد؛ الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ الحد من أوجه عدم المساواة؛ مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان.
في معظم التظاهرات العربية، تغيب معظم هذه الأهداف، ففي مهرجان بعينه، على سبيل المثال، لا يوجد أدنى توجّه لتحويل المركبات التي تقلّ فناني (السبع نجوم) إلى مركبات تعتمد الطاقة الخضراء الصديقة، بل إن الطاقة الأحفورية هي الأكثر استخدامًا في النقل والإضاءة ومختلف احتياجات توليد الطاقة خلال أيام المهرجان.
لا تخدم المهرجانات والتظاهرات مساعي القضاء على الفقر، ولا القضاء التام على الجوع، بل إن بعضها تستنزف بعض المقدرات بلا طائل، فإذا بها حتى لا تسهم في نموّ اقتصاديّ مثمر. لا ابتكار، ولا هياكل أساسية، وكثير من عدم المساواة. مدن تستهلك عراقتها بشكل عشوائي غير مدروس. تخيلوا أن واحدًا من هذه المهرجانات لم يفكر القائمون عليه، مجرّد تفكير، أن يحوّلوا مناطق ترابية فيه (كثيرة ومتشعبة ومضرّة) إلى مسطحات خضراء.
تخيلوا أن مهرجانًا ما، أكبر المطاعم حوله (السياحية من ذوات النجوم) ليست لأبناء المنطقة، بل لمستثمرين من خارجها. ويعيش أبناء المدينة التي يقام فيها المهرجان على فتات حِرَفٍ يدوية لم يعد يُقبل عليها أحد. لا إنتاج مسؤول، ولا استهلاك مدروس.
إن تظاهرات هذا هو حالها لن تسهم في مواجهة التغيّر المُناخيّ، ولن تشكّل أي مدماك من مداميك التنمية المستدامة.
الشعلة تقع، كما الغريب، على نفسها. الحافلات تنخر روح المكان. الفضاء تلوّث صوتي. الإعلانات الطُرُقية فوضى نسيت من نسيت، وأثخنت المدى بالكثرة الزبدية التي لا تنفع الناس. التكرار.. تكرارٌ وراء تكرارٍ وراء تكرار لا يُفْرِح طفلًا، ولا يعلّم شطّارًا.
لا مساحات حقيقية للصغار، ولا حسابات مدروسة لذوي الإعاقة.
الأمن كما لو أنه في حفل شواء طقسيٍّ طقوسيٍّ في غابة الافتراس، يريد أن ينقضّ على كل شيء وكل أحد، وينظر نظرات ازدراء للفن والفنانين. كيف لا وهو في بعض التظاهرات العربية صاحب الكلمة الفصل واليد الطولى؟
في بلاد الزهور، يقيمون مهرجانًا للزهور. وفي بلاد البحار والمحيطات، يقيمون مهرجانات للزعانف والمراكب وجَلَد السباحة الشجاعة الصبورة. وفي بلاد السمك.. لبن.. تمر هندي، يقيمون مهرجانات لـ”الولائم التي تملأ بطون المعزومين الذين يكيلون عبارات المديح والإطناب لمن أوْلَم لهم، على أمل العودة في الوليمة القادمة، التي سيتبادل أصحابها المصالح والصفقات في زحمة الصراخ الاحتفالي”.
كيف لا وقد أصبحت بلادنا: بلاد “التخمة الاحتفالية والشحّ الثقافيّ”.
يبدو أننا لا نحتاج، فقط، للوحة “الصرخة” كي نقترب من توصيف حالنا، بل لعلنا نحتاج أيضًا، إلى لوحة “مصاص الدماء” (1895) للفنان نفسه، فعلى ما يبدو هنالك من يريد أن يمتص عنفواننا عن آخره.
ضفة ثالثة