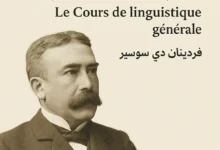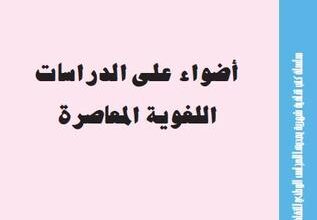إبيستمولوجيا اللسانيات .. نماذج نظريات

أ – تشومسكي: *النظرية والتجربة في النحو التوليدي
*النماذج والقيود الصورية على بنائها
تتميز النظرية التوليدية بميزتين أساسيتين:
1 – إنها نظرية تتبنى مفهوما عقلانيا للمعرفة العلمية، نلخصه في ضرورة انتقاد النظريات التي يبنيها العالم في ميدان تخصصه، وذلك بمواجهتها مع التجريب. وهذا هو الطريق الوحيد نحو التقدم العلمي، إذ المطلوب هو إبطال النظريات وليس البرهنة عليها أو إثباتها.
2 – إنها نظرية لا تعتني باللغة، وإنما بالنحو أي بالآلة الصورية التي تمكن من توليد عدد لا محدود من المتواليات التي تنتمي إلى لغة بشرية معينة. فلم تعد مسألة البحث في اللغات مسألة خروج بـ”أفكار” عن طبيعة هذه اللغات، من ذلك الأفكار التي أفرزتها اللسانيات البنيوية كالتمفصل المزدوج واعتباطية الدليل اللغوي..” بل إن مضمون العمل التنظيري أصبح (في هذه النظرية) يقتضي بناء آلات ونماذج صورية تحاكي خصائص اللغات البشرية، وتمثل بنية “العضو الذهني” الذي يتم بواسطته اللغو. وعاد ضمن البحث اللساني، البحث في الخصائص الصورية لهذه الآلات الكافية لوصف اللغات البشرية”[1].
“قاد تشومسكي ثورة علمية فعلية نجم عنها بروز أنموذج جديد Newparadigm للتفكير في اللغة، أفرز مجموعة من الإشكالات يجب أن يعتني بها اللغوي، وضمنها الاهتمام بالجهاز الداخلي الذهني للمتكلمين، عوض الاهتمام بسلوكهم الفعلي. ومع هذا الأنموذج، بزغ زمن التركيب، حين اتجه اللساني ليس فقط إلى ما هو موجود من السلاسل اللغوية السليمة، ولكن أيضا إلى ما يمكن أن يوجد. واتضح حينه أن إجراءات التقطيع (البنيوية) المستعملة في الأصوات وفي الصرف لم تعد ناجعة بما يكفي حتى تمتد إلى التركيب”[2].
فالنحو في هذه النظرية ليس نشاطا تصنيفيا تطبق فيه إجراءات التقطيع والاستبدال على العينات اللغوية، وإنما نظرية استنباطية صورية تنتج الجمل النحوية (ما يدعى بالقدرة التوليدية الضعيفة) وتخصص أوصافا بنيوية لها (القدرة التوليدية القوية)، وضمن هذا التصور أصبح مجال التفسير المبادئ اللسانية الكلية (أو الخاصة) الثاوية وراء الجمل اللغوية. وهو تصور أدى إلى الفصل بين النظرية والميتودولوجيا، واعتبار إجراءات اكتشاف النحو غير كافية لبناء نظرية لسانية. فوظيفة النظرية اللسانية الأساسية تقويم الأنحاء.
فما هي محاور البحث في إطار البرنامج التوليدي التي يجب أن تضبطها النظرية اللسانية؟
أ – تحديد طبيعة اللغة البشرية.
ب – طبيعة تعلم اللغة باختيار نموذج نحوي معين.
ج – مفهوم النحو كمجموعة من القواعد القائمة في الذهن في صورة ملكة بيولوجية، وعلى اللسانيات أن تعنى بتصويرها وصوغها في إطار نموذج صوري.
د – العلاقة بين النحو الخاص (قواعد لغة خاصة) والنحو الكلي (الثوابت المشترك فيها من طرف كافة لغات البشر).
هـ – علاقة الملكة اللغوية ببقية الملكات الذهنية، أي ما يدعى في الأدبيات اللسانية المعاصرة بالقالبية، فالذهن مكون من مجموعة قوالب متفاعلة أثناء الإنجاز اللغوي ومن بينها: قالب النحو –قالب الاعتقادات والاقتضاءات التي يحملها الإنسان عن العالم – قالب تداولي..
و – العلاقة بين المعطيات التجريبية وبين فرضيات العمل في استخلاص وصياغة الملكة، فالنظرية اللسانية تقييد الشواهد اللسانية بوضع شروط عليها حتى تدمج في الاستدلال اللساني، ومن بين هذه القيود: -صفة الشاهد وطبيعته العلمية- شرعية الشاهد وقانونيته –وضوحه- شموليته..[3]، من أجل صياغة الملكة على شكل نموذج نحوي مصوغ صياغة صورية وما يقتضيه من أمثلات idéalisations، لكون فهم اللغة الإنسانية لا يمكن أن يستغني عن إجرائية مفهوم الأمثلة وما يستلزمه من أبعاد للبرامترات الهامشية التي تعيق الفهم الفعلي للغة، من ذلك: أمثلة المتكلم/المستمع المثالي، وأمثلة العشيرة اللسانية المتجانسة، وهي عبارة عن فرضيات للبحث لا يمكن الرجوع فيها إلى التجربة، فإذا تصفحنا التجربة قد تبطل هذه الفرضية، وهي من المفاهيم التي أدخلها تشومسكي إلى الدراسات اللسانية[4].
ز – إنشاء جهاز مفهومي صوري لصياغة الملكة: كافتراض البنية العميقة والبنية السطحية والتحويلات..
ح – إقامة قيود على الجهاز الوصفي، انطلاقا من النتائج المتوصل إليها في كل من (أ) و (د) من جهة وما تقتضيه الشروط الرياضية والمنطقية المعاصرة على بناء النماذج من جهة أخرى.
ط – بناء مسطرة تقويمية للحكم على النماذج الوصفية.
ي – تفسير العلاقة القائمة والممكنة بين الملكة اللغوية والوعي الفعلي، مع إفراز أوصاف لسانية مضبوطة للمفاهيم النظرية كالحدس اللغوي والحكم النحوي والمقبولية..
يبدو إذن أن التحول الإبستمولوجي في اللسانيات التوليدية لم يطل، كما قد يعتقد، المفاهيم الواصفة وإنما طال النظرية اللسانية برمتها وما يمكن أن يكون عليه الدرس اللساني، ولإبراز المكانة التي يوليها تشومسكي للنظرية، كطفرة إبستمولوجية، في اللسانيات المعاصرة نقتطع هذا النص: “..
يبدو أن المسألة الأكثر صميمية في النظرية اللسانية تتمثل في تجريد فرضيات وتعميمات انطلاقا من نماذج نحوي خاصة تستوفي شرط الملاءمة الوصفية، وهي فرضيات وتعميمات تحمل بعد ذلك –كلما كان الأمر ممكنا- على النظرية العامة المتعلقة ببنية اللغة، فيتم بذلك إغناء النظرية وإدخال المزيد من الهيكلة على نموذج الوصف النحوي.
فكلما قمنا بشيء من هذا القبيل سنكون قد استعضنا عن حكم من الأحكام الصادقة على لغة بعينها بحكم مقابل ينسحب على اللغة بصفة عامة، فيصبح الحكم الأول عبارة عن نتيجة من نتائج الحكم الثاني وإذا ما كان حكمنا الفرضي الأعمق هذا مخالف للصواب، فإن من شأن ذلك أن يبرز للعيان حينما نقيس مفعوله على مظاهر أخرى من مظاهر تلك اللغة أو من مظاهر لغات أخرى.
وباختصار فإننا نبدي إشارة وهي من الوضوح بمكان ألا وهي وجوب صياغة فرضيات عامة للعمل تتعلق بطبيعة اللغة وذلك كلما كان الأمر ممكنا، إنها لفرضيات سنتمكن انطلاقا منها من استخلاص السمات الخاصة المتعلقة بالنماذج النحوية لمختلف اللغات الخاصة[5].
إن النظرية بهذا المعنى ليست مجموعات مسلمات دوغمائية مسبقة، وإنما هي إطار مفتوح للبحث من خلال الذهاب والإياب بين النظري والتجريبي، فالقيود اللسانية هي قضايا قابلة للدحض. فالمعطيات لوحدها لا تزودنا بالأوصاف اللائقة للغات الطبيعية، فلا بد من أعمال تنظيرية، تسبق كل تحليل للغات، لذا يجب التفكير في شروط النحو اللائق، أي ما يعرف بدرجات الكفاية، وهي:
1 – الكفاية الملاحظية: وهي تمثل أدنى المستويات ويبلغها البحث إذا تمكن من رصد دقيق وشامل لكل الخصائص التي يمكن التوصل إليها عن طريق الملاحظة، فإذا ما لاحظ اللساني أن اللغة العربية تملك “جعل” و”عجل” ولا تملك “لجع”[6] فهذا الوصف يعتبر كافيا من ناحية الملاحظة.
2 – الكفاية الوصفية: يهدف النحو، حينذاك، تصوير حدس المتكلم المستمع حول لغته ومعرفته بها، فهو يصف قدرة المتكلم في لغة بعينها، وفي المثال المستشهد به أعلاه، على اللساني أن يبين أن قدرة المتكلم المستمع العربي لا تستسيغ تركيبات صواتية معينة.
3 – الكفاية التفسيرية: ويقدم النحو تفسيرا لمشكل اكتساب اللغة وللإسقاط، لأن المتكلم يتعلم أشياء محدودة في محيطه اللغوي المباشر ويسمع معطيات قليلة ليبني عليها فرضيات حول بنياتها فيسقط تصوره على متواليات يسمعها للمرة الأولى أو ينتجها، والنحو الذي يبنيه المتكلم يعتمد في ذلك على نظرية النحو الكلي، وهدف اللسانيات أن تفسر مبادئ وبرامترات النحوي الكلي.
ب – النماذج والقيود الصورية على بناءها:
*تبرير الأنحاء:
المشكل الأساسي في اللسانيات النظرية هو اكتشاف مجموعة من المعطيات التي تفصل بين التصورات المتناقضة للبنية اللسانية، وإحدى هذه التصورات لا تسمح بوصف للمعطيات إلا باللجوء إلى وسائل وحلول موضعية Adhoc، بينما الأخرى يمكن أن تفسرها على أساس فرضيات عمل تجربية تمس بنية اللغة ذاتها.
ويلخص تشومسكي المشكل في: “عبارة “تبرير نحو توليدي” يمكن أن يكون لها معنيان: -في مستوى الكفاية الوصفية: النحو يكون مبررا بمقتضى وصف تام وصحيح لموضوعه أي الحدس اللساني (القدرة الضمنية) للمتكلم، النحو مبرر بواسطة دليل خارجي..
وفي المستوى الأكثر عمقا.. النحو يبرر إذا كان نسقا وصفيا كافيا مضبوطا بواسطة مبادئ.. مما يعني أن النظرية اللسانية المرتبط بها اصطفته انطلاقا من معطيات لسانية تنطبق عليها كل الأنحاء الأخرى.. فالنحو مبرر داخليا بالنظر إلى.. فرضية تفسيرية تهم شكل اللغة.. ويرجع ذلك إلى بناء نظرية لاكتساب اللغة، والنظر في القدرات الفطرية النوعية التي تجعل الاكتساب ممكنا”[7].
ومن ثمة نتضامن مع جوليا كريستيفا في تخصيصها لوضع إبستمولوجية اللسانيات مع الثورة التوليدية: “انطلاقا من عناية كل من اللسانيات التصنيفية وخاصة مع النحو التوليدي، بنظام الصورنة المضبوطة بواسطة معاير رياضية ومنطقية، لم يعد بالإمكان جمع كل (النظريات) اللسانية تحت مفهوم اللسانيات، فالمعايير الوصفية التي تبنتها أنحاء القرن 18 و19 والنحو التوليدي لا تنتمي إلى نفس اللسانيات. أصبحت هذه الأخيرة انطلاقا من النحو التوليدي نظرية وصفية وتفسيرية حيث بدأت النظرية تفرز وسائل منطقية وصورية لإنتاج (مفاهيمها)”[8].
*مساطر التقويم:
تأسيسا على طروحات النص أعلاه، سنشدد على الوسائل المنطقية للمفاضلة بين الأنحاء في الدرس التوليدي. تفاضل النظرية بين الأنحاء والأوصاف على أساس مفهوم البساطة، وهو مفهوم يمس طبيعة جهاز اكتساب اللغة، إذ يشبه من هذه الجهة ثابتا فيزيائيا ما، حيث نمتلك في البداية ربط تجريبي بين نمط من المعطيات اللسانية الأولية، وأنحاء مبنية من طرف المتكلمين، واقتراح مقياس للبساطة يشكل جزءا من تحديد مضبوط لطبيعة هذا الربط. ولا يمكن استعماله حين المقارنة بين نظريات مختلفة لنحو اللغات الطبيعية، فهو يلعب دورا مركزيا في الأنحاء التي تتغيا الكفاية التفسيرية فقط، يقول تشومسكي: “..
في البداية نحن لا نعرف أي تصور قبلي للبساطة متطور في النظرية أو الإبستمولوجية العامة يسمح بالمقارنة بين ن.ل.غ ون.ل.م.، فمن العادة الإقرار بشكل مطلق أن ن.ل.غ. أكثر بساطة من ن.ل.م.. (كل المقاييس المقترحة في إبستمولوجية اللسانيات: كمقياس التخصيصات بواسطة السمات الصواتية (هال) أو مواضعة الكتابة المختصرة)، جزء من نظرية لسانية معينة وتبريرها من الناحية التجريبية ينهض على هذا الأساس.. ولاختيار بين ن.ل.غ ون.ل.م يجب أن نتساءل أي من النظريتين تسمح ببناء أنحاء وصفية كافية للغات الطبيعية أو تؤدي إلى كفاية تفسيرية”[9].
إذن مسألة تعيين قيمة الأوصاف من الناحية الرمزية الاصطلاحية جد هامة لأن نحوين مختلفين في قيم رموزهما وطريقة صياغتها يؤديان إلى نتائج جد مختلفة في وصف اللغة الطبيعية من ذلك: -نحو يقوم على أساس أن القواعد الصواتية تطبق بشكل سلكي- ونحو آخر يلغي هذه الإمكانية. إذن النحو الأول يحقق كفاية وصفية أعلى من الثاني لأن اللغات الطبيعية تستجيب بنياتها لقيد السلكية.
إن التعميم يعد مقياسا إلى جانب مقياس البساطة لتقويم الأنحاء المبنية، والتعميم هو تعويض مجموعة من القواعد المرتبطة بعناصر متمايزة، بقاعدة واحدة تغطي مجموعة العناصر بأتمها، المشكل هنا يتعلق ببناء مسطرة تسند لنحو مقياسا عدديا من القيم تقيد درجات التعميمات اللسانية، والمقياس الذي تعمل به الأنحاء التوليدية هو: إنشاء مواضعات للكتابة مضبوطة ومقيدة بحيث يمكن اختصار النحو (من ذلك مواضعات التقويس، ومواضعة الاختزال الأدنى للسمات المميزة في الصواتة إلى سمات مثنوية Traits binaires، فالمتكلم في تعلمه للغة يختار التعميمات اللسانية الدالة وبموجبها يلغي الأنحاء التي لا تقوم عليها ومن ثمة يبدو أن اختيار تعميم لساني ما لا يخلو من مضمون تجريبي في النظرية اللسانية العامة.
شهد الدرس اللساني في منتصف القرن العشرين تطورا حاسما، حيث اتجه البحث إلى الآلات الواصفة والنماذج، وقد تم هذا التحول بموجب تطورات حدثت في اللسانيات نفسها وفي الحقول المجاورة لها من جهة:
1 – اتصال اللسانيات والنظريات الإعلامية الحاسوبية حيث كان انشغال الباحثين منصبا على تطوير آلة متناهية تشبه نموذج الحالات المتناهية، لنمذجة العمليات اللغوية، فكان عمل كل من هاريس وهوكيت.
رائدا في هذا المجال، إذ الهدف هو تطوير بنية رياضية للغات الطبيعية.
2 – مع بروز النحو التوليدي، عاد من الضروري تقييد علاقة اللسانيات بالمنطق والرياضيات وتحديد القيمة الإبستمولوجية لهذا الاتصال، فكان أول عمل متكامل يصور نتائج هذا الالتقاء بين علمين متمايزين (الرياضيات واللسانيات) في مشروع مشترك بين تشومسكي وميلر في:
Hand book of Mathematical psychology. Introduction to the formal analysis of natural languages.
قام تشومسكي بنقد إبستمولوجي لأسس اللسانيات ومفاهيمها ومبادئها ليجعل من اللسانيات علما فرضيا-استنباطيا يقطع مع المناهج الاستقرائية.
3 – نلمس أيضا تأثر تشومسكي بإبستمولوجية كارل بوبر، وقبل ذلك تكوينه الرفيع المستوى في أساليب التفكير العلمي، إذ يتبع طريقة وضع الفرضيات ودحضها: “في إطار ما يسمى بالتصور الافتراضي-الاستنباطي في العلوم الذي يقوم على تقديم افتراضات دالة ومحاولة الاستدلال على قيامها أو إلغائها والبحث عن افتراض آخر، وهكذا دواليك. والافتراض الذي نقيم عليه الاستدلال الكافي قد نتخلى عنه لصالح افتراض آخر يهدم الاستدلال السابق”[10].
4 – انقسام أعمال تشومسكي نفسها، إلى مساهمات تهتم برصد الخصائص الصورية لبناء النماذج اللسانية[11]، إضافة إلى الأعمال ذات الصبغة التجريبية التي تطبق مبادئ النظرية على لغة بعينها، علاوة على المقدمات الفلسفية والتصورية للبرنامج التوليدي، كل ذلك يبين أن إبستمولوجية اللسنيات ترتبط بالممارسات الاستدلالية ارتباطا عضويا، بل إن هذه الإبستمولوجية ضرورة منهجية لتطور اللسانيا نفسها إذا أرادت أن تبلغ مستويات عليا من الكفاية.
5 – انبثاق مفهوم مستويات اللغة الواصفة في اللسانيات، فبعدما كانت اللسانيات البنيوية تولي اهتمامها لمستوى الوقائع اللغوية، تحول الاهتمام إلى مستويات أخرى، كالمستوى الميتودولوجي والإبستمولوجي.
6 – بروز كتابات إبستمولوجية موازية للتأليف اللساني التطبيقي منذ الثورة التوليدي إلى الآن، نفكر بهذا الشأن في كتابات بوطا وجوليا كريستيفا وبارهيل وكابلين وبريزنان وكازدار.[12].
ب – الإبستمولوجيا الجدلية: جوليا كريستيفا
يعتبر المقال الذي سنلخص مضمونه جزءا من مجموعة أبحاث أشرفت عليها الناقدة البلغارية جوليا كريستيفا، وينسجم هذا المقال مع تصورات الناقدة عن العلوم ونقدها في معظم كتاباتها التي اطلعنا على جزء منها وخاصة كتاب أبحاث في علم الدلالة التحليلي. ومن ثم يجب أن تقرأ هذه المواقف في إطار نسق تفكير معين للباحثة، وسنربط تصوراتها هنا بمواقفها هناك في نهاية بسط أطروحاتها الأساسية.
تميز كريستيفا بين التقليد الفرنسي والإنجليزي في تحديدهما لمصطلح الإبستمولوجيا، حيث توازي هذه الأخيرة نظرية المعرفة عند الأنجلوساكسونيين، وبالتحديد حصر مجال اهتمامها في فرضيات وقوانين ونماذج ومناهج الاستدلال في نظرية علمية خاصة، حيث يراقب الإبستمولوجي الصرامة المنطقية لعلم ما، أي ما إذا كانت نظرية ما تستجيب لقواعد القياس Règles de syllogisme، ومن هذه الزاوية يمكن تصنيف مقاربة بوطا للنظرية التوليدية، ونسميها بعد كريستيفا بالإبستمولوجية الوضعية، هذه القواعد القياسية معيارية، لذلك ينبغي أن تستجيب لها كل العلوم: فيزياء كانت أو رياضيات أو لسانيات، لكي نصل إلى مستوى الصرامة الداخلية للصورنات في العلوم ومن ثم يميز بوطا بين المظهر الجوهري والمضموني للعلوم، وبين المظهر المنطقي لها ويقارب الدرس التوليدي من هذا المنطلق.
ـ الإمساك بالحدود الصورية للنظريات يؤدي إلى معرفة حدودها الاكتشافية.
ـ كل تغيير في نظام النمذجة والصورنة لا يؤدي إلى نظرية جديدة، طالما أن جوهر النظرية والاختيارات الإبستمولوجية التي تتأسس عليها لم تتغير، من ذلك تغير النماذج التوليدية من 1965 إلى 1986 لم يؤد إلى نظريات توليدية، لأن المقدمات الفلسفية التي تتأسس عليها النظرية لم تتغير وتشكل النواة الصلبة للبرنامج التوليدي.
ـ تنقلت بعض الخطوات العلمية من قوانين المعيارية la normativité، من ذلك مثلا: اختيار المشاكل العلمية التي تعتبر ذات دلالة في البحث، وضع الفرضيات والذي تعتمد على حدس العالم أكثر من اعتمادها على مساطر اكتشاف جاهزة، هذه المسائل المتعلقة بجمالية العلوم (أنظر هولطن والفهري) يسندها بوطا إلى مجال خارج معيارية البحث العلمي.
ـ على عكس المقاربة الأنجلوساكسونية في إبستمولوجية اللسانيات، تهتم إبستمولوجية جان كلود شوفالييه بنشأة علوم لسانية محددة (كالتركيب) انطلاقا من القطائع والتقاطعات المعرفية في القرن 16 و17، من ذلك الحفر في الأصول المعرفية التي أدت إلى نشأة مفهوم “الفضلة” في القرن 16، وطرائق الاستدلال النحوي في القرن 17 مع حصر مياسم تقاطع التفكير النحوي والتصورات السوسيولوجية والميتافيزيقية والبلاغية والجمالية للعصر. تسمي جوليا كريستيفا هذه المقاربة بسيرورة إنتاج المفاهيم والنظريات في/داخل التاريخ، عبر عملية تسميها compactification، أي لحظات ملء الثغرات في النظريات والعلوم، حيث كان على النظرية التوليدية لكي تستثمر مفهوم البنية العميقة أن تفرغه من محتويات سيكولوجية غير مرغوب فيها، من ذلك أيضا إفراغ مفهوم الفطرية من محتوياته الميتافيزيقية التي اشتغل بها على امتداد تاريخ الفكر الفلسفي، يتحول مع تطور البيولوجيا إلى مفهوم وراثي، تقول كريستيفا في حديثها عن إبستمولوجية لا وضعية: “على الإبستمولوجية أن تهتم بتكوين الأجهزة النظرية بالنظر إلى التاريخ والذات (المجتمع والإيديولوجيا)، وهكذا نحصل على تصور للإبستمولوجية يجاوز الإطارات الوضعية ليستنبط الشروط الواقعية أعني العلمية-الداخلية والاقتصادية (بمعنى اقتصاد الذات والتاريخ) لبلورة كل علم ملموس”.
لكن كيف تنمذج هذه المفاهيم داخل اللسانيات؟ أي ما هو الوضع الصوري والمنطقي للمفاهيم الواصفة؟ تميز كريستيفا بين النظرية 1 والنظرية 2، بينما تنمذج الثانية مفاهيما وصفية صالحة معينة كالفونيم والمركب والجملة..، تدمج الأولى التعميمات الوصفية للثانية داخل نسق نظري يخصص الطبيعة الرياضية للمفاهيم الأولية للنظرية 2 les termes primitifs، تلاحظ كريستيفا أن المفاهيم اللسانية القديمة (الجملة والمركب..) تدمج في النظريات اللسانية المعاصرة بعد إفراغها من محتويات غير قابلة للصورنة، إذ نظام المجعلات الرياضية في اللسانيات التوليدية لا يسمح إلا بالمفاهيم المحددة خصائصها وشروط اشتغالها داخل المستوى الإبستيمولوجي.
ما الذي يجعل النظريات اللسانية المعاصرة كافية من الناحية التفسيرية؟ إذا كات النظرية 1 و2 لا تكفي للاستدلال على الواقعية النفسية للنماذج اللسانية، كيف نعرف أن نظرية ما تطابق الواقع النفسي للمتكلم/المستمع؟ تلجأ اللسانيات إلى معطيات، تشكل ما يدعى في الأدبيات الإبستمولوجية بالأساس التفسيري للنظرية la base explicative، في العلوم المجاورة لها كعلم النفس وعلم الأعصاب-البيولوجي.. وذلك ما تصوره عبارات تشومسكي: “إننا لن نفهم القدرة اللغوية إلا في علاقة مع علم نفس يدرس أنساقا متنوعة للمعارف والاعتقادات الإنسانية”.
تهتم إبستمولوجية اللسانيات، علاوة على تدخلاتها في مختلف الحقول المعرفية المتصلة بها والتي تساهم في سيرورة تكوينها كعلم، بمسألة التمييز بين مستويات التحليل اللساني (المستوى التركيبي والدلالي والصوتي الصرفي)، فالسؤال حول ما إذا كان هذا التمييز كليا، يفضي باللساني إلى تقصي معطيات ونتائج اللسانيات النفسية والسوسيو لسانية. ولكن النظرية التوليدية جعلت منها مستويات متمفصلة Articule؟
رياضيا ومنطقيا، حيث إن العلاقة بين المستويات اللسانية مسألة تجريبية تؤدي إلى تنبؤات مختلفة بطبيعة اللغات الطبيعية، من ذلك العلاقة بين البنية العميقة أو السطحية والمكون الدلالي وعلاقة التحويلات بالبنية العميقة.
كيف تنتج المفاهيم والنظرياتفي اللسانيات؟ إن هذه العملية متمفصلة بشكل مزدوج: -من جهة القوة الصورية للنظريات وقدرة الصورنات المنطقية- الرياضية لذلك لم يستطع هامبولت أن يصورن مفهوم الإبداعية اللغوية في إطار “التكرارية”، فوضيفة الرياضيات والمنطق صورنة المفاهيم اللسانية الحدسية.
تصوغ كريستيفا مجموعة من القضايا التي على كل إبستمولوجية للسانيات أن تجيب عليها وأهمها:
1 – حدود استعمال اللسانيات كنموذج لدراسة الظواهر في العلوم الإنسانية، هل يمكن لعلم النفس أن يستفيد منها؟ وينبغي أن نعكس السؤال لنسائل العلائق الممكنة بين اللسانيات وعلم النفس والمنطق والرياضيات.
2 – البحث عن منهج لحصر إبستمولوجية اللسانيات وتمييزها عن الإبستمولوجيات الوضعية، فهي تسائل من موقعها الخاص علاقة النظرية بالشروط الواقعية لتشكلها: الشروط السوسيوتاريخية والذاتية والداخلية، فهي نظرية للإنتاجات النوعية للمفاهيم والنظريات العلمية، وهي إذ تؤمن بالعلم كممارسة وسيرورة ينبغي أن تكون جدلية لتقطع مع الإبستمولوجية الوضعية والعلموية.
في اعتقادنا المتواضع، لا يمكن فهم خصوصية الإبستمولوجية الجدلية عند كريستيفا إلا بواسطة موضعة فكر هذه الأخيرة داخل تقليد فلسفي فرنسي يضم كل من جاك دريدا وميشيل فوكو وفيليب سولر ورولان بارت، أي داخل نسق ذهني كلي تشتغل فيه جل الأنساق الفلسفي لعقد الستينيات في فرنسا والذي يتميز بخصوصية:
1 – الانفتاح على مناهج تحليلية مغايرة لأفق المقاربات التقليدية، كالماركسية والتحليل النفسي والبنيوية واللسانيات.
2 – الدفع بالتوجه الماركسي إلى أقصى حدوده للاشتغال على ممارسات دالة، مع إعادة قراءة جديدة للماركسية نفسها وإفراغها من كل تأويل دوغمائي ستاليني يمكن أن يكون قد لحقها عبر سيرورة تمثلها في المذاهب والعقائد المختلفة، ولم تخف كريستيفا توجهها في الأعداد الأولى من مجلة تل كل.
3 – الاعتقاد في إجرائية المقولات ومنهج التفكير الماركسي دفع بها إلى جعل الدلائليات علما ينقد نفسه باستمرار وعلما ناقدا للإيديولوجيات، واستبدال مقولة العلم بالسيرورات العلمية والأدب بالممارسة الدالة. ولا يمكن للعين أن تخطئ في استقرائها لهذا التوجه داخل كتاباتها الإبستمولوجية ومنها المقال المشار إليه أعلاه، أن العلم سيرورة تكوينية مستمرة تخضع لإواليات ملئ الثغرات، la decompactification والتشابك la compactification، وهكذا يجب على اللسانيات أن تستدرج إلى حقلها التداوليات وعلم النفس للإمساك بلحظة الذات داخل عملية إنتاج الدليل، وعلى إبستمولوجية اللسانيات الجدلية أن تعين المواقع النظرية التي يمكن لهذه العلوم أن تحتلها داخل النماذج والصورنات اللسانية، إنها مواضع الذات المتكلمية في كل من اللسان والكلام[13].
4 – في سياق التقليد الفلسفي أعلاه نعثر على قراءة دالة لصوسير من طرف بارت في كتابه “إمبراطورية العلامات”، حيث يبحث بارث عن الأصول المعرفية للمفاهيم الصوسيرية كالدليل الاعتباطي والنسق والنظام واللسان كظاهرة اجتماعية، ويعيد قراءة السياق المعرفي برمته للعصر الذي أنتج فيه صوسير أفكاره، وهكذا نلحظ بالملموس تأثره بعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم التشريع وكذلك الانقلابات العلمية في سياق نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. ومن ثمة على إبستمولوجية اللسانيات أن تستفيد من التوجهات التحليلية السابقة في:
أ – الكشف عن الأصول المعرفية المختلفة التي تنبثق منها المفاهيم الواصفة، إذ يستعمل دارس اللسانيات تلك المفاهيم دون التساؤل عن الخطابات العقلانية التي اشتغلت فيها، ومن ثمة معرفة كيفية هجرة مفاهيم ما حقولا نظرية معينة لتستثمر في حقول أخرى، حيث لاحظنا أن المفاهيم التي تزظفها اللسانيات مقترضة من مجالات معرفية كالرياضيات والمنطق والبيولوجيا: كمفهوم النسق –التكرارية- التبعية للسياق – الحاجز – السلكية..
ب – إعادة قراءة التراث اللغوي العربي انطلاقا من هذا المنظور، يعد حقلا مناسبا لاختبار إجرائية تلك العدة المفاهيمية، وأيضا من أجل استثمار مصطلحاته النحوية والبلاغية.. في مقاربة الظواهر اللغوية.
5 – استند كل من ميشيل فوكو وجان كلود شوفالييه على منهج الإبستمولوجية الجدلية، وهكذا حاول الأول تتبع بناء المفاهيم النحوية في القرن 17 و18، إذ لاحظ أن مفاهيما كالنظام التركيبي الطبيعي والمفعول به (الذي أدخله بوزي في القرن 18)، كانت قادرة على الاندماج في المنظومة المفاهيمية لنحو بور رويال لكن بعض المفاهيم أخرى كالقيمة التعبيرية للأصوات أو انتظام تحول الحروف.. عاجزة على أن تنسجم ومجموع المفاهيم التي كان لنصلو ودكلو يستند إليها. ومن جهة أخرى حاول ربط الجهاز المفاهيمي للنحو العام بالعلم العام للنظام مع الجبر الديكارتي، ومحاولة معرفة العلاقة بين التحليل الفلسفي للتمثيل ونظرية الإشارات وبين قضايا التاريخ الطبيعي ومنهجه في التمييز والتصنيف.
ج – الإبستمولوجية الوضعية: – رودولف بوطا
ارتبط اسم بوطا بمسار الدرس التوليدي، محاولا اقتناص الآليات الإبستمولوجية والاستدلالية التي تشتغل بها النظرية التوليدية ليثمنها، بواسطة منهج القياس Méthode de syllogisme، المتبعة في العلوم الحقة لضبط ومراقبة الصرامة المنطقية الداخلية للاستدلالات الصورية. وتأسيسا على ذلك، يمكن ملاحقة لحظتين في إنتاجات بوطا:
1 – لحظة قياس استدلالات في النظرية التوليدية وفي نماذجها الأولى على وجه التحديد ويسائل بوطا هنا آلية التفسير المتبعة في الاستدلالات الذهنية Mentalistes، والاكتشافية Heuristique، للنحو التوليدي.
2 – لحظة متابعة آخر تطورات النظرية التوليدية مع نموذج الربط العاملي في إطار ما يدعى بالأسلوب الغاليلي في البحث اللساني، ويحاول ربط خطوات استدلال والدفاع عن النظريات المهددة عند كل من غاليلي وتشومسكي.
ويمكن تلخيص هذه اللحظات في الكتابات الآتية:
1 – 1968 the Function of the lexicon in transformational generative grammar.
2 – 1970 the Methodological status of grammatical argumentation.
3 – 1971 Methodological Aspects of transformational generative phonology.
4 – 1971 B.patterns of non demonstrative inference in generative grammar.
5 – 1982 On the Galielean style. Of linguistic inquiry lingua 58.
الوضع الميتودولوجي للدليل الخارجي في اللسانيات التوليدية:
تفرز النظرية التوليدية مجموعة من البراهين أو الحجج لتدعيم فرضية نحوية معينة حول قدرة متكلم مستمع في لغة معينة أو حول القدرة اللغوية البشرية، وهذه الحجج يمكن أن تصنف إلى:
أ – حجج داخلية.
ب – حجج خارجية. الحجة الداخلية تحتوي كل الحدوس اللغوي لمتكلم-مستمع فعلي للغة معينة، وهذه الحجج يمكن للساني أن يستند إليها في براهينه اللسانية لتدعيم قانون أو قاعدة لسانية، وتعرف بـ”المعطيات اللسانية الأولية”. الحجة الخارجية تحتوي كل المعطيات التي لا تنتمي ضمنا للغة: كالمظاهر التطورية أو اللهجية أو النفسية-العصبية.
تحتل هذه المعطيات أهمية بارزة في النحو التوليدي ويمكن البرهنة على ذلك من خلال الكتابات التالية:
1 – حاول كل من كيبارسكي وتشومسكي وهال وبوسطال وليكوف، الاعتماد على مظاهر دياكرونية لتدعيم فرضية نحوية معينة.
2 – اعتماد بوسطل على معطيات علم النفس-العصبي للاحتفاظ بفرضيات لسانيات تمس الجانب الذهني.
3 – استناد طومسن واليوت إلى اختلافات اللهجية من أجل الغاية نفسها.
4 – ظواهر متصلة باكتساب اللغة عند الطفل اعتبرت ذات دلالة في البحث اللساني.
يتساءل بوطا عن الأدوار والوظائف الميتودولوجية المسندة للحجج الخارجية في البحث اللساني السانكروني. من بين الإشكالات التي يطرحها هذا الاستدلال يمكن حصرها في:
1 – ما هي المشاكل المنهجية (الميتودولوجية) التي تعرفها اللسانيات في استعمالها للحجج الخارجية؟ ما هي وظائفها وأدوارها في النظرية اللسانية؟
2 – لماذا يلجأ اللساني للحجة الخارجية، ولا يكتفي بالمعطيات اللسانية الأولية لبناء الفرضيات اللسانية؟ هل بالإمكان أن نشطب على دور المعطيات اللسانية الثانوية في بناء النظريات اللسانية؟
الإجابة عن السؤال الثاني تقتضي منا حصر أدوار الحجج الخارجية في:
أ – حجج إيجابية ندعم بها الفرضيات اللسانية الذهنية، وتعد بمثابة الأساس التفسيري للنظرية.
ب – حجج سلبية تبطل وتلغي فرضيات لسانية ذهنية.
ولك من الحجتين في منظور بوطا تعتبران حججا غير برهانية، لأنها لا تستجيب للطرق القياسية المتبعة في العلوم الحقة، والقيود الموضوعة على التفسير والاستنباط، لأن النتيجة التي نصل إليها في القياس مثبتة انطلاقا من القضايا البرهانية السابقة، والتي تؤسس عليها النتيجة، فالتفسير هنا داخلي بالنظر إلى المقدمات الأولى التي تبنى عليها النظرية، فالنظرية هنا مجموعة من المجعلات الرياضية التي يفسر بعضها بعضا بالنظر إلى النسجام الداخلي لمقدماتها ونتائجها.
يقول بوطا: “النتيجة لا تمتلك محتوى غير موجود أصلا في المقدمات المنطقية أما التسدلالات الغير البرهانية، فهي تخرق هذه القاعدة المنطقية، لأن محتوى نتائجها غير مرتبط بمحتوى مقدماتها، ولذلك نعتبر الاستدلالات غير البرهانية (في النحو التوليدي مثلا) غير محترمة لشروط الصرامة المنطقية” إذ يمكن اختزالها في المعادلة المنطقة الآتية:
P É q
q .. p
مضمون هذه المعادلة (تدعى في الأدبيات المنطقية بالاختزال الرجعي la réduction régressive أن الاستدلال يبدأ بالنتيجة المعروفة وغير المبرهن عليها، ليصل إلى المقدمة التي عليها أن تفسر النتيجة، وإذا استبدلنا أطراف المعادلة بمفاهيم لسانية، نقول أن اللساني التوليدي ينطلق من فرضية لسانية، ويحاول البرهنة عليها أو تفسيرها في حقول معرفية لا تتضمنها اللسانيات في ما صدقها أو مفهومها. والنتيجة (P) تفاضل بين فرضية تفسيرية لتحتفظ بفرضية من بين فرضيات متعددة، فاللساني التوليدي لا يعرف أي الفرضيات وارد لتفسير تقويم الأنحاء أو اكتساب اللغة، ودور النتيجة أو المعطيات التي يحصل عليها من مجالات محاقلة للغة، أن تمده بمعطيات تفسر أي الفرضيات واردة بالنسبة للنظرية اللسانية.
P É q
P .. q
وإذا سلك اللساني طريقا معكوسا في الاستدلال: أي أن يضع فرضية لسانية عامة حول بنية اللغات الطبيعية، ثم يحاول الاستدلال على ملائمة هذه الفرضية للغة الطبيعية عن طريق إجراءات تحليلية على لغات خاصة (الإنجليزية، الفرنسية، العربية)، ليصل في نهاية المطاف إلى نتيجة تؤكد المقدمة (الفرضية المنطلق منها)، في هذه الحالة تعد خطوات الاستدلال الداخلية طريقا إلى النتيجة، إذن النتيجة تستلزمها المقدمة ومحتواها العام متضمن فيها، ولكنها قد تتضمن محتوى جديدا لا يحافظ على قيمة صدق مقدماتها، أو تستنتج من مقدمات أخرى. الإشكال في النظرية التوليدية هو معرفة كيفية بناء معيار لتحديد ما إذا كانت الأنحاء التوليدية ذوات واقع نفسي، أي ما إذا كان نسق القواعد النحوية يوازيه نسق مستبطن من طرف المتكلم – المستمع للغة معينة.
والحل عند كيبارسكي يكمن في اللجوء إلى المعطيات الدياكرونية المتصلة بالتغييرات اللسانية لكي نمتحن نسق القواعد اللسانية ومن بينها مستويات التمثيل ومواضعة الكتابة بالمعقوفات، فإذا كانت الصورنات في اللسانيات تستجيب لميكانيزمات التغير اللساني دون أن تشوش على النسق الداخلي للنماذج كانت النظريات التي يبنيها اللساني التوليدي ذات واقعية نفسية، فالتغيرات اللسانية بمثابة الحجة الخارجية على انسجام النظريات اللسانية وواقعيتها النفسية، لأن الميكانيزم النظري في النحو التوليدي المتعلق بالتغيرات اللسانية يتنبأ بتحولات صواتية في اللغات الطبيعية، فإذا تأكدت هذه التنبؤات بواسطة دراسة فعلية للغة طبيعية ما كان الميكانيزم النظري أو الصوري ذا واقعية نفسية، ولكن القياس المنطقي المعبر عن هذه القضية لا يستجيب لشروط الصرامة المنطقية، لأنه يتضمن عنصرا جديدا لا تحتويه المقدمات والنتائج.
P É q
q¢ ~
r ~ p¢ ~ ..
مفاد هذه المعادلة أن أساليب التحليل في الصواتة تقوم بتنؤات حول التغيرات في اللغات الطبيعية، هذه التنبؤات (q) ليست صحيحة (q¢)إذن الميكانيزم النظري (P¢)، ليس له واقع نفسي موازي (r) فظهور (r) كعنصر غير متضمن في المقدمة والنتيجة يجعل من كل استدلال في النظرية التوليدية استدلالا غير برهاني:
“هذا الاختلاف يعزى في نظرنا إلى الظواهر التي تحيل عليها مقدمات والنتيجة على التوالي”. لأن المقدمات تحيل على التحولات اللسانية وهي مسألة دياكرونية، أما النتيجة فمجالها الإحالي سانكروني، أي القدرة اللغوية لمتكلم-مستمع في الحاضر، إن هذا التحول يسمى في المنطق “بالنقلة النوعية”، والثغرة المنطقية في النظرية التوليدية هي كونها لا تفسر لماذا تعتبر المعطيات الدياكرونية أو النفسية-العصبية.. واردة لتقويم الفرضيات اللسانية الذهنية. إلى أي حد نعتبر نظرية صواتية صالحة من جهة التنبؤ بالمعطيات اللسانية وتحولاتها كافية لتستعمل من أجل الاستدلال على صحة نظرية وصفية تتجسس على قدرة المتكلم-المستمع؟، فالنظرية التوليدية لا تميز تمييزا ميتودولوجيا بين النبؤ والوصف، إذ ليست كل نظرية تقوم بتنبؤات جيدة، نظرية وصفية لائقة بل إن تاريخ العلوم شاهد على ضرورة إقامة هذا التمييز. والمسلك السليم هو: “فلأن الأنحاء مصاغة في إطار نظرية لسانية عامة، شكلها ومحتواها محددان بواسطة المبادئ النظرية ومواضعات الكتابة المدمجة في النظرية العامة، مما يستلزم إبطال مفعول المعطيات الخارجية في تقويمها للأنحاء، لأن الأنحاء تقوم عبر الميكانيزمات التحليلية والصورية للنظرية العامة”. فخلافا لمواضعات التقليد العلمي الذي يستدل على ورود دليل خارجي انطلاقا من التجربة، لأن تقويم الفرضيات ودحضها مسألة تجريبية: “على كل لساني يلجأ إلى معطيات تمس مظاهر لهجية، أو نفسية-عصبية أو مظاهر أخرى خارجة عن اللغة، ويستثمرها كحجج واردة لتقويم الفرضيات الذهنية والتي تختلف محتويات مقدماتها نوعيا عن محتويات المعطيات أعلاه، أن: 1- أن يبلور مقياس ميتودولوجي عام يبرهن به على ورود هذا الدليل الخارجي. 2- أن يبين بواسطة هذا المقياس أن المعطيات الخارجية التي سيستعملها تشكل حجة واردة لتقويم الفرضيات. في حدود معرفتي لم يقدم النحاة التوليديون أية مساهمة لمعالجة القيود أعلاه بطريقة مرضية”.
ومما يدل على غياب أي مقياس استدلالي في النظرية التوليدية كونها لا تعتمد على نظرية حساب درجات ورود الحجج الخارجية، فالتوليدي يعتبر من الناحية الحدسية أن المعطيات الفيزيولوجية أو الإدراكية ذات دلالة في معالجة القدرة اللغوية، فيلغي جل المعطيات الأخرى، ففي غياب مقياس للملائمة تكون النتائج التي تصل إليها اللسانيات التوليدية حول نسق القواعد المستبطن في ذهن المتكلمين، محط شك: فتحت أي معيار يعتبر بوسطال أن معطيات علم الفيزيزلوجيا والإدراك واردة في الاستدلال اللساني، وتحت أي معيار يعتد كيبارسكي بالمعطيات التاريخية؟
يستعمل التوليديون الحجج الخارجية من أجل وظائف أخرى ويمكن حصرها في: 1) وظيفة توسيع خقل التفسير في النظرية العامة والأنحاء الخاصة، 2) إفراز دعامة نفسية صارمة للفرضيات اللسانية، 3) تعطي للنظرية اللسانية قدرة اكتشافية تتجاوز مجال الفرضيات اللسانية التطبيقية إلى مجال النظرية العامة.
فيما يتعلق بالوظيفة الأولى، تفضل النظرية التي تفسر المعطيات التجريبية ومعطيات لسانية خارجية نظرية تعجز عن تفسيرها. فنحو كيبارسكي التوليدي يمايز بين النظريات التي تحقق كفاية تفسيرية في مجال التغيرات الدياكرونية للغة، وبين النظريات التي لا تفسر تلك التحولات. إلا أن الوظيفة الأولى للدليل الخارجي تواجه عدة مشاكل ميتودولوجية يلخصها بوطا في: “لا نعتبر معيار توسيع مجال التفسير وحده كافيا للمفاضلة بين الأنحاء لماذا سيفضل هذا المعيار، معايير أخرى كبساطة النظريات وإنتاجياتها الاكتشافية؟.. فالنظرية يجب أن تكون أكثر من مجرد التلخيص محكم للمعطيات، وذلك حينما تعنى بوضع فرضيات حلو ظواهر غير مألوفة في البحث العلمي أو غير المعروفة فهي تمارس الوظيفة الفعلية للعلم باعتبارها أداة فعالة لاكتشاف المعطيات”. فيما يتعلق بالوظيفة الثانية، تلعب الحجج الخارجية دورا بارزا في الاحتفاظ بفرضية نحوية معينة، لأنها تؤدي إلى اعتقاد بصحة الفرضية بين أطراف العشيرة العلمية، حتى في غياب وسائل موضوعية لاختبارها.
وأخيرا تدفع المعطيات الخارجية اللساني إلى اكتشاف المحتوى الفعلي لما يجب أن يكون عليه النحو والنظريات اللسانية، لأن العالم لا يمتلك قواعد توجيه صارمة ومنطقية لبناء الفرضيات وإنما يصل إليها بواسطة الحدس العلمي ومن ثمة تقيد المعطيات الخارجية شكل بناء الفرضيات اللسانية، من ذلك قادت الدراسات المنجزة حول العمليات التكلمية والإنجازية في علم النفس اللغوي إلى أن التحويلات لا تملك واقعا نفسيا في دماغ المتكلم بلغة معينة، وأيضا إلى اعتبار قواعد إسناد النبر في اللغات الطبيعية ذات طبيعة سلكية. لذلك يجب أن تعكس الأنحاء والنماذج اللسانية المتبناة هذه العمليات الذهنية في إطار نموذج صوري.
تعالج الإبستمولوجية الوضعية لدى رودولف بوطا الوضع الاستدلالي للدليل الخارجي في اللسانيات التوليدية، وتحاول الإمساك بالثغرات الاستدلالية التي ينبغي إلى الدرس التواليدي أن يعتد بها حين بناء الفرضيات اللسانية الذهنية، ومقاربة بوطا لا تنسحب إلا على النظريات التي تأخذ بافتراض الواقعية النفسية للنماذج النحوية، وهي بذلك لا تطول النظريات التي تعتبر اللسانيات جزءا من الرياضيات، وليست جزءا من علم النفس كالنحو المركبي المعمم والنحو الواقعي.
تتصور هذه الإبستمولوجية أن مشكل الأسبقية أو الفرعية لا يأخذ معناه العلمي الاستدلالي إلا في إطار خريطة إبستمولوجية، نتصور فيها أن التعميمات الدالة هي أوصاف داخلية، وأن التفسير يكون خارجيا، وهنا يتبين أن القول بخارجية مشكل من المشاكل يتحول إلى افتراض حول الخريطة الإبستمولوجية. حينها يكتمل الاستدلال عن واقع الظاهرة الداخلي (في اللسانيات) بالاستدلال عن واقعها الخارجي (في علم النفس وعلم الأعصاب وعلم الاجتماع..)، بل تتلازم النتائج حول واقع الظاهرة في الأصل والفرع (الداخل والخارج) بشكل يجعل أي تصور في الأصل مرتبطا بالتصور في الفرع، وكذلك العكس. فالقول بالخارجية لا يخلق علاقة في اتجاه واحد، ومن هذه الجهة يرتبط الاستدلال في اللسانيات الآخذة بمفهوم الواقعية النفسية بالنتائج المحصل عليها في السيكو-لسانيات وكذلك العكس[14]. تقول بريزنن وكابلن في هذا الشأن: “إن أشكال الواقعية ليس إشكالا فلسفيا أنطولوجيا، كما يعتقد تشومسكي (أي معرفة هل البناءات النظرية تقابلها عمليات وذوات ذهنية فعلية)، ولكن الإشكال علمي، وهو أن هذه البناءات بإمكانها أن توحد نتائج البحث اللساني والنفس-لساني ومعالجة المعلومات في الإعلاميات، لتقدم صورة نموذج الإنجاز اللغوي الذي يأخذ بافتراض القدرة”[15].
تتناول الإبستمولوجية الوضعية بالدرس والتحليل، ما تركته الإبستمولوجية الجدلية في الظل، أعني قوالب الاستدلال والبراهين في اللسانيات النظرية، ولذلك يصح أن تنعت بالإبستمولجية العلموية، لأنها تقنن النشاط العلمي بمعايير كلية تضبط كفاية قواعد القياس في كل الممارسات العلمية: سواء كانت لسانيات أو غير لسانيات.
تركت مطارحات بوطا تأثيرا واضحا في الأوساط العلمية، ومباشرة بعد ترجمة المقال إلى الفرنسية، أخذ بعض التوليديين الفرنسيين كنيكولا روفي وجان كلود ميلنر وإيفس بولوك يشككون في النواة الصلبة للبرنامج التوليدي، أي كون اللسانيات فرعا من علم النفس أو البيولوجيا، لتصبح هذه الحقول العلمية إبستمولوجية جهوية، بالمعنى الباشلاري في إطار اللسانيات النظرية. يقول ميلنر: “لماذا اللسانيات في حاجة لتحقيق مشروعيتها وصرامتها العلمية إلى برنامج العلوم الصلبة (البيولوجيا أو علم النفس.؟)، لماذا لا تكتفي بموضوعها؟ من ثمة نشكك في قدرة العلوم الصلبة على حل معضلة الخواص اللسانية المجردة في علاقتها بخصائص الشفرة الوراثية للدماغ.. فإلى حد الآن يبدو لنا أن أساليب البرهنة والدحض المتبعة من لدن التوليديين لا ترتبط بما يجري في علمأعصاب الدماغ أو البيولوجيا.. فالشفرة الوراثية للعضو المتعلق باللغة والأعضاء المتصلة به تمتلك منطقها الخاص والتي لا علاقة بمنطق بناء المبرهنات والبديهيات الكلية في اللسانيات ما دامت هذه الأخيرة تسلك مسلك الأساليب المتبعة في العلوم الحقة والمتعلقة بالمفاضلة بين النظريات ودحضها”[16].
د – الدلالة الإبستمولوجية للمحاور في استقراء سيرورة النشاط العلمي: النظرية التوليدية كنموذج.
لقد انفردت الإبستمولوجية الأنجلوساكسونية بعدة مفاهيم خاصة لتحليل الفكر العلمي، إذ تنطلق من مفترض نظري لا يؤاسر دلالة الإبستمولوجية لدى الفرنكوفونيين، لذلك أتت مقارباتهم للخطاب اللساني من هذه الجهة متميزة، فبينما ركز التقليد الفرنسي على سيرورة التكوين والقطائع والعتبات الأساسية في تاريخ العلوم، كان نظر الأنجلوساكسونيين يتجه إلى آليات الاستدلال في العلوم. والمقاربة المحورية بدأت تظهر معالمها مع الإبستمولوجي الأمريكي جيرالد هولطن، وتم اقتراضها ونقلها إلى مجال اللسانيات مع اللساني الإيطالي ماسيمو بياتلي بالماريني[17]. والغاية من هذه المقاربة التدليل على كون البرنامج التوليدي تنحدر محاوره من تقليد علمي ظهر منذ القرن 18، وتعد هذه أول محاولة للبحث عن الأصول العلمية والمعرفية لنظرية التوليدية، ما دام من المفروض أن يكون التاريخ الفكري والنظري خطيا ومتصلا وتراكميا من جهة محاوره، فإذا طرحت: “إشكالات ولو كانت قديمة، فإنها تطرح في صيغة تقنية، وبتمثل تقني جديد يعتمد الأنساق الصورية والحساوبية الجديدة، ولا يمكن طرحها في صيغة الكلام العفوي أو الأفكار”[18].
فما هي الدلالة التي يعطيها هولطن للمحاور؟ ما وظيفتها في فهم آليات الفكر العلمي؟ كيف يمكن استثمارها للإمساك بالأصول العلمية للنظرية التوليدية؟ يحصر هولطن وظيفة التحليل المحوري للعلم في: “دراسة الاقتضاءات الموجهة للبحث الأساسية، والمفاهيم والحدود والقرارات والأحكام المنهجية.. أو بعبارة المحاور أو المحوريات، والتي لا يمكن استخلاصها من الملاحظة الموضوعية أو النشاط العقلاني ذي النمط المنطقي..”[19]. والمحاور ضمنية في العلوم، وعلى الرغم من اتساع مجال التحليل المنطقي والرياضي أو الوسائل الاختبارية والتجريبية في تاريخ العلوم ظل عدد المحاور الأساسية محدودا، حيث يمكن الاحتكام إلى ثنائيات أو ثلاثيات محورية قديمة تعاود الظهور في صيغ تقنية مختلفة داخل النشاط العلمي كمحورية: الثبوت والتحول والصورنة والتجربة والتعقيد والبساطة في الأنساق الرمزية والاتصال والانفصال والوظيفة والغائية…، بل تقدم العلوم لا يجد دلالة إلا في طبيعة الانزياحات والعتبات والقطائع المحورية التي تحدثها نماذجه، من ذلك أن الفكر العلمي للقرن 20 يتأسس على محورية مضادة للفكر السابق عليه، وهي محورية نسبية المعرفية مقابل حتميتها، وقد أدى هذا التحول إلى اعتبار النظريات العلمية نسق افتراضات هدفها مساعدة الباحث على التعامل مع التجربة والواقع المبني لا المعطى، مما أفرزه هذا التحول تشظي التصور المطلق للعقلانية وبروز عقلانيات جهوية تتمفصل مع الاتجاهات التخصصية في العلوم، بل له إمكانية تأسيس أنساق رمزية متباينة لا يجمعها إلا اتساق مقدماتها ونتائجها. وجماع الأمر يحصل التقدم في العلوم بفضل إبطال إجرائية المحاور القديمة أو إعادة استثمارها في صيغ تقنية جديدة، وهذا شأن التحول في اللسانيات التوليدية التي قطعت مع محورية البحث في اللغة، لتوجه اهتمامها إلى النحو وأخيرا نلاحظ أن محور أحادية أصل اللغات ساهم كثيرا في تعطيل نمو البحث اللساني، وتنضاف إلى ذلك طرائق مقاربة البنيات المعرفية والذهنية عند الإنسان التي كان ينظر إليها في البحوث الفلسفية التقليدية على نحو مخالف للبنيات العضوية، وإحدى النقلات الدالة في علم النفس المعرفي دراسة البنيات المعرفية بشكل مواز لمقاربة أعضاء الجسم، فحسب تشومسكي ينبغي أن تعالج اللغة البشرية: “بكيفية مماثلة لتلك التي سيدرس بها عضو مثل العين أو القلب، ساعيا إلى تحديد: 1) خاصياته لدى فرد معين، 2) خصائصه العامة التي لا تتغير من نوع لآخر، بغض النظر عن كل نقص واضح، 3) موقعه ضمن نسق بنيات من هذا النمط، 4) مجرى نموه لدى الفرد المعني، 5) الأساس المحدد تحديدا وراثيا لهذا النمو، 6) العوامل التي أدت إلى ظهور هذا العضو الذهني أثناء النمو”[20]. إذا كان انشغال النحو التوليدي بفطرية المعرفة البشرية يشكل النواة الصلبة لبرنامجه، فإن تشومسكي لا يفتأ يشدد على القطيعة مع التصورات الميتافيزيقية التي ترجع المعرفة التي يطورها ذهن الإنسان إلى ذات متعالية، وليس إلى أسباب وراثية متعلقة بالنوع البشري، فإذا كانت التصورات العقلانية مكسبا هاما في تاريخ الأنساق المذهبية للفكر الأوروبي، فإن التوجه الذي ينبغي أن يسلكه الدرس اللساني لمقاربة بنيات الفهم عن الإنسان يجب أن يكون استمرارا لذلك التاريخ من جهة اقتراضه للمواقف التي على اللسانيات أن تسلكها لفهم بنية الدماغ البشري، وانفصالا عنه من جهة تحويل النظر من المتعالي إلى الواقعي أي الأسباب الوراثية والنوعية المتعلقة بالجنس البشري والتي تؤدي إلى استعمال خلاق للغة، وحاصل الأمر، لم تحصل تلك القطيعة إلا بموجب تفاعلات وأزمات حصلت في مجال العلوم الطبيعية وبالضبط في حقل البيولوجيا وعلم الوراثة والفيزيولوجيا، والتي أفرزت محاور جديدة في الفكر العلمي، دفعت البرنامج العقالني إلى تحويل مستويات النظر من المتعالي إلى المتجسد[21]. ومن ثمة لا يمكن فهم المقدمات المعرفية في النحو التوليدي إلا حينما نكشف عن تلك الأزمات الفعلية في الفكر العقلاني الأوروبي، لذلك نزعم أن الإمساك بتلك اللحظات في تاريخ البرنامج العقلاني سبيلا إلى حصر الأصول العلمية للدرس التوليدي، ومن هذه الزاوية تأتي مشروعية التحليل المحوري للعلوم، سنحاول إذن تتبع المفاهيم المحورية للبرنامج العقلاني بدءا من القرن 18 وصولا إلى بداية القرن 20، وهدفنا موضعة الفكر التوليدي داخل إرث نظري وملامسة مياسم التقاطع من جهة المفاهيم والمناهج: 1) يمكن التمييز بين برنامجين علميين سادا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 انصب مجال تفاسيرهما على الخصائص المعقدة للكائن الحي، أحد هذين البرنامجين ينطلق من فرضية أساسية وهي أن العضويات مزودة بشفرة وراثية تحدد الخصائص المطردة للنوع، وأن تلك الخصائص لا تأتي من الخارج أو المحيط، وإنما تنبثق من الطبيعة الداخلية والمبرمجة للنوع. بينما يسلك البرنامج الثاني طريقا مغايرا لتفسير الخصائص الظاهرية، ويعتقد أن البنية المنتظمة تأتي نتيجة سيرورة إعادة الضبط الذاتي المستمرة من خلال تفاعل بين البنيات الداخلية والتي ليست مهيأة وراثيا بكل الخصائص الملاحظة، لتصل إلى حالة التوازن النهائية.
2 – ظهر محور البنيات القبلية مع جوسييه في مجال علم النباتات، حيث تم إحداث أنموذج جديد لتوجيه التفسير العلمي يتمحور حسب بالماريني حول: -معالجة البنية الميكروسكوبية أو الصغرية للكائنات، أو التمظهرات الجزئية والنوعية للعضويات- كل تغيير في البنيات الداخلية، يعود نفسيره إلى القوانين الذاتية للعالم-الصغري أو الجزئي للكائنات، ولا يمكن إرجاعه إلى المحيط الخارجي، والقطيعة الإبستمولوجية حدثت مع العالم الطبيعي ويشمان: “ولأن الجزئيات الفرضية لا يمكن أن تنظم حسب اختيارات عشوائية، ولكن حسب خضوعها للقاعدة محددة سلفا وحسب علمي، لا يمكن لعالم أن يعزو هذا النظام المنسجم إلى قوة إلاهية.. وإنما إلى قوانين طبيعية داخلية”. وسرعان ما استطاعت العلوم أن تحل لغز هذا النظام مع الاكتشاف الرائد للصبغيات، والثنائية المفهومية: النموذج الوراثي والطبع الوراثي أو الظاهر، والتي استثمرها تشومسكي في نظريته تحت مفهومي النحو الكلي والخاص، فالنحو الكلي هو مجموعة القوانين الوراثية التي يتقاسمها البشر، ومن هذه الجهة يماثل مفهوم النموذج الوراثي الضروري لبناء النموذج النوعي المكتسب، كما أن النحو الكلي ضروري لاكتساب لغة معينة من خلال إثبات برامترات تحددها التجربة المحيطية، كان النموذج الوراثي ذا أهمية لتطور العضويات في تفاعلها مع الوسط. فالقدرة الوراثية تدمج جميع إمكانيات التحقق المتعلقة بالنوع، ويبقى دور المتغيرات محصورا في تحديد تحقق نوعي وخاص لجل الإمكانيات التي يتيحها النسق الوراثي. لهذا كانت لاكتشافات واتسن وكريك في حقل علم الوراثة دلالة كبيرة بالنظر إلى التصورات السابقة، إذ حاول ضبط البنية الداخلية لتلك القدرة الوراثية الداخلية وتحديد قوانينها التأليفية السابقة على كل تفاعل مع المحيط الخارجي، ويبقى دور التجربة المحيطة محصورا في إثارة تلك البنية الداخلية، لتحدث تأليفات جديدة بين العناصر الوراثية المبرمجة في الكائن الحي، مما يؤدي إلى الاختلافات السطحية، ومن هذه الجهة نلمس تشابها في الأجهزة الاصطلاحية الموضفة عند البيولوجيين وتشومسكي، حيث يستعمل هذا الأخير مصطلح الإثارة للدلالة على نفس الشيء، ويستعمل البيولوجيون مصطلح التقلبات التذبذبية، إذا مجال التفسير في الدرس التوليدي هو البنية الداخلية للمتكلم-المستمع المثالي، كما أن البيولوجيين حصروا موضوعهم في إطار المنطق الداخلي للبنيات الوراثية المبرمجة مسبقا في الكائنات الحية. وأخيرا نلحظ التشابه في فرضيات العمل بين كل من البرنامجين، فالتوليدي يعطي الأسبقية المنهجية لدراسة التنظيمات الممكنة أي النحو الكلي التي تنتج عنه أنحاء خاصة بموجب شروط محيطية محددة، على كل دراسة لتحققاته المتعددة وتمظهراته الخاصة، وهدف البيولوجي الوصول إلى القوانين الكلية المنظمة للنموذج الوراثي، وهذا التشابه يؤدي في منظورنا إلى إبراز تقاطع قوي بين اللسانيات التوليدية وبرنامج البحث العلمي في مجال البيولوجيا، وهذا التقاطع يبرز في عدة مستويات:
أ) من جهة المفاهيم المقترضة والتي استثمرها تشومسكي نظرا لانسجامها مع أهداف النظرية التوليدية، ولا ينبغي على الاختلاف الملحوظ في المصطلحات أن يخفي وحدة المفاهيم ووحدة الاتجاه.
ب)من جهة فرضيات العمل، إذ يمكن استنتاج اتصال النظرية التوليدية ببرامج البحث العلمية المعاصرة، حيث ترمي إلى استثمار نتائجها في دراسة البنيات المعرفية عند الإنسان، وانفصال عن الأفق المعرفي للأنساق العقلانية الفلسفية التي تربط فطريات المقولات الذهنية بمفاهيم متعالية، ولا تستضمر في برنامجها أي إمكانية للدراسة التجريبية لتلك الخصائص الفطرية المزعومة. وجماع الأمر نعتبر بعد بالماريني أن الدرس التوليدي وريث فكر عقلاني ظهرت مياسمه العلمية مع انطلاق الطبيعية في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، ومن ثم تهدف المقاربة للنظرية التوليدية إلى الحفر في الأصول العلمية والمعرفية للسانيات الديكارتية، وللتدليل على كون هذه اللسانيات تمتح من جهة المصطلحات ومناهج البحث العلمي من ذلك الإرث العلمي. لقد اعتبرنا من جهتنا أن ذلك الموروث العلمي استمرار لمحورية مفهومية عرفها الفكر الفلسفي عبر تاريخه، أي محورية العقلانية، والتي حول مجالها من المتعالي إلى التجريبي، ولم يحدث هذا التحول إلا موجب التقدم الحاصل في العلوم الطبيعية. ولأن برنامج هامبولت وياسبرسن وسابير..، انشغل بمسالة الكليات اللغوية كإطار لتوجيه البحث اللساني لم تكن عندهم اللسانيات جزءا من علم البيولوجيا، ولأن الدرس اللساني ظل حبيس التصورات الفلسفية للنحو العام، لم يكن بالإمكان وضع برنامج علمي متسق لدرس النحو الكلي، ولذلك كانت الانطلاقة التوليدية دالة في تاريخ اللسانيات الكارتيزية فهي استمرار للبرنامج أعلاه ولكن هذه الاستمرارية ليست ممكنة إلا من جهة تقاطع اللسانيات والبرنامج العقلاني في العلوم المعاصرة وذلك ما تستعلن عنه كتابات تشومسكي صراحة أو ضمنا، ومن هذه الجهة نشاطر الأستاذ الفهري في نعته للدرس التوليدي بالثورة المعرفية الحديثة، إذ ساهم بدراسته للغة البشرية وفق المنحى الديكارتي في الإبانة عن طبيعة أنساق المعرفة والاعتقاد في الذهن البشري، بل له التقدم التقني للحوسبة وأساليب بناء النماذج الصورية.
تتسم خصوصية المقاربة المحورية للسانيات التوليدية، كما قدمت من خلال اللساني الإيطالي بالماريني، في إدماج مستوى جديد للتحليل ينضاف إلى المستوى الوصفي والمستوى الميتودولوجي من منظور الإبستمولوجيين الوضعيين، وهو المستوى المحوري، فإذا كانت المفاهيم الواصفة والقضايا العلمية لها إسقاطات على البعد التجريبي من حيث جواز روزها وإبطالها، وإسقاطات تحليلية من منظور رياضي-صوري من جهة اتساقها الداخلي وتوظيفها لآليات منطقية ونمذجية معمول بها في العشيرة العلمية، فإن البعد المحوري يظل مهمشا في تاريخ المقاربات الإبستمولوجية للعلوم. لذلك لن تتكامل الرؤية المتسقة لبرنامج البحث العلمي في اللسانيات إلا بإدخال مستوى محوري، وهذه الرؤية تنسحب على الخطابات الإبستمولوجية التي تناولت الدرس التوليدي من جهة مقدماته الفلسفي والتصورية، ومن جهة آلياته الاستدلالي، وهمشت الأصول المحورية التي شكلت الركيزة الأساسية للبرنامج التوليدي وهي محاور العقلانية المعاصرة في صيغتها المعدلة مع البيولوجيين وعلم النفس المعرفي.
مثل هذا التحليل يمكن أن تستثمر نتائجه لدراسة تاريخ اللسانيات، إذ الغاية من إقامة تأريخ للفكر اللغوي، لا تنحصر في الوقوف عند القضايا اللسانية المناقشة وإنما في الكشف عن الأفكار والمحاور الموجهة للبحث اللغوي، وهكذا قد يبدو أن تاريخ الأفكار اللسانية يضم اتجاهات متعارضة، إلا أن الأصول والمقدمات التي تؤسس عليها أقوالها العلمية قد تكون واحدة، إذا كانت تجمعها محاور موحدة، وعلى العكس نفهم القطيعة في تاريخ اللسانيات على أنها تأسيس لمحاور جديدة في الدرس اللغوي، كمحورية اللسان كموضوع مجرد ومبنين ومتمفصلة مستوياته، ومحورية النحو كموضوع للسانيات بدل اللغة..
يندرج هذا الهاجس ضمن إشكاليات اللسانيات العربية التي تروم: “بناء نظرية تؤرخ للفكر اللغوي العربي، بعيدا عن الإسقاطات الظرفية، بتبني منهجية المحاور والنفاذ إلى الأفكار الدالة والمبادئ المحورية الموجهة للدرس اللغوي عند العربي”[22]. إذ قد نجد محوريات قديمة تتكرر في خطابات حديثة، كمشكل علاقة الوظيفة بالدور الدلالي، والإعراب بالدور الدلالي، وعلاقة الشكل بالمعنى والبنية بالوظيفة التداولية، وهي مشاكل نظرية نعثر عليها في جل الأنحاء القديمة عربية أو غير عربية: “هناك تقارب على مستوى المحاور [بين اللسانيات القديمة والحديثة]، إنما على مستوى الظواهر وعلى مستوى صيغ ووسائل مقاربتها، هناك في كثير من الأحيان قطيعة”.
ـ كاستون كرانجر: من إبستمولوجيا اللسانيات إلى إبستمولوجيا الأنساق الرمزية للغات[23].
إن تطور إبستمولوجية اللغة مشروط بحالة العلوم التي تجعل من المعطيات الرمزية موضوعا لها من أجل وصفها أو بنائها. ويبدو أن طرح إبستمولوجية اللغة أتى كاستجابة لتحولات في فلسفة الأنساق الرمزية، نجملها [ التحولات ] في:
1 – بروز المنطق الرياضي كدراسة نقدية وبنائية للنماذج الصورية؛ فقد أدى تكون هذا الفرع المعرفي إلى تجديد بعض المسائل القديمة المتعلقة بفلسفة الأشكال الرمزية على وجه العموم، وتوجيه عناية اللغويين ببنية اللغات الطبيعية على ضوء التجديدات التي لحقت النماذج الصورية والرياضية .
2 – ظهور دلالة شكلية من طرف تارسكي وبولزانو، مما أدى إلى مساءلة دور المنطق في أنسقة الأوصاف الدلالية للغات الطبيعية، أما باعتباره أداة لبناء الأنحاء أو باعتباره نموذجا لهذه الأنحاء، وهكذا فالمساجلات في الأدبيات اللسانية بهذا الشأن تفضي إلى التمييز بين موقفين:
أ- الأول يعتبر المنطق أداة لصوغ نحو للغة الطبيعية، ويستبعد نموذجية المنطق بالنظر إلى اللسانيات، ولذلك ينكر على الأنساق الشكلية للمنطق دور النموذج المثالي للغات الطبيعية، ففحص بنية اللغة الطبيعية المدروسة هو وحده الذي يمكن أن يمدنا بقاعدة لتبرير اختيار نسق شكلي كنموذج للغة الطبيعية . والحجة الثانية تتعلق بافتقاد الأنساق الشكلية للقدرات التعبيرية الغنية في اللغات الطبيعية .
ب – الموقف الثاني يشدد على كون المنطق جزءا من نظرية اللغة، يقترح بارهيل إدماج المنطق في علم الدلالة الكلي وفي قواعد الدلالة ويستبدل مونطاك مفهوم البنية العميقة بمفهوم الشكل المنطقي، وهكذا يصبح المنطق في منظور مونطاك وسكوت جزءا مكونا لنظرية اللغة نفسها، مما يستبعد كل تصور أداتي له في علاقته باللسانيات.
3 – كان لفكرة بناء خوارزمي للأنساق الشكلية والمطبقة على اللغات الطبيعية، كقيد بول على التحليلية، ونظرية المجموعات والمتواليات، تأثير على نظرية البنيات الصورية الممكنة للغة الطبيعية[24]. وجماع الأمر، لقد ساهمت التطورات المعرفية في حقل المنطق الرياضي في بلورة قضايا إبستمولوجية مدارها اللغة الطبيعة والنماذج الصورية الممكنة لتمثيلها. إلا أن هذا التحول أتى بموجب التجديد الحاصل في اللسانيات نفسها، إذ لم يكن بالإمكان صياغة تلك القضايا، لولا النظر إلى موضوع اللسانيات كبنية شكلية مجردة ومبنينة في مختلف المستويات اللغوية (الصوتية والصرفية والتركيبية..): “فالنتيجة الضمنية لهذا الطرح، تتعلق بتقييد المقاربة العلمية للغة لبناء النماذج المجردة لتلك المستويات ولإمكانيات تمفصلها المبنين مع هيلمسليف ومارتيني، إلى حد نفي قدرة المعطيات على دحض أو تأكيد نظرية لسانية، فدور النظرية عند هيلمسليف هو تحقيق الشمولية وعدم التناقض والانسجام، فهي مرجع بسيط للوصف، واستراتيجية لاختزال المفاهيم”[25].
لكن مسار الدرس اللساني المعاصر يقدم لنا نظريات متضاربة، تختلف بالنظر إلى ما تعده نموذج مجرد للبنية اللغوية، وهذا التعدد في الأنساق الرمزية يستدعي تدخل إبستمولوجية للنماذج الصورية تبين قدرتها على دراسة الخصائص والمبادئ الانتظامية المفترضة في اللغات الطبيعية، وتقويم مفترضاتها النظرية حول سيرورة التواصل اللغوي. يرى كرانجر أن هدف إبستمولوجية اللسانيات الإجابة عن الأسئلة التالية، وتحديد حلول مناسبة للقضايا المتصلة بها:
1 – ما هي الخصائص التي يجب على كل نموذج مجرد لتمثيل اللغة كنسق أن يستجيب لها؟
2 – هل يمكن بلورة بنية كلية للغات الطبيعية مع التنوع الواقعي للغات الطبيعية وتعقيد الأنحاء؟
3 – ينبغي المفاضلة بين ثلاثة نماذج للغة الطبيعية: نموذج استقرائي يصف نسق اللغة ونموذج تأليفي يأخذ بعين الاعتبار تعقيد انتظام اللسان من الناحية التركيبية أو الصوتية أو الصرفية، ونموذج كلوسيماتي غارق في التجريد، إذ يعود أمر المفاضلة إلى إبستمولوجية اللغة الرمزية التي تصوغ قيودا وفرضيات صارمة حول نسق وتبنين الألسن الطبيعية.
4 – على هذه الإبستمولوجية أن تكون شاملة وعامة، إذ ينبغي أن تقطع مع الدراسات التي حاولت صورنة الأنساق –الفرعية في تعابير اللغات الطبيعية، من أجل بلورة منطق نوعي لها (مثل دراسة منطق الزمن أو منطق الجهة في لغة ما).
5 – إقامة إبستمولوجية مقارنة بين الأنساق الرمزية اللسانية وغير اللسانية لحصر حدود إمكانية استفادة الأولى من الثانية.
6 – تنطلق هذه الإبستمولوجية من فرضية موجهة، تنظر إلى اللغة كنسق رمزي معقد من الناحية البنيوية والوظيفية، وأن السبيل الوحيد لمقاربته هو تقسيم اللغة إلى مستويات تمثيلية متمايزة ومتمفصلة في الآن نفسه كالمستوى الصوتي والتركيبي والتداولي، ومحاولة ضبط انتظامات هذه المستويات والقوانين الثاوية فيها، يقول كرانجر في هذا الشأن: “ولأن اللغة محددة تحديدا مضاعفا ينبغي على الفكر الشكلي المنمذج لها أن ينفصل إلى أنساق متنوعة تصف أو تفسر مستويات انتظامها”، ووفق هذا التحديد لن تعود النماذج الرمزية مجرد أدوات صورية لإجراء التمثيلات اللسانية، وإنما ستغدو البنية المحايثة للغة نفسها، لأن اللغة الواصفة تترجم على المستوى المفاهيمي التمفصلات المبنينة في الألسن الطبيعية. ومن هذه الجهة تنصهر اللغة الواصفة في النظام اللغوي، خلافا للطروحات اللسانية التوليدية التي تقوم على اعتبار المفاهيم الواصفة خارجة عن هذا النظام، ولذلك أمكن لإبستمولوجية اللغة أن تقترض مفاهيما لضبط موضوعها من علم البيولوجيا ومن النظرية الكارثية لروني توم[26]: كمفهوم الضبط الذاتي والانتظام والاستقرار، وهي مفاهيم تعكس الخصائص البنيوية المجردة للأنساق الرمزية سواء كانت عضوية أو غير عضوية لذلك فهي تندرج في إطار سيميوطيقا عامة.
تنفرد نظرية كرانجر بمميزات خاصة، تبرر الاختلاف بينها وبين النظريات الإبستمولوجية السابقة، لكن تجمعها والإبستمولوجية الوضعية خصائص مشتركة تبرز خصوصية البرنامج الوضعي في كليته من ذلك:
أ – إبستمولوجية اللسانيات موضوعها لغة العلم، وأساليبها البرهانية والقياسية، لذلك حصرت إبستمولوجية كرنجر موضوعها في نطاق الأنساق الرمزية وكفايتها في النظريات اللسانية، وأن هدف اللسانيات ليس الوصول إلى كليات لغوية مزعومة، وإنما الكشف عن الخصائص الداخلية التي تجعل من اللغة نسقا مبنينا بامتياز.
ب – يتحصل من كل ما سلف أن كرانجر لا يخضع اللسانيات إلى معايير علمية سابقة عن كل نشاط عقلاني كما هو الشأن عند بوطا، بل إن إبستمولوجية هذه اللسانيات جزء لا يتجزء من الطبيعة البنيوية للنماذج الرمزية على وجه العموم، ومن النسق الداخلي والمحايث للغة على وجه الخصوص والذي على الإبستمولوجية أن تحدد خصائصه للنظر بعد ذلك في إمكانية وحدود النماذج اللسانية والرياضية على تمثيلها صوريا.
ج – يؤاسر كرانجر طروحات كريسيفا من جهة وعيه بكون نشأة إبستمولوجية اللسانيات أتت كاتسجابة لشروط إبيستيمية تتعلق بتطور علم المنطق وبتطور اللسانيات نفسها، ولهذا أتت نشأتها كاستجابة لضرورة معرفية.
[1] – الفاسي الفهري، المعجم العربي، ص5-6.
[2] – الفهري، اللسانيات واللغة العربية، الجزء الأول، ص65.
[3] – عن كتاب نوام تشومسكي:
Règles et représentations, le chapitre intitule, les bases biologiques des capacités langagières.
[4] – ويبدو أن أحد أسباب تقدم العلوم سواء تعلق الأمر بميكانيكا نيوتن أو كاليلو هو الاعتماد على الأمثلات، فلصياغة عدد من قوانين الحركة والجاذبية كان على نيوتن أن يضع جانبا كل الظواهر والقوى التي تعتبر غير جاذبة، فبدل أن يهتم العالم بجميع الظواهر الفيزيائية، يولي عنايته لبعضها فقط محاولا وضع مبادئ لتفسيرها، حتى إذا تأكدت نظريته في مجال معين أمكن له نقلها إلى مجالات أخرى محاولا تفسيرها. أنظر ألان شاملرز: ما هو العلم؟ وانظر:
R. Botha ; on the Galilean style of linguistique inquiry lingua 58.
والفاسي الفهري الفصل من اللسانيات واللغة العربية، الجزء الأول. يقول مارسيل بول بهذا الصدد: “يعتبر مبدأ التغاضي خيط الاهتداء بالنسبة للمنهج العلمي، فإذا لم نستطع غض الطرف عن عدد كبير من العوامل المتصلة بالظواهر المدروسة (من ذلك العوامل المتصلة بالإنجاز اللغوي في النظرية التوليدية، والتي تشوش على الباحث اللساني معرفة الملكة اللغوية، إذ الإنجاز اللغوي للمتكلم الفعلي لا يترجم ضوابط وقواعد الملكة من هنا الحديث عن متكلم مستمع مثالي) فإن ذلك يعني حرماننا من كل نشاط ومن كل معرفة”، ومن ذلك أيضا: لم ينتظر كاليلو بناء مركبات سبر الفضاء ولا إقامة تلسكوب أكثر دقة من المتوفر في عصره، أو أن تستكمل كافة إجرام الكون إحكام ذواتها في أفلاكها لكي يصوغ نماذجه الرياضية للنظام الفلكي للكون.
[5] – تشومسكي، مظاهر النظرية التركيبية، بالفرنسية، ص68.
[6] – إدريس السغروشني، مدخل للصواتة التوليدية، ص49.
[7] – مظاهر النظرية التركيبية، ص45.
[8] – Julia Kristeva ; Epistémologie de la linguistique, p7.
[9] – مظاهر النظرية التركيبية، ص61.
[10] – أنظر كارل بوبر: منطق الاكتشافات العلمية.
[11] – نفكر هنا في الفصل الأول من كتاب مظاهر النظرية التركيبية وكتاب مسائل عن الدلالة، الفصل الأول والثالث وكتاب مسائل في الشكل والمعنى، الفصل الأول والأخير.
[12] – انظر بيبلوغرافية كتاب:
Formalismes syntaxiques pour le traitement automatique du langage naturel, philip miller et therese torris.
[13] – نفكر في المقالة الأخيرة من مجلة إبستمولوجية اللسانيات والمعنونة بـ”عن الذات في اللسانيات”، ص107-125 والمسكوت عنه في هذه الأوراق هو قضية إعادة قراءة الماركسية نفسها في ظل الشروط التاريخية لفرنسا في العقد السابع من هذا القرن، فينبغي الإمساك بما لم يصرح به النص الإبستمولوجي أعلاه ليتبين أن المعرفة العلمية أو الخطاب العلمي ليس كتابة بيضاء ومحايدة وإنما متخم بالعناصر الإيديولوجية التي تتناثر بين سطوره ومن ثمة علاقة المعرفة بالسلطة والإيديولوجية.
[14] – أنظر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية، الجزء الثاني، ص184.
[15] – المرجع نفسه، الجزء الأول، ص9.
[16] – J.C.Millner ; ordres et raisons de langue, le troisième chapitre ; linguistique, biologie, psychologie, p302.
[17] – حيث أشرف على تنظيم مجموعة مقالات ألقيت في ندوة عالمية جمعت بين تشومسكي وبياجي والمقال المعني هنا هو:
A propos des programmes scientifiques et de leur noyau central, in théories du langage, théories d’apprentissage ; débat entre Chomsky et Ppiaget.
[18] – البناء الموازي، الفاسي الفهري، ص20.
[19] – أنظر بالماريني، ص22.
[20] – Théories du langage, théories de l’apprentissage, p65-87.
[21] – يقول بياجي في إحدى المداخلات الهادفة إلى تقويض برنامج العقلانيين الميتافيزيقي: “والنتيجة هي أن جميع الفلاسفة المنشغلين بالمطلق قد لجأوا إلى ذات متعالية تتجاوز الإنسان، بل تتجاوز الطبيعة على الخصوص، بطريق تمكنهم موضعة الحقيقي خارج العوارض الزمكانية والفيزيائية” والحق أن الإنسان جزء من الطبيعة لذلك ينبغي أن تدرس خصائص بنياته بمناهج العلوم الطبيعية. مجلة ديوجين، العدد 54، 1966، ص3-26 عنوان المقال: البيولوجيا والمعرفة.
[22] – التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم: محمد غاليم، ص12، رسالة جامعية.
[23] – يتعلق الأمر بكتاب: اللغة والإبستمولوجية.
[24] – أنظر، ص14 و15 من المرجع السابق.
[25] – ص200-201 من الكتاب المذكور.
[26] – أنظر:
Rene Tom ; Morphogenèse du sens, surtout le chapitre consacré aux principes de la théorie des catastrophes, p76-91 et granger, p202.
المصدر: موقع عابد الجابري