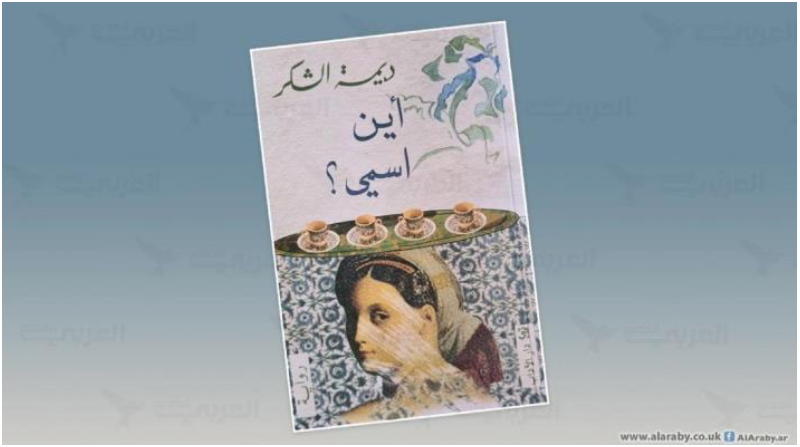نقد السرد الأدبي: مفاهيم وقضايا
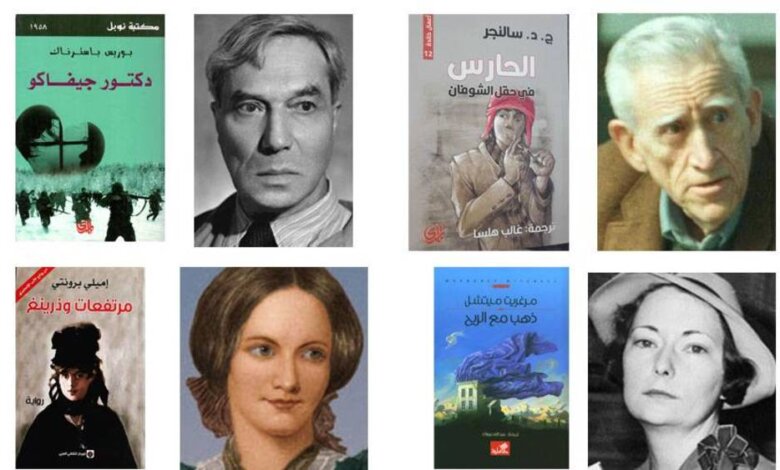
لماذا تنتقد النصوص الأدبية؟ هل مازال النقد ضروريا؟ هل تحتاج النصوص الأدبية إلى النقد؟ ماذا يضيف النص النقدي للنص الإبداعي؟ هل كل النصوص الإبداعية قابلة لأن تنتقد؟ عما يبحث النص النقدي في النص الإبداعي؟
لا شك أن هذه الأسئلة، وسواها، تضع المتأمل في جوهر ماهية ووظيفة النص النقدي، مثلما تضعه أمام البحث عن تصور (نظري) لطبيعة موضوعاته ومرجعياته ومناهجه التي يتوسل بواسطتها التعلق بألوان شتى من الأنشطة الإبداعية، وما يوافقها من تجارب ومجالات تحددها علاقة الأدب بالثقافة.
وهذا ما يجعل تصورات الأدب والنقد تواقة –على اختلاف المراحل التاريخية- نحو اكتساب خصوصية “الخطاب العلمي”. تلميحي هنا للخطاب العلمي يمكن أن أعود به –مثلا- إلى اجتهادات “الوضعيين” الفرنسيين في القرن التاسع عشر وآرائهم الخاصة ببحث أسس للمعرفة الإنسانية وتحويلها إلى نسق ممتلك لقواعد ونظم محددة قادرة على تقريب خطاب النقد من مجال الخطاب العلمي كما تتداوله مختلف تطبيقات العلوم الإنسانية.
وبالفعل، حاول النقد الأدبي أن يستفيد من منجزات العلوم الإنسانية، كما حاول استثمار مفاهيمها ومناهجها في بناء أسلوب للمقاربة يؤهله –ذات يوم- لإنتاج خطاب علمي مكتف بذاته. اعتمد الخطاب النقدي على علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجمال وعلم اللغة، لكن هل امتلك جواز مروره إلى دائرة التفكير العلمي؟ مهما يكن من أمر، فإن صفة العلم المستقل التي ينشدها النقد لن تلقي به إلا إلى دائرة العلوم الإنسانية.
خطاب النقد، إذن، لا يمكنه أن يوجد إلا في علاقة بخطاب الأدب، كما أن كل خلفية ثقافية أو اختيار معرفي يعرضه أو يستثمره ينطلق من النص الأدبي ويستند على بعض المقترحات:
أولها: امتلاك فرضية للبحث.
ثانيها: إيجاد المفاهيم المناسبة.
ثالثها: التوفر على القدرة الكافية على الاستدلال والبرهنة.
- 1 – الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث:
يشكل التفكير في علاقة الأدب بالنقد أحد المداخل النظرية في دراسة الأستاذ أحمد المديني: الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث. ويبدو لي أن الأساس الذي يوضح معالم هذه العلاقة يتولد عن صلة الكتابة السردية ذاتها وتنوع أشكالها وصياغاتها الفنية والجمالية بوظيفتها الخاصة بإنتاج الأفكار الأدبية والنقدية التي رافقت تطور كتابة السرد في الأدب المغربي الحديث، بالرغم من أن الإشكاليات التي يمكن لخطاب النقد أن يثيرها قد تختلف عن إشكاليات خطاب الأدب.
هكذا، يفتتح أحمد المديني دراسته بمناقشة مستفيضة وخصبة لوضع الخطاب الأدبي والنقدي المغربي انطلاقا من العقد الأربعيني الذي شهد انبثاق تيار تجديدي، ثقافي وأدبي، جاء موازيا لحركة يقظة وطنية عامة (را: ص5). وهذا وضع كان مناسبا لانتساب الخطاب الأدبي والنقدي المغربي، في ذلك الإبان، إلى تصور عام أدرجه في إطار ما يعرف بالأدب الواقعي والملتزم.
معنى ذلك، أن وظيفة الأدب كانت تهدف إلى إنتاج قيم اجتماعية غير منفصلة عما تستتبعه القضية الوطنية من بحث عن الهوية واسترجاع السيادة. وبهذا يصبح جوهر الأدب وما يوازيه من تفكير نظري أحد السبل المتحكمة في نشأة الأنواع الأدبية وتطورها وترسيخ الحاجة إليها.
ومن أجل الإحاطة بمختلف مميزات هذا الجوهر وفهم سياقاته الاجتماعية والثقافية والتاريخية لإنتاجه وتلقيه، يختار أحمد المديني القصة القصيرة والرواية لاستخلاص أهم المبادئ التي حققت للكتابة السردية بالمغرب شروط تداولها منذ سنة 1956 وإلى حدود سنة 1980.
وإذا كان التحديد الزمني الأول يصلنا بحدث سياسي حاسم، أي باستقلال المغرب مدشنا عهدا تاريخيا وثقافيا جديدا.. فالشيء نفسه يقال عن التحديد الزمني الثاني الذي لا يرسم حدا أو فاصلا زمنيا جامدا، بل إن عددا من النصوص المكتوبة في العقد الثمانيني تعكس نزعة تجديدية وتطورا نوعيا بشر ببداية قطيعة مع الموروث المتواضع من الأدب السردي في المغرب (را: ص12).
لماذا اختار أحمد المديني دراسة القصة القصيرة والرواية في نفس الوقت؟
لهذا الاختيار اعتبارات يقدمها الباحث عبر جملة من الإضاءات أختصرها في ما يلي:
1-لكون القصة القصيرة والرواية تنزعان، معا، إلى تشكيل كيان نصي متجانس في الأدب المغربي الحديث بحكم شروط النشأة والتطور المتشابهة. يضاف إلى ذلك، أن غالبية الروائيين هم أيضا من كتاب القصة القصيرة.
2-لأن مصطلح الجنس الأدبي لم يكن على درجة من الوضوح لدى كتاب كان شاغلهم الرئيسي أن يسردوا ويضمنوا كتاباتهم قيما اجتماعية وتاريخية محكومة بظرفية خاصة.
3-الموقع الذي احتلته القصة والرواية في الأدب المغربي الحديث ومساهمتها في تحقيق تطور مطرد لتصورات ثقافية وجمالية منسجمة.
4-اكتساب القصة والرواية –أكثر من أي نوع أدبي آخر- قدرة الانفتاح على الواقع وتحولات المجتمع.
وعليه، يتحدد إشكال دراسة أحمد المديني حول الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث بتتبع موضوعين متلازمين يحيل أولهما على مفهوم التكوين الذي يبحث في شروط وقوانين نشأة النوع الأدبي، ويحيل ثانيهما على مفهوم الرؤية الذي يقترن بتفسير العلاقة الجلية والضمنية للكتابة السردية بواقعها الاجتماعي والتاريخي والثقافي العام.
من التكوين إلى الرؤية يتحرك المحتوى المنهجي لهذه الدراسة، ويقدم للقارئ بحثا يحتوي مقاربة تاريخية واجتماعية وتحليلية لنصوص مختارة من فني القصة والرواية.
لهذين الموضوعين –في رأيي- أهميتهما على مستوى تحليل “الإطار النقدي للواقعية” في سياق ما يمثله الأدب السردي من تصورات للكتابة بالإمكان –حسب اجتهادات كل دارس- حصر أساليبها وأشكالها ومظاهر انتساب أنواعها إلى ثقافة معينة، أو رصد تحولاتها وأدوار تلقيها.
وسواء تعلق الأمر ببلورة تيار أدبي أو استطيقي للواقعية، فإن الاهتمام بدراسة الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث من زاوية التكوين والرؤية يسمح باختبار المبادئ التي تسند صلة التعبير الأدبي بشرطه الاجتماعي وبيان أوجه الالتزام ووضع المثقف المغربي خلال العقود التالية لاسترجاع السيادة الوطنية، وكذا وصف التحولات التي عرفتها الظاهرة الإبداعية خلال العقود اللاحقة.
يتجلى من هذا أن الكتابة السردية القصصية والروائية بالمغرب ساهمت بحظ وافر في إنتاج خطاب أدبي حديث وتحديثي فرضته حركية المجتمع قبل أن تفرضه المفاهيم الجاهزة والمسبقة، وقبل أن يماثل التقاليد الأدبية المشرقية. ويعلن المسار التاريخي والاجتماعي للكتابة القصصية-الروائية أنها كتابة لم تنحز إلى النزعة الكلاسيكية المحافظة ولم تراهن كثيرا على التقاليد السردية التراثية، بالقدر الذي راهنت فيه على ترسيخ تلك العلاقة العضوية بين التجديد الوطني والتجديد الأدبي. ومنذئذ سيشكل مسعى تحديث الأدب والالتزام بالقضية كلا متجانسا (را: ص62).
وبهذا المعنى يمكن الحديث عن “واقعية الكتابة” التي تتخطى حدود المضمون وحدود الخطاب الإيديولوجي لتبلور تجليات نصية وفنية مؤهلة لتجاوز وظيفة المحاكاة نحو وظيفة التخييل.
في اقتران بما سلف، يلح أحمد المديني على أهمية الأدب السردي المكتوب بين العقدين الأربعيني والستيني، ليس فقط لكونه شكل “محاولات التعلم في سياق الشرط التاريخي” المتعلق –مثلا- ببلورة جنس أدبي كالقصة القصيرة من خلال تجليات محددة للرؤية الواقعية، بل لأنه أدب غامرت نصوصه بإدخال صيغ كتابية ذات علامات فنية غير مألوفة في الوسط الأدبي والثقافي المغربي لتلك الفترة التاريخية.
ولعل هذا ما يفسر اعتماد د.أحمد المديني، في تصنيفه للكتابة السردية، على منظور الرؤية الواقعية لاستخلاص مجمل أبعادها التعبيرية والفنية في صلة بما كان يتطلبه الوعي الوطني والاجتماعي من أشكال ومضامين.
يعتني المديني في دراسته بتحليل أهم خصائص الكتابة السردية للعقد الستيني متخذا من قضايا الالتزام وتطوير الأشكال النصية إمكانية لوصف صيغ التعبير القصصي وما يحيط به من واقع يومي وتاريخي، وما يعج به من وعي سياسي وإيديولوجي أفرزه الفضاء الاجتماعي الستيني. ويعمق الباحث هذا الرأي حين يقرن –مثلا- نشأة القصة القصيرة ضمن فضائنا الأدبي والثقافي بميلها نحو أخذ مادتها إما من الأحداث المجيدة لتاريخ الأمة أو من مشاعر الكفاح ضد الاحتلال أو أنها صورت مجتمعا يواجه نماذج حياة وسلوك أجنبيين، دخيلين على نظامه التقليدي (را: ص131).
بموازاة ذلك، وإذا كانت القصة القصيرة تخضع لتوجيه إيديولوجي مسبق، فالنص المشكل لها بدأ يتنمذج وفق واقع يتحول حسب رؤية واقعية لم تعد تعتمد فقط على النوايا المعلنة أو الضمنية للمؤلف (را: ص131). وبعد هذا الرأي مباشرة يقدم د.المديني الخلاصة التالية:
“في هذه الحقبة ستعرف القصة القصيرة، ضمن نهج التكامل بين الشكل والمضمون، تطورا ملحوظا من ناحية الحذق الفني في تسخير العناصر الفنية.. إذ التغيير النوعي للمادة المسرودة سيؤثر على طرائق تقنية السرد ويحفز الكاتب لإعادة النظر في أدواته (ص132)”.
يركز الباحث تحليله لوضع الرواية المغربية في الأدب المغربي الحديث على تتبع مسارات محددة تهم: تكوين الرواية المغربية-التاريخي والاجتماعي: استقطاب رؤية-إشكالية الهوية وتحولات الرواية الواقعية. أود، في هذا العرض الوجيز، أن أقدم للقارئ خطاطة محدودة ومركزة لعلها تقرب له أبرز الإشكالات وتفتح له آفاقا ممكنة من التأمل والاختبار:
ـ استدعاء النصوص الروائية (أو القصصية) لأحداث تاريخية غالبا ما كان أصحابها يحولونها إلى حكايات روائية ذات غايات ومقاصد تفتخر، أحيانا، بأمجاد الماضي وتحتفي، أحيانا أخرى، بقصة غرامية مشوقة كما هو الأمر لدى عبد العزيز بن عبد الله في شقراء الريف والجاسوسة السمراء وغادة أصيلا والجاسوسة المقنعة، وعبد الهادي بوطالب في وزير غرناطة.
ـ إذا كانت الكتابة الأدبية باعتمادها، خلال سنوات الأربعين، على المقالة قد عبرت عن جملة من القضايا الاجتماعية والإيديولوجية، فإنها أولت الاهتمام لصياغة خطاب يسر الانتقال إلى سرد قصصي وروائي سيمنح للنثر المغربي أشكالا جديدة من التعبير تخلصه من هيمنة الأسلوب التقليدي.
ـ تنامي اقتران البداياتالأولى لكتابة الرواية في أدب المغرب بالتعبير الأوتوبيوغرافي والتمسك بالواقعية خلال العقد الخمسيني والستيني، وفي تناغم مع المحيط السياسي والاجتماعي والثقافي الذي عرفه المغرب غداة الاستقلال، والنصوص الأولى لكل من عبد الكريم غلاب ومبارك ربيع ومحمد زفزاف ومحمد عزيز الحبابي وخناتة بنونة ومحمد شكري وعبد الله العروي شاهدة على ذلك.
هكذا، تثير دراسة أحمد المديني حول الكتابة السردية في الأدب المغربي الحديث عدة قضايا تهم التحقيب الأدبي ونشأة الأنواع الأدبية ووظيفة المثاقفة ومقترحات من التحليل النصي، وغيرها من القضايا التي تستدعيها مقاربة القصة القصيرة والرواية.
ولذلك، تتعدد الخلاصات وتتشعب ويصبح تبسيطها واختزالها أمرا مخلا بمنطلقاتها وتطبيقاتها. مهما يكن من أمر، فقد أثارت هذه الدراسة انتباهي إلى نتيجتين أعتبرهما مدخلا ممكنا لتعميق النظر في الكثير من الاختيارات التي يثيرها كل حديث عن الكتابة السردية بالمغرب:
أولاهما: تأكيد الباحث على أن الأدب (والسرد جزء منه) لم يكتب، في الأغلب الأعم، بنية فنية خالصة، ولا للمتعة الملازمة له، ولكن بوصفه غرضا أو كتابة غرضية أهميتها في منطوق جدواها وتبشيريتها وليس في جماليتها، ولا في استيفاء شروط ما يجعل منها خلقا بديع التكوين (را: ص325).
ثانيهما: اعتقاد الباحث أن الحداثة لا يمكن أن تتحقق من خلال نص مفرد ولا من خلال استيهامات منفردة كيفما بلغت انزياحاتها واختراقاتها، بل هي إلى جانب ذلك وأبعد حالة مدينية وحضارية وثقافية واجتماعية ووضع إنساني شامل، وهو وضع يفتقر إليه الأدب العربي الحديث والمعاصر مهما جرؤت فيه التعابير والخطابات (را: ص327).
خلاصتان جديرتان بالمناقشة تعلن عنهما هذه الدراسة الغنية والمفيدة.
- 2 – الرواية المغاربية: مسائل في اللغة والخطاب.
توجد اليوم –في مجال الدرس الأدبي المتعلق بنقد الرواية- عدة تحاليل تهتم باشتغال اللغة والخطاب وتقدم تصورات دقيقة ومتطورة بطرق منهجية مختلفة، سواء تعلق الأمر بالسرديات العامة أو السميائيات أو تحليل الخطاب أو اللسانيات الجملية والنصية وحتى فلسفة اللغة.
ولكي نفهم بجدية الأسئلة المتعلقة باشتغال اللغة والخطاب يمكن القول إن تحليل النص السردي شكل أحد الخصائص النوعية لفهم المستويات العامة للتمييز بين مظهرين اثنين: فالنص السردي حكاية وخطاب في الآن ذاته. إنه حكاية بإثارته لواقع ولمجموعة من الأفعال الواقعية أو المتخيلة، وهو أيضا خطاب يتوفر على سارد يسرد الحكاية وفي مواجهته قارئ يتلقاها.
ولهذا السبب، يمكن حصر العلاقة بين السارد والمسرود له فيما تتيحه اللغة والخطاب من أشكال للتعبير ناتجة عنهما. وحين تهتم الدراسة بإعداد العلاقة بين اللغة والخطاب، فإنها تفترض أن جوهر الموضوع اللغوي والخطابي كامن في تحليل الكلام بما هو فعل دال على توليد التخييل الحكائي.
ولا شك أن تعيين الحدود بين اللغة والخطاب، في هذه الحالة، يتجاوز مستوى تركيب الجملة السردية إلى مستوى أشمل يخص تركيب النصوص السردية؛ إن المنظور الوظيفي لتحليل الكلام ينفتح –لا محالة- على مفهوم الكتابة بمعناها الأوسع، ويجعل السرد والحكاية متعلقين بشكل أدبي يوافق إدراكا ما للعالم وللتجربة الواقعية أو المتخيلة.
من هذه الزاوية، وحتى لا يكون هذا التصور موضع اعتراض، يمكن إيجاد العلاقات النظرية والتطبيقية بين اللغة والخطاب والكلام والسرد والنص والكتابة. وتشكل هذه العلاقات –في نظري- الأطروحة المركزية لدراسة الأستاذ عبد الحميد عقار: الرواية المغاربية، تحولات اللغة والخطاب. كيف ذلك؟
يبين عبد الحميد عقار، في هذه الدراسة، بعمق أن اللغة وجود اجتماعي، والأدب الروائي تعبير عن قيم الحياة ونغمات المعيش واليومي والمبتذل والخارق والذاتي والجماعي. يبدو لي أن المدخل الذي وضعه عقار لدراسته ويعرض فيه لفكرة المغرب العربي والوضع اللغوي مدخل نظري ومنهجي ضروري لفهم تطور الإنتاج الأدبي ووضع الرواية المغاربية وسماتها الثقافية والاجتماعية.
وكذا أبرز التوصيفات التي تميز أبنيتها السردية والحكائية. يغدو –في ضوء هذا المعطى- الإبداع الروائي، بما هو جزء من الإنتاج الأدبي، مكونا ثقافيا من جملة مكونات أخرى لبيان “التعدد في إطار الوحدة والتنافس في إطار التكامل بين أقطار المغرب العربي”. وهذا يعني أن اللغة الأدبية (اللغة العربية هنا) وسيلة إجرائية فعالة لرصد درجة التغيير والتحول والتطور التي تعرفها الحساسية الأدبية ضمن هذا الفضاء الثقافي.
ويمكن القول، بهذا الصدد، إن دراسة اللغة الروائية تستمد أهميتها من قيم الأدب ذاته، لأن أي تفكير في اللغة بإمكانه أن ينقل مركز الاهتمام من الكاتب وأعماله إلى مسألة الكتابة والقراءة، وهذا ما سأوضحه في الفقرات اللاحقة.
إذا كان تعريف الرواية أمرا صعبا ويحتاج إلى اعتماد خلفية نظرية دقيقة وتمثل إمكانات نصية متنوعة، فإن عبد الحميد عقار يغامر بجرأة وذكاء باقتراح تعريف جامع للرواية مرتبط بموضوع الدراسة ومشتمل على عدة مفاهيم سيفصلها في مختلف مباحث وفصول هذا الكتاب. وجدت هذا التعريف في صفحة 6 أقدمه كما يلي:
“الرواية شكل يكتب في عدة مستويات أو كلام علاقي بامتياز”.
لو بحثنا في القاعدة النظرية لهذا التعريف لوجدناها متعلقة (على الأقل) بثلاثة مظاهر:
1-مظهر الشكل الحامل لصيغ تقديم الحكاية من قبل السارد وبطريقة معينة.
2-مظهر مستويات الكتابة الذي يسمح بإفراز الأبعاد الدلالية والجمالية للحكاية.
3-مظهر الكلام العلاقي الدال على الصيغ الإنجازية للسرد وتشخيصاته الذاتية والموضوعية.
يتخذ هذا التعريف، إذن وبطريقة ضمنية، من صوت السارد خيارا أساسيا لإيجاد علاقات الإسناد بين الشكل والكتابة والكلام واللغة. ولعل التسليم بوجود هذه العلاقات هو ما أملى على عبد الحميد عقار دراسة الخطاب الروائي المغاربي باعتباره نصا تطوريا يضفي على اللغة طابع التهجين والتنويع والسخرية، مثلما يضفي على الشكل طابع التقطع والتداخل والتشذر والتوليد.
ولما كانت الحوافز بين اللغة والشكل متعددة ومتنوعة من حيث الابتكار والتداول، فإن الإمكانات التعبيرية التي تتيحها اللغة ذاتها، على صعيد التخييل الأدبي عامة والروائي خاصة، تزاوج بين القصد “الفردي” و”الاجتماعي” لاستعمال “الكلام الأدبي” بما هو مقولة نصية وخطابية بموجبها يمكن رصد التحول والتطور اللذين تعرفهما الكتابة، وهذا هو ما يجعل الكلام الأدبي يتصف بالخصوصية بالقدر الذي يتصف فيه بالعمومية، لأنه جزء من نسق لغوي ذو نبرات خاصة في الإنشاء وتركيب الأساليب.
قبل أن أواصل مناقشة قضايا هذه الدراسة أعرض، أولا، للتنظيم العام للكتاب حتى يتسنى ضبط إشكاله وأهدافه، ينقسم هذا البحث إلى قسمين:
ـ قسم أول يختص بتحليل تحولات اللغة الروائية مغاربيا ويشتمل على ثلاثة فصول:
1-شعرية التعدد اللغوي في رواية الفريق.
2-السخرية وتنوع السجلات اللغوية في عرس بغل.
3-اللغة الروائية وآفاق التجريب في الرواية المغاربية.
ـ بينما يركز القسم الثاني على فهم تحولات الخطاب الروائي المغاربي ويشتمل على أربعة فصول:
1-التأصيل والمغايرة في الرواية الجزائرية.
2-الساخر والبحث عن الذات في أحلام بقرة.
3-العجائبي ومحاولة الإمساك بالأنا في عين الفرس.
4-الذاتي والصوغ الحواري في دليل العنفوان.
ـ بالإضافة إلى تمهيد يقدم لمشروع البحث وخاتمة تحدد الاستخلاصات والآفاق.
يعتمد عبد الحميد عقار في هذه الدراسة على تحليل متن روائي مغاربي مكتوب بالعربية يبلغ 18 رواية صدرت ما بين سنتي 1973 و1989. لهذا التحديد التاريخي قيمته المنهجية، لأنه لا يعكس فقط تنوع الحساسيات الفنية على صعيد البناء والدلالة فحسب، بل يجلي –أولا وأساسا- مبدأ عاما لتأطير الاختيار المنهجي، إنه مبدأ الملاءمة: ملاءمة فرضية البحث مع الهدف المبتغى، أي فهم تحولات اللغة والخطاب في الكتابة الروائية المغاربية وتتبع العناصر المهيمنة الدالة على قيم التطور والتحول.
ولذلك، حين يتعامل عبد الحميد عقار مع المتن المدروس في مستويين: “مستوى النص المفرد والذي له جوانبه المفردة والخصوصية، ومستوى المدارات المشتركة لنصوص المتن بمجمله حيث تبدو الرواية متتالية دينامية ومتميزة”، لا يتحدث عبد الحميد عقار عن النصوص، ولكنه يتحدث عن الكتابة، وكأني به يؤكد أن اللغة الأدبية بما تعرفه من تحولات تظل مميزة عن كل اللغات التي يعرفها فضاء ثقافي واجتماعي معين؛ ولأن الرواية نوع أدبي ولغوي بامتياز فإنها لا تعكس اللغات بل تحاكيها، فالرواية محاكاة للغات، والإبداع لا يتم داخل اللغة بل داخل لا نهائية اللغة.
لا يحصر عبد الحميد عقار تحليله على دراسة الاشتغال اللغوي والخطابي في الرواية المغاربية بقدر ما يعتمد على وصف مستويات التحول التي تجليها النصوص بحسب مادة التأليف، ويستثمر في هذا المجال مفاهيم الشعرية الأدبية لدى كل من باختين وكريزنسكي عبر تشغيل عدة أطر نظرية: التعدد اللغوي وتعدد الأصوات –الصور اللغوية والتشكلات الدلالية الناتجة عنها- سجلات التعبير وسماتها الأسلوبية التي تمكن الدارس من تسمية مختلف الإيقاعات السردية المتعلقة بدراسة الخطاب الروائي من منظور تطوري تعلنه أنماط متنوعة من الوعي والصوغ الحكائي المنظم لانتظام النص الحكائي وتمططه.
هكذا، مكنت الاعتبارات السالفة عبد الحميد عقار من إيجاد خلفية منهجية لتقريب المسافة بين مستوى اللغة ومستوى الخطاب في الرواية حتى يسهل وصف مستويات التحول في النص الروائي المغاربي. لقد أفضت بي دراسة عقار إلى إعادة تنظيم أبرز تفريعات تلك المسافة النظرية بين اللغة والخطاب من خلال ما يلي من تحديدات تلخص على العموم ملمحا من ملامح اللغة الواصفة التي تقوم عليها تأويلات هذه الدراسة:
1-يمنح عبد الحميد عقار جل اهتمامه حين يقارب تحولات اللغة الروائية مغاربيا لثلاثة مواثيق متنوعة يختبر بواسطتها آليات: التعدد اللغوي والسخرية والتجريب، وهي آليات تستثمر، على نحو عام، اشتغال اللغة في الرواية المغاربية على أساس فني وثقافي وجمالي لا يقتصر فقط على تعيين المصادر المتنوعة للكلام والمتكلمين فيالرواية، بل يرصد كذلك تفاعلاتها الممكنة بمختلف منظورات الحكاية، وهذا ما يفصح عنه اهتمام عقار بـ”لغة الاستبطان الذاتي” و”الفانطازيا” و”لغة التداول اليومي” و”البناء التهجيني والبارودي” مما يعني أن تحولات اللغة في الرواية المغاربية تمس البنية السردية وتمس المتخيل بمختلف تجلياته الاجتماعية والسياسية والثقافية.
2-يبني عبد الحميد عقار فرضياته لتحليل تحولات الخطاب الروائي المغاربي على بحث مدارات أخرى من التشخيص اللغوي حين يربط تحولات الخطاب بصيغ إنجازية محددة توافق أشكالا وأنواعا تعبيرية بعينها: الرواية التاريخية، والرواية الاجتماعية، والسيرة الذاتية، والسيرة الذاتية الروائية إلخ.. وهذا ما مكنه من معاينة اشتغال بنيات الساخر والعجائبي والذاتي والصوغ الحواري في نماذج من الرواية المغاربية وربطها بما يناسبها من بنيات سردية وحكائية.
هذه بعض علامات تحول اللغة والخطاب في الرواية المغاربية، وهي تبين تأثير حوارية اللغات وتعدد الأصوات على بنية السرد وتركيب الحكاية. وبهذا القصد تصبح علامات الحوارية إحدى إمكانات إنتاج خطاب ثقافي ممتلك لأسس اجتماعية وجمالية تعبر عن الرأي والموقف والوعي بضرورة خطاب التخييل.
ومن هذا المنظور، يحرص عبد الحميد عقار على تأكيد أن التعدد والتنوع الذي تتصف به اللغة الروائية قد يخص المعجم والتركيب والدلالة، فيغدو قالبا أدبيا يقول ما لا تقوله خطابات أخرى. صحيح أن الوعي بمسألة اللغة شكل، عموما، إحدى قضايا الإبداع الأدبي العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بل إن مشروع النهضة العربية ارتكز في جانب من ملامحه الفكرية على تطوير وتحرير وإحياء اللغة العربية ضمن المنجز النصي الشعري والنثري على حد سواء.
معنى ذلك، أن تشخيصات اللغة أدبيا وبلاغيا وثقافيا وهي تستوحي سجلات التداول اليومي والشعبي والتهجيني والبارودي، فإنها تستعيد مواضعات المجتمع وتصنع النصوص والخطابات: لم تعد اللغة استعمالا موجودا خارج النصوص والخطابات، ولكنها أضحت جزءا من صنعة الكتابة.
حاولت في الفقرات السالفة أن أبين وأناقش أهم المنطلقات وأحدد أبرز الخلاصات التي ضمنها عبد الحميد عقار في دراسته: الرواية المغاربية: تحولات اللغة والخطاب، مركزا على تتبع علامات التحول اللغوي والخطابي، وقد جعل عقار من تلك العلامات أفقا نظريا وتطبيقيا لوصف سيرورة وصيرورة تحولات النصوص وعلاقاتها بأشكال السرد. وبالإمكان حصر أبعاد التحول –تلافيا للاستطراد- فيما يلي:
1-تقوية الذاكرة النصية للرواية المغاربية وتطوير سبل إغنائها وتعميقها.
2-تنويع الحساسية الأدبية من ناحية الأبنية والأشكال، وكذا التصورات المتداولة عن الأدب.
والأكيد أن دراسة عبد الحميد عقار تسعفنا على تعميق التأمل حول بعض إجراءات علاقة اللغة بالتخييل الروائي وتشخيص الكلام ومحاكاة الأقوال. وحين يؤكد عقار على أن اللغة جزء من الكينونة والصيرورة، فلأنها وعي بالواقع وكشف لهوية هي منبع الكتابة وأفقها وقدرها الإبداعي والجمالي.
للرواية المغاربية تحقق فني نوعي بالرغم من أنها تعاني من عدة مآزق تخص الإنتاج والتلقي والتداول؛ إنها خطاب يراهن على أن يكون ثقافيا ومعرفيا وحاملا لتصور ما للأدب والكتابة مع تفاوت درجات النضج أو التراكم المنجز في كل فضاء ثقافي على حدة. وبهذا، لا يمكن أن نفهم تحولات اللغة والخطاب في الرواية المغاربية ما لم نبحث لها عن مفهوم ما للأدب أو، على الأقل، تصور ما لجدوى الكتابة.
فإلى أي حد يصح القول إن ملاحظة كون الأدب قد تغير وتحول هو، بكل تأكيد، أسهل من تحديد أين يكمن هذا التغيير والتحول، وهل هو عابر أم متواصل ودائم، وهل ينبغي أخذه كبداية أم كنهاية؟.. مهما يكن من أمر، يبدو أن التغيير أو التحول الأكثر عمقا ينبغي أن يمس العلائق الشخصية للكاتب مع فكرة الأدب نفسها، أي مع عالم المعتقدات والصور، ومع الأمل والانفعال، ومن كل ما يستمد منه الأدب –إلى حد الآن- سلطته التواصلية الخاصة.
- 3 – في الرواية العربية: التكون والاشتغال
هذه دراسة في الرواية العربية من ناحية التكون والاشتغال.
محور الدراسة مركب، إلا أنها تحقق أهدافا متكاملة: تقدم اختيارها النظري عبر استدعاء أبعاد تاريخية ومفاهيمية تخص الجنس الأدبي الروائي من جهة، وتتعلق بنوعية نصية متعددة من جهة ثانية. ولذلك، يحتل بحث مستوى الجنس والنص والمجتمع حيزا مهما من تحليلات الأستاذ أحمد اليبوري من وجهة عامة تستفيد من مختلف ميادين العلوم الإنسانية.
تطرح مقاربة الرواية العربية وقضايا تكونها واشتغالها الإقرار بتنوع طرق المعالجة وتركيزها إما على فهم خلفياتها التاريخية والاجتماعية والثقافية، أو تركيزها على بيان نوعية النصوص الروائية ووسائلها الفنية والدلالية. وقد خلفت لنا الدراسة الأدبية في هذا السياق جهودا يعرفها أهل العلم بتحليل الرواية ونقدها.
يبين أحمد اليبوري بعمق وبرهنة مقنعة علاقة النص الروائي العربي بأشكال معينة من التعبير وبحسب سياقات اجتماعية محددة، وكأني بهذه الدراسة تبحث في الكيفية التي ظلت من خلالها الرواية العربية متصلة مع التراث السردي الكلاسيكي، ومتواصلة مع مختلف التقنيات الحديثة في كتابة السرد وابتداع الحكايات.
يهتم أحمد اليبوري في هذا الإطار بمناقشة بعض القضايا التي أثارتها نماذج روائية ونقدية منذ نهاية القرن التاسع عشر وتركيزها حول تجليات الجنس الأدبي واللغة الروائية وإضافات المتخيل بوصفه خطابا ثقافيا واجتماعياـ أي بوصفه خطابا معرفيا انبثقت عنه ما دعاه اليبوري بمؤسسة الرواية.
يبدو لي أن مفهوم مؤسسة الرواية مركزي في دراسة أحمد اليبوري، وإليكم البيان:
يحاول اليبوري بواسطة هذا المفهوم تحديد أهم القيم الثقافية والاستيطيقية التي ينتجها المجتمع في علاقة بمؤسساته الثقافية السائدة وبتأثير من المؤسسة الثقافية الغربية. بهذا الصدد، أتصور أن مفهوم مؤسسة الرواية، وبالتحديدات التي منحها إياه اليبوري، ينفتح على سؤالين أحدد صيغة أولهما كما يلي:
1-لماذا كان المجتمع العربي (المصري والشامي أساسا) مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في حاجة إلى جنس أدبي جديد هو الرواية للتعبير عن أوضاعه وأحوالة، أي في حاجة إلى ذوق أدبي جديد يخرجه من مواضعات أساليب بلاغية أضحت جامدة ومتكررة؟
أما صيغة السؤال الثاني فأستعيرها من الإيديولوجية العربية المعاصرة للأستاذ عبد الله العروي:
ما هو الشيء الروائي في مجتمعاتنا؟
أود، من خلال ما سلف، أن أثير الانتباه إلى ثلاثة مسارات علينا أن نجد مبرر طرحها والقاسم المشترك بينها. هذه المسارات هي: مؤسسة الرواية وحاجة المجتمع إلى الجنس الأدبي (الرواية هنا) والشيء الروائي في المجتمع.
أتصور أن هذا المسعى الذي يجعل حاجة المجتمع للجنس الأدبي منفتحة على مؤسسة الرواية وعلى الشيء الروائي الذي فرضه المجتمع العربي لم يكن منفصلا عن مشروع النهضة المبشر بعهد اجتماعي جديد وزمن إبداعي مختلف ومغاير عن القيم الأدبية التقليدية.
لقد كانت مؤسسة الرواية العربية لحظة تكونها وتشكلها مؤمنة بجدوى التحرر من سلطة النوع الأدبي المهيمن ومتطلعة نحو نوع أدبي منفتح وقادر على تجسيد قيم اجتماعية وثقافية وفنية وسياسية أضحت جلية في كتابات المفكرين والمبدعين على حد سواء.
يستنتج أحمد اليبوري، بهذا الشأن أن مؤسسة الرواية العربية كانت مستجيبة خلال فترة تكونها، التي امتدت منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين، لدينامية داخلية في علاقة مع النص الثقافي العام، والدينامية خارجية تتمثل في المثاقفة، وعن طريق التفاعل بين هاتين الديناميتين برزت المعالم الأولى للإنتاج الروائي العربي الجديد (ص24).
يتأكد من هذا أن الكيفية التي اقترن بها تكون الرواية العربية إزاء سؤال النهضة تمثلت في دعوة المجتمع إلى تبني ثوابت التنوير والتحرر من قبضة التخلف، أي –كما يقال في العادة- الدعوة إلى الابتداع بدل الاتباع.
تنتمي الرواية إلى المجتمع. كل المجتمعات هي مجتمعات روائية، أم أن هناك مجتمعات روائية وأخرى غير روائية؟ كتب رولان بارت ذات يوم: المجتمع هو الذي يفرض الرواية. معنى ذلك، هو الذي يفرض مجموعة من القيم بوصفها صيرورة وديمومة. وفي جميع الأحوال، فإن الرواية –من هذا المنظور- تتصل بأفق تحديث اجتماعي توافقه أشكال متنوعة من التعبير ومن التخييل وتنويع اللغات.
يقول أحمد اليبوري:
“ومن الأكيد أن الانتقال من مؤسسة أدبية قديمة إلى أخرى جديدة يتم عبر صيرورة قد تستمر عقودا في بعض الأحيان، يتساكن خلالها، القديم والجديد، في علاقة توتر، بين هدم وبناء، استشرافا لأنماط أدبية جديدة. وقد كانت نهاية القرن التاسع عشر مرحلة قصوى لتلك الصيرورة إيذانا بالوعي بضرورة تحول نوعي أساس، على مستوى عدة بنيات في مقدمتها البنية اللغوية (ص26)”.
تحدث العديد من الأدباء والنقاد عن مسألة اللغة، بيد أن حديث الأستاذ أحمد اليبوري عنها يحمل جملة من الإضافات أستسمحكم في مناقشتها من خلال ما يلي:
حين يهتم أحمد اليبوري بالمكون اللغوي فإنه يعتبره مكونا مركزيا، لا يمكن الحديث عن مؤسسة الأدب أو عن الجنس الأدبي دون تحديد وظائفه ومستوى تطوره. يبدو هذا التصور مهما وعميقا، لأنه ينظر إلى مسألة اللغة الأدبية عموما ضمن سياق تاريخي وفكري يعيد تأمل سؤال الكتابة والقراءة وفق الاعتبارات الثقافية التي تجعل من لغة النص الأدبي ذات صلة بقيم واقعه ومؤسساته.
هكذا، يستدعي الاهتمام باللغة الأدبية فتح مجال التفكير حول ما تعرفه المجتمعات من تحولات على صعيد التصورات والخطابات: يحتاج الأدب، بين الفينة والأخرى وخلال هذه الفترة التاريخية أو تلك، إلى لغة أدبية جديدة، لأن المجتمع يحتاج إلى تجديد تصوراته حول الأدب. إن الوعي بتحولات اللغة الأدبية جزء من تحولات المجتمع ثقافيا واجتماعيا وسياسيا.
هذه تحديدات عامة، وإذا أردت التخصيص تساءلت:
هل استطاعت الرواية العربية، منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أن تساهم في تطوير أساليب الكتابة النثرية التي كانت سائدة آنئذ وابتكار وعي لغوي جديد؟
تسمح القراءة المتأنية لتحليل أحمد اليبوري –إذا فهمت جيدا أبعاد هذا التحليل وأطروحته المركزية- أن الرواية العربية استطاعت أن تبتكر وعيا لغويا جديدا كان يوافق خصوصية النوع الأدبي، ويوافق كذلك الحاجة إلى امتلاك تصور جديد للأدب وللمؤسسة الأدبية.
ويحيل اليبوري في السياق ذاته على آراء ومواقف جملة من الأدباء والنقاد: سليم البستاني – جرجي زيدان – إبراهيم اليازجي – أحمد فارس الشدياق – رفاعة الطهطاري – محمد المويلحي – روحي الخالدي.. معنى ذلك، أن الوعي اللغوي الذي أبان عنه النص الروائي العربي، منذ تلك الفترة المبكرة، قد صاحبه تداول معين لمفهوم الكتابة ذاتها غير منفصل عن توظيفها لألوان من الموضوعات والأساليب فرضتها أذواق وذهنيات ضمن فضاء اجتماعي معلوم. ويفضي هذا الاعتبار إلى نتيجة لعلها أساسية في سياق هذا الحديث:
كانت الرواية العربية، منذ اللحظات الأولى من تكونها، تنتمي إلى أفق النص الثقافي العام الذي يفكر في قضايا المجتمع.
كانت الرواية تمثل وتماثل خطاب الفكر.
تهتم دراسة أحمد اليبوري، إضافة لمجمل ما سبق، بتحليل المتخيل الروائي بحسب منطلقات يمكن حصرها أو إعادة صياغتها وفق ما يلي:
1-الرواية منتوج متخيل، ذو قاعدة اجتماعية، تفرز أحيانا داخلها تخييلا من درجة ثانية، متولدا عن استيهامات بعض الشخوص، مما يساهم في خلق مسارات حكائية مخالفة لسيرورة الواقع الروائي (ص33).
2-إن التخييل المزدوج لا يتم في الفضاء الروائي وحده، ذلك أننا نجد بعض مرتكزاته في صميم العلاقات الاجتماعية (ص34).
3-والرواية بمرجعياتها البدئية واللاشعورية والواقعية تخضع في تكونها واشتغالها لأطر الإدراك ولأنماط المتخيل بمختلف تشعباته (ص34).
هل المجتمع العربي مجتمع روائي؟ بتعبير آخر: ما هي طبيعة المتخيل الروائي الذي أنتجه وينتجه ويمكن أن ينتجه المجتمع العربي؟ لا أهدف من طرح هذا السؤال إبراز الوظيفة الاجتماعية للرواية، بقدر ما أهدف تأكيد أهمية الاهتمام بالوظيفة الاجتماعية للمتخيل. من هذا المنظور، يعتبر بحث موضوع المتخيل في علاقته بقضايا تكون الخطاب الروائي العربي مهما للتعرف على خصوصية السرد وصيغ تداوله اجتماعيا وتاريخيا، وكذا بيان طبيعته: من اللاسرد إلى السرد أي من اللامتخيل إلى المتخيل،
وبالتالي إعادة فهم المرجعيات التي تدفع إلى الاعتقاد والتوهم بأن الخطاب الروائي العربي هو سرد متخيل من لقطات عابرة لبقايا الواقع تتصل بالمعيش واليومي والمنفلت والهامشي، مثلما تتصل باعتبار الغريب والعجيب جزءا لا يتجزأ من الواقع ذاته (انظر ص35).
ولهذا السبب يصبح المتخيل الروائي إحالة وجودية أو فكرية على الراهن العربي على الأقل منذ نهاية القرن التاسع عشر وتوقه نحو التحديث وإعادة تأسيس مفاهيم الأدب والاقتناع بجدوى الحاجة إلى أنواع أدبية جديدة؛ كان الخطاب الروائي العربي متمثلا لقيمة الحوار بين حضارتين: شرقية وغربية، أي خطابا متجها، بالأساس، نحو إصلاح المجتمع.
بهذا المعنى، قد يكون المتخيل الروائي العربي قريبا من الخطاب الإصلاحي المنفتح على قضايا المجتمع رغم اختلاف درجات النضج الفني بين النصوص وتصورات الأدب ووظيفة الكتابة الملازمة لها. وحين نتطلع إلى تعيين بعض صيغ المتخيل في علاقته بمجالات الحياة يصبح هذا المتخيل منتميا –بالضرورة- إلى زمن اجتماعي يجسد وعيا ثقافيا وفكريا يحرره من سلطة النوع الأدبي الثابت. وهذا قول يجد صداه –مثلا- في حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي، حديث:
“وإن كان في نفسه موضوعا على نسق التخييل والتصوير فهو حقيقة متبرجة في ثوب خيال لا أنه خيال مسبوك في قالب حقيقة حاولنا أن نشرح به أخلاق أهل العصر وأطوارهم وأن نصف ما عليه الناس في مختلف طبقاتهم التي يتعين اجتنابهم والفضائل التي يجب التزامها (طبعة: دار الجنوب للنشر، تونس 1992 ص22)”.
هكذا يبدو أن انتماء المتخيل إلى زمن اجتماعي معين يستدعي كذلك سبلا من التلقي تكسبه صفة الاعتراف والشرعية. من هنا لا تتحقق “بلاغة المتخيل” إلا عبر وساطة القارئ، أي عبر ما يدعوه أحمد اليبوري بالذوق والأخلاق والذهنية (ص127)، ويمكن أن نضيف إلى هذه المفاهيم مفهوما آخر رافق تكون الرواية العربية وتحولات الثقافة في ذلك الإبان: إنه مفهوم العقل والوعي بحاجة المجتمع إلى عقلانية متنورة قادرة على تمثل قيم التطور والتحول.
سأبين أبعاد هذه العلاقة بين وساطة القارئ وحاجة المجتمع إلى عقلانية متنورة من خلال نص لجرجي زيدان. لنتأمل هذا القول:
“وأما أهل هذه النهضة فقد أكثروا من نقل هذه الكتب عن الفرنساوية والإنكليزية والإيطالية، وهي تسمى في اصطلاح أهل الزمان “روايات”.. وقد رحب قراء العربية العقلاء بهذه الروايات لتقوم مقام القصص التي كانت شائعة بين العامة لذلك العهد مما ألفه العرب في الأجيال الإسلامية الوسطى، نعني قصة الزيبق وسيف بن ذي يزن الملك الظاهر وبني هلال ونحوها، فضلا عن القصص القديمة كعنترة وألف ليلة وليلة، فوجدوا الروايات المنقولة عن الإفرنجية أقرب إلى المعقول مما يلائم روح هذا العصر فأقبلوا عليها (تاريخ آداب اللغة العربية، الجزء الرابع، القاهرة 1914 ص230)”.
هكذا تحدث جرجي زيدان عن ترحيب قراء العربية العقلاء بالرواية وكيف وجدوها أقرب إلى المعقول الذي يلائم زمانهم. وعلى هذا النحو كان الاهتمام بالرواية بوصفها موضوعا للتفكير في روح العصر بموازاة خطابات أخرى اقتصادية وسياسية وإيديولوجية. كان ذلك في بداية القرن السالف، أما اليوم ونحن في قرن جديد، يحق لنا أن نتساءل فقط:
هل مازال للرواية العربية قراء عقلاء يرحبون بها؟