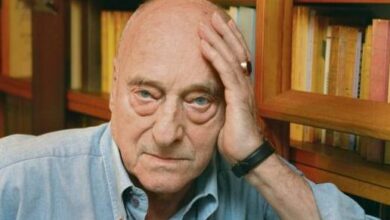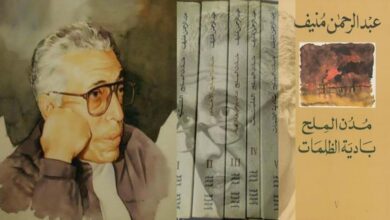سرديّات أمْ محكيّات قراءةٌ في عتَبتيْن نقديَّتيْن روائيَّتيْن عربيَّتيْن

يبدو أنّ الارتباك القائم في توظيف المصطلح السّردي سيستغرِق زمنًا طويلاً، في ظلّ غياب الوعي بماهية هذا الضرب من المصطلحات وحدوده وتشاكُلاته وتقاطُعاته واستعمالاته؛ فقد أراد بعض الباحثين العرب بمصطلح “سرديّات” السّرد، في الوقت الذي ذاع فيه مصطلح narratologie، بتصوُّره الغربي الذي يُشير إلى العلم الذي يدرس ذلك السرد، ودالّه العربي، ألا وهو السّرديات، الذي تواضع عليه عدد غير يسير من علماء السّرد ونقّاده العرب.
ومن ثمّ، فقد استوقفتنا بعض عناوين الكُتُب التي نحا فيها مُؤلفوها نحو استعمال مصطلح “سرديّات” لغيْر ما وضِع له ابتكارًا في اللّغة – المصدر ونقلاً إلى اللّغة – الهدف، وذلك في سعيهم إلى مُقاربة السّرد العربيّ القديم(1) والسّرد العربيّ الحديث والمعاصر مثلاً بمثلٍ. وقد اصطفيْنا، ابتغاء الكشف عن مظاهر الارتباك في تلك الكُتُب، عتَبتيْن نقديَّتيْن روائيَّتيْن، هما “سرديّات المنفى؛ الرّواية العربية بعد عام 1967″ لمحمَّد الشحّات، و”مساءلة النّص الرّوائي في السّرديات العربيَّة الخليجيَّة المعاصِرة” للرّشيد بوشعير(2).
- 1 – موضوعة النّفي بين الهوية الأجناسية والهوية العلمية:
يستعمِل محمَّد الشحّات، في كتابه “سرديّات المنفى؛ الرواية العربية بعد عام 1967″، مصطلح “سرديّات” للإشارة إلى تصوُّريْن اثنيْن في الآنِ نفسِه؛ فهو يروم به النّصوص الروائية التي تُعنى بموضوعة النفي من جهة، والعلم الذي يُوظَّف في مُقاربة مظهريْ تلك النّصوص السّردي والثّقافي من جهة أخرى؛ فيصبح المصطلح، حينها، مُشترَكاً مصطلحياً يدلّ على مفهوميْن متمايزيْن، هما رواية المنفى بوصفها نصّاً تخييليًا ومعرفيًا، والعلم الذي يُسترشَد به في تشريح مُكوِّنات ذلك النّص.
يقول الباحث: “لقد تمثَّل طموح هذه الدّراسة الأكبر في إعادة قراءة قطاع عريض من قطاعات الرّواية العربية الحديثة، ألا وهو “سرديّات المنافي العربية” من منظور “السّرديات ما بعد البنيوية”، ومناقشة كثيرٍ من المقولات والمفاهيم التي أحاطت بتاريخ الرّواية العربية الحديثة في علاقتها بالآخر من منظور جماليّ مُغايِر لا يغفل الوعي بالتّقنيات التي مارسها الكُتّاب العرب المنفِيُّون في تشكيل نصوصهم الإبداعيَّة، ولا يزال البعض منهم يمارسها إلى الآن، مع بدايات القرن الحادي والعشرين، في الوقت ذاته الذي تسعى مثل هذه القراءة سعيًا حثيثًا نحو عدم إغفال خصوصية رواية المنفى العربية التي تشكَّلت في سياقٍ من القمع والحصار والنّبْذ والمطارَدة، عبر مراحل مُمتدَّة في الزّمان والمكان العربيَّيْن، وفي ضوءٍ من الجدل والحراك الثّقافي والاجتماعي العريض الذي أفْرَز هذا الجماع من النّصوص الرّوائية العربية المتنوِّعة”(3).
وإذا كان مصطلح “سرديّات” يصدُق على العلم الذي يُعالِج جنس السّرد، وهو مصطلحٌ كان قد استحدثه تزفيتان تودوروف عام 1969 في كتابه “نحو الديكاميرون”، وارتبط بجملةٍ من الدّراسات السّردية ذات الاتّجاه العلميّ، والتي شرع فيها الشّكلانيون الرّوس، ثمّ طوّرها ثلّة من علماء السّرد الفرانكفونيين، مثل تودوروف، ورولان بارت، وكلود بريمون، وجيرار جينيت، وألجيرداس جوليان غريماس، فإنّ المصطلحَ ذاتَه لا ينطبِق على النّص الذي يطرح قضية المنفى، لأنّ ذلك يفترِض أنّ لهذا النّص خصائص وسمات تُميِّزه عن سواه من النّصوص التي تنصرِف إلى تناوُل موضوعات أخرى، مثل الثّورة والإرهاب والفساد والصّراع الحضاري والهويَّة والغيريَّة؛ فالسّرديات علمٌ يُحلِّل المظاهر الأربعة للمحكيّ الأدبيّ، وهي الحكاية والخطاب والسّرد أو التّلفُّظ والدّلالة، ويصبو إلى تعْميم المثال المستنْبَط من دراسة محكيٍّ بعيْنه على محكيّات أخرى.
إنّ نصّ المنفى لا يختلف، من حيث مبْناهُ ومعْمارُه، عن نصوص الثّورة والإرهاب والفساد والصّراع الحضاري والهويَّة والغيريَّة، لأنّ هذه النّصوص جميعها تمتلك بنية مُشترَكة، تتجلّى في جملة من العناصر والمركِّبات والمهيْمِنات التي تُميِّزها عن النّصوص الشّعرية والدرامية، بل إنّ تلك البنية تتقاسَمها الرّواية، مهما كانت موضوعاتها وأشكالها (الرّواية الاجتماعية، والرّواية النّفسية، والرّواية السّياسية، والرّواية التّاريخية، والرّواية البوليسية،…)، مع الأنواع السّردية الحديثة، نظيرَ القصّة la nouvelle، والأنواع والأشكال السّردية القديمة، من قبيل الحكاية le conte والمقامة والنّادرة والسّيرة الشّعبية.
إنّ التّسلسُل والتّناوُب والتّضمين والتّرتيب الذي يُمثِّله كلٌّ من الاسترجاع والاستشراف، بوصفها أساليبَ يعتمدها الرّاوي في سرْد الأحداث والأخبار، والإخفاء والمجمَل والوقْفَة والمشهَد، باعتبارها مُكوِّنات تُحدِّد سرعة النّص أو مدته التي تنهَض على العلاقة بين زمن الحكاية وزمن الخطاب، لا تختصّ بها، فقط، الرّواية عموماً، ورواية المنفى خصوصًا، بل هي سمات عامّة يتّصف بها السّرد الذي يُعَدُّ جنساً أدبيّاً “تُوظَّف فيه صيغة السّرد، وتُهيمِن على باقي الصّيغ في الخطاب، ويحتلّ فيه الرّاوي موقعًا هامًّا في تقديم المادة الحكائية”(4).
ولعلّ نظرةَ السّرديات البنيوية أو الكلاسيكية إلى المحكيّ الأدبيّ بوصفه نسَقًا منغلقًا على نفسه، واقتصارَها على مُقارَبة مضمونة الحكائي وتمظهره الخطابي وتحليل عملية تلفُّظه ومعانيه النّصية، وإقصاءَها، من ثمّ، لمُنْشِئه وظروف إنشائه، قد حدا بالباحث إلى الاهتداء بتصوُّرات ومفاهيم ما بعد بنيوية أو ما بعد كلاسيكية في دراسة البعد المعرفي لنصّ المنفى الذي يتمحور حول الإبْعاد والجور والقهر والاستلاب؛ فكان أن استدلّ، في تأويل مثلِ هذه الموضوعات الثّانوية التي تدور في فلك الموضوعة الرّئيسة وهي النّفي، ببعض المقولات الباختينية (نسبةً إلى الباحث الشّكلاني – الماركسي ميخائيل باختين) وبعض مفاهيم النّقد الثّقافي والنّقد ما بعد الكولونيالي، حيث اتّخذ المجمَل والوقْفَة والتّواتُر، وهي مصطلحات سردية بنيوية أو كلاسيكية، مَداخِل إجرائيّة لدراسة جوْهَر موضوعة النّفي، مُعتقِدًا أنّ اصطفاءَ أسلوبٍ سرديٍّ أو صيغةٍ خطابيةٍ ما ليس أمرًا اعتباطيًا؛ فهو يُترجِم موقفَ الرّاوي من التّاريخ والرّاهِن؛ إذ “لعلّ اختزال أغلب رواة المنافي العربيَّة وقائع حرب السّابع والسّتين، أو غيرها من الوقائع والثّورات والحروب والانقلابات، في مشاهد سردية “مُجْمَلة”، يعكس رغبات دفينة لديهم في عدم التّوقُّف طويلاً إزاء ما خلَّفته هذه الانتكاسة أو تلك من آثار في الأمّة العربيَّة.
الأمر الذي يُؤكِّد أنّه لا يزال ثمّة آثار لم تمّح وأخاديد من مرارة لا تزال محفورة بالذّاكرة والمُخيّلة العربيَّتيْن، حتّى وإنْ تجلّى ذلك في الهروب من “فعل الرّواية” أو “مُمارَسة الحكْي”؛ فالرّواية كشْفٌ للرّاوي المستور والمُختبِئ خلف روايته، والحكْي تعريةٌ للحاكي عن قيمه وقناعاته [و] أيديولوجيته، مهما ادّعى هذا الرّاوي أو ذلك الحاكي من درجات الحياد والموضوعية والشّفافية، أو مهما حاوَل الانفصال عن مرويِّه؛ فهو مُتورِّطٌ لا محالة”(5).
وهو ما يعني أنّ السّرديات ما بعد البنيوية أو ما بعد الكلاسيكية تروم تجاوُز الرّؤية الآلية لمكوِّنات المحكيّ الأدبيّ؛ فإذا كانت رؤية السّرديات البنيوية أو الكلاسيكية لا تسعى سوى إلى تحديد مسارات الفعل الذي تضطلع به الشّخصية وتحوُّلاته التي تُفْضي إلى تشكُّل دلالة الحكاية نسقياً ووصْف قواعد الخطاب السّردي وقوانينه وتعريف أساليب السّرد وتقنياته، فإنّ هدف السّرديات ما بعد البنيوية أو ما بعد الكلاسيكية هو استعمال تلك المكوِّنات في الكشْف عن العلاقة بين التّاريخ والواقع والمجتمع من جهة والمحكيّ من جهة أخرى.
إنّ أقصى ما يطمح إليه عالِم السّرد البنيوي هو تحليل عناصر المحكيّ الأدبيّ وتعريفها واتّخاذها مثالاً يُمكِن أن يُطبَّق على السّرد كلّه، دون أن يعني ذلك أنّ محكيّات هذا الجنس الأدبي لا تتوفَّر على ما يُميِّزها عن بعضها بعض؛ فلكلّ محكيّ أدبيّ سماته النّوعية التي تُحيل إلى صنفه الأجناسي، حيث يتضافر كلٌّ من “مُكوِّنيْ السّرد والهزل في النّادرة، بوصفها جنسًا أدبيًا تتحدَّد هويته الأجناسية بالهزل الذي يتجسَّد سردًا.
إنّ مُكوِّنيْ السّرد والهزل يرتبطان بسماتٍ أخرى مُهيمِنة في متونها، كالغرابة والطّرافة والشّذوذ والمفارَقة. كما يرتبطان بسماتٍ أخرى تحضُر في بعض النّصوص وتغيب في نصوصٍ أخرى، كالحجَّة الطّريفة، أو الحيلة، أو قلْب دلالة الكلمة أو الجملة، أو المحاكاة السّاخرة، وغيرها”(6). بينما يكمُن طموح عالِم السّرد ما بعد البنيوي، الذي لا يغفَل أهميَّة المقولات السّردية البنيوية التي تُمثِّل السّمات العامّة والنّوعية للمحكيّ الأدبيّ فيقرنها بالمقولات ما بعد البنيوية التي تصدُر عن علوم ونظريّات وتخصُّصات ومناهج مختلفة، في تأويل معاني ذلك المحكيّ الاجتماعية والنّفسية والدّينية والأخلاقية والفلسفية والعِرقية والسّياسية والأيديولوجية.
إنّ طموحًا مثل هذا واضحٌ وجليٌّ، لا شكّ، في دراسة محمَّد الشحّات التي يريدها بحثًا في معرفيَّة نصّ المنفى العربي الذي يستمدّ خصوصيته من الطّرائق المستخدَمة في التّعبير عن موضوعة النّفي. ممّا قد يجعل هذا النّص ينفرِد، هو الآخر، بسماته النّوعية التي تمنحه هوية أجناسية تُميِّزه عن نصوص الغربة والاغتراب واللّجوء والهجرة مثلاً، بل قد تتعدَّد صُوَر النّفي؛ فتتعدَّد معها ضروب رواية المنفى قبل عام ألف وتسعمائة وسبعة وستّين، كما يستشفّ الباحث، من منفى داخلي وآخر خارجي وثالث مزدوج ورابع وجودي وخامس لغوي، وذلك من غير أن يتنكَّر صنف رواية المنفى وضروبه المفترَضة للسّمات العامّة التي هي سمات أصيلة ومتأصِّلة في كلّ محكيّ أدبيّ.
يقول الباحث عن هوية نصّ المنفى بوصفه صنفًا روائيًا يكاد يستقلّ بخصائصه الفنيَّة وطرائقه الأدبيَّة عن هوية الرّواية باعتبارها نوعًا سرديًا: “وتأخذ مظاهر هذا التّمرُّد ضد النّوع الرّوائي، في روايات المنفى العربية، أشكالاً وتجليَّات مختلفة. وهي مظاهر تتأرجح ما بين الأسلوب والبناء: كتصدير نصوصهم بمقاطِع شعريَّة أو نثريَّة مُطوَّلة لكُتّاب منفيِّين، وامتلاء السّرد بنصوص وفقرات كاملة ومقاطِع شعريَّة تدور حول قضايا المنفيِّين (المكان، الوطن، اللّغة، الهوية)، والتّعامُل مع المنفى من منظورات عِدّة (غرائبي، أو واقعي – سحري، أو أسطوري،…)، والاسترسال الرّوائي، وتيّار الوعي والذّاكرة، وتمثُّل أسلوب وبناء أنواع أدبيَّة أخرى، كالمقامة، أو الملحمة، أو الشّعر، أو السّيرة الذّاتية، أو [النوفيلا] في روحها المكثَّفة المشحونة،…”(7).
وتُؤكِّد مُقارَبة محمَّد الشحّات لتمظهرات النّفي في المحكي الروائي العربي ابتغاء تحديد ماهية نصّ المنفى وثقافته معًا، من خلال التّوظيف التّأليفي لمصطلحات سردية بنيوية (مصطلحات سرديّات الخطاب التي تُمثِّلها أبحاث جينيت) ومصطلحات ما بعد بنيوية، مثل الزّمكان والتّهجين والآخر والمركز والهامش، أنّ تصوُّر مصطلح (سرديّات) لا يُمكِن أن يُحيل سوى إلى العلم الذي يُستنَد إليه في مُعالَجة النّصوص، وهو، هنا، السّرديات ما بعد البنيوية أو ما بعد الكلاسيكية، وأنّ المدوَّنة، التي اعتمَدها الباحث موضوعًا للتّحليل والتّفسير، والتي تتشكَّل من خمسة عشر نصّاً روائيًا أساسيًا لاثنيْ عشر مُؤلِّفًا عربيًّا، ليست سرديّات، بل محكيّات، أو حتّى مرويّات ومسرودات، كما ورَد في تضاعيف الدّراسة نفسها؛ فقد تواتَر ذكْر مصطلح مرويّات في صيغة الجمع، ومصطلحيْ مرويّ تارةً، ومرويّة تارةً أخرى، في صيغة المفرَد.
وتظلّ (محكيّات) récits، في رأينا، المصطلح الأنسبَ للتّعبير عن النّصوص التي تحتفي بالنّفي، باعتبار أنّ المرويَّ أو المرويَّة أو المسرودَ le narré يحذو حذْوَ الحكاية lhistoire التي تدخل في تركيب المحكيّ إلى جانب الخطاب والسّرد. ومع ذلك كلِّه، نميل إلى عَدِّ النّفي، وليس المنفى الذي يُشير إلى المكان الذي يُطرَد إليه المنفيُّ، موضوعة، أو تيمة thème، بتعبير محمَّد الشحّات ذاته، وليس محكيًّا أو صنفًا روائيًا، أو نوعًا روائيًا ثانويًا أو فرعيًا على حدّ قول الباحث، ذلك أنّ مظاهر التّمرُّد الأسلوبي والبنائي، باستثناء، ربّما، التّصدير بمقطع شعريّ أو نثريّ لكاتِب تعرَّض للإبْعاد والإذْلال، لا تمنح نصّ النّفي، بالضّرورة، هوية أجناسية تجعله يستقلّ عن الرّواية أو يتميَّز عن موضوعاتها وأشكالها التي تُبدي، هي الأخرى، وبناءً على مفهوم التّمرُّد عند الباحث، عدولاً عن تقاليد كتابة الرّواية.
- 2 – الرّواية الخليجية بين المعرفة النّصية والمعرفة العلمية:
يصبو الرّشيد بوشعير، في كتابه الموسوم “مُساءَلة النّص الرّوائي في السّرديات العربيَّة الخليجيَّة المعاصِرة”، إلى توجيه نظر القارئ إلى التّطوُّر الكبير الذي شهدته الكتابة الرّوائيَّة في منطقة الخليج العربي التي عُرِفَت، أكثر، بنظْم الشّعر. لذلك، جاء عملُه “الضّخم”، الذي يقع في سبعمائة واثنتيْن وستّين صفحة، تعريفًا بنصوص كُتّابٍ مرموقين نالت حظَّها من القراءة والبحث، مثل نصوص تركي الحمد وإسماعيل فهد إسماعيل، ونصوص كُتّابٍ آخرين لا تزال تنتظر مَنْ يلتفِت إليها تحليلاً وتأويلاً.
لقد حاول الباحث، في هذا الكتاب، أنْ يُلِمَّ بالإبداع الرّوائي في كلٍّ من المملكة العربية السّعودية والإمارات العربية المتَّحِدة والكويت وقطَر وسلطنَة عُمان ومملكة البحرين؛ فكان جهدُه أدنى إلى الاشتغال الموسوعيّ الذي يروم الإحاطة بأكبر عددٍ من النّصوص والمؤلِّفين، وإنْ كان اهتمامُ الباحث بنصوص كُتّابٍ مُعيَّنين جليًّا، مثل يوسف المحيميد من المملكة العربية السّعودية، وعلي أبو الرّيش من الإمارات العربية المتَّحِدة، ودلال خليفة من قطَر؛ اهتمامٌ قد يكون حافزُه غزارة الإنتاج عند هؤلاء الكُتّاب، أو حضورهم المتواصِل في مشْهَد الإبداع الرّوائي على الأقلّ. كما يحثُّ ذلك الضّرب من الاشتغال جمهورَ المهتمِّين بالسّرد الرّوائي العربي على مُقارَبة الرّواية الخليجيَّة التي أظْهَرت، كما يومئ الرّشيد بوشعير، مقدرة فنية ومعرفية كبيرة على التّعبير عن القضايا والإشكالات التي تقضّ مضْجَع الإنسان في هذه المنطقة، دون أن تنكفِئ، مع ذلك، عن هموم الأمّة العربية والبشريَّة جمعاء.
وقد برَّر الباحث نزوعَه إلى “مُساءَلة” هذه المدوَّنة الكبيرة، بشكلٍ جعل دراسته مُبتسَرة، لا تفي كلّ نصّ روائيّ نصيبه من الوصْف والتّفسير، بقوله: “وأيًّا ما يكن، فإنّ هذا الكتاب الذي نُقدِّمه للقارئ الكريم يُحاوِل أن يُسائِل النّص الرّوائي في منطقة الخليج العربي، مُتجنِّبًا التّقيُّد بمدخل واحد أو بدرب واحد، لأنّ ذلك المدخل أو ذلك الدّرب قد يُفضي بالمتلقّي إلى نمط معرفيّ مُعيَّن ذي علاقة بالبناء الفكري أو البناء الجمالي أو السّيميائي، ولكنّه لا يُمكِن، في أيّ حالٍ من الأحوال، أن يُغطّيَ جوانب أخرى ذات أهميَّة كبيرة في العمل الرّوائي. وبتعبير آخر: فإنّ دراسة “البطل الملحميّ في الرّواية الخليجيَّة” – على سبيل المثال –، أو دراسة “جماليات المكان”، أو دراسة “الرّؤية الاجتماعية”، أو دراسة “الخطاب الرّوائي”، أو دراسة “اللّغة الرّوائية”، أو دراسة “أساليب السّرد”، أو دراسة “علاقات التّأثير والتّأثُر” في أعمال الكُتّاب الرّوائيِّين الخليجيِّين، لن ترويَ فضولَ المُتلقّي وتطلُّعَه إلى المعرفة المتكامِلة غير المُجزَّأة بتلك الأعمال”(8).
إنّ تبرير الرّشيد بوشعير لأسلوبه الموسوعيّ في مُعالَجة الرّواية الخليجيَّة يفتقِر، في الواقع، إلى الحجَّة الدّامغة والإقناع المُفْحِم؛ إذ كيف يُمكِن لتحليلٍ يستغرِق، في حدوده القصوى، اثنتيْن وثلاثين صفحة (نقصد، هنا، البحث الموسوم “هاجس الحرية في ثلاثية “أطياف الأزقة المهجورة” لـ “تركي الحمد””) أن يُقدِّم معرفة مُتكامِلة للقارئ بالمدوَّنة الرّوائيَّة الخليجيَّة؛ معرفة تقتضي من الباحث أن ينصرِف إلى مُقارَبة التجليّات البنيوية لتلك المدوَّنة على مستوى الحكاية والخطاب والسّرد، ومُضْمَراتها الدّلالية التي قد تُولِّدها النّصوصُ نفسُها، أو تفرزها سياقاتُها المختلفة. ثمّ إنّ مثلَ هذه الطّريقة المنتهَجة في العمل على تقديم هذه المعرفة المتكامِلة “المرجُوَّة” ما كان لها أن تكون لولا تخيُّر الباحث لأداة مُعيَّنة من الأدوات الشّكلانية والبنيوية أو مقولة مُحدَّدة من مقولات ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة تُسعِفه في دراسة النّصوص الرّوائية.
لهذا، يجوز أن تكون تلك المعرفة مُتكامِلة، كما يتمنّى واهِبها، إذا نُظِرَ إلى العمل في كليَّته وشموليَّته، لكنّها تظلّ مُجزَّأة أو مُجتزَأة، بالنّظر إلى تحليل الباحث لرواية أو جملة من الرّوايات لكاتبٍ واحدٍ بناءً على هذه الأداة أو تلك المقولة.
ومن الأمثلة التي تشير إلى سمة الاجتزاء في تقديم المعرفة، على الرّغم من أنّ مجموع العمل يمنح الإحساس بأنّ ثمّة معرفة مُتكامِلة تُهدى للمتلقّي، من خلال مُحاوَلة الوقوف على ما تفتّقت به قرائح الكُتّاب في دول الخليج العربيّ الستّ، استئناس الباحث بمصطلح التّناص في مُقارَبة صُوَر التّعالُق والتّقاطُع النّصيَّيْن بين رباعية إسماعيل فهد إسماعيل التي تتألَّف من أربع روايات، هي “كانت السّماء زرقاء” و”المستنْقعات الضّوئية” و”الحبل” و”الضّفاف الأخرى” من جهة، ورواية “الوشْم” لعبدالرّحمن مجيد الرّبيعي وروايتيْ “اللّص والكلاب” و”ميرامار” لنجيب محفوظ من جهة أخرى، حيث يُحدِّد الرّشيد بوشعير أربع صُوَر لذلك التّناص الرّوائي، وهي: تناص الأحداث، وتناص الشّخصيات والمواقف، وتناص الرّؤى الفكرية، وتناص التّقنيات السّردية. يقول عن تعدُّد الأصوات ووجهات النّظر بوصفه صورة فرعيَّة تُمثِّل تناص التّقنيات السّردية: “إنّ إسماعيل فهد إسماعيل، في “الضّفاف الأخرى”، يُقدِّم شخصياته التي تتصدَّر فصول الرّواية على نحو ما فعل نجيب محفوظ في “ميرامار” تمامًا، بدءًا بـ”فاطمة”، ومرورًا بـ”كاظم عبيد” و”كريم البصري” و”الزاير”، وانتهاءً بـ”فاطمة” كذلك.
وكلّ شخصية من هذه الشّخصيات تُعبِّر عن آرائها في الأحداث وفي شخصيات الرّواية الأخرى. وهو ما يتيح تعدُّد الأصوات ووجهات النّظر بدلاً من هيْمنة صوتٍ واحدٍ أو وجهةِ نظرٍ واحدةٍ في الرّواية، على نحو ما نرى في الرّواية الكلاسيكية الأوربية أو العربية”9. إنّ اصطفاءَ الباحث للتّناص، باعتباره تصوُّرًا يُمكِّن من التّعرُّف إلى النّصوص الغائبة التي ترفد النصّ الحاضر، ثمّ انتقاءَه التّناصَ الرّوائيَّ من بين أنواع التّناص الأخرى، من قبيل التّناص التّاريخي والتّناص الدّيني والتّناص الأسطوري، لا يهَب سوى معرفة بصُوَر التّفاعُل بين رباعية إسماعيل فهد إسماعيل وروايات عبدالرّحمن مجيد الرّبيعي ونجيب محفوظ.
وسواء أكانت تلك المعرفة مُتكامِلة أم مُجتزَأة، فإنّها معرفة تتعلّق بالأعمال أو النّصوص أو الرّوايات التي ألَّفها الكُتّاب الخليجيُّون رجالاً ونساءً، وليس بالسّرديات، كما يوحي إليه عنوان المؤلَّف والعناوين الفرعية التي ارتضاها الباحث لأقسام الكتاب الستّة، وإنْ كانت السّرديات البنيوية حاضرة في طيّات هذه الدّراسة، من خلال بعض المصطلحات و / أو الإجراءات، نظيرَ العتَبة والتيمة أو الموضوعة والحبكة والسّرد والزّمن والحيِّز والعجائبي، بجِوار علم النّفس والتّحليل النّفسي اللّذيْن يتبدّيان في مفاهيم مُعيَّنة، كالمازوخية والسّادية والهلوسة وعقدة أوديب، والفلسفة التي تتجلّى في مصطلح الاغتراب الذي له تمظهرات سوسيولوجية ونفسية، والمقولات ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثية، مثل الهوية والآخر.
ومن شأن تلك المصطلحات والإجراءات والمفاهيم والمقولات جميعها أن تُعِينَ الباحث على تحليل المدوَّنة؛ فيمضي، لا إلى “مُساءَلة” النّص الرّوائي العربي الخليجي المعاصِر مثلما يُفْصِح ويُعلِن في عتَبة العنوان، بل إلى “مُحاوَرة” أو “مُعالَجة” أو “دراسة” أو “مُقارَبة” أو “قراءة” أو “تحليل” أو “تأويل” أو “تفسير” أو “فهْم” أو “وصْف” مظاهره البنيوية والأسلوبية وأبعاده الاجتماعية والنّفسية والتّاريخية والذّهنية، كما يُلْمَس، حقيقةً، من طريقة تفكيره في النّصوص؛ فـ”المساءَلة”، بوصفها مُمارَسة، لا تُلائِم علم السّرد و/أو نقده، الذي يُفترَض أنّه عمل إبداعيّ مُنتِج يتجاوَب مع المحكيّ، لأنّها تجري مجرى الاستخبار والاستعلام والاستجواب والاستنطاق بل المحاكَمة والحُكْم، وتدّعي، من ثمّ، القدرة على كشْف جوْهَر النّص.
- خلاصة:
يُمثِّل هذان المؤلَّفان عيِّنة من الدّراسات العربيَّة التي لا تُوافِق عناوينُها متونَها، حيث يوجد تبايُنٌ بين ما تروم العتَبتان وصْفه وتعيينه والإيحاء إليه وإغراء القارئ به(10)، وهو السّرديات، وما هو موصوفٌ ومُعيَّنٌ ومُوحى إليه ومُغرى به في أصل الكتاب، وهو السّرد. ولا شكّ أنّ الفرق بيِّنٌ بين هذيْن المصطلحيْن السّرديَّيْن؛ فإذا كان السّرد مفهومًا جامعًا، كما يقول سعيد يقطين في كتابه “السّرد العربي؛ مفاهيم وتجليّات”، للمحكيّات كلّها التي تتشكَّل من الحكاية والخطاب والسّرد؛ فتكون المادة الحكائية نواتها والسّرد صيغتها الخطابية الرّئيسة والرّاوي مُتلفِّظها، فإنّ السّرديات، هي الأخرى، مفهومٌ جامعٌ للسّرديات البنيوية أو الكلاسيكية والسّرديات ما بعد البنيوية أو ما بعد الكلاسيكية. كما يُمكِن أن تكون السّرديات البنيوية أو الكلاسيكية مفهومًا جامعًا ثانويًا لسرديّات الحكاية وسرديّات الخطاب وسرديّات السّرد أو التّلفُّظ وسرديّات الدّلالة، وتكون السّرديات ما بعد البنيوية أو ما بعد الكلاسيكية مفهومًا جامعًا ثانويًا للسّرديات الاجتماعية والسّرديات الثّقافية والسّرديات ما بعد الكولونيالية.
ويبدو أنّ مصطلح السّرد، بالتّصوُّر الذي سبقت الإشارة إليه، قد استحوذ على اهتمام الكثير من علماء السّرد ونقّاده العرب؛ فغدا عنوانًا أثيرًا يتصدَّر دراساتهم وأبحاثهم، وموضوعاً مُحبَّبًا إليهم ينبرون لوصْفه وتأويله(11). غير أنّنا نفضّل على هذا المصطلح، كما أومأنا إلى بعض ذلك من قبلُ، مصطلح المحكيّ، لسببيْن اثنيْن؛ فأمّا الأولّ فيتمثّل في أنّ السّرد، الذي جعله بعض الباحثين والمترجِمين مُعادِلاً لمصطلح récit12، مُشتركٌ مُصطلحيٌّ يثير اللّبس؛ فهو يُحيل، باعتباره مفهوماً جامعاً، إلى تصوُّر الجنس الأدبي، ويُشير، بوصفه أحد مُكوِّنات هذا الجنس، إلى فعل تلفُّظ الحكاية الذي يقوم به الرّاوي، ويُقابِله، في اللّغة الأجنبية، مصطلح narration. وأمّا الثّاني فيتمثّل في أنّ المحكيّ يُناسِب مشروع السّرديات ما بعد البنيوية أو ما بعد الكلاسيكية الذي يستوي، عنده، المحكيّ الأدبيّ والمحكيّ غير الأدبيّ (المحكي الفيلمي، والمحكي الموسيقي، والمحكي القانوني).
- الهوامش:
1 – مثل كتاب “جماليات السّرديات التّراثية؛ دراسة تطبيقية في السّرد العربيّ القديم” لمي أحمد يوسف.
2 – توجد مُؤلَّفات نقدية روائية عربية أخرى وظَّفت مصطلح (سرديّات) توظيفاً يُجانِب الصّواب، نظيرَ مُؤلَّف “سرديّات القرن الجديد” لصلاح فضل، ومُؤلَّف “فن الرّواية في سرديّات زيد الشّهيد” من إعداد وتقديم فوزية لعيوس الجابري.
3 – محمَّد الشحّات: “سرديّات المنفى؛ الرّواية العربية بعد عام 1967″، أزمنة للنّشر والتّوزيع، عمّان، ط. 1، 2006، ص 14، 15.
4 – سعيد يقطين: “السّرد العربي؛ مفاهيم وتجليّات”، دار الأمان، الرّباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدّار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط. 1، 2012، ص 76.
5 – محمَّد الشحّات، مرجع سابق، ص 95.
6 – سليمان الطالي: “بلاغة النّادرة في الأدب العربيّ”، دار كنوز المعرفة للنّشر والتّوزيع، عمّان، ط. 1، 2015، ص 24، 25.
7 – محمَّد الشحّات، مرجع سابق، ص 39.
8 – الرّشيد بوشعير: “مُساءَلة النّص الرّوائي في السّرديات العربيَّة الخليجيَّة المعاصِرة”، هيئة أبو ظبي للثّقافة والتّراث، أبو ظبي (الإمارات العربية المتَّحِدة)، ط. 1، 2010، ص 8، 9.
9 – المرجع نفسه، ص 503.
10 – تلك أربع وظائف تضطلع بها عتَبة العنوان، في منظور جينيت.
11 – نذكر من تلك الدّراسات والأبحاث: “السّرد في روايات محمَّد زفزاف” لمحمَّد عزّ الدّين التّازي، و”تقنيات السّرد الرّوائي في ضوء المنهج البنيوي” ليمنى العيد، و”السّرد ووهْم المرجع؛ مُقارَبات في النّص السّردي الجزائري الحديث” الذي يتناوَل فيه السّعيد بوطاجين الرّواية والقصّة معاً، و”أساليب السّرد في الرّواية العربية” لصلاح فضل.
12 – مثل حسن بحراوي وبشير القمري وعبدالحميد عقار وأحمد الودرني وأنطوان أبو زيد وسعيد الغانمي وفلاح رحيم.
أ.د. سيدي محمَّد بن مالك – المركز الجامعي مغنيَّة – الجزائر
خاص لمجلة فكر الثقافية