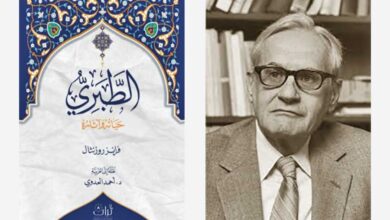في زحمة الأحداث المتراكبة التي يَضج بها العالم؛ وعالمُنا العربيُّ منذ ثورتِه الأولى على الباب العالي التي فَضَّتْ عُذريةَ اللُّحمة العربية، وجعلتْها مِزَقا يُرفرِفُ على كلِّ زُقاقٍ منها عَلَمٌ، ويُعزَف على كلِّ بُرجٍ منها سلامٌ ونشيد،
والتي أورثتْنا “سايكس بيكو” ونزاعاتٍ حدودية وعِرقية وطائفية وقبَلِية وإيديولوجية لا تنتهي، وأضاعت منّا وعلينا سنواتٍ من العِلم والتنمية والنهضة والتقدم والازدهار، وطمستْ كلَّ معالِم المجد التليد، حتى مِن الوعي الجمعي العربي والإنساني. وصار الإنسان العربي أهونَ وأرخصَ ما يكون.
دخلتْ الأمم ألفيتَها الثالثة، وقد ارتوتْ وتشبّعتْ بكل المنجزات السابقة، واستثمرتْها في الخَطْوِ نحو عوالمَ نهضوية، فكرية، عِلمية، صناعية، ثقافية، وديمقراطية أكثر انفتاحا واتساعا ورحابة؛ وأكثر سرعة أيضا، في تنافس محمومٍ لإحراز قَصَبِ السبق. سباقٌ يمضي بوتيرة متسارعة وبمتوالية هندسية لا نهائية.
في حين؛ تَحُثُّ أمم أخرى الخُطى شيئا فشيئا، لِلَّحاق بركب الألفية، أو على الأقل تعقبَ آثارِها واقتفاء ظلِّها، والبقاءِ في نطاق الزمن وما يجري فيه من تحولات وتطورات هائلة سريعة ومتلاحقة، وما يتحقق فيه كل يوم من اكتشافات واختراعات وابتكارات علمِّية أشبه بالسِّحر، في حين تقبعُ أمم أخرى خارج الزمن، وتعيش حياةً أخرى، لا تنسجم وروحَ العصرِ وسرعةَ تطورِه.
تعيش الأمة العربية اليوم (في ظروفِها وواقِعِها الحالي) خارجَ الزمن والمكان، بعد أن كانت قبل قرون قليلة حاملةً لِمشعل الحضارة، ورُبّانةً لسفينة البشرية في كل الفنون والمعارف والعلوم.
واليوم؛ صار الإنسان العربي رخيصا جدا، بل وصار نعتا لكل نقيصة، فهو الأمية، وهو الجهل، والتخلف، والرِّجعية، وهو التطرف والإرهاب، وهو الـ..،. ولم تعد هذه الأزقة التي يُسمونها أوطانا، سوى مرتعٍ ممتدٍّ للغرب؛ ومكبٍّ ضخم لكل سُموم وفضلات العالَمِ ونِفاياته الثقافية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية، مِمّا يُستهلَكُ ومِمَّا لا يُستهلك، وسوقٍ سوداءَ رائجةٍ، تارة باسم السوق الحرة، وتارة باسم العولمة، وتارة باسم التبادل التجاري الحر.
فأضحى هذا الإنسان العربي مَهووسا بالشراء والاستهلاك وإشباع رغباتِه، وإرضاء نهمِه، فاستحالَ بذلك (ماركةً مسجلة) في الاستهلاك، ورقماً مربحا ورائجا في التبضّع.
صحيحٌ أن الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين الكيانات والنطاقات العربية متفاوتة ومتباينة إلى حد بعيد، ولكن القاسم المشترك بينها يبقى هو هو، الاستهلاك؛ ولا شيء غيرُه.
إن كل الويلات والمآسي والآفات والهوان الذي يعيشه العالَم العربي منذ ردحٍ بعيد من الزمن، وفي الوقت الذي بات العالم المتقدم عِلميا وصناعيا وفكريا، يُفكر الآن جدّيا في إمكانية إقامة رحالات ذهابٍ وإياب سياحية مِن وإلى كوكب المريخ والزهرة،
مازال الإنسان العربي، بَعضُهُ يحلم ببيت من إسمنتٍ بدلَ كوخ من صفيح، ويبتهجُ لقُربِ مَدِّ حَيِّه بقنوات الصرف الصحي، وينام مبتسما لقرب حصوله على بطاقة استشفاءٍ في مدينة بلا مستشفى، أو بطاقة تموين في دولة تستورد كل شيء، ولا تُنتج أي شيء،
فيما يظل العربي الغني ُّكذلك؛ يَحلُم في هَجر قصرِهِ الفخم إلى قصرٍ أفخمَ منه، واستبدال طائرتِه الجديدة بأخرى أحدَثَ منها، وتظل ثقافة الاستهلاك والانغماس في المادة؛ هي القاسمَ المشتركَ بين غنيِّنا وفقيرِنا.
في غياب كامل لمشروع جادٍّ يبني الإنسان العربي بناءً صحيحا، ويمنحه حقوقه كاملة ويُحدد له واجباته، ويضعه على الطريق الصحيح والسبيل القويم الذي يوصل للتقدم العلمي والتكنولوجي والفكري والثقافي والتنموي الحقيقي والشامل.
إن المأساة التي نعيشُها حقيقة ومنذ عقود، تتمثل في ظاهرة كراهية العِلم التي تُفصح عنها كل تصرُّفاتِنا وكل ممارساتِنا وكل قراراتِنا ومواقِفنا، زاد من هذه المأساة هجرة الأدمغة، أو نزيف الأدمغة إذا صح هذا التعبير،
كون معظم العقول العربية الوازنة، والمبعثرة الآن في أصقاع العالم، إما تكوَّنت واختمرَ نُضجُها في الغرب، مستفيدة من الظروف الجد ملائمة التي تسمح ببناء الإنسان النموذجي والمثالي، أو ظلت في منشئِها العربي ولم تهاجر، لكنها بَنتْ وطوَّرتْ نفسَها بإمكانياتها الذاتية وبوسائلها الخاصة، واستثمرت مواهبَها استثمارا مثاليا،
وهذا واضح وجلي في عالمنا العربي، وأبرز تجلٍّ له، هم النوابغ العرب، وثلة من المتميّزين ذوي الكفاءات العلمية والفكرية العالية، الذين سرعان ما تَظْفَرُ بهم المعاهد العالمية في الدول التي تُقدِّر الإنسان، وتعترف له بقدراته وإمكاناته.
إنهم في المُحصلة أعلامٌ فَرْديون، تم اكتشافُهُم صُدفةً وتبنِّيهم لأسباب استثمارية تَرَبُّحِيَّة ودعائية لا أكثر، في حين تتولَّى المعاهدُ في الغرب بناءَ وصناعة الأعلام وتكوينِهم ومواكبتِهم.
إن منطقَ الصدفة الذي يسير عليه عالمنا العربي، لن يُحقق لنا الإنسانَ الذي نصبوا إليه، وفي النهاية نتعذَّرُ بألف عذر؛ ونستدعي مرة أخرى ثقافة الاستهلاك التي أدمنّاها؛ بسبب الفكرة المدفونة في وعينا الجمعي، وهي أن الآخر (الغربي) هو الأفضل دائما، وذلك عندما نلجأ إلى شراء الرياضيين والإعلاميين والتقنيين والعلماء والخبراء وشركات الحراسة و…،
وما دمنا غير قادرين على رسم سياسة واضحة تقوم على مؤسسات حقيقية واعدة تبني الإنسان العربي بناء صحيحا وسليما، يؤهلُه إلى دخول مُعتركَ الألفية، ومجابهة الكبار؛ وتضمن كذلك عدم نضوب خزان المواهب والكفاءات العربية، ما دُمنا غير قادرين على تحقيق هذا الشرط الأساسي، سنَظلُّ غير قادرين على امتلاك قراراتِنا، وتحديد وجهاتِنا ومصائرِنا، وسنظل رقما صعباً في الاستهلاك وحَسْب.
هوَّةٌ سحيقة، وشرخٌ كبير ذلك الذي يفصل بيننا وبينهم، رغم كل ما يُقال عن الغرب وجشعه ورأسماليته المتوحشة، ونفاقِه ونفعيته المطلقة وانهدام لُحمتِه و …، إلا أنهم لا ينظرون أبدا إلى المادة (الثروات الطبيعية) على أنها غاية،
إنها عندهم دائما وأبدا وسيلةٌ، وسيلة وحسب، (وسيلة للتملك والنجاح والتميُّز والسيطرة والهيمنة والتحكم والتفوق والبطش)، يأخذونها منَّا ويمنحوننا عوضا عنها القمحَ والشعيرَ والبطاطسَ والحليب والأغطية والأدوية والمواصلات، وأطنانا من (الشيكات)، التي نشتري بها أمننا وقَبُولنا واعترافنا الموهوم،
ونكتري من يحرس حدودنا، ويحمي أوطاننا، في حين يُختم على ثرواتهم الوطنية بالشمع الأحمر ويُكتب عليه (احتياطيٌّ استراتيجي للأمن القومي) ثم هُم يَدرسون ويبحثون ويتطورون ويتقدمون ويخترعون ويُطوّرون، ونحن نتبضَّع ونتسوّق ونستهلك.
يتطور الإنسان الغربي بشكل مُنظِم ومُنتظِم بالموازاة مع أنماط التطور الأخرى في المجالات المختلفة، ويُنظم العلاقة بينهما شبكة جد معقدة من المؤسسات والنُّظُمِ التي تنضوي تحتها سلسلة من التخصصات ذات المنحى العمودي والأفقي، وِفق رؤية مستقبلية مرسومة واضحة وجلية لا مَحيد عنها،
في حين ننظر نحن العرب وكثيرٌ من الأمم النامية أو ما يسمى بـ ((الدول السائرة في طريق الهلاك))، إلى التطور والتقدم من منظور مادي خالص، يتلخص إما في صفقات اقتصادية مربحة لا تنبني على رؤية استراتيجية واقتصادية مُمنهَجة، وليس لها أي أثر رجعيٍّ إيجابي على البلاد والعباد.
وإما في مجاراة بعض الدول المتقدمة، في تشييد الأبراج وإنشاء الجزر والمدن النموذجية، في حين أن مَناط الأمرِ كُلِّه يتعلق ببناء الإنسان أولا قبل أي شيء آخر، وليس العكس.
مفارقة لا أغربَ منها إذًا، هذه التي نَعيشُها ، يعجز كل ذي منطقٍ على توصيفها، ففي الوقت التي تتراوح فيه ميزانيات بعض الدول العربية ما يقارب 1000 مليار دولار، أينما ولَّيْتَ وجهك لا تجد لهذا الرقم أيَّ أثرٍ إيجابيٍّ مواكب،
في حين؛ تجد دولا وكيانات حديثة التكوين، قائمة على المساعدات والمعونات (الاحتلال الاسرائيلي)، تجدها حاضرة وبقوة في المراكز الأولى عالميا في البحث العلمي وفي المنجزات والاكتشافات العلمية.
كل هذا سببهُ عجزُنا التام عن تقدير المادة، واستشعار القيمة، وتحديد الخيط الرفيع الناظم بينهما، وانعدام رؤية مستقبلية محددة الأهداف، وواضحة المعالم، تعتمد أنظمة حرة ديمقراطية ومؤسساتية حقيقية تربط المسؤولية بالمحاسبة، وهياكلَ تنظيميةٍ جادة وفاعلة.
إن قيمة الإنسان في نهاية المطاف، تكمُنُ فيما يَعْلَم وليس فيما يملِك، “قيمة الإنسان فيما يعلم” وضع تحتها ألف خط وخط.