هل لغة النشر العلمي لغة علمية؟
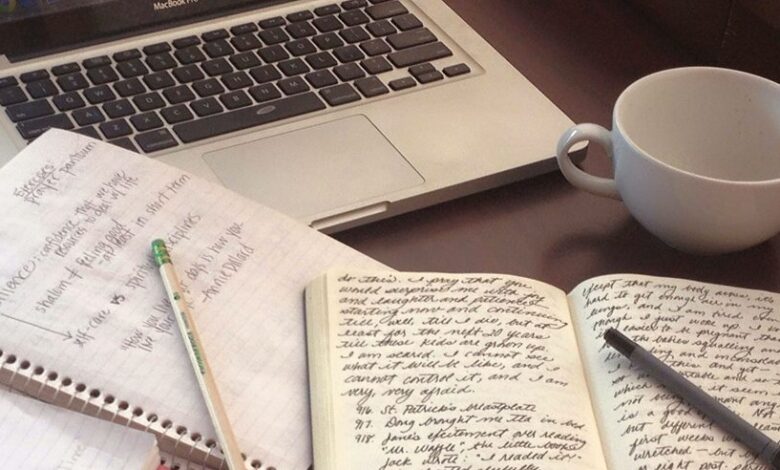
لم أكن معنيا كثيرا بما دار في قبة البرلمان المغربي حين صادق على مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا بما سبقه من نقاشات حول لغة التدريس بالمغرب، واختيار الفرنسية لتدريس العلوم،
والذهاب إلى أن العربية ليست لغة العلوم وما شابه هذا التصورات التي كان يرمي بعضها إلى جعل الدارجة وسيلة لتقريب المعلومات من الأطفال، لسبب بسيط هو أنها ذات طبيعة سياسية محضة. وحين يتعارض السياسي بمعناه الإيديولوجي مع الرغبة الوطنية،
في بعدها الحضاري، تكون وراءه الخلفيات ما وراء الكولونيالية بالمعنى الحقيقي للكلمة، وليس ما بعدها كما بات شائعا. وكنت مقتنعا أن القرار النهائي رغم كل ما سبقه من اختلافات سيكون الحسم فيه ضد العربية ولفائدة الفرنسية.
أن يظل النقاش حول اللغة الوطنية لمجتمع ما معناه أنه لم يستطع بعد أن يستقر على قرار يجعله يدخل العصر مزودا بما يحمله تاريخ المجتمع، وبما يعمل على تحقيقه في المستقبل.
صحيح قد نجد في بعض الدول التي تشكلت بسبب التوزيع الاستعماري للأراضي المحتلة منذ القرن التاسع عشر غيابا للغة جامعة بسبب كثرة اللغات واللهجات، وهيمنة الشفاهة، وعدم قدرة لغة ما لتكون مشتركة بين الجميع أثره البالغ في اعتماد لغة المستعمر.
لكن الأمر مختلف بالنسبة للمغرب. فاللغة العربية الكتابية موجودة فيه تاريخيا بل وحتى قبل تشكل اللغة الفرنسية نفسها. واختيار لغة المستعمر لأي اعتبار كان لا يمكنه إلا يدفع في اتجاه التساؤل حول المستقبل اللغوي المغربي؟
فرض الاستعمار الفرنسي لغته في المغرب العربي، ولكنه لم يستطع القضاء على اللغة العربية. لقد ظلت العربية في المغرب، وباقي الدول العربية لغة كل العلوم التي كان ينتجها تاريخيا أبناء هذه المنطقة الجغرافية من العالم.
صارت اللغة الفرنسية مع الاستعمار لغة الإدارة والتعليم والثقافة والإعلام جنبا إلى جنب العربية خلال فترة الحماية، واستمرت بعدها. وفي غياب سياسة لغوية واضحة بعد الاستقلال ظل التجاذب بين اللغتين متضمنا نوعا من التواطؤ حول ازدواجية تعبر عن التعايش.
وفي الوقت نفسه عن التعارض الذي يسعى أنصار كل لغة إلى فرض لغته على حساب الأخرى. وبعد أكثر من ستين عاما من الاستقلال ها نحن نعاود السجال ويتم إقرار “التناوب اللغوي” وهي عبارة ملتبسة تقضي تصريحا بأن تدريس العلوم يكون بالفرنسية. وهنا مربط الفرس.
كان النقاش الرسمي والشعبي حول “اللغة” في ذاتها: هل العربية؟ أم الفرنسية؟ أم الأمازيغية؟ أم الدارجة؟ أي أنه كان متصلا بالوجود في حد ذاته. ويعزى هذا الوجود إما إلى الهوية التاريخية (الأمازيغية) أو الحضارية (العربية) أو الاستعمال اليومي (الدارجة) أو الإداري (الفرنسية).
وكل حزب بما لديهم فرحون. لكن النقاش لم ينصب على الجوهري: كيفية الوجود. وأعتبر أن هذا هو النقاش المغيب رغم أهميته القصوى، والكل كان مجمعا على تجنب الخوض فيه لسبب بسيط هو أن سؤال الوجود ارتبط بالسياسة، وأن سؤال كيفية الوجود متصل بالتربية.
وحين لا يكون السؤالان مطروحين على السياسي والمربي بكيفية منسجمة ومتفاعلة لا يكون الجواب إلا لأحدهما ضد الآخر.
إن المشكل الحقيقي ليس في لغة التدريس أيا كان الاختيار: عربية، أو فرنسية، أو إنكليزية، أو أمازيغية. إن المشكل الجوهري يتعلق بكيفية تدريس هذه اللغات. إنه سؤال التربية. ومشكل التربية منذ الاستقلال إلى الآن ظلت تطبعه الارتجالية والتجريب والتسرع والفساد وغياب المحاسبة.
سؤال التربية يجر إلى طرح مشكلات عويصة تتصل بالبنيات التحتية، وتكوين الأطر، والتسيير والتدبير، وانسجام الرؤية إلى التعليم من الروض إلى العالي وفق خطط مدروسة ولغايات محددة.
مشكل التربية يتحدد في الجواب عن سؤال ماذا نريد منها: هل خلق الموظف؟ أم العالم؟ أم المواطن؟ وحين لا تكون عندنا دقة في الاختيار لا نكون سوى أمام التخبط والمتاهة.
إن الطريقة التي طرح بها التعريب لم تكن سليمة، لذلك لا أعتبر جوهر المشكلة في التعريب، ولكن في كيفية ممارسته. وهو السؤال نفسه الذي يطرح حول تدريس الفرنسية، وخاصة منذ استحداث “الأكاديميات”.
إذا كان الأستاذ الذي يدرس الفرنسية لا يعرف الفرنسية كيف يمكنه أن يعلمها للطالب في الشعب العلمية أو الأدبية؟ أذكر في إحدى اللجان الوطنية لتقييم اعتمادات الماستر والدكتوراه، سألت إحدى الزميلات من شعبة الفرنسية، وهي من الجيل القديم، عن عدد الملفات المقبولة، فلم تخبرني إلا بملف مرفوض بشكل مطلق بدعوى أن صياغته الفرنسية مليئة بالأخطاء الإملائية والنحوية والأسلوبية.
ولقد وقفت على هذا بأم عيني في مراقبة الامتحانات وتصحيح الأوراق في فرنسا حيث كنت ألاحظ أخطاء إملائية يرتكبها الطلاب الفرنسيون يندى لها الجبين. وأتذكر، في السياق نفسه، عندما كنا في الثانوي في السبعينيات أن أغلب طلبة العلوم لا يتقنون الفرنسية كما يتقنها الأدبيون.
وعندما كنا نصحح لبعض أساتذة الفيزياء أو الرياضيات اللغة التي يستعملها لم يكن لبعضهم من جواب سوى أنهم ليسوا أدبيين.
إن دعوى اللغة العربية ليست لغة علم باطلة، ولا أساس لها من الصحة نهائيا. ولن أذكر بتاريخ الفلسفة والعلوم إبان ازدهار الحضارة العربية الإسلامية. والذين يدعون أن الإنكليزية هي لغة العلم يقعون في الخطأ نفسه. اللغة تتطور بتطور المجتمع الذي يستخدمها.
اللغة الإنكليزية هي لغة النشر العلمي لأن التطور الذي عرفته هذه اللغة نتاج تطور وهيمنة الولايات الأمريكية المتحدة على المستوى العالمي.
إن كل العلوم الجديدة والمعاصرة التي تشكلت في العالم بعد الحرب الثانية موئلها أمريكا. لقد استقطبت أمريكا أنجب العلماء من مختلف الجنسيات واللغات، ووفرت لهم كل شروط وبنيات البحث العلمي في كل الاختصاصات بدون تمييز أو مفاضلة، كما هو الشأن عندنا.
وجعلتهم ينتجون العلوم والمعارف باللغة الواحدة والموحدة التي هي لغة أمريكا، وليس بلغاتهم الأصلية. وكان من بين أهم نتائج هذا الاختيار تطوير تدريس الإنكليزية نفسها، وبذلك صارت لغة قابلة لتعلمها بأبسط الطرق لدى الجميع.
إن الإنكليزية هي لغة النشر العلمي، وليست لغة العلم. إن علماء كل العالم الذين يشاركون في تطوير العلوم ينتجونها بلغتهم الوطنية، وفي الوقت نفسه ينشرون أعمالهم لتكون متداولة باللغة الإنكليزية أيضا.
وحين لا يقدمون على ذلك تضطلع المؤسسات العلمية المختلفة الأمريكية بترجمتها إلى الإنكليزية. لا بد من التمييز من لغة النشر العلمي واللغة العلمية.
إن اللجوء إلى التصويت لإقرار مشروع هذا القانون كان ليكون مقبولا ومنطقيا ووطنيا، في رأيي، أن يبين، موضوعيا، أن هناك، أولا: إكراهات سياسية ومالية، خارجية وداخلية تفرضه علينا واقعيا. وأن يكشف، ثانيا:
عن كون كل التجارب التي جربناها لإصلاح منظومة التعليم المغربي باءت بالفشل الذريع لأنها لم تكن واقعية ولا عملية، وأن اللجوء إلى هذا المشروع تقتضيه مصلحة عابرة، ويمكن تقييدها بزمن محدد، ثالثا. وأن العمل متواصل، من خلال لجان مختصة، لإنجاز سياسة تربوية تعتمد اللغة الوطنية لتدريس كل المواد بما فيها العلمية رابعا.
تتعرف الأمم المتقدمة على العالم، وتتواصل معه بواسطة لغتها. أما الأمم المتأخرة فتترك الآخرين يحددون لها لغتهم على أنها لغتها، وفي هذا منتهى التمييز بين الأمم المتخلفة والمتطور.














