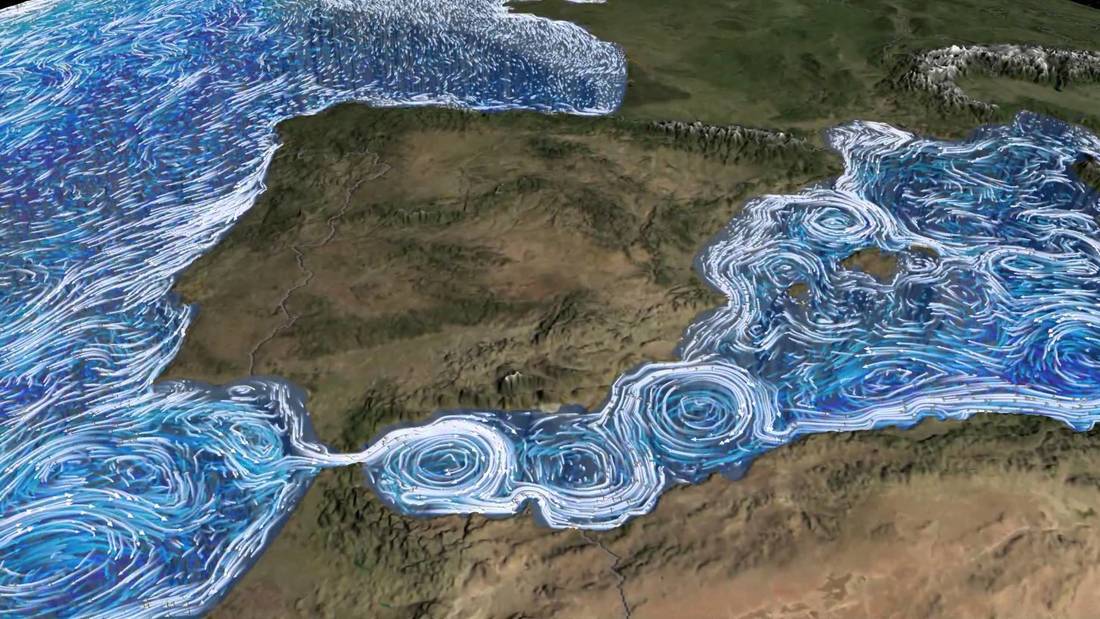دفاعا عن الثقافة الشعبية

حين تهمل ثقافة الشعب وتهمش لفائدة الثقافة الجماهيرية بسبب قيامها الأساس على الترفيه، والكثير من الترييض (من الرياضة) مع القليل من التثقيف، وخاصة في البلدان العربية، ولا توظف الثقافة العالمة في الوسائط الجماهيرية لتنوير المواطنين بالقضايا الكبرى التي تهم الفرد والمجتمع، فليس لذلك من معنى سوى إقامة الحواجز بين الشعب والنخب المختلفة.
كما أن إهمال الثقافة الشعبية في سياق التحولات التي بات يفرضها العصر وخاصة مع هيمنة التمدين، وزحف الرصيف على المناطق الطبيعية والخضراء، والدفع إلى الهجرة إلى المدينة، كل ذلك لا يسهم فقط في ضعف الثقافة الشعبية، والمقصود بها هنا الرصيد الرمزي والقيمي الذي كان يعيش بواسطته الإنسان في بيئته الطبيعية بعيدا عن زخم التمدين وآثاره التي تؤدي إلى الغربة والعزلة والتوتر، ولكن أيضا إلى تلاشي ذاك الرصيد واندثاره.
عورضت الثقافة الشعبية بادعاء أنها متخلفة، وفولكلور، وأن لغاتها ولهجاتها تهدد اللغة العربية. ويكفي أن نرى كيف أن إسرائيل وهي تعمل على صهينة فلسطين تحارب كل ما يتصل بالتراث الفلسطيني مدعية أنه جزء من ثقافتها الشعبية.
لم يلتفت في حمأة هذا الحماس ضدها إلى أنها ثقافة لها أسسها وقيمها ورمزياتها ورؤيتها للعالم. إنها خزان الرصيد التاريخي بكل إيجابياته وسلبياته لحياة شعب. تكمن خصوصية الثقافة الشعبية في كونها في آن واحد هي ما تتميز به الشعوب عن غيرها، وفي الوقت نفسه ما يجمع بينها.
إنها تمثل اللاشعور الجماعي الذي يوحد الناس ويضمن استمرار حياتهم التي عاشوها على مدى قرون محافظين على ما تعارفوا عليه أملا في التعايش والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلام. أما الثقافات الأخرى (العالمة، والجماهيرية، والمتفاعلة) فهي الشعور الذي تأسست معه الفردانيات والأنانيات والانتهازيات التي تدفع إلى التفكير في الذات المتعالية على الجميع والتي تجر إلى العنصرية والحروب المدمرة.
يكفي أن نقارن بين مباراة في كرة القدم (ويسمونها العرس الرياضي) يتابعها الجميع، وكيف يجري عرس حقيقي يغني ويرقص فيه الكل لنعاين الفرق بين العنف المبطن والظاهر الذي يجمع الجمهور الرياضي، والمودة والفرح الجماعي الذي يسود في الفضاء الشعبي. كما يكفي أن نقارن بين مبدع ينهل من الثقافة الشعبية، وآخر يستمد ثقافته مما هو سائد.
كان بسبب نشأتي في المناطق الشعبية في الدار البيضاء، أن تشبعت بثقافة الشعب المغربي في تنوعها وتعدد روافدها. كنت أتأمل العلاقة التي تجمع بين اللاشعور الجماعي المغربي في الفضاء الشعبي الذي كانت تعيش فيه شرائح اجتماعية فقيرة من مختلف أرجاء المغرب: تعدد لغات، وأصول، وتواريخ.
وكنت أرى أن ما يجمع بينهم رغم الاختلاف هو لغة الفرح والحزن التي تتعالى على كل اللغات: فيرقصون ويتفاعلون مع مختلف الألوان الموسيقية الشعبية التي يحسون بكونها تعبيرا عن آمالهم وآلامهم.
لم يكن التمايز حسب الأصول (عربي، صحراوي، أمازيغي) كما صرنا نتباهى اليوم بالهوية المغرقة في خصوصيتها. كان الفرح والتضامن والتآزر والتعايش هو ما يطبع الحياة الشعبية التي لا يمكن تلمسها في الأحياء المدعاة راقية حيث يتم الافتخار بعدم الحديث مع الجيران أو تبادل الكلام معهم.
منذ بدايات كتاباتي كنت أعتبر الثقافة الشعبية هي الركيزة التي تبنى عليها أي ثقافة. ومن بين مقالاتي المبكرة في جريدة المحرر (1977) كتبت مقالة تحت عنوان “دفاعا عن الثقافة الشعبية”. ظل اهتمامي بهذه الثقافة مستمرا طيلة حياتي، وإن كان انغماري في الحياة الثقافية العالمة والجماهيرية والمتفاعلة يجعلني بعيدا عن التفرغ للكتابة فيها وعنها.
فحيثما سافرت كنت أصر على اقتناء وسماع الموسيقى والأغاني التي تتداول في الأحياء الهامشية، وفي البوادي والقرى. وكنت أحس رغم أنني لا أعرف اللغة أن ما أسمعه تعبير صادق عن اللاشعور الإنساني العام والمشترك بين الناس جميعا.
كانت مجلة “التراث الشعبي” العراقية، و”الفنون الشعبية” المصرية، وبعد ذلك كل المجلات الخليجية التي اهتمت بها، وخاصة في الإمارات والبحرين من المجلات التي أتابعها بالاهتمام نفسه الذي كنت أتابع به مجلات “الطليعة” المصرية و”الطريق” و”آفاق عربية” و”الأقلام” و”مواقف” و”كلمات”… وكنت ألاحظ فروقا كبيرة بين النوعين.
وكان هذا يدفعني إلى التساؤل لماذا لا توجد في المغرب، وهو الغني باختلاف ثقافاته وتعددها، مجلة ثقافية تعنى بالثقافة الشعبية أيا كانت لغاتها وأصولها؟ وحين كنت أرى الجهود التي بذلها المصريون في الاهتمام بثقافهم الشعبية جمعا ودراسة وبين ما أتابعه في الدراسات الشعبية الأجنبية وما هو موجود عندنا كنت أعتبر ذلك ليس فقط نوعا من التقصير في البحث العملي، ولكني كنت أعتبره دائما تكريسا لتهميش الحلم الشعبي، ولقضايا الشعب الحيوية.
في إحدى اللجان التحضيرية للجنة الوطنية حول الثقافة المغربية (في عهد محمد بنعيسى)، اخترت المشاركة في لجنة التراث، وكان دفاعي مستميتا عن ضرورة إصدار مجلة ومنشورات خاصة بالثقافة الشعبية المغربية.
وفي نقاشاتي مع بعض الإخوان الذين يرفعون شعار الأمازيغية، كنت دائما أردد ماذا تقدمون للإنسان الأمازيغي في المناطق المعزولة والمهمشة؟ وما هو الفرق بينه وبين البدوي الذي يعيش قريبا من الدار البيضاء قلب المغرب النابض ولا يجد الماء الصالح للشرب، ولا المدرسة ولا المستشفى؟ هل استمعنا إلى نبضهما وكل منهما يصرح بهمومه في النكتة، أو يصرخ بها في أغنية؟
حين رفعت شعار “المغرب الثقافي”، و”مغربية” الرواية المغربية في الثمانينيات، كانت تتوارى خلفهما المطالبة بالاهتمام بالثقافة الشعبية من لدن الباحثين والمبدعين المغاربة، وليس لذلك من معنى سوى الاهتمام بقضايا الشعب.
اقترحت على دار الزمن، حين كلفتني بالإشراف على سلسلة “روايات الزمن”، أن تفكر في سلسلة أخرى حول “الثقافة الشعبية”، ولم يتحقق هذا الحلم. كنت لا أتردد في الإشراف على رسائل الإجازة أو دبلوم الدراسات العليا أو دكتوراه الدولة التي يرغب أصحابها في البحث في التراث الشعبي المغربي.
وفي أطروحة حول الحكاية الشعبية الأمازيغية لطالبة من اخنيفرة، قرأت حكاية (حيلة الحية لصيد العصفور) التي سبق أن رأيتها عند الجاحظ، فتساءلت: هل هذه حكاية أمازيغية؟ كيف هاجرت هذه الحكاية من فضاء الصحراء لتعيش بين أحراش الجبال، وتقدم بلغة غير لغتها؟ هذا ما يجمع رغم كل ما يمكن أن يوظف على أنه يفرق.
إن الثقافة الشعبية في تنوع روافدها العربية والأمازيغية والصحراوية ثقافة واحدة اللاشعور الذي تشكل عبر قرون من التعايش والتزاوج والتفاعل. وهي الثقافة نفسها التي تجمعها مع الثقافة العربية والإنسانية أيضا.
لم أتردد في الاستجابة لدعوة الزملاء بعد تأسيس الاتحاد المغربي للثقافات المحلية في العمل في المشروع الذي كان من بين أهدافه إصدار مجلة للثقافة الشعبية المغربية. فجاءت “الثقافة الأخرى” لتحقق حلما كبيرا بالنسبة إلي وإلى العديد من المهتمين والدارسين.
تغيرت أمور كثيرة الآن مع ما كانت عليه سابقا. بات الحديث عن التنمية البشرية، والجهوية الموسعة، وعن التراث اللامادي. كما أصبح الحديث عن البدائل المعاصرة في التغذية والصحة مثلا دالا على أن الإنسان الذي عانى كثيرا من “الشعور” الذي فرضه العصر الغربي الحديث الذي دمر النظام البيئي الطبيعي والشعبي يبحث عن الخلاص في “اللاشعور الإنساني”.
ليس الدفاع عن الثقافة الشعبية سوى رجوع إلى الشعب ودفاع عنه.