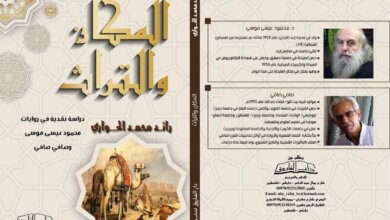أين تقف حركة الحداثة الشعرية اليوم

كثيرة جداً هي رهانات الحداثة الشعرية العربية، وأكثر منها رهانات شعراء الحداثة أنفسهم وهم يؤسسون لبرامج ومشروعات شعرية فردية وجماعية، ويسلكون فيها مسالك ومفازات متنوعة، متقاطعة أحيانا، منذ بدايات إرهاصات الحداثة الشعرية العربية في خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم بدءاً من قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر وانتهاءً بقصيدة النثر، مروراً بقصيدة النص المفتوح وقصيدة الأشكال والبنى المتجاورة بتعبير كمال أبوديب، دون أن نهمل كلياً بعض التجارب الطموحة للشعراء الشباب الذين بدأوا منذ منتصف تسعينات القرن العشرين بتطوير مشروع تحديثي للقصيدة العمودية أطلقوا عليه مصطلح “قصيدة الشعر”.
وهذه التطلعات التي قدمتها مختلف الأجيال الشعرية هي تجارب وتطلعات تهدف، ربما، إلى الوصول إلى “مدينة أين” الشعرية التي كرّس الشاعر سركون بولص حياته للبحث عنها، أو ربما للوصول إلى رؤيا شعرية متميزة ولغة شعرية متوجهة ومتفجرة قادرة على استكناه المجهول والأعماق، وكسراً للمألوف والراكد والمتحجر والزائف، دون أن تتعالى على الوجع الإنساني ونداءات الأرض الجريحة، ومن خلال الإيماء غير المباشر وغير القسري إلى الدلالات والمعاني والحمولات المعرفية والإحالات السيميائية الخفية، الكامنة والظاهرة معاً، الصامتة أو المسكوت عنها التي تنطوي عليها، في الجوهر مدونة شعراء الحداثة الشعرية العربية ورهاناتهم الجريئة.
ووجهة نظري النقدية هذه هي حصيلة متابعة يومية وميدانية لعطاء الحداثة الشعرية العربية عبر مختلف أجيالها ورموزها، وهي تنظر إلى متن الحداثة الشعرية، ليس بوصفه متناً، محايثاً، ولسانياً ليس إلاّ، كما تذهب إلى ذلك بعض المناهج الشكلانية والبنيوية والتي تعمد إلى تقديم قراءات نصية خارج الزمان والمكان والواقع الإنساني المعاصر، وربما يموت فيها المؤلف، كما أشار إلى ذلك رولان بارت، بل هي تنطلق جزئياً من منظور “المؤلف المزدوج” الذي طرحه “النقد الثقافي” وبلورة بشكل محدد الناقد د.عبد الله الغذامي في كتابه “النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية” عندما أشار إلى أن النتاج الإبداعي هو ثمرة تأليف مزدوج من قبل المؤلف التقليدي وما أسماه بالثقافة، حيث يقول “سنرى أن في كل ما نقرأ وما ننتج وما نستهلك، هناك مؤلفين اثنين أحدهما المؤلف المعهود، ومهما تعددت أصنافه كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي، والآخر هو الثقافة ذاتها، أو ما نرى تسميته هنا بالمؤلف المضمر، وهو ليس صيغة أخرى للمؤلف الضمني، وإنما هو نوع ً من المؤلف النسقي.. وأن هذا المؤلف هو ناتج ثقافي مصبوغ بصيغة الثقافة أولا”.
وهذه الرؤيا تلتقي إلى حدٍ ما مع طرحه المفكر الفرنسي بيير بورديو حول مفهوم “الهابيتوس″ أو الحاضنة الثقافية والاجتماعية التي تتحكم بالنتاج الثقافي والأدبي لأيّ مبدع.
وتظل عملية ملاحقة رهانات حركة الحداثة الشعرية، وإلى درجة أكبر رهانات شعراء الحداثة وبرامجهم ورؤاهم الإبداعية المتباينة، هي الهدف الأسمى لمشروعي النقدي الاستقصائي والتأويلي والاستنطاقي هذا.
ولكن، وبعد كل هذه الفتوحات والكشوفات الغنية والمتنوعة التي حققها الشعر العربي الحديث يحق لنا أن نتساءل: أين تقف اليوم حركة الحداثة الشعرية العربية عموماً، والعراقية بشكل أخص؟ هل هي حقاً في منطقة جمود وأزمة، أو تراجع وتعثر، كما يوحي بذلك بعض النقاد؟ أهي في مرحلة مراجعة لمعرفة الإنجازات والإخفاقات ولتلمّس حدود الخطوة القادمة؟ أم إنها ما زالت متعافية ومعطاء وحيّة، وقادرة على مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها العصر، ومنها تحدي الأجناس الأدبية الأخرى، وفي مقدمتها الرواية، وكشوفات ثورة المعلوماتية الرقمية وعوالم الصورة والميديا التي راحت تنافس المتن الورقي المطبوع.
بداية، لا بد من الاعتراف بأن الشعر رؤيا وموقف من العالم، وسلوك شعري قبل أن يكون تقنية أو نزعة أسلوبية، أو آليات تعبيرية وبلاغية معينة. وربما تعد واحدة من السمات الأساسية، فضلاً عن سمات أخرى للشعر الحديث، وتحديداً للحداثة الشعرية، تتمثل فيما عبر عنه ت. س. إليوت بمقولة “الهروب من الذات”. فبعد أن ظلّ الشعر، وخاصة خلال المرحلة الرومانسية ملتصقاً بالذات، بدأ يهرب منها ويتجه إلى لون من الشعر الموضوعي “البارد” والذي وجد بعض تمظهراته في مطلع القرن العشرين في النزعة الإيماجية ( التصويرية Imagism) ، وفي بعض أنماط الشعر العيني أو الكونكريتي (Concrete)، وفي محاولة البحث عن معادلات موضوعية، بتعبير إليوت نفسه للتعبير عن مواقف الشاعر ورؤاه تجنباً للمباشرة والتقرير والإنشاء الخالص.
وربما وجد الشعر العربي الحديث ضالته بعد إرهاصات مبكرة شهدها النصف الأول من القرن العشرين في قصيدة “الشعر الحر” أو قصيدة التفعيلة على أيدي رواد الحداثة الشعرية في العراق: بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبدالوهاب البياتي وغيرهم. وربما وجد هذا الشعر فرصته الأكبر في تنميطات القصيدة الستينية وتجاربها وكشوفاتها، سواء في إطار قصيدة التفعيلة أو “قصيدة النثر ” أو في القصيدة المدوّرة وقصيدة النص المفتوح وقصيدة البنيات المجاورة بتعبير كمال أبوديب حيث الانفتاح الأجناسي على أنواع وأصناف موضوعية وغير غنائية مثل الدراما والسرد والملحمة، وهي كلها كانت تمثل هاجساً أو نزوعاً لتحقيق لون من التجريب الذي يفضي إلى بنيات وأنساق وألوان وتقنيات شعرية متجددة، وهو بحث قلق ومتواصل ومتواتر، إذ ليس ثمة من نهاية للشعر، مثل تلك النهاية التي افترضها في وقت ما فوكوياما للعالم قبل عقود قليلة.
لقد راحت التجارب الشعرية الحداثية عموماً، والعراقية بشكل أخص، تتخلى تدريجياً عن جوهرها الغنائي الصرف من خلال الانفتاح على الأصوات الغيرية وعلى أجناسيات فنية وأدبية وإعلامية مثل السيناريو والسينما والمسرح والرسم والنحت وفن التصوير الفوتوغرافي أو المنشور السياسي والإعلان التجاري، لكنها ظلت في تقديري تنتمي في الجوهر إلى الغنائي أجناسياً، وكل الاجتهادات التي تتحدث عن أجناس شعرية جديدة بعيدة عن الدقة، لأن ما نراه هو تنويعات أو ضروب ثانوية ملحقة ومتفرعة عن المتن البدئي للغنائية، لكنها لم تعد تلك الغنائية الكلاسيكية أو الرومانسية الصافية بل اكتنزت بمقومات وحمولات معرفية وفلسفية ومظاهر موضوعية، من خلال التعدد في الأصوات الشعرية والاحتشاد بعناصر كولاجية فسيفسائية وبنيات سردية ومشهدية من مختلف الألوان.
كما تخلّت قصيدة الحداثة الشعرية عن النزعات المنبرية والخطابية والصوتية والعاطفية. فقد راح الشاعر يقدم خطاباً شعرياً موجهاً نحو الآخر، فرداً أو جماعة ، بعد أن ظلت القصيدة الجاهلية، وحتى منتصف القرن العشرين تتسم بهيمنة “أنا” الشاعر المهيمنة. فقد تكون “أنا” الشاعر نرجسية أو تكون الذات الثانية للشاعر أو قناعه. أما “أنت” فهي في الغالب “الآخر” الممدوح أو الحبيب أو القبيلة. وبين هذين القطبين تمتد فضاءات القصيدة العربية الكلاسيكية ما قبل الحداثية التي يمثلها عمود الشعر التي ورثها عن دور الخطابة، ومن وظيفة الشاعر القديم بوصفه صوتاً للقبيلة وممثلها.
وقد كان هدف المنبر، وما زال، التأثير المباشر في الآخر، وتحريضه على تبنّي موقف الشاعر الفردي والاجتماعي، وثمة دائماً حضور افتراضي أو واقعي لجمهور ما يتلقى هذا الخطاب وينفعل به.
ولذا فقد تمثلت النقلة الجديدة في التخلي الجزئي عن النزعة الصوتية بما فيها من تطريب وإيقاع وقعقعة بالقوافي. وقد كانت القصيدة التقليدية الكلاسيكية تحتشد بتراكم صوتي وموسيقي داخلي وخارجي، وزني وإيقاعي، فضلاً عن سلسلة لا تنتهي من اللعب والأساليب والمحسنات البديعية والبلاغية مثل الجناسات التامة والناقصة ومقوّمات الرويّ والقافية والجرس الموسيقي، وغير ذلك من مقومات لازمت البنية السيمترية المتناظرة لجزأي البيت الشعري بوصفها بنية إيقاعية ودلالية مكتفية بذاتها.
وربما يمثل الإنجاز الأبرز الذي اقترن بمشروع قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر بالسعي لخلق شعرية بديلة عبر الاعتماد على مبادئ المغايرة وتفجير اللغة واللعب الحر بالدوال وتعويم المعنى وتشتيته أو تمويهه وخرق المألوف وتحقيق الصدمة والتلاعب بأفق توقع القارئ ومباغتة بصيرته وخلق مناخ شعري ضاج ومدهش وصادم.
وعلينا الاعتراف أن قصيدة الحداثة الشعرية العربية، بشكل عام، لم تصعد إلى أبراج شعرية عاجية ولم تستمرئ اللعب الحر الكولاجي بالكلمات والصور الذي بشرت به النزعة الدادائية أو انفلاتات اللاوعي التي أسست لها النزعة السريالية، بل بقيت إلى حد كبير قريبة من الهم الإنساني ولواعج الذات المجروحة وانكسارات الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي، هذا الهم الذي لم يصعد بطريقة مباشرة بل كان يمثل النسغ الداخلي أو الأرضية التي ينهض عليها الخطاب الشعري الحداثي.
وربما كانت الحداثة الشعرية الخمسينية في العراق تعبيراً موضوعياً وذاتياً عن غليان داخل الواقع الاجتماعي ألزم الشاعر بالالتزام بموقف اجتماعي نقدي رافض لعناصر التخلف ومتطلع لتحقيق تغير جذري اقترن ذاتياً بالوعي بحاجات التغيير التعبيري والأسلوبي والفني والبنيوي في القصيدة الذي يتناغم مع التبدل السريع في الذائقة الأدبية وفي ظهور لون من الحساسية الفنية الحداثية المبكرة.
بينما جاءت الحداثة الستينية العراقية متمردة وثائرة وترفض المصالحة مع الواقع الخارجي والثقافي ومع الأعراف الأدبية والجمالية، وحتى مع الذائقة الفنية السائدة، ودشنت مشروعاً “صاخباً” من خلال التمرد على أبوّة الجيل الخمسيني والتطلع صوب مشروع الحداثوية أو الحداثانية الغربي بشقيه الفرنسي والأنكلو-أميركي حيث تغيرت الرؤيا الشعرية والموقف من العالم.
فالشاعر الحداثي الستيني، في العراق خاصةً، بدأ مثقلاً بهموم العالم والكون حد الانكسار، وكان منشغلاً أساسا بهمّه الذاتي والداخلي ومحاولته مواجهة كل ضغوط العالم وكوابيسه فردياً بعيداً عن الاندماج في الهمّ الجماعي أو الاجتماعي الذي لم يعد أصلا في مركز رؤيته. لقد بدأ الشاعر الستيني متمرداً أو مشاكساً وصارخاً ورفض عقد أيّ “مصالحة” مع الواقع الخارجي، وحتى مع الآخر، خلافاً لموقف شاعر الحداثة الخمسيني. كان الشاعر الستيني مفعماً بالشجن والحزن والانكسار، ولم يعد قادراً على الغناء الصافي الشفاف، وكان يبدو أحيانا عبثياً وكئيباً، كما قطع كل الخيوط التي كانت تربطه بالرومانسية وبأحلامها ومعجمها الشعري، لكنه من الجهة الأخرى نجح في دفع مشروع الحداثة الشعرية العراقية خطوة جسورا إلى الأمام قطعت الطريق أمام كل مظهر من مظاهر التردّد التي كانت تخامر الشاعر الخمسيني والتي دفعت شاعرة مهمة من رواد الحداثة هي نازك الملائكة للانكفاء عن مشروعها الشعري والعودة إلى الأصول التراثية الأولى، لكنّ شاعراً مهماً آخر هو بدر شاكر السياب سار بالحداثة الستينية حتى نهايتها. وربما كان “البيان الشعري” الصادر في آذار 1969 دلالة وشاهداً على مستوى الرؤيا الشعرية الحداثية التي كان يراهن عليها معظم شعراء ذلك الجيل آنذاك. ولذا فقد آثر البيان الشعري أن يختتم بهذا الرهان الصعب للشعر معاً: “لقد آن للقصيدة العربية أن تغيّر العالم من خلال نسف أضاليل الماضي والحاضر، وإعادة تركيب العالم داخل رؤيا شعرية جديدة. لقد آن للقصيدة العربية أن تتحدث عن رحلة الإنسان إلى الحقيقة، عبر حضور جوهر كل الموجودات في الذهن، حيث القصيدة آخر طلقة في بندقية هذا الكائن البدائي المتحرر والمعقد”.
وفي السبعينات من القرن الماضي أعاد الشاعر العراقي الحداثي مصالحته الجزئية مع العالم الخارجي وتخلى عن الكثير من أحلام الشاعر الستيني ورهاناته وأعاد قراءة منجز قصيدة الحداثة الخمسينية وأفاد منها، كما بدأ بتفحّص شعرية أشياء الواقع من خلال خلق “القصيدة اليومية” التي أعادت الاعتبار لما هو حسي ومرئي وبصري في تضاريس الحياة الإنسانية ورموزها ومكوناتها. كما واصل هذا الشاعر تعميق ثقافته الشعرية والنقدية من خلال الاطّلاع على الشعر العالمي واتجاهاته المختلفة، مع إعادة الاعتبار للموروث الثقافي والشعري العربي الكلاسيكي، والذي تجاوزه بعض شعراء الستينات من خلال البحث عن مثال جمالي وشعري أوروبي وغربي تحديداً أنتجته حركات الحداثة الشعرية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وبدأ الشاعر السبعيني بالتوغل داخل غابة الميثولوجيا وطقوسها السرية، فضلاً عن استحضار الرموز الفولكلورية والثقافية الإنسانية والعربية. وراحت القصيدة المهموسة خافتة الصوت تتكرّس من خلال التخلي عن مظاهر المنبرية والخطابية والمباشرة والشروع الحقيقي لتأسيس ذائقة شعرية حداثية متوازنة تمتلك بعداً عقلانياً مثلما تمتلك بعداً لا منطقياً وتخييلياً.
وكانت محنة الشاعر الحداثي في الثمانينات من القرن الماضي كبيرة تحت ظل صعود الاتجاهات الاستبدادية والفردية في الحكم والتي حاولت أن تفرض اشتراطات أيديولوجية وسياسية وتعبوية لتبرير حروب النظام المجانية ولتكريس سياسة التطبيل لرموز النظام السياسية وبرامجه الفاشية الإقصائية المعادية للثقافة ولكل ما هو إنساني. وقد دفعت محنة الشاعر الحداثي هذه إلى الهرب تدريجياً من إملاءات أجهزة النظام الثقافية والحزبية من خلال الانكفاء على تجارب ذاتية وشبه شكلانية اتخذت من إطار “قصيدة النثر” ملاذاً لها، وهو ما سبق لي وأن توقفت أمامه في كتابي النقدي الموسوم “شعر الحداثة: من بنية التماسك إلى فضاء التشظي” الصادر عام 2012. وفي الوقت ذاته ظهر عدد غير قليل من الشعراء وأنصاف الشعراء ممن كرسوا قصائدهم لتمجيد الطغيان وتزوير حقائق الحياة ومعاناة الفرد العراقي في ظل سياسة الاستلاب والحروب والتجويع من خلال توظيف القصيدة العمودية التقليدية أساسا، وقصيدة التفعيلة جزئياً.
وتفاقمت محنة الشاعر العراقي في التسعينات في ظل مواصلة الحروب العدوانية والحصار وقمع الحريات، فظهر اتجاهان أساسيان في ذلك الشعر يتمثلان في مواصلة شعراء قصيدة النثر مشروعهم الحداثي للتخلص جزئياً من ملاحقات المخبرين وكتبة التقارير السرية، ولتعميق شعرية هذا الاتجاه فنياً واجتماعياً. أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس مشروع تجديدي لبنية القصيدة العمودية أُطلق عليه مصطلح “قصيدة الشعر” أطلقه عدد من الشعراء الشبان ممن كانوا يكتبون القصيدة العمودية التقليدية وانتقلوا إلى هذه المنطقة الجديدة للخروج من العمود الشعري من التقليدية والرتابة والمباشرة والمنبرية، وضخّ عناصر وحمولات ومقومات حداثية من خلال تجديد الصورة واللغة والرموز والموضوعات والثيمات. ومن جهة أخرى فقد حاول معظم شعراء هذا الاتجاه، إلاّ ما ندر، الابتعاد عن تكريس تجاربهم الشعرية لتمجيد الحرب والطغيان وعبادة الأصنام السياسية، تاركين هذه المهمة لذوي النفوس الضعيفة ولبعض شعراء القصيدة العمودية التقليدية، بما فيها من مباشرة ومنبرية وخطابية وجعجعة لفظية وصوتية.
وعلينا الاعتراف أن القصيدة العمودية، أو قصيدة الشطرين، لم تنته مع ظهور قصيدة الشعر الحر وموجات الحداثة الشعرية المختلفة، إذ استمرت هذه القصيدة وبشكل خاص في الثمانينات والتسعينات بالتزامن مع الحروب العبثية للدكتاتورية لتكون جزءاً من المؤسسة الأيديولوجية الداعمة للحرب والعنف، وكانت تمثلها تجارب شعراء منهم عبدالرزاق عبد الواحد ولؤي حقي ورعد بندر وعلي الياسري وغيرهم. وربما ساهمت حالة الانكسار العربي بعد حرب الخامس من حزيران عام 1967، وزج الشعر العراقي في محرقة حروب الدكتاتورية وتجميل صورة رموز النظام الاستبدادية، في انتعاش هذا الشعر بما فيه من منبرية ومباشرة وقعقعة صوتية.
لكن ظهور الاتجاه الجديد في القصيدة العمودية الذي تمحور حول مصطلح “قصيدة الشعر” ساهم في تحقيق مغايرة ملموسة وإزاحة عن المسار التقليدي التعبوي، من خلال تأكيد شعراء هذا الاتجاه على أن ينأوا بأنفسهم عن الانغماس في لعبة التطبيل والولاءات التعبوية للنظام الاستبدادي، حتى يمكن القول إن هذا الاتجاه كان يمثل -إلى جانب اتجاه شعراء قصيدة النثر في العقد التسعيني- حركة احتجاج سياسي واجتماعي صامتة ضد الحرب والاضطهاد ومصادرة الحريات، وكان هذا الاتجاه بطريقة أو بأخرى التعبير الاجتماعي عن وعي تاريخي وثقافي جديد.
ولكن يا ترى هل كانت هذه التجارب، بإشكالياتها تلك ومحدوديتها تتساوق والتطلع إلى تحقيق مهمة جذرية في التمرد والاحجتاج وإعادة صياغة الذائقة السائدة والتغيير الاجتماعي الجذري؟
في تقديري أن “قصيدة الشعر” ظلّت تعاني من مقومات تحدُّ إلى حدّ كبير من قدرتها على التحول إلى حركة ثورية في الشعر، كتلك التي ظهرت على أيدي شعراء الحداثة في الخمسينات أو تلك التي طرحها شعراء الستينات.
فقد ظلت تلك القصيدة متسمة بالاستسلام للموقف الغنائي والرومانسي والذاتي إلى درجة كبيرة، وهو موقف يذكرنا بالكثير من تجارب الرومانسيين العرب من مهجريين وشاميين، بينما لم تعد قصيدة الحداثة -هذا إذا أردنا لقصيدة الشعر أن تندرج ضمن لافتة الحداثة- تحتمل مثل هذا الغناء الرومانسي الحالم، وهذه النزعة النرجسية الشديدة والافتنان بالذات. لقد راحت قصائد الحداثة تكشف عن رؤيا فلسفية، وربما متفلسفة للعالم والإنسان والتجربة الإنسانية، مما يجعلها تكتسب هدوءاً وعمقاً وتأملا كشف عن معاناة عميقة للوجود الإنساني، كما أن القصيدة أصبحت أكثر ميلاً للشعر المهموس الذي لا يطمح إلى ارتقاء منبر الخطابة المباشر، بل يكتفي أحيانا برسم مشهد صغير، بلغة حسية، ربما سينمائية وبصرية، تتحرك خلالها الأشياء والموجودات والكائنات بطريقة دالة تاركةً للقارئ المدرب يملأ الفجوات والفراغات ويستنطق ما هو مسكوت عنه في النص الشعري.
الملامح الحداثية التي أخذت بها “قصيدة الشعر” لا تكفي، لأنها تضيع، في الغالب، داخل رؤيا عمودية -إذا جاز التعبير- ما دام الشاعر يتبناها وينطلق منها، وكأنه يريد أن يبقى فارس القبيلة وممثلها وصوتها. وليس معنى هذا أن يكفّ الشاعر عن الاحتجاج والصراخ. فشعر الحداثة هو الآخر، مليء بالصراخ والعويل والبكاء، لكنه مصاغ بطريقة حداثية من خلال الصورة أو الموقف أو المشهد الشعري وليس من خلال خطاب مباشر.
ويمكن القول إن معظم شعراء “قصيدة النثر” كانوا من الشبان النرجسيين المفتونين بأنفسهم وبالحياة، وينظرون إلى أنفسهم في عشرات المرايا، إضافة إلى التحديق داخلهم، ولذا ظلوا في الغالب عاجزين عن التأمل والتفلسف والنظر العميق إلى إشكالية الوجود الإنساني ومحنه المتراكمة.
ومحنة شعراء هذا الاتجاه أن ثقافتهم، في الأغلب، ظلت ثقافة تقليدية وتراثية أساسا، ولم يحاول هؤلاء الشعراء أن يفتحوا كوىً كافية للتشبع بما هو جديد وحداثي في التجارب الشعرية الحداثية في العالم. فالمرجعيات الثقافية والنقدية كانت هي الموروث العربي الكلاسيكي، وكانوا ينهلون من منابع محدودة ويتعلمون من بعضهم البعض، وأحيانا يكررون نماذج معروفة ومكررة. كما يمكن ملاحظة ضعف الذخيرة النقدية والفلسفية الحية والشاملة والحداثية اللازمة لخلق تجربة شعرية كبيرة ومتميزة بسبب ضعف انفتاح شعراء هذه التجربة على التجارب الشعرية الحداثية الكبرى والدراسات النقدية والسيميائية الجديدة من خلال الترجمة أو القراءة باللغات الأجنبية.
لا شك أن أيّ تطور جذري داخل تجربة وطنية أو قومية يظل إلى حد كبير محكوماً بمجموعة من القوانين الذاتية والموضوعية والمؤثرات التكوينية والثقافية المتنوعة. ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال إهمال أو إسقاط المؤثرات الخارجية الثقافية والفنية والجمالية على تجربة أيّ شاعر ووعيه وتكوينه. ولو رصدنا المؤثرات الأساسية التي أسهمت في إنضاج تجربة الحداثة الشعرية العربية لوجدنا دوراُ استثنائياً للمؤثرات الخارجية، الشعرية والنقدية أساسا، التي أسهمت في إنتاج قصيدة الحداثة الخمسينية على أيدي المثلث العراقي السياب، نازك، البياتي.
فلولا اطّلاع بدر شاكر السياب ونازك الملائكة، على التجارب الشعرية العالمية وتأثرهما العميق ما كان لهما أن يتوصّلا إلى تقديم هذا الأنموذج الشعري الحداثي، وخاصة من خلال استلهام مفهوم قصيدة الشعر الحر (Free Verse) في الأدب الإنكليزي، وطبيعة البنية الداخلية للقصيدة الحديثة ومكوناتها، والتي سبق لنازك الملائكة أن درستها في فحصها لمفهوم “الهيكل” الشعري في القصيدة الحديثة. كما أن المثال الجمالي لشعراء الحداثة، أمثال إليوت والذي استلهمه شعراء الحداثة الخمسينية كان عاملاً مؤثراً وحاسماً في الخروج من الموضوعات والضروب التقليدية للقصيدة العمودية والاتجاه صوب ما يمكن تسميته بالوحدة الموضوعية للقصيدة. كما أن حركة الحداثة الشعرية في الخمسينات كانت منفتحة على قيم اجتماعية، وطنية وقومية وإنسانية وتقدمية تمثلت في استلهام تجارب شعرية لشعراء أمثال مايكوفسكي وناظم حكمت وبابلو نيرودا ولويس أراغون وفيدريكو غارسيا لوركا وغيرهم. وفي الستينات ما كان يمكن لحركة الحداثة الشعرية أن تتفجر لولا استلهام تجربة الحداثانية الأوروبية، وتجارب شعراء الحداثة الفرنسية أمثال بودلير ورامبو، والاطّلاع على قصيدة النثر وبعض التجارب المتمردة في الأدب الأميركي والإنكليزي مثل تجارب وولت وتمان وقصائد البيتنكس في الشعر الأميركي التي تمثلها قصائد ألن غنسبرغ وفرلنكهيتي وكورسو وبعض تجارب شعراء الجيل الغاضب الخمسينية في بريطانيا.
ويمكن القول إن انكباب شعراء موجتي الحداثة الشعرية في الخمسينات والستينات على استلهام الشعر العالمي والبحث عن مثال جمالي مغاير قد اقترن، إلى حد كبير، بتحقيق لون من القطيعة المعرفية النسبية -بتعبير ميشال فوكو- مع الموروث الكلاسيكي، الذي ظل ضاغطاً، في اللاوعي، على اتجاهات الحداثة الخمسينية ونجح في استعادة نازك الملائكة إلى صفه ثانية، بينما سار شعراء الحداثة في الستينات إلى نهاية الشوط وحققوا لوناً من القطيعة المعرفية الكلية التي قادتهم إلى كسر النسق المنطقي والعقلي والانفتاح على فضاءات التخييل والفنطازيا واللاوعي.
ويمكن القول إن شعراء السبعينات، في العراق خاصةً، قد أعادوا التوازن بين المؤثر التراثي الكلاسيكي والمؤثر الخارجي المتمثل في تجارب الحداثة الشعرية في الغرب. لكن شعراء الثمانينات عادوا بقوة للتفاعل مع المؤثر الخارجي بدرجة أكبر مما فعله معظم شعراء السبعينات، وكان للمؤثرات الفكرية والفلسفية والأنثروبولوجية والميثولوجية تأثير كبير في خلق مثال جمالي جديد كشفت عنه القصيدة الحداثية العراقية منذ السبعينات والثمانينات.
وفي التسعينات عمق شعراء قصيدة النثر ما شرع بتجذيره شعراء الثمانينات من حوار متصل ومثمر مع المؤثر الأجنبي، بينما آثر الجناح الآخر في تجربة شعراء التسعينات المتمثل بتجربة “قصيدة الشعر” العودة ثانية لاستلهام المثال الحي للمتن الشعري التراثي والكلاسيكي وتجنب تحقيق أيّ مستوى من مستويات القطيعة المعرفية مع ذلك التراث. ولذا واصل شعراء هذا اللون الكثير من تقاليد القصيدة العمودية، ومنها التقيد بالإطار العروضي والإيقاعي والارتفاع النسبي للنبرة الغنائية والذاتية، وأهم من ذلك الالتزام بالمنظور العمودي في الرؤيا والبناء فضلاً عن الجوانب العروضية والإيقاعية. ولذا فإن شعراء “قصيدة الشعر” لم يفتحوا نوافذهم على تجارب الحداثة الشعرية العالمية بدرجة كبيرة، لذا ظل مثالهم الجمالي والشعري شبه تقليدي وعجزوا عن تحقيق ثورة شعرية حداثية جذرية، لأنهم حاولوا تحقيق هذه الثورة بأدوات ووسائل تقليدية، وقاتلوا القديم بسلاحه، وظلت ثورتهم الشعرية محدودة وناقصة وغير مكتملة إلى حد كبير. لكنهم مع ذلك استطاعوا تحرير قصيدة العمود من الكثير من الملامح التقليدية والانفتاح على قيم وإمكانيات تعبيرية لم تكن متوفرة سابقاً كما خطا بعض شعراء هذا الاتجاه خطوات فردية لولوج أبواب الحداثة الشعرية.
وشخصياً لا أتقبل فكرة جذرية تجربة شعراء التسعينات من رواد “قصيدة الشعر” ورهاناتها التي أطلقتها بيانات المجموعة، أو تلك التي صاغها الشاعر أسامة مهدي في كتابه ولكنّي أعدّها محاولة جريئة ومهمة لتحديث قصيدة العمود الشعري ووضعها تدريجياً في مسار حركة الحداثة الشعرية، حيث سيحدث انشطار لاحق متوقع شطر يسير نحو أقصى درجات التحديث، وآخر ينكفئ، إلى الوراء مستسلماً لسلطة الموروث الشعري التراثي الكلاسيكي. شعراء “قصيدة الشعراء” يمتلكون بالتأكيد مواهب شعرية أصيلة، لكن الموهبة لا تكفي لأي شاعر لأن يخلق منجزاً استثنائياً لأنه بحاجة إلى التشبع بفضاءات شعرية مغايرة: شرقية وغربية، وإلى أن يغترف من بحور الثقافة الحديثة ومعارفها الفلسفية والأنثروبولوجية والتاريخية والميثولوجية، وأن يفهم النبض الحقيقي للعصر والذات، لكي يكون قادراً على فهم متطلبات بناء قصيدة حداثية قابلة للحياة في مواجهة هذا السيل الذي لا ينقطع من التجارب الشعرية المتباينة عبر تحقيق لون من المزاوجة الخلاقة بين ما هو ذاتي وموضوعي، وبين ما هو تخييلي وما هو واقعي، بين ما هو وجداني وعاطفي وسنتمنتالي، وبين ما هو تأملي وفلسفي واستبصاري، بين ما تفعله العين للمرئيات والأشياء، وما تفعله الذاكرة من إعادة صياغة الأحداث والمواقف، ونبشها من قعر الماضي إلى فضاء الحاضر، بين هيمنة صوت الشاعر الأحادي وبين تعددية الأصوات الشعرية.عند ذاك فقط سيكون الطريق سالكاً أمام ممثلي “قصيدة الشعر” لكي يدخلوا مملكة الحداثة الشعرية من أوسع أبوابها.
وشهد الشعر العراقي بعد التغيير الزلزالي في2003 مخاضات عديدة كانت موشومة بإشكالية المشهد السياسي وتناقضاته ومفارقاته بوصفه يحمل في أحشائه ثنائية الاحتلال وسقوط الدكتاتورية معاً مما رتّب على المبدع العراقي وفي المقدمة الشاعر العراقي مسؤوليات ومتطلبات جديدة لم تكن مطروحة سابقاً. إذ سبب هذا المشهد صدمة عنيفة لوعي الشاعر ففي الوقت الذي كان يرى فيه نظام العسف والاستبداد الذي سامه الجور والعذاب يتهاوى ويسقط في مزبلة التاريخ، لكنه من جهة أخرى صعق بمرأى قوات الاحتلال الأجنبي وهي تدمر منشآت البلد الحيوية وبناه التحتية، وتعرّض الدولة العراقية إلى الخراب. وكان من الصعب على الشاعر أن يتقبل فكرة تحقيق التغيير عبر عامل خارجي متمثل بالاحتلال الأجنبي. وبالتأكيد فإن ذلك سبّب أزمة صراعية داخلية فكرية وشعرية لدى الشاعر للخروج بموقف واضح عما ينبغي عليه فعله، وفيما إذا كان خطابه الشعري وأدواته التعبيرية ولغته تصلح للتعامل مع الواقع الجديد، أم أنه بحاجة إلى خطاب شعري بديل وقادر على هضم هذه الصور المتناقضة وتمثّلها، وخاصةً عندما راح الاحتلال يتسبب في “تفريخ” قوى العنف والإرهاب والتكفير والانقسام الطائفي.
وكان المشهد الشعري العراقي في هذا المفترق الحاسم هو نتاج مشترك لأجيال الحداثة الشعرية منذ الخمسينات وحتى اليوم، وتواصل بشكل واضح دور شعراء الحداثة الستينية بشكل متميز عبر إضافات كبيرة، وتواصل إثراء بقية الأجيال الشعرية في السبعينات والثمانينات والتسعينات، حيث يمكن متابعة ثلاثة اتجاهات شعرية أساسية: هي قصيدة التفعيلة المتمثلة بقصيدة “الشعر الحر” و “قصيدة النثر” والاتجاهات المجددة للقصيدة العمودية المحدثة الممثلة بـ”قصيدة الشعر” فضلاً عن اتجاهات تقليدية وحديثة متنوعة.
ولاحظت أن العدد الأكبر من ممثلي هذه الاتجاهات الثلاثة توقفوا قليلاً بعض الوقت لتمثل الصدمة السياسية واستيعابها ولإعادة صياغة رؤاهم الشعرية ومواقفهم في ضوء مرحلة ما بعد التغيير، بينما استطاع عدد غير قليل من الشعراء تقديم استجابة سريعة وفورية لعملية التغيير. لكننا بشكل عام كنا بحاجة إلى وضع مسافة جمالية وزمنية مع ذلك الزلزال من أجل الشروع ثانية بالكتابة الشعرية في ضوء جديد. ويمكن التأكيد أن جميع الاتجاهات سرعان ما استعادت عافيتها وقدمت أسماء ونماذج ورموزا أغنت حركة الحداثة الشعرية ودفعتها إلى الأمام، ويمكن القول إن خطاب الحداثة الشعرية لم ينكسر، كما يخيل للبعض، وظل متواصلاً. وعبرت حركة الحداثة عن معاناة الإنسان العراقي وهمومه، وأدانت كافة مظاهر العنف والتكفير والإرهاب والطائفية والفساد والقبح والتطرف، وانتصرت للإنسان العراقي المتطلع لبناء مجتمع مدني ديمقراطي مبرأ من أدران التطرف والعنف والإرهاب ويرفض كل مظهر من مظاهر الاحتلال والتدخل الأجنبي والإقليمي في شؤوننا الداخلية.
إن شعراء الحداثة في العراق ما زالوا اليوم يحملون رهانات التحديث والتجديد والابتكار، لأنهم ببساطة لا يمكن لهم إلاّ أن يكونوا حداثيين وطليعيين ومجددين لأنهم يعدّون تحقيق التفوق والتجاوز والمغايرة هدفاً مركزياً لمشاريعهم الشعرية الحداثية والتي لا يمكن لها أن تنفصل عن هموم تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د- فاضل ثامر / ناقد من العراق