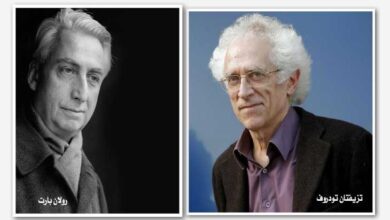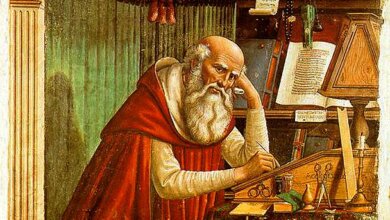«ألواح» رشيد الضعيف.. البحث عن بوصلة الزمان

تاء مربوطة «ة» مقهى في شارع الحمراء الذي يقول للحياة “كوني فتكون”. في طبقته العلويّة مكتبة لنادي المطالعة تناقَش فيه أعمال أدبيّة بحضور أصحابها. كان اللقاء بتاريخ 27 حزيران 2018، مع الروائيّ اللبنانيّ رشيد الضعيف لمناقشة روايته «ألواح» الصادرة عن دار السّاقي في طبعتها الأولى 2016.
تدخل الثقافة في نسيج الحياة. فهذا المقهى ليس لتغذية الأبدان وحسب، بل لفرح النفوس ومتعة العقول. في أجواء غير تقليديّة تحلو فيها اللقاءات الثقافيّة على الرّغم من ضيق المكان وانحشاره بين المحالّ، فتكاد لا تلاحظه. فكرة اتّصاف الثقافة بابنة الواقع المعيش، وليست في بطون الكتب، وعلى رفوف المكتبات، أو في مجالس الأدب، شدّد عليها الرّوائي بقوله إن وعينا بذاتنا يتشكّل على الرّصيف لا عبر الرّواية، باعتبار الرّصيف مجاز الحياة اليوميّة. إذ ذاك احتجّت إحدى المشاركات في اللقاء، وجلّ الحضور ينتسب إلى التاء المربوطة، فكيف لروائيّ إنكار دور الرواية والسّرد بعامّة، في تكوين الوعي بالذات؟! فأجاب بإلقاء سؤال أربك أذهان مستمعيه ليبلبل استقرارها، فتتوالد منه التساؤلات على طريقة المحاورة الأفلاطونيّة: كم من قارئ رواية يوجد، وإذا وجد، كم من رواية يقرأ لكي يكوّن وعيه بذاته؟
كلّ قارئ يفهم الرواية بحسب ثقافته، أردف قائلًا. فمتى وضع الروائيّ قلمه جانبًا ينسحب لتصبح روايته ملك التاريخ، وتكتسب معانيها من قارئيها.
يحلم بأن يكون العنوان للرواية رقمًا كأرقام الشوارع والأرصفة في المدن، يوحي ولا يفصح، يبعثر الاتجاهات في غير تأويل، ولا يوجّه القارئ ويحدّد مسار قراءته. ربما نبت هذا الحلم لديه بعد اعتراض صديقه المفكر اللبناني الراحل موسى وهبه على عنوان روايته «تقنيّات البؤس»، إذ قال له إنّه يملي على القارئ كيفيّة القراءة لحظة تقع عيناه على العنوان.
أراد في «ألواحه» أن يعود إلى التراث السّردي الجميل الذي أهملناه بمقاماته وأخباره وقصصه وحكايات ألف ليلة وليلة، وتبنّينا الرواية غربية المنشأ في بنائها. ألواح بمنزلة لوحات لوّنتها الحياة، دوّن عليها ما كان له من تجارب، وما ينبغي أن يكون عليه ما لم يحدث «أحداث لو حدثت لكانت حدثت كما دوّنتها». إذن، ألواحه كألواح شرائع حمورابي، وكالتي تحفظ التعاليم السماويّة، تنقش ذاته. انتبهت إليه ولم تدعه ينتبه على طريقة المتصوّفة كما يعبّر.
على ذلك، لا يدّعي الرّسوليّة، بل يودّ زعزعة هذه الإيديولوجيا إزاء الكاتب ودوره. يترك إشارات خفيّة تلتقطها العيون من زاوية الرؤية الخاصة بها، كما في مشاهد تعذيبه الحيوانات والحشرات مع رفاقه عندما كانوا فتية. نغّص على بعض العيون متعة القراءة بهذا الاسترسال في الوصف. إنّما نلمحه يتدخّل معلّقًا بعد وصف تعذيب السلاحف التي لم تترك بيوتها، بل ماتت فيها. «إنّ هجر البيت بالانسلاخ منه بالقوّة أمر بالغ الصعوبة. إنّه مؤلم للجماد وليس للمخلوقات الحيّة فقط. والله لو كنت نبيًّا لأوحى الله إليّ بآية من هذا النوع: طوبى للمهجّرين من بيوتهم عنوةً، فإنّ لهم ملكوت السماوات. وأنا نفسي قد هجّرت من بيتي بالنار…» مشاهد تحيل ذاكرتي إلى قصّة «شهوة دم» لتوفيق يوسف عوّاد من مجموعته «الصبيّ الأعرج»، حيث سرد أحداث تعذيبه الكلاب بضمير الغائب، في دلالة إلى استبعاده ذاتَه، وتبرئة ذاكرته بنفي الحدث عن صفحتها عبر نقيضه، بتدوينه على صفحات كتاب لم يعد ملكه.
هي كتابة للتطهّر، وإيمان بالوظيفة الاستشفائيّة للسرد. هكذا قال «رشيد» في اللوح الأخير بعنوان «الكتابة والعلاج»، معدّدًا دوافع محتملة للكتابة، من أن تكون شهادة، صرخة، أو وقفة عزّ، وقد تكون إذلالًا للنفس بالاعتراف، أو رغبة في الخلود، أو قهرًا للأعداء، ومن ضمنهم ربما تكون المرأة المحبوبة.
حضرتُ اللقاء محمّلةً بعدّة نقديّة، وبقراءتين انطباعيّة ونموذجيّة للرواية. بدأت تتهاوى لديّ القوالب المنهجيّة شيئًا فشيئًا، وما اختزنته ذاكرتي من عيون النظريّات، في أجواء اللقاء الطّازجة، حيث نبض الآراء المتباينة، وصخب المشاعر المتولّدة إثر القراءات المختلفة، وحيث للّغة حياة متخفّفة من ثقلها. رشيد الضعيف المؤمن بقيام ساعة بلاغة جديدة، كان تفكيكيًّا بامتياز، في روايته كما في ندوة المناقشة. والبلاغة، كما وصفها، هي تصوّرنا للعالم تصوّرًا بعيدًا من موروثات غدت بدائه ومسلّمات. «لم تعد السماء مبيت الألوهة حتّى نشبّه بها كل ما هو متعالٍ. الحقائق لا تؤنس بالضرورة، فعلينا ابتداع أسرار جديدة، بلاغة جديدة».
البلاغة بوصلة الزمان، هكذا يرى الروائي. ومع تقدّم العلوم تتغيّر الطبقات والسلطة، وتتبدّل المفاهيم بدورها. فعلينا أن نتغيّر بابتداع بلاغة زماننا، بلاغة تأتي من أرصفتنا. بكثير من الذّاتيّة لنتف من سيرة تتموقع بين التخييل واللاتخييل، وبين الحرفيّة والاستعاريّة، وبين التصوّر والتصديق من خلال المكاشفة والسؤال، تتبدّى «ألواح» متناثرة المشاهد ومتباعدة الأضواء، لكنّ خيطًا ما يربطها. هي محاولة لزعزعة المركز وإيجاد منطقة رماديّة بين بياض وسواد، وخطوط مائلة. لوح يدين فيه براءة الأم والإنسانيّة القاتلة، ويبتغي محاكمة البراءة المسبّبة للألم والمثيرة للغضب، وآخر يعرّي فيه عداوة اسمه واسم عائلته له. لوح يتّهم فيه الحداثة التي لم تجلب لنا السعادة، بل خرّبت بيتًا متهاويًا وحسب. وألواح أخرى يتحرّر فيها من “أوساخه”، هو المهووس بالنظافة، ويخلع أقنعة نخالها لم تخفِ سوى اغتراب مثقّف مصاب بأرق مزمن، وخيبة. يتوقّع أعداءً ينبتون أمامه فجأة من حيث لا يدري. جعلته المعرفة تعيسًا، «بعدما صارت للأشياء أسماء وللأسماء مفاعيل سياسيّة». بوجه مطفأ وعينين بلا نور كوجه أبيه، مع فارق يسجّله بأنّ والده لم يكن يخاف ألّا يغفو عندما يذهب إلى النوم، وبأنّه مات سعيدًا.