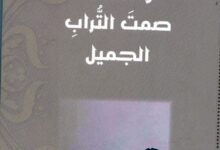يقظة…

تقاذفت الأفكار إلى رأسي مثل قطيع يندفع نحوي محاولا افتراسي… تساءلت معاتبا نفسي، كما اعتدت أن أفعل دائما، لماذا عدت إلى هنا؟ ما الذي ذكرني بهذا المكان؟ لقد انقطعت كل أواصر الوصل بيننا بعد وفاة والدتي.
ولهذا السبب كنت أرفض العودة، حتى إنني لم أزر قبرها إلا مرة واحدة منذ وفاتها. لست ابنا عاقا، لطالما أحببت والدتي، واعتقدت على حين غرة أنني هالك بعدها لا محالة، لكنني شخص معتوه وجد طريقه بعد فقدان أسرته… انقطع الرابط الأخير ثم ذهبت بعدها إلى حال سبيلي. شعرت أنني أحب الحياة أكثر من ذي قبل، وأزعجتني فكرة أن يباغتني الموت وأتلاشى في العدم، بعدما رحبت بي الحياة ورحبت بها، وتماهينا مثل جسدين منتشيين إثر بلوغ ذروة اللذة.
هي تمارس غوايتها وأنا أمارس فحولتي بكل التهور الممكن رغم علمي أنها ستغدر بي. تسمرت بجانبها ككلب ضال، هزيلا وبلا وجهة، ففتحت لي نافذتها عطفا علي… قفزت إلى الداخل ولم أشأ بعدها المغادرة مطلقا. نعم لا زلت حيا، ولا زال جسدي يرتجف من ثقل فكرة الموت… لكنني ضللت الطريق من جديد، لعلني لذلك عدت إلى هنا، من حيث انطلقت إثر ما اعتبرته ولادتي الثانية، باحثا عن كل السبل التي قد ترمم أعطابي…
هل سأنجح هذه المرة أيضا؟ لماذا أشعر اليوم أن جراحي قد تعمقت أكثر من أي وقت مضى؟ لم أكن مكلوما بهذا القدر حتى في أكثر محطاتي بؤسا وقتامة. بدا رأسي كأنه يدور وازدحمت الاحتمالات أمامي، دون أن أجد سببا واحدا شافيا يفسر هذا الارتجاج الذي أصابني. وددت لو يسير الزمن قدما دونما التفاتة، لكنه بدا كمن يجرني عنوة إلى الخلف.
كان قويا جدا، أقوى مني بكثير ومع ذلك لم أجد بدا من المواجهة… سأمسك بطرف آخر فرصة لي أملا في الخروج ناجيا من هذا الازدحام الشقي. تسير قدماي بي إلى حيث لا أدري لكن أفكاري تستمر في وخز جسدي لأتوفق عن الحركة… هل أدنو من الجنون؟ وأي جنون هذا الذي ينذرني باقترابه؟ كيف تغدر بي الحياة بهذا اللؤم والعنف البالغين، رغم أنني سألقى حتفي في النهاية شأني شأن الآخرين؟… لست شخصا استثنائيا.
إنني الشخص المعتوه نفسه الذي هرول إلى الحياة كطفل جائع، لكنني الآن عرضة إلى الزوال، بعدما أدمنت التعاطي إلى الحياة… إنني أرفض الموت، لماذا إذا يحرص على مطاردتي ولماذا أصر على تفاديه؟ زحفت رغم انهياري صوب الخمارة التي اعتدت ارتيادها، كانت خطواتي بطيئة جدا، كأنني أجر خلفي أعباء كونية لا أحد بوسعه جرها غيري، وكأنني الكائن الوحيد الشاهد على مثالب الوجود.
بدا العالم من حولي كتماثيل غير قادرة على الحركة أو الشعور، وكأن الحياة تسحب نفسها شيئا فشيئا في هدوء تام لا يخلف أثرا يذكر… لا عويل ولا صراخ ولا مقاومة، نأتي إلى الوجود كومضات سريعة الزوال، لا أحد منا يشعر بالآخر عندما يدركه دوره، ويضمحل شيئا فشيئا إلى أن يتلاشى، فليس مسيرنا الجماعي إلا حدثا عابرا قبل وجوب الانفصال.. .
انزويت في ركن داخل الخمارة التي بلغتها بعد دهر طويل، أريد لهذه الليلة التي تبدو لانهائية أن تنقضي بسرعة.
طلبت قنينة ويسكي أملا في ذلك، اعتدلت في جلستي لأطرد الأنظار القادمة نحوي. تمنيت لو أنني كنت كائنا خارج الزمن، شخصا لامرئيا بوسعه نزع ملابسه والاستلقاء فوق الأريكة، مكتفيا بمشاهدة المترددين على الخمارة.
لم أكن أعي شيئا من حولي على الإطلاق، كنت حاضرا بجسدي لا غير. غرقت في ذكرياتي حتى شارفتُ على الاختناق، فكيف أهتدي إلى سبيل الخلاص؟ كنت أدرك بين وبين نفسي جيدا جواب هذا السؤال لكنني كنت أشد وهنا من أن أواجه الحقيقة اللعينة، وربما الحقيقة الوحيدة التي لا يمكنها النضوب مهما كبرت أكاذيبنا. ليست الخمارة في الواقع ولا الويسكي إلا امتدادا لهذه الأكاذيب، مثلما لسنا جميعنا إلا امتدادا لبعضنا البعض عندما يتعلق الأمر برهاب الموت.
وحده الموت يذكرنا بحجم هشاشتنا وتعاستنا وعجزنا كلما ألهتنا الحياة عن ذلك، وحده الموت ينبهنا إلى مدى تشابهنا مهما اتسعت الفوارق بيننا، وحده الموت يشكل خلاصنا. يا للمفارقة، ترى ما الذي لا زال يربطني بهذا الوجود على نحو يجعلني أرفض فكرة الرحيل؟ ما أشبه اليوم بأمس عندما فقدت والدتي وبدت الحياة وقتها مشلولة عاجزة عن الحركة وأنا مستلق فوق جثتها وجسدي يرتجف من بشاعة المنظر.
انكمش الزمن طويلا داخل هذا الحدث المشؤوم بينما تبدت تفاهة الوجود صريحة ووقحة أكثر من أي وقت مضى، كم هي حياتنا مهترئة وآيلة للسقوط. انتبهت كمن استيقظ لتوه من غيبوبة إلى أن المكان ضج بالزبائن الذين ارتفعت أصواتهم في غمرة أحاديثهم، واصطفت قنينات النبيذ كشاهد على بؤسنا…
كم تكرر هذا المنظر أمامي لكنه اليوم تلبس معاني أخرى، فأنا لست الشخص نفسه الذي أتى إلى هنا أمس أو الذي سبقه، مثلما لم أكن منبوذا من الحياة مثلما أنا منبوذ اليوم…ما أشد هذه العزلة التي تجعلني أتآكل وأنشطر إلى أشلاء، حتى إنني لا أقوى على لم أشلائي وأمضي جانب الحياة مكسورا مطأطأ الرأس معلنا انهزامي.
كان الجميع مستغرقا في الحديث، تماما كما أنا مستغرق في محادثة نفسي، فحتى وإن كنا نتشارك المكان نفسه لا أحد منا يكترث للآخر في الواقع، لكل منا معاركه ووحدها معاركنا الخاصة قابلة للإبصار، مثلما أنا جالس هنا أتصارع مع أفكاري بمفردي لا أرى أحدا ولا أحد يراني. أنا أيضا شخص نرجسي أقاتل من أجلي، من أجل أن أخرج من العتمة، من أجل أن أتحرر من أعبائي، من أجل أن أحيا…
كل شيء يتعلق بي، وفكرة العدم ترعبني بالقدر الذي تريحني به، لكنني لست على استعداد، فمتى يتحقق ذلك؟ أتساءل كيف بوسعي ألا أكون مستعدا للموت رغم يقيني بأن وجودي ليس إلا انحدارا صوب اللاوجود، وأن موتي لن يهز شعرة من الوجود مهما كان دراماتيكيا، ثم سأمحى داخل النسيان.
نعم، لن يشكل غيابي فارقا يذكر، ستمضي الحياة على جثثي وجثث رفقائي من الموتى دون أن تحزن لفقداننا، فلماذا كل هذا التمسك بها؟ ليس وجودنا من عدمه في الحقيقة ذو قيمة إلا داخل مدارنا، وخارج هذا المدار لسنا إلا كائنات ضئيلة تصارع من أجل البقاء، شأنها شأن باقي الأنواع، حيث لن يكون اندثارنا لسبب أو لآخر إلا مشهدا مكرورا لن يتسبب في تعطيل الزمن ولن يتوقف الكون على إثره عن الحركة.
عقارب الساعة تزحف ببطء شديد، والخمارة توشك على غلق أبوابها بعد انصراف معظم الزبائن…لا أذكر من تفاصيل هذه الليلة إلا القليل القليل، وسط شرودي وذكرياتي المثيرة للشفقة. لم أكن أرغب في العودة إلى المنزل لكنني كنت منهكا جدا وجسدي يوشك على السقوط.
أنهيت كأسي الأخير، ودفعت الفاتورة ثم مضيت إلى حال سبيلي. ترى متى يأتي الصباح رأفة بي أنا الذي لطالما كررت على مسامع الآخرين كوني كائن ليلي؟ ها أنا ذا الآن أتوسل إلى الليل كي ينقضي، مثلما أتوسل إلى هذه العزلة الثقيلة بأن تمنحني قسطا من الراحة.
كم أتوق إلى التحرر من هذا التيه الذي يملأ كل أجزائي والعودة إلى اندفاعي وجموحي قبل أن يهوي بي إيماني ويضعني على حافة الهاوية. أدركت وقتها حجم وحدتي، وأنه لا مفر لي من الغرق في هذا التيه بمفردي، لا أحد منا يشاطر الآخر تعاسته، فحتى المواساة نفسها ليست في الواقع إلا تعبيرا عن المسافة التي تفصلني عن غيري…لا شيء يغير حقيقة كوننا نواجه في نهاية الأمر مصيرنا فرادى.
شعرت بأن كل رغباتي بدأت بالأفول الواحد تلو الآخر، وددت لو كان بوسعي أن أخلص نفسي من هذه اللعنة التي ألمت بي، وأنا موقن بأن ذلك لن يكون ممكنا إلا بإطلاق الرصاصة الأخيرة للانتقال إلى حالة الأفول الأبدي.
ألم يكن من الأفضل لي لو أنني لم أوجد على الإطلاق؟ يا لغائلة الوجود الذي أخرجني من العدم دون أن أملك حق الاختيار، فما الجدوى من وجودي؟ ها أنا ذا الآن أقف قبالة الحياة، والموت في ظهري ينتظر اقتناص فرصته للانقضاض علي، فماذا أنتظر؟ ها أنا ذا الآن أملك حق الاختيار بالفعل، ومع ذلك لا زلت أتمسك بالحياة كمن يمسك بيديه حبل المشنقة الملتف حول عنقه محاولا إزالته عبثا.
إنني لا أختار الموت، وبهذا فأنا لا أقوم سوى بتأجيل نهايتي، فإن لم أضع هذه النهاية بنفسي سيتسلل الموت إلي على حين غرة بعد أن ألتئم وأعود للانهماك في الحياة، ثم أتبدد ببساطة متناهية تدعو إلى التساؤل إذا ما كنت موجودا بالفعل.
بلغت المنزل بالطريقة نفسها الذي بلغت بها الخمارة بداية هذه الليلة، فتحت الباب ودخلت، لم أشأ أن أشعل النور واكتفيت بالضوء الخافت الذي تسرب من مصابيح الشارع إلى غرفتي، نزعت سترتي واستلقيت على السرير جسدا مضنى يستجدي هو الآخر طلبا للراحة…
فكرت أن هذا الألم الحاد بوسعه أن يزول بجرعة زائدة من العقاقير فحسب، لكنني سخرت في الوقت نفسه من اختياري الأقل خطورة من بين السبل الأخرى الممكنة التي تؤدي إلى موت محقق، كأن ألقي بنفسي من مكان شاهق العلو ينعدم معه احتمال نجاتي، أو أن أقفز قبالة قطار سيفتت جسدي لا محالة…
رأسي يكاد ينفجر، ماذا لو أنني أقطع وريدي وأنزف وحيدا حد الموت؟ فحتى وإن لم أكن وحيدا لا شيء سيغير مصيري. ما الشيء الذي تغير وأنا بجانب والدتي ساعة الاحتضار، لم يكن بوسعي فعل شيء غير الشعور بالعجز واليأس، دخلت حالة من الذهول وأنا أعيش هذه التجربة للمرة الأولى، دون أن أكون قادرا على استيعاب هذا الغياب الذي لا رجعه فيه.
تراجعت كل الصور القديمة عن والدتي بينما علقت بذاكرتي لحظة احتضارها فحسب، اللحظة التي دقت المسمار الأخير في نعشي، ثم لم تنقض إلا بضع هنيهات حتى أنجز الموت مهمته دون اكتراث لنحيبي وللألم الذي كان يمزق أجزائي من شدته.
خيل إلي تحت تأثير الويسكي الذي لم ينسحب بعد كليا من جسدي أنني أسمع نداء أمي وأشعر بوجودها في غرفتي…تملكني الخوف وأنا أحاول التحقق مما يجري حولي، تساءلت في قنوط هل دقت ساعتي؟ تسارع نبضي وشعرت ببرودة محسوسة تسري في كامل جسدي، أغمضت عيني واستسلمت لهواجسي، لا مفر لي إلا المواجهة…أنا مجبر على دخول المعركة وإن كنت موقنا بأنني سأخرج منها خاسرا رغم انتصاري…نعم سأنتصر أخيرا لكنني سأخسر في الوقت الذي سأنتصر فيه…