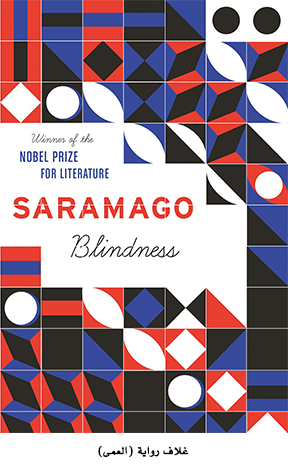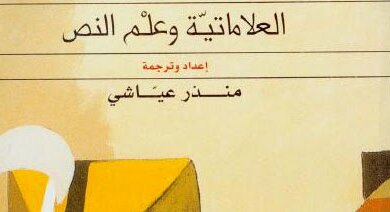جوزيه ساراماجو الكاتب الاستثنائي في الرواية البرتغالية

ما أصعب أن يكون المرء مبصرًا في مجتمع أعمى” – ساراماجو في رواية “العمى”
بدأت الرواية البرتغالية بداية تاريخية شأنها شأن معظم المشاهد الروائية في العالم، استهلها الكاتب الروائي “هركولانو” ببعض الأعمال التاريخية ثم جاراه في طريقته “كاميلو كاستيلو برانكونى” في روايته الشهيرة “حب مهلك وحب منج”، “وجومز كوئلهو” في رواية “يتيمة السيد مدير الكلية” ثم ما لبث أن ظهر الروائي “أيسادى كيروس” بروايته الشهيرة “جريمة أمارو” التي نشرت عام 1875 وكان لها أبلغ الأثر في انتشار المدرسة الطبيعية التي بشر بها أميل زولا رائد المذهب الطبيعي في فرنسا،
كما ظهر خلال نفس الفترة روائيين برتغاليين أهتموا أيضًا بالناحية التاريخية في رواياتهم نذكر منهم “أولييفرا مارتانس”، “وآرنالدو شاجاس” في تلك الحقبة الأولى من الرواية في البرتغال. أما المرحلة المعاصرة في الرواية البرتغالية فكانت تلك المرحلة التي برز فيها كل من “تيكيزيرا دي كيروز” الذي تناول في رواياته الطبقة الوسطى و”راؤل برندارتى” الذي وصف في روايتيه “الفقراء” و”الصيادون” حياة تلك الطبقة الفقيرة في المجتمع البرتغالي.
مهد هذا التاريخ الروائي للبرتغال لظهور عدد من الكتّاب المعاصرين اتكأوا على تراث إبداعي طويل له إرثه وأثاره المتجذرة في اللغة البرتغالية، منذ تلك الكاتبات التي كان يصنفها النقاد تحت اسم “الغنائية الجالايكو- برتغالية”، التي سادت في القرون الوسطى من خلال بعض الأعمال الأدبية للعديد من الكتّاب مثل: “لويس دى كاموينز”، و”جيل فيسنتى”، و”أنتيرو دي كينتال”، و”كاستيلو بلانكو”، و”أيسا دي كيروز” لتصل إلى الأدب البرتغالي المعاصر الذي يعتبر من أبرز ممثليه: “فرناندو بيسوا”، و”مجيل توجرا”، و”فيرجيليو فيريرا”، و”أجوستينا بيسا لويس”، وهي أعمال اطلع عليها ساراماجو، ونهل من معينها الكثير، وتأثر بأعمال هؤلاء الكتّاب البرتغاليين العظام، وكانت مسيرته الإبداعية امتدادًا لهذا الخط الطويل الذي ابتدعه كتّاب البرتغال، وسرعان ما اختط لنفسه أسلوبه الخاص ورؤية تجاه أدب ما بعد الحداثة.
ففي عام 1947 أصدر ساراماجو روايته “أرض الخطيئة” ثم ما لبث أن انقطع عن الكتابة لأكثر من عشرين عامًا ثم عاد إليها مرة أخرى عام 1977 بإصدارة رواية “كتابة الرسم والخط” التي أتبع فيها تقنية السيرة الذاتية والسرد بضمير المتكلم، وعن هذا الانقطاع قال ساراماجو: “لم يكن لدى م اقوله بصمت”، وصدرت بعد ذلك سيرته الذاتية “الذكريات الصغيرة” التي دون فيها سيرته العائلية بعدها توالت أعماله الروائية “ثورة الأرض”، “مذكرة الدير”، “عام موت ريكاردو رييس”، “كل الأسماء”، “الطوف الحجري”، “رحلة إلى لشبونة”، “الأنجيل كما يراه المسيح”، “العمى”، “الكهف”، “الأخير مبتلى”، “البصيرة”، “انقطاعات الموت”، “مسيرة الفيل”، “قايين”.
ويقول جوزيه ساراماجو في سيرته الذاتية “الذكريات الصغيرة” الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2007، وهي سيرته التي أجاد فيها الحكي عن حياته منذ أن كان صغيرًا وحتى حداثة الكتابة عنده في الكبر والتي توّجت بحصوله على جائزة نوبل للآداب 1998 وقد تجاوز الخامسة والثمانية من عمره، وقد سمع ساراماجو بفوزه بجائزة نوبل أثناء تواجده في مطار فرانكفورت وعودته إلى مقر إقامته في جزيرة لانزاروتي إحدى جزر الكناريا، وكان مشاركًا في الأسبوع الأخير في مائدة مستديرة حول الكتاب البرتغاليين موضوعها “لماذا ما زلت شيوعيًا؟”، في هذه الأثناء قول ساراماجو: “لقد وجدت إني مضطر لارتداء درع واق، وأشعر الآن بمسئولية كبيرة لأنى أول برتغالي يحصل على الجائزة”.
وكيف كان تأثيره على مجايليه من كتاب الرواية البرتغاليين أمثال “الفونسو كروش”، و”إلبارو كونيكرو”، و”أنطونيو لوبوا أنطونيس” الذي كان بعض النقاد في البرتغال يأملون أن يحصل هذا الكاتب على نوبل بدلاً من ساراماجو كذلك الكاتب “جوزيه لويس باتسوت” وغيرهم من كتاب الرواية في البرتغال، لقد كان الأدب الروائي في البرتغال أدبيًا سخيًا للغاية حينما أخرج لنا جيلاً عظيمًا من الكتّاب كان على رأسه هذا الكاتب الاستثنائي في كتاباته وآراؤه وأفكاره ومفاهيمه إنه جوزيه أو جوسيه ساراماجو الكاتب الاستثنائي في الرواية البرتغالية المعاصرة.
ولد جوزيه ساراماجو في 16 نوفمبر 1922 في قرية أزينهاجا وهو مصطلح مشتق من الكلمة العربية “الزنقة” أي الشارع الضيق، كما ورد في مستهل سيرته الذاتية “الذكريات الصغيرة” 2007 حين أشار إلى مكان مولده بهذه العبارة: “يطلقون عليها اسم “ازينهاجا”، هذه القرية التي تقع في نفس مكانها منذ شقشقة الفجر الأولى على الأرض” كانت هي مكان المولد والنشأة، وفيها نبتت الذكريات الصغيرة التي ظهرت في هذه الرؤية السيّرية عن حياة قال عنها ساراماجو إن هذا الكتاب يحكي عن الطفل الذي كنته في هذا العالم.
والداه هو خوسيه دي سوزا، ووالدته هي ماريا دي بيندادى وكانت كلمة ساراماجو “Saramago“، تعنى الفجل البري في اللغة البرتغالية وهي كنية العائلة وبالخطأ دمجت مع اسمه عند تسجيله عقب والدته، فعندما أصبح في الثالثة من عمره قرر والده أن يستخرج له شهادة ميلاد.. وقف الأب الذي كان في حالة سكر بيّن أمام موظف التسجيل ليدون الاسم جوزيه دي سوزا، ولما سأله موظف التسجيل عن اسم العائلة، فكر قليلاً ثم قال في ارتباك “ساراماجو”،
كانت نشأته في بيت جده وجدته لأمه “جوزيفا وجيرونيمو”، وفي نهاية دراسته بمدرسة ألفونسو دوميتيجيس الصناعية تخرج ساراماجو صانعًا للأقفال، وعمل بعد تخرجه ميكانيكي سيارات لمدة عامين، ثم كاتبًا في إحدى المستشفيات، ثم عاملاً للطباعة، ثم انتقل للعمل في دار نشر مراقبًا لحركة النشر والتوزيع، ثم أصبح مترجمًا ثم صحفيًا حتى أصبح مساعدًا لرئيس تحرير صحيفة “دياريو دي نوتسياس” البرتغالية، ويستطرد ساراماجو في ذلك حول نشأته في بيت العائلة، وعلاقته بأفراد العائلة والفتيات في قريته، وغير ذلك من العلاقات والممارسات الصبيانية،
وكما تشير السيرة إلى أن أجداده كانوا رعاة خنازير، وأمه كانت أمية، فيما كان أبوه يدور من حقل إلى حقل لكي يعمل في الفلاحة عند إحدى مالكي الأرض الاقطاعيين، قبل أن يقرر الأب الرحيل إلى لشبونة لينخرط في سلك الشرطة، وفي لشبونة يجد الابن جوزيه ضالته في الكتب والقراءة، إلى جانب عمله المبكر في إحدى شركات التأمين مقلدًا بذلك كافكا الذي عمل في نفس المجال التأميني، وتحول ساراماجو إلى فأر كتب قارئًا وباحثًا ومنقبًا عن الثقافة في كل مناحيها،
وفي عام 1980 نشر ساراماجو روايته الأولى “أمل في الأنتيجو” التي اشتغل فيها على تجارب عمال الزراعة، وحقول الإقطاعيين وربما كان متأثرًا فيها بعمل والده الأول، وكان صوته الإيديولوجي اليساري قد بدأ يطغى على واقع حياته وكان هو الطاغي أيضًا على هذا العمل الروائي الأول. وتتواتر أعمال جوزيه ساراماجو الروائية عملاً تلو الآخر، وتكتظ رواياته بالمعرفة، والجدل، والإثارة، والعبثية والفلسفة،
وهذا ما جعل العالم ينتبه إلى ساحة الرواية في البرتغال ويفاجأ بقرار الأكاديمية السويدية بمنحه الجائزة عام 1998. وليصبح بذلك أول أديب برتغالى يحصل على أعلى جائزة أدبية في العالم.
يعتبر ساراماجو من الكتّاب العصاميين الذين ثقفوا أنفسهم بأنفسهم لذا كان التزامه بالثقافة التزامًا إنسانيًا وذاتيًا لم يقدم أى تنازل أخلاقي أو سياسي ليضمن رضاء السلطة بل كان على العكس من ذلك فقد ناوئ السلطة السائدة في ذلك الوقت، وتحدى الجميع بما في ذلك السلطة الدينية من منطلق حرية الفكر والتعاطي مع التوازن العقلي المؤمن به، وكان توازنه الذاتي والثقافي يسمح له بالتفكير الصحيح في قضايا مجتمعه والعالم والإنسان.
لذلك ترك مسقط رأسه وهاجر إلى جزيرة لنثاروتى إحدى جزر الكناري الاسبانية نتيجة غضبه من قرار وزارة الثقافة والتعليم منع روايته “إنجيل المسيح” من التداول بالمدارس والجامعات البرتغالية، ولم ينقطع ساراماجو في جميع أعماله الروائية عن الطواف في تاريخ البرتغال ولكن على طريقته الخاصة، وكان في كل ما كتب يعبّر عن على الأدب الناجم عن ثورة القرنفل التي أنهت حكم نظام سالازار عام 1974،
بدأ جوزيه ساراماجو الكتابة الأدبية في وقت متأخر وكان روايته “مانويل بالرسوم والكتابة” الصادرة عام 1973 هي البداية الحقيقية، وطريقه نحو الشهرة؛ لأنها كانت النموذج الحقيقي لرؤيته وأسلوبه الشاعري في الكتابة الروائية المعبرة عن رؤية جمالية خاصة، ونظرة شمولية لقضايا الواقع ككاتب ملتزم بالأدب والقضايا العامة لمجتمعه.
ثم كانت رواية “ثورة الأرض” 1980 والتي نجمت عنها صوفية “حلم نيسان الجميل” في هذه الرواية، ويقص الكاتب في هذا النص بؤس الفلاحين الذين لا أرض لهم والذين يعملون مزارعين بنظام المياومة، أو عمال التراحيل على التسمية المصرية، لتؤكد التزامه بقضايا مجتمعة بصورة أشمل من روايته الأولى لتناولها أسرة ريفية منذ بدايات القرن في حياتها وتأزماتها وحتى فترة السيتينيات، تأتي بعدها رواية “الدير” 1982 والتي حققت نجاحًا باهرًا على المستوى الشخصي والعام في منجز ساراماجو الروائى.
في 18 يونيو عام 2010 رحل ساراماجو إلى اسبانيا، بعد أن ترك للبرتغال إرثًا روائيًا يجعله من الكتّاب الذين أثروا هذه المرحلة الحديثة من الرواية العالمية. وكانت أعماله تتغذى من شعوره العميق بغنى التاريخ البرتغالي ورغبته في رسم لوحة تفصيلية واسعة تشكل خلفية لملاحظاته التأملية على المجتمع ومهارته في نسج القصص الرقيقة الخاصة.
وتعتبر رواية “العمى” 1995 التي أهداها ساراماجو إلى أبنته “فيولانتي” وتحولت إلى فيلم أخرجه فريناندو مايرليس، من الروايات التي حققت له مجدًا كبيرًا، فهي من الروايات التي تستكشف فلسفة الواقع من معطيات افتراضية قد لا توجد بالمرة، ولكنها في نفس الوقت ترمز إلى فلسفة هذا الواقع من خلال الترميز الساخر لما هو حاضر بالفعل أمام البشر في كل زمان ومكان.
تبدأ في مدينة غير معروفة رحلة وبائية غريبة حينما يصاب رجل بعمى أبيض أثناء قيادته لسيارته، إذ بدأ يرى كل شئ أبيض ومشعًا، ينقل الرجل إلى عيادة طبيب رمد الذي لم يجد تفسيرًا علميًا لهذه الظاهرة الغريبة، ثم لم يلبث الطبيب نفسه أن يصاب بنفس الظاهرة، وسرعان ما تتوالى الإصابات في أنحاء المدينة، ولا أحد يعرف ما هو السبب في هذه الإصابات الغريبة، وأين تقع هذه المدينة، فهي نموذج فاضح لمجتمع العولمة، ولا يربطها بأصولها البرتغالية أى ملمح، هي مدينة إنسانية على إطلاقها، والعمى الذي يصيب سكان المدينة عمى غريب ورهيب ينتج عنه أمور وأشياء غريبة في هذا المجتمع،
فالبلاء يبدأ عند تقاطع أحد الشوارع، عندما يفقد الناس فجأة حاسة النظر ولا يستطيعون الالتزام بإشارات المرور، وتصطدم السيارات ببعضها، ولا أحد يستطيع الخروج من هذا المأزق السائد في المدينة الساقطة في فوضى لا حد لها، ويتحول الجميع ذات صباح مضيء إلى “مدينة للعميان” ويتكالب الجميع على السلطة والحياة بأساليب غير إنسانية وتتسم بالوحشية. إلا أن الغريب في هذه الظاهرة أن هناك امرأة واحدة فقط في هذا المجتمع كانت هي المبصرة.
كما صورها ساراماجو وهي ترمز إلى بقعة الضوء الوحيدة الموجودة في هذا المكان المأزوم. وعليه فهي ترى كل الموبقات حاضرة أمامها السرقة، والقتل، والدعارة، والاستبداد، واستغلال النفوذ، والعمى الإنساني بصوره المختلفة والمتنوعة. وتبدو ظاهرة غريبة مصاحبة لهذا الوباء وهو وجود في بؤرة وجود هذا المجتمع وهو الجهل الصارخ الذي يعتبر عمى أبيض يجعل صاحبه لا يرى ما يحيط به من حياة ونعم وهبها له الله.
وتعتبر هذه الرواية وكأنها رؤية تنبؤية حول حضور الأوبئة في العالم ومدى خطورتها على الإنسان في كل زمان ومكان، خاصة ما أشار إليها الكاتب برؤيته الخاصة وهي أن البربرية قادمة بشكل خطير لا محالة. كما تكشف الرواية عن الجانب المظلم من طبيعة الإنسان عندما يصاب بالعمى الذاتي في حياته الخاصة، ومدى تدمير العمق والعقل الإنساني الفعال والحقيقي، من هنا نضع أيدينا على رواية عابرة للزمان والمكان وفاتحة لأبواب كثيرة لمعان وإشارات للخلود والحكمة والوجود الإنساني المعتم.
وفي رواية “كل الأسماء” تحمل الرواية هذا العنوان الإشكالي مع أنه ليس هناك ثمة أسم سوى اسم علم واحد هو أسم جوزيه وهو أسم يشبه اسم الكاتب وهذا يعني أن هناك دلالة غير مرئية تربط هذا الاسم بهوية وأسم الكاتب، مع وجود نقاط تشابه ربما تكون مع كثير من الأسماء من الناس الذين يجدون أنفسهم منساقين إلى مصائرهم وأحوالهم الشبيهة بالكمائن والأفخاخ، الحاملة معها تأزمات الواقع وصداماته المتعددة، ولا شك أن الطرح الذي كان ساراماجو يحاول فلسفته داخل روايته بهذا الأسلوب الفانتازي العميق كان هو المعادل الموضوع السائد بقوة في نسيج النص.
تتمحور الرواية حول موظف مغمور في الإدارة العامة للسجل المدني يتسلل ليلاً إلى الإدارة التي يعمل بها ليسلى نفسه بالإطلاع على ملفات شخصيات لامعة في المجتمع أنتقى منهم مئة شخصية مشهورة وأثناء البحث عن بطاقات هذه الشخصيات تعلق معه بطاقة بطريق الصدفة لامرأة مجهولة مولودة قبل ستة وثلاثين عامًا، لكنها تتسبب في قلب حياته رأسًا على عقب،
فقد دفعه حب استطلاعه وهواية الفضول المتجذرة داخله، للبحث عن هذه المرأة لمعرفة هويتها من خلال فضوله الذاتي، بحث عنها في كل مكان، في منزلها بحسب العنوان المدون في البطاقة، في مدرستها الأولية، حتى اكتشف أنها قضت منتحرة، ومن ثم يذهب إلى مقبرة المدينة الشاسعة لكى يعثر على قبرها لكن دون جدوى، ويكتشف أن رئيسه في العمل قد زار منزله في غيابه، وقرأ كل ما كتبه عن مغامرته الغريبة، ويطلب منه رئيسه إتلاف كل هذه البطاقات والوثائق المرتبطة بهذه المرأة.
وتنتهي الرواية بمغزى غريب هو أن أفراد الجنس البشري مشهورين أو مجهولين لا تربطهم بهذه الحياة أو الموت إلا بطاقات ووثائق صماء، وهم منساقين بفعل الزمن والمصير إلى قدرهم المحتوم وفي روايته “الإنجيل بحسب يسوع المسيح” يحاول ساراماجو في هذا النص الروائي الجريء في موضوعه والذي أثار جدلاً كبيرًا في ساحة الأدب البرتغالي والأوربي حيث استنكرت الكنيسة صدور هذه الرواية واعتبرتها رواية تجديفية، أما الحكومة البرتغالية فمارست الرقابة عليها، معتبرة أنها مهينة بحق الكاثوليك،
وبذلك حالت دون ترشحها لأي جائزة أوروبية رفيعة حال صدورها عام 1992 ويمكن اعتبار هذه الرواية من الأعمال التي حاولت إعادة كتابة حياة المسيح بهذه الطريقة أبرزها روايتي نيكوس كازنتزاكيس “التجربة الأخيرة للمسسيح” التي تحولت إلى فيلم سينمائي من إخراج سكورسيزى عام 1988، ورواية “، “ولكن ما يميز رواية ساراماجو عن هذه الأعمال، هي جرأتها المستفزة في موضوعها وشاعريتها الاستثنائية في التعبير وغموضها في حبكتها وانحيازها للإنساني الأرضي، حيث يظهر يسوع في رواية ساراماجو طفلاً ذكيًا بريئًا، يحلم بعالم أكثر عدلاً وحبًّا،
ويتساءل عن بديهيات المجتمع اليهودي آنذاك، كالزواج والصلاة والزنى والتضحية والذنب والألوهة، فيدفع السؤال في عالم واقعي، وتدور الأيقونة التوراتية الملغزة في هذا النص الروائي، وفي رواية “قايين” أيضًا حول إله الصواعق والغضب والرعد الذي يعرفه الكنعانيون باسم ألوهيم أو “يهوه” وهو أحد ثلاثة آلهة في الأساطير السومرية القديمة، يعرف بإله الشر الذي يرتوي من دماء الضحايا والقرابين المقدمة إليه. ويدخلنا تفكيك الأيقونة التوراتية المغلزة في متاهة الغواية الأسطورية الكبرى في هاتين الروايتين بجرأة غير مسبوقة.
إذ يتناول ساراماجو مفاصل التاريخ التوراتي القديم ليناقش فعل القتل كحرية توسوس للإنسان الممتحن بالخلاص، متخذًا من قايين مثالاً للبطل الأسطوري الذي دشنت جريمته فجر التاريخ الإنساني، وبالمقابل يتخذ من شخصية المسيح مثالاً للشهيد الذي يفدي الإنسانية ويفتح أبواب الغفران والخلاص.
ولرواية “المنّور” – المعروض لها في هذا السياق – قصة غريبة، ففي إحدى الأيام كان جوزيه ساراماجو يحلق ذقنه حين رن الهاتف، وضع السماعة على خده غير المطلى بصابون الحلاقة وتلفظ ببضع كلمات: “حقًا هذا مذهل! ثم لا تزعجوا أنفسكم سأكون عندكم في أقل من نصف ساعة”، لم يحلق ساراماجو ذقنه أبدًا بمثل هذه السرعة قبل أن يتوجه إلى إحدى دور النشر لاستعادة رواية كان قد كتبها بين عامي 1940 و1950 وهو في الثلاثينيات من العمر، وكانت بعنوان “كلارابويا” وضاعت مخطوطتها الوحيدة منذ تلك الفترة.
بعد أقل من ساعة عاد إلى منزله ومعه كدسة من الورق لم تصفر وتتلف بفعل الزمن، وكأن الزمن كان أكثر احترامًا للمخطوطة من أولئك الذين استلموها عام 1953 ورفضوا نشرها بسبب شهرة كاتبها التي لم تكن بالمعنى الجدير بالنشر في ذلك الوقت. كانت هذه الأوراق التي عثر عليها ساراماجو هي رواية “المنّور” التي قامت بترجمتها للغة الاسبانية زوجته بيلار دل ريو وكان ساراماجو قد كتبها منذ نصف قرن ثم فقدت لدى إحدى الناشرين وتم العثور عليها أثناء انتقال مقر هذا الناشر إلى مكان آخر،
وحين عثروا على هذا المخطوط القديم أتصل به مكتب الناشر تليفونيًا ليبلغه أنهم وجدوا مخطوطًا قديمًا لروايته وهم يلملمون أغراضهم للانتقال إلى مكان جديد. كان ساراماجو قد قدمها لهم للنشر عام 1953 وأهملت منذ هذا التاريخ لأن المؤلف لم يكن اسمًا معروفًا في ذلك الوقت حتى تم العثور عليها عام 1989 وعرض الناشر على ساراماجو طباعة هذه الرواية،
وعندما سألته زوجته في ذلك الحين عن سبب الرفض أجاب في ألم: “لقد أنتظرت منهم ولو سطرًا واحدًا عن سبب الإعتدار أو الرفض يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر إلى أن امتد الانتظار قرابة أربعة عقود” ثم أبلغ زوجته بقراره الحاسم “لن أنشر هذه الرواية ما دمت حيًّا”. وقد اعتبر النقاد أن فترة صمت ساراماجو خلال تلك الفترة كان مرحلة لنضج أمكانياته وخبرته الروائية ويستدلون على ذلك بأن شخصيات رواية “المنور” قد ظهرت في أكثر من عمل لاحق كتبه ساراماجو في رواياته اللاحقة.
في العتبة الأولى للرواية يستدعى ساراماجو بيتًا من الشعر للشاعر البرتغالى “راؤول براندو” يقول فيه: “في كل نفس، كما في كل بيت، توجد، غير الواجهة، زوايا مخبأة” وكانت هذه العبارة بمثابة المفتتح الطبيعى لخط السيرة الرواية والدخول إلى عالمها الطبيعى عبر قصة بيت بمنطقة من مناطق الطبقة الوسطى في لشبونة الخمسينيات، تسكن فيه ست عائلات في ست شقق، ويمثل المنوّر أو الشباك الخلفي لهذه العائلات، الكوة التي ينفذ منها الكاتب إلى هذه الشريحة من أسر الطبقة الوسطى الذين يعيشون في مجتمع الديكتاتور سالازار، وتدور في هذا البيت المكوّن من ثلاث طوابق في كل طابق شقتان أحداث الرواية.
في الطابق الأول شقة الإسكافي (الفيلسوف) وزوجته المرأة الطيبة، ثم المستأجر الشاب الحالم، اللامنتمى إلى أي شيء في هذا المجتمع والذي استأجر غرفة في شقة الإسكافي، ومن خلال النقاشات التي كانت تدور بين الإسكافي وهذا الشاب تظهر محنة الحياة الدائرة خلال تلك الفترة من عام 1952، في هذا الطابق أيضًا شقة مندوب مبيعات سوداوى النزعة يائس من الحياة وزوجته الاسبانية سليطة اللسان وأبنهما الموزع بينهما بسبب معارك وخلافات مستمرة بين الزوج والزوجة وحيرة الابن بينهما.
أما الطابق الثانى فتسكن فيه السيدة ليديا التي يزورها عشيقها الثري ثلاث مرات في الأسبوع ليقضى معها بعض الوقت، وتشعر هذه المرأة في حياتها بالخواء واللامبالاة، بسبب احتقار جيرانها لها لمسلكها المشين ورغبتها في الحياة مع هذا العشيق الذي يوفر لها مستلزمات الحياة بسهولة.
لذا فهي تقابل جيرانها بازدراء ونفور، أما الشقة الثانية فيسكنها عامل طباعة في جريدة كبرى مع زوجته المريضة نفسيًا نتيجة وفاة ابنتها الوحيدة وهي في مقتبل العمر، زوجها يعمل ليلاً وينام بالنهار. وأخيرًا الطابق الثالث الذي تعيش في شقته الأولى أربع نساء فقراء الخالة والأم وابنتان تجاوزتا سن الشباب، يعشن الإحباط والكآبة على نغمات موسيقى منبعثة في الأمسيات الحزينة من المذياع، وهن يطوين رغبات أجساد تذوي بمرور الزمن.
أما الشقة الأخيرة في هذا البيت فهي شقة موظف متوسط الحال يكمل مصاريف الشهر بالكاد وزوجته الراضية بهذه الحياة مع ابنتهما الشابة الجميلة ذات التسعة عشر ربيعًا وهي الشعاع المضيء في حياتهما الجافة المظلمة. يتسلل الكاتب من الباحة الخلفية للمنزل عبر المنور المطل على هذه الشقق إلى نفسيات هذه الشخصيات من خلال حبكة مليئة بالمتعة القائمة على التحليل العميق لهذه الشخصيات لتعبر عن المجتمع البرتغالي أثناء حكم الديكتاتور سالازار نهاية خمسينيات القرن الماضي.
في رواية “انقطاعات الموت” يفتتح ساراماجو روايته دون مقدمات: “في اليوم التالي لم يمت أحد، إذ توقف الموت في الأول من يناير لإحدى السنوات عن عمله الدؤوب الذي كان بدأه مع نشأة البشرية، ليتكدس آلاف المحتضرين، في ظل هذا المتغيّر، ويرسم الكاتب عالمًا جديدًا إذ يشكل غياب الموت معضلة لدور كل من الكنيسة والسلطة والفلاسفة ورأس المال، حيث تفقد الكنيسة دورها بسبب غياب الموت ورهبته، وانقطاعه عن العمل مما سبب لها ركودًا في أدعيتها وعملها الجنائزي، وتوقف الفلاسفة عن التفكير، وانقسموا بين متشائم ومتفائل وعمت الفوضى بمبرر ضرورة تواجد الفلسفة في خضم هذه الفوضى الذي سببها غياب ملك الموت،
ولما كان الحاضر دومًا في أعماق الإنسان هو هاجسه بعمر مديد لا ينتهى ولما كان الإنسان يئن تحت سطوة استمرارية الحياة والموت معًا من خلال المدى المجدي لحلم الخلود في هذه المروية المحققة لاستمرارية كل الأشياء في هذا الوجود. ومنذ الاستهلال الأولى للرواية يضعنا الكاتب في قلب الحدث، وهو توقف الموت حيث يجعل منه جزرة غواية، فيستعرض المفارقات في لعبة الحياة ومتناقضاتها حيال هذا الموضوع الذي ألم بالجميع وجعل الإنسانية في منعطف الطريق إما إلى الموت أو إلى الخلود الأبدي وما سيحدث بعده من أمور وأحوال،
والكاتب ببراعته يجعل الخلود ينفتح على صحراء من اللاجدوى والعبثية والاكتظاظ ما يكشف أن الإنسان تائه في هذه الحياة ويعرض الكاتب أيضًا أبعاد المشكلة التي تسبب بها توقف ملك الموت عن الإمساك بالإحياء والبعث بهم إلى الآخرة. فيجمد الإنسان مدهوشًا عند إشارات الخوف متأرجحًا ما بين وبين، وكل همه أن يلمح ولو ومضة من بريق أمل إما للحياة وإما مصاحبة ملك الموت.
لقد فجر الكاتب قنبلة فكرية نفسية جعلتنا نقف على حافة الوجود فالموقف محيّر حد الاختناق حين تطرح المروية أسئلة وجودية تستبيح كيان الإنسان المعاصر وهو على حافة الوجود إما وإما. الكاتب يقدم حالة بائسة للخلود، وهو خلود أرضى محكوم بمعطيات الواقع (وليس خلودًا إلهيا كما هو في الأذهان) خلود يفّرخ اكتظاظًا واختناقات إنسانية في كل مناحي الحياة، وهو تعرية وإدانة للمجتمع والفساد السياسي والديني والأخلاقي وزيفًا يضع الجميع أمام مفترق طرق للكشف عن الأقنعة المزيفة التي يلبسها الإنسان أحيانًا في العديد من المواقف ويفضح قذارة السياسيين أمام الجميع،
كما يفضح موظفي الدين حيث يشكل الموت والبعث أساس هذا الخطاب الدنيوي بكل ما فيه من المجردات العمياء. تلك كانت فلسفة النص الذي بنى عليه الكاتب الأساس من الوجود والأساس من عدم الوجود. ولما كان الكاتب يساري حتى العظم إلا أن فكرة أن الموت كانت رؤيته، حلاً ضروريًا لمشاكل الحياة تلتقى مع ما طرحته الرأسمالية من أن الحروب هى الحل الأمثل لمواجهة زيادة عدد السكان وهذا يبتعد بنا عن خط الكاتب السياسي، هذا وقد طغت طريقة السرد كتعليق على غالبية الفضاء السردى بكل موجوداته.
وفي رواية “سنة موت ريكاردو رييس” يعود ساراماجو لينبش إلى التاريخ كما في فعل في روايات “الإنجيل يكتبه المسيح”، و”حصار لشبونة”، ويشيّد عالمًا خاصًا، مفارقًا وموازيًا للواقع المعيش، عالمًا من الحيوات الحقيقية والمتخيلة، أحداث واقعية حدثت بالفعل في مدينة لشبونة إبان حكم الدكتاتور “سالازار” وتأثيرات الحرب الاسبانية على المجتمع البرتغالي والتي اعتبرها النقاد نوعًا من التكريم لأعمال الكاتب البرتغالي الكبير “فرناندو بيسوا”، وأخرى أحداث ملفقة تدور في مخيلة الكاتب،
تروي هذه الرواية من خلال حلم طويل.. يقترب إلى حد ما من أحلام اليقظة، حيث القرين (ريكاردو رييس) الذي أوجده شاعر البرتغال الكبير (فرناندو بيسوا) وهو هنا سيحظى بحياة كاملة طيلة تسعة أشهر، بدءًا من وصوله إلى لشبونة وتردد بيسوا الميت عليه في زيارات خاطفة وحتى موته هو (ريكاردو رييس) في السنة الجديدة 1936، يقول بيسوا إن لديه تسعة أشهر بعد الموت تمامًا مثل عمر الجنين في الرحم قبل أن يستوي طفلاً، ويخرج إلى العالم، لكن مع موت بيسوا خالق قرائنه، ومنهم ريكاردو ريس يختار القرين الموت هو الآخر فليست لديه فرصة أخرى للعودة، إنه نتاج مخيلة بيسوا أولاً،
ومع موت الأخير يمنحه الكاتب تسعة أشهر مضافة فكلاهما الآن الشخصية وخالقها، أي (ريكاردو رييس الشخصية وخالقها فريناندو بيسوا) وهما نتاج مخيلة روائي يستمتع بالمضي قدما مع لعبة الأقنعة والقرائن. والشخصية وخالقها ليسا متشابهين ولا متقابلين في توجههما، فلكل منهما له تميزه وسماته الخاصة عن قرينه: “كل منا فريد ولا يمكن إبداله.. حتى لو انبثق فرناندو بيسوا هنا في هذه اللحظة، فإنه لن يكون فرناندو بيسوا الذي كان، ليس لأنه ميت، بل لأنه لن يستطيع أن يضيف شيئًا إلى ما كانه، وإلى ما فعل، وإلى ما عاشه وكتبه”.
وعلاقات ريكاردو ريس النسائية ليست بمعزل عن المخيلة ذاتها في قدرته على استدراج النساء، خاصة الخادمة في الفندق براجنسا التي سيستدرجها إلى الفراش والتي ستتبعه إلى شقة مؤجرة لتنظيفها له، وتغسل ملابسه، وتعد له الطعام، وتمنحه جسدها، وعندما تحمل منه تخبره بأنها ستحتفظ بالطفل، أيضًا العلاقة الرومانسية التي ربطت بين ريكاردو ريس والفتاة مرساندا ابنة مسجل العقود المصابة بشلل في ذراعها الأيسر،
وعلى الرغم من فارق السن الكبير بينهما، وتدخل المتخيل في اختفاء كل مظاهر الزواج في المكان المتخيل، عدا شفاء الفتاة، والباقي من شأن الشاعر فيرناندو بيسوا القرين لهذه الشخصية. يبدو في هذه النص الروائي أن أصوات الشخصيات تتداخل وتتقاطع دون تحديد للحدود.
وكان ساراماجو في نشاطه السياسي والاجتماعي صادقًا مع نفسه قبل أن يكون ذلك في مواجهة الآخرين. فهو يتقبل النقد بروح ملؤها الشفافية، لكنه لا يقبل التشكيك في آراؤه المؤمن بها. وربما من أبرز المواقف التي تعبر عنه ما حدث بعد زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة عقب مذبحة “جنين”، التي وصفها بأنها جريمة بشعة، ولا تقل بشاعة عن أوشفيتز التي بنت عليها إسرائيل أسطورة وجودها،
ورد على منتقديه وقتها بأنه يفضل أن يكون ضحية كالفلسطينين على أن ينتمي إلى معسكر القتلة سفاكي الدماء، وهو في روايته يسخر من خمول البرتغاليين خلال الدكتاتورية التي أسسها أنطونيو سالازار عام 1933 ودامت 41 عامًا. وذلك باستدعاء أشهر شعراء البرتغال وهو الشاعر الحداثى فرناندو بيسوا من بين الأموات لكى يغيّر الأمور في البرتغال،
وفي رواية “تاريخ حصار لشبونة” يقوم مصحح نصوص بإقحام كلمة لم في نص استعادة العاصمة البرتغالية من المغاربة في القرن الثاني عشر وبذلك يغيّر خياليًا التاريخ الأوروبي بجرة قلم. وتحكى رواية “بالثازار وبليموندا” وهي أول رواية تحظى بالثناء خارج البرتغال.
أصيب ساراماجو في سنواته الأخيرة بالتهاب رئوي، وعانى كثيرًا من “سرطان الدم”، وفي صباح الثامن عشر من يونيو 2010، استيقظ مبكرًا من نومه، وتناول كعادته طعام الإفطار مع زوجته، ثم ذهب إلى طاولة الكتابة، وبعد ساعات قليلة شعر بالتعب والإعياء الشديد، اتصلت زوجته بالطبيب، لكنه كان قد أسلم الروح ورحل عن عالمنا بعد أن ترك لنا إرثًا روائيًا له سحره الخاص واستثنائيته العارمة، ورونقه الرامز إلى كنه الحياة ومعضلات إشكالياتها التي لا تنتهى أبدًا.
وقد أعلنت البرتغال الحداد لمدة يومين على ابنها المتمرد كما نعاه بعض الساسة مثل الرئيس البرازيلي والرئيس الكوبي كاسترو ووزراء من فرنسا واسبانيا. كانت جنازته من أكبر الجنازات التي شهدتها البرتغال. سار فيها الآلاف وهم يحملون زهرة القرنفل البرتقالية اللون الرامزة لثورة القرنفل، ودفن رماد جثته التي أحرقت تحت شجرة زيتون عمرها مئات السنين حسب ما كتب في وصيته التي قال فيها: “أريد أن أعود من جديد إلى الأرض مثل بذرة زيتون قاومت الزمن كثيرًا”.
المراجع:
• خوسيه ساراماجو الكاتب الذي أردت أن أكونه.. مع كتّاب نوبل حوارات نادرة، حسين عيد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2006 ص 182
• موضوعية ساراموجو تستنفر صهيونية عاموس عوز، محمد رضوان، الأسبوع الأدبي، دمشق، ع 808، 18/5/2002 ص 15
• جوزيه ساراماجو ينشد في “العمى” مرثية القيم الإنسانية، إبراهيم حاج عيدى، الحياة، لندن، ع 14405، 28 أغسطس 2002 ص 12
• الكتاب المفقود لساراماجو يخرج إلى العلن.. حول رواية “المنور”، المحرر، عمان، مسقط، 4/3/2012 ص 12
• خوسيه ساراماجو وواقعيته المخادعة، آلان رايدنج، ترجمة أحمد خضر، الثقافة العالمية، الكويت، ع 92، يناير 1999 ص 182.