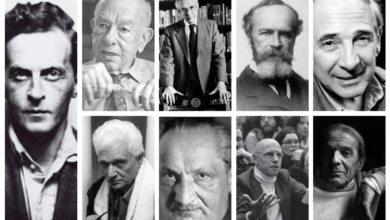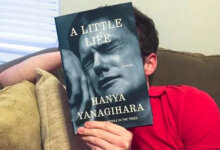عندما كتب تزيفتان تودروف كتابه «الأدب في خطر»، كان على بينة من أنه قد أسس لعلاقة دفينة بين الأدب والحياة، بل دفع الحياة إلى الأدب بكل أسرارها وألغازها وتوجُّساتها. فتاريخ الأفكار لا يعرف حدودا ولا مذاهب، انطلاقا من الشرق الشيوعي إلى حدود الغرب الرأسمالي، الغارق في فلسفات الوجودية، وما وراء الطبيعة . «الأدب في خطر» فسح المجال للحياة كي تحيى، وتعانق مذاهب تعيشها أوروبا إلى اليوم. وعلى غرار هذا الهروب الكبير من الواحدية في كل شيء، حسب أدونيس، استطاع تزيفتان أن يكون جسرا ثقافيا كبيرا يمتد، كسرب حمام، من بلغاريا الشيوعية إلى فرنسا الرأسمالية، عالم الفنون والأدب والحرية .
إن الهروب من القبضة الحديدية أو الستار الحديدي، كما هو معروف، الذي تطبقه الأيديولوجية الكليانية الشيوعية، وتسوس الناس بسياسة تحدو بين السن والمخلب، فضح طموح النظام، بعدما تشبع بأفكار الماركسية اللينينية، بما هي ترنو إلى أن تجعل الناس في كتلة واحدة، غير آبهة باختلاف الأعراق والانتماءات والهويات والثقافات والمعتقدات. فمن أجل ذلك كان هذا الهروب الكبير من القولبة البشرية والقمع الدامي، الذي يترك ندوبا لا تمحى أبدا من ذاكرة التاريخ، لأن الطموح يعمل في تزيفتان كآلة بخار تمخر عباب المحيطات .
وسعيا نحو الكشف عن الفردية والذاتية والهروب من الفكر الجماعي، والانصهار في البوتقة الواحدة، بعيدا عن إثبات الذات في معترك الحياة، دفع تزيفتان نحو سحب مشروعه الأدبي الضخم من جامعة صوفيا، وإلحاقه بجامعة السوربون الباريسية الحرة. وبفضل ذلك، مهّد لظهور أيديولوجيات غيرت مجرى تاريخ أوروبا، بفعل التطورات والإبدالات العميقة والجوهرية في الفكر والأدب. فانطلاقا من الشكلانية، التي كانت منطلق تزيفتان في رؤيته للأدب، حدد الأدب الفرنسي غايته من هذا الوافد الجديد على الثقافة الباريسية الحديثة. لم يعد بالإمكان، في ظل هذا المعطى، العمل وفق نظريات سابقة، وإنما كان السعي حثيثا نحو اكتشاف تقنيات جديدة في الأسلوب والتركيب، والدلالة، وتأويل الرموز.
وتماشيا مع الفكر الحديث، استطاع تودروف أن يشتغل وفق أساليب حديثة، أضاءت له دروب البحث والمعرفة. ما خوّل لجامعة السوربون أن تفتح له ذراعيها وتحتضنه، على اعتبار أن تزيفتان سيكشف لها عن المغلق، وتحقق بذلك التميز المرغوب عن سائر الجامعات الأوروبية المنافسة آنذاك. علاوة على المكانة المتميزة، التي يحتلها عميد الجامعة المؤرخ أندري آيمار، حيث تمكن هذا الأخير من أن يزرع هذا البلغاري الشغوف إلى العلم والمعرفة، في قلب العاصفة الفكرية والعلمية والفلسفية، التي تغزو أوروبا آنذاك، عن طريق الاحتكاك الفعلي بدهاقنة الفكر الفرنسي، أمثال جيرار جونيت ورولان بارت، بما هما أسهما بشكل فعال في إخراج المشروع الفكري لتزيفتان تودروف إلى حيز الوجود. وفضلا عن ذلك، أثمر هذا المجهودُ، كتابا في المثقافة الحديثة بين المعسكرين عنونه بـ»نظرية الأدب»، إذ إن الأدب الفرنسي تعرّف، ولأول مرة، على نصوص مغمورة للشكلانيين الروس. معروف جدا، أن للشكلانيَّة جذورا تمتد في أوصال البنيوية، كإطار منهجي وبيداغوجي في تناول النصوص. فلا سبيل، إذن، إلى ثورة معرفية من دون هذا التقارب الحاصل بين تزيفتان وبارت، على مستوى الإشراف على أطروحة في علم النفس، سجلت في السوربون .
كانت لهذا الشربورغوي يد سابغة في الإبحار المعرفي لتودروف، حيث بدأ يطل، هذا الأخير على أسرار الثقافة الفرنسية، ما أهله كي يحتل مكانة أسمى في وجدان التلاميذ والطلبة، إذ أصبح مشرفا عاما على المقررات الدراسية، من خلال المركز الوطني للبحث العلمي. من زاوية أخرى كان إشراف رولان بارت على أطروحته في علم النفس، أول الطريق. بالإضافة إلى ذلك، وسّع تودروف من وعائه المعرفي والثقافي، حيث رأى في حوارية باختين سلوكا وممارسة، دافع عنها بشراسة، منطلقا نحو اكتشاف التعدد الثقافي عبر العالم، وتفاعل الذات في ظل الآخر. فغير بعيد عن ذلك، كان الاهتمام منصبا على الخطاب الشعري، الذي يعتبر حلقة وصل بين شعوب العالم، لما فيه من محاكاة ذات بعد أرسطي، لتجليات طبيعية في الإنسان والوجود. فمهما كان الحديث عن القول الشعري، إلا واستند تودروف إلى معرفة راكمها من خلال تجربته في مجلة «الشعرية»، برفقة زميله جيرار جونيت، بداية السبعينيات من القرن الماضي، حيث كان ينظر إلى الشعرية من منظور التجريد المطلق .
فالأدب بالنسبة لتزيفتان يدرس ظواهر غير تجريبية وغير ملموسة، ولا تخضع للحواس الخمس. ومن ثـَم فهو يتبنى البعد البنيوي، الذي استمده من أستاذه رولان بارت، من خلال العديد من مؤلفاته بدءا بـ«درجة الصفر للكتابة»، باعتباره الكتاب الذي دشن به بارت الحرب على خصومه، واستأثرت القطيعة، مع الكتابات التقليدانية في الأدب والثقافة الفرنسية، الجزء الأكبر في مشواره العلمي، منتصرا في ذلك لمجهودات بعض النقاد الفرنسيين المعاصرين كموريس بلانشو، وجون بول سارتر. وبالموازاة مع ذلك، كانت الحوارية والبوليفونية الإبداعية لباختين حاضرة بقوة في السير، قدما، نحو تأسيس خطاب جديد حول الأدب. ومن خلاله، فهو يتعدى كل معايير الأدب الكلاسيكي، ويهد متاريسه وقلاعه الحصينة، حيث إن بارت كان ينظر إلى النقد الموضوعي بعين كليلة، ليسحب البساط من تحت أقدام غوستاف لانسون، بما أنه يعتبر من أعرق رواد هذا التوجه، الذي سيطر على الاتجاه النقدي الفرنسي زهاء خمسين سنة .
ظل رعيل تودروف، ينظرون إلى الأدب بشيء من الغموض، فسواء كان الإبداع إفصاحا عن هموم الذات وارتواءاتها المعرفية، لابد أن ينقذف بكل ثقله نحو الإبهام والغموض.
إن النقد الموضوعي، الذي هد بنيانه رولان بارت، يعود بشكل رسمي إلى الأيديولوجية، ويظل الكاتب، في خضم ذلك، كأرفيوس جديد يبحث عن حقيقة غائمة، في ظل تشعب مسالك اللايقين واللامعنى. ولأن الإنسان مرتبط بالتاريخ والعادات والتقاليد، الذي تخلق منه كائنا ذا وضع اعتباري ومعياري، فإن الأيديولوجية، حسب بارت، تصبح في هذا المستوى كسلعة مهربة في ثوب العلمية. وجراء ذلك وجه، للنقد القديم، في كتابه «النقد البنيوي للحكاية»، جملة من الانتقادات أهمها: الأسلوب المعياري الذي يعالج به القضايا الفكرية، فضلا عن توظيفه لعلم التحليل النفسي توظيفا تجزيئيا، علاوة على غلوه في استعمال الذوق الفني في العمل الأدبي، الذي يفضي في نظرهم إلى الموضوعية . يقول بارت، في هذا المضمار: «تلك هي القاعدة الأولى، التي بها بصموا آذاننا: الموضوعية. ماذا نفهم بالموضوعية في مادة النقد الأدبي؟ ما نوعية العمل الأدبي الموجود خارجا عنا؟ هذا الخارج الأثمن من كل المعايير، لأنه يضع حدا لهوس النقد.. قبلا كانت الموضوعية تعني المنطق، والطبيعة، والذوق.. وأمس كانت تعني حياة الكاتب وقوانين النوع الأدبي، الذي يتشكل منه الإبداع».
ظل رعيل تودروف، ينظرون إلى الأدب بشيء من الغموض، فسواء كان الإبداع إفصاحا عن هموم الذات وارتواءاتها المعرفية، لابد أن ينقذف بكل ثقله نحو الإبهام والغموض . فموريس بلانشو، مثلا، يعتبر نفسه امتدادا شرعيا لفلوبير، من زاوية البحث عن المعاني الثاوية في الإبداع الأدبي. بيد أن فلوبير، في إحدى رسائله، كان ينظر إلى اللامعنى نظرة مغايرة للمألوف والاعتيادي، حيث كان يعتبره بمثابة جسد متفوق على المعنى. فغير بعيد عن ذلك، بدأت طلائع الرمزية ترسي دعائمها في الثقافة الفرنسية.
وكانت السيريالية، بزعامة تريستن تازار، قد خرجت إلى العالم بثوب قشيب، بفكر يكسر كل الحدود المنطقية بين الفكر والعقل، لينتشر هذا التيار، ويعم كل أرجاء أوروبا .ففي الوقت الذي كان فيه رولان بارت يؤسس لنظريته في الأدب، انطلاقا من «درجة الصفر للكتابة»، نجد فردنان دوسوسير، سبق أن عبَّد له الطريق في علم اللسانيات البنيوية، من خلال كتابه المهم «دروس في اللسانيات العامة». لم يجد رولان بارت صعوبة في مسيرته العلمية عندما قرر الانفصال عن التاريخ، لأن لسانيات دوسوسير تكتشف النصوص من الداخل، من اللغة، ومن الأسلوب، ومن البلاغة أيضا.
بالموازاة مع ذلك كان الطرح الأيديولوجي بعيدا في تناول الظواهر الأدبية، فكلما ابتعد عنه الكاتب ـ أي عن الطرح الأيديولوجي ـ صفا معين الكتابة. في هذا المقام، نجد كذلك تودروف من بين المفكرين، الذين دافعوا بشراسة عن هذا المد المعرفي الجارف. فكيف يمكن للكاتب أن يكتب بمعزل عن الأيديولوجية؟ فهل بإمكان الكاتب أن يبدع قصة أو رواية أو مسرحية، من دون أن يحدد الهدف؟ عبر تاريخ الإبداع الإنساني لا يمكن الاستقلال التام عن الأيديولوجية، فإذا كان كذلك، سنجد أن البناء الخاص بالثقافة الإنسانية بدأ يتصدع ويذوب كمدن الملح من الداخل، ويصبح العمل الأدبي فاقدا لمصداقيته الوجودية . فالفن له غايات ومرام بعيدة، فبقدر ما يمتزج الفن بالأدب بقدر ما يغزو هذا الأخير المخيال الإنساني، ويطوع الواقع .