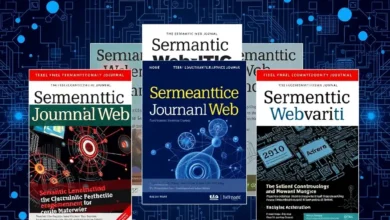جدلية الرقص والزمان

غنّت فيروز:
“يا دارة دوري فينا ضلّي دوري فينا تينسوا أساميهن وننسى أسامينا
تعا تنخبّى من درب الأعمار وإذا هنّ كبروا نحن بقينا صغار”.
تغنّي ناقلةً صورة طفليّة واقعيّة لحركة الدّوران حول الذات في اللعب، وترافقها أصوات “آه” لا تنقطع إلّا حين السقوط أرضًا. يسقط الأطفال متضاحكين، ليقفزوا ويعيدوا اللعب الدّائري من جديد. مَن منّا لم يجرّب – طفلًا – هذه “اللعبة” الممتعة، ويختبر شعور الفرح في الغياب عن محيطه حين يختلّ توازنه ويقع؟! غير أنّ في الأغنية أبعادًا رؤيويّة فلسفيّة في فكرة الغياب والنّسيان للزمن الفيزيائي، وتغييب الإدراك أو الوعي بالمكان والواقع.
هل لنا أن نقفز في رحلة غياب عن المكان، عابرين حجاب الزّمن؟!
- تناغم وانعتاق
قد يكون الرّقص، بحركيّته وانسيابيته، التعبير الأمثل – بين الفنون – عن نشوة الجسد والنفس والفكر معًا؛ فهو حالة حركيّة ترسم لوحات من الجنون والتوحّد، ومن الانفصال للحظات عن الواقع، إذ هو احتفاء بالفرح، ولغة من دون كلام، وفوق الكلام، وتجلٍّ لغريزة الحياة. فما برح الإنسان في أرجاء العالم، وفي كلّ زمان، يعبّر بالرّقص عن رغبته في الانعتاق من الفناء. ويذهب البعض في وصفهم للرقص بأنّه صلاة تصل الكائن بالكينونة، أي المطلق. هذا الوصف يأخذنا، في حركة ذهاب وإياب، بعيدًا إلى البدايات التعبيريّة الحركيّة ومسوّغاتها، والعودة بها إلى التجلّيات المعاصرة لهذا الفنّ.
يكشف تاريخ الصّلاة عن حالة المزاوجة التي أحدثتها بين الجسد والرّوح. ولا يخفى أثر العامل الدّيني في الفن، فيظهر بخاصّةٍ في المجتمعات الأوّليّة؛ حيث تكون الحياة الاجتماعيّة متّصلة اتّصالًا وثيقًا بالحياة الدّينيّة؛ ذلك لأنّ تجمهر الأفراد للاشتراك في الحفلات الكبرى يدعو عفوًا وضرورة إلى انتظام الحركات والأصوات، فينشأ من جرّاء ذلك نظام في حركات الأيدي والأرجل والجسم، وترتيب في الأصوات والسّواكن، ما يؤدّي إلى فنّي الرّقص والغناء. ألم تكن صلاة عرب ما قبل الإسلام مكاءً وتصدية، أي تصفيقًا وصفيرًا، خلال طوافهم حول الكعبة في إطار حركي احتفالي جماهيري؟
تكشف النّقوش الأثريّة، كذلك الأمر، على جدران معابد قدماء المصريّين في وادي النيل، والآشوريين في بلاد الرّافدين، أنّ الرّقص كان أحد أشكال التقرّب إلى الآلهة، ويمارَس ضمن الشعائر الديّنيّة طلبًا للخصب والوفرة والمطر؛ الأمر الذي يفسّر ارتباط الرّقص المقدّس بالمرأة بوصفها رمزًا مكثّفًا للخصوبة.
التلازم بين الفنّ والمقدّس، وبين العشق والعبادة يبدو في الحياة الثقافيّة الهندية لا فكاك منه؛ إذ يتجلّى في الدراما والأفلام الهنديّة التي لا يخلو منها عمل من غير استعراض فنّي غنائي راقص، وارتباط وثيق بالعبادات. أكثر من ذلك، فقد أكّدت الثقافة الهنديّة قوة الرابطة بين الموسيقى والدين والفلك، فاتّخذت الموسيقى شكلًا من أشكال الكمال: صوفيًّا وعلميًّا وفلسفيًّا.
وقد أشار الفيلسوف الألماني المعاصر، غادامار Gadamer، إلى عدم الفصل بين الدين والفنّ، في قوله: “إنّ السؤال الذي يكون مطروحاً في هذه الصيغة: لغة شعريّة أم دينيّة؟ لهو سؤال سيكون دون حدود اللياقة عندما نكون في مواجهة تقاليد الفكر الهندي أو الصيني.”
- سحر التّحوّلات
لئن يشكّل الرّقص منفذًا لقراءة سلسلة من التّحوّلات الاجتماعيّة التّاريخيّة، بتحوّله من طقس ديني وعبادة إلى تعبير فرح، وتشكيل فنّي حركي، تعيدنا أغنية استنزال المطر أو الاستسقاء الشّعبيّة إلى فيروز مجدّدًا:
“شتّي يا دنيي تيزيد موسمنا ويحلا
وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلا”
تنتمي تلك الطقوس إلى السّحر الانجذابي الذي يقوم على افتراض أنّ الحدث المرغوب في حصوله، يحصل إذا ما جرى تقليده أو الإيحاء ببعض عناصره؛ فتتشابه الرقصات الطقسيّة والممارسات الاحتفاليّة لدى شعوب حوض البحر المتوسّط. الاحتفال الطّقسي ب”أم الغيث” في الأردن: يا أمّ الغيث غيثينا ………… هزّي غيماتك واسقينا، و”أم الغيض” في لبنان: يا أم الغيض غيضينا ……….. شتّي بأراضينا بالابتهال إلى “الأم” أن تنزل المطر، يماثل الاحتفاليّات الشعائريّة في دول البلقان من خلال طواف عذارى في القرية يرقصن حول “الدودولا” (وهي فتاة عارية مكسوّة بالأعشاب والأزهار)، يطرقن الأبواب فتخرج ربّات البيوت ويرششن الماء على الفتاة فيما الموكب ينشد:
نمضي في القرية تمضي الغيوم في السماء
نمضي أسرع أسرع من الغيوم
ولكن ها أنّ الغيوم تجاوزتنا
وبلّلت شتلات الذرة والدّوالي
إنّ حضور الدّيني في أصل المجتمعات البشريّة كلّها هو حقيقة بدهيّة وجوهريّة، فالفكر الأسطوري يعود دائمًا إلى ما حدث أوّل مرّة، أي إلى فعل الخلق بالذّات. ما حدث أوّل مرّة يكون حدثًا خلّف في البشر انطباعًا قويًّا يتواصل عبر الدّيني، وفي الأشكال الثقافيّة. فقد أشار رينيه جيرار René Girard في كتابه “العنف والمقدّس” إلى أنّ في المرأة من الضعف وصفة الهامشيّة النّسبيّة ما يخوّلها أن تؤدّي دورًا ذبائحيًّا؛
هكذا كان يمكن أن تشكّل موضوع تقديس جزئي. فالضحيّة الفدائيّة قادرة على إيقاف سيرورة الهدم – كما مفهوم الفداء الذي استمرّ في المسيحيّة التي تأسّست على مثال المسيح الفادي والمخلّص – ولا بدّ أن تكون في أساس كلّ بنيان منظّم، مثل ما يُفهم من وظيفة الأعياد والاحتفالات التذكاريّة التي لا تختلف عن وظيفة ما عداها من طقوس ذبائحيّة، “كأنّ الّلاعنف هبة العنف المجّانيّة”.
فالمطلوب هو إحياء النظام الثقافي وتجديده بتكرار التجربة التأسيسيّة، على ما يذهب عالم الاجتماع إميل دوركهايم Emil Durkheim.
بالإمكان الخلوص، من خلال رصد التحولات الطقسيّة في السّياق التاريخي، إلى تصوّر الرّقص الطقسي قربانًا بديلًا من الذبيحة، الطوطم، وكان قد مورس في المعابد بموازاة البغاء المقدّس. فإذا كان الإبدال الذبائحي الأول الذي ابتكرته الجماعة كوسيلة تقيها خطر التّفتّت والانهيار، يرتكز على ثقافة عنفيّة – ثقافة قتل وموت – في الإجماع العنفي على التّضحية بفرد واحد بديلًا من جماعة يترصّدها خطر ما، فإنّ الرّقص الطقسي، في سياق تطوّر الفكر الإنساني، يتأسّس على ثقافة حياة وإحياء نشدانًا للسلام والخصب والاستمراريّة.
- طقوس العبور في الرقص والنار
في السياق الإيماني التقليديّ عينه، تتكشّف رقصات موغلة في القدم أضحت من التراث الثقافي الشعبي، لكنّها ما زالت تحتفظ لدى الشعوب بهالتها المقدّسة، كـ”رقصة التنين” و”رقصة الأسد” لدى الصّينيين، والرقص على الجمر في مقاطعة سترانجا- بلغاريا على سبيل المثال لا الحصر. تحكي الأسطورة أنّ وباءً ضرب إحدى القرى الصينيّة، فأخبر أحد الكهنة السكان بأنّ السبيل إلى اختفاء الوباء هو تأدية رقصة ناريّة.
فيرى الصينيّون أنّ هذه الرقصة التي يحتفلون بها في عيد ميلاد بوذا، جالبة للحظ والمطر في أيام الجفاف وتبعد الشرور. أمّا رقصة الأسد فتعود إلى تقديرهم هذا الحيوان لرمزيّته المتجلّية في القوة والنبل، وفكرتها تقوم على الرقص بدمية أسد، يؤدّي هذا الاستعراض راقصان.
وإن دلّت هذه المظاهر على شيء فهو خشية الإنسان من المجهول والغيب في ظل صراعه مع الطبيعة والأقدار. ويستمرّ تجلّي التداخل بين الوثني والتوحيدي في طقس الرّقص على الجمر احتفالًا بالقدّيسين قسطنطين وهيلانة، وهو في بعده الرّوحي والإيماني تأكيد انتصار الذات على الخوف، في فكرة العبور، وتجاوز الراهن للتوحّد مع العالم.
الإيقاع الداخلي وإيقاع الموسيقى الخارجي واحد؛ إذ يعبّر بعض الرّاقصين بالقول: “النار لا تتغلب عليها. إمّا أن تعبرها إما لا.. ينبغي أن تكون ثقة المرء أكبر من خوفه، لكي يتغلّب على الخوف، وينقّي عقله، ويهمل العالم الخارجي. أوّلًا عليك أن تؤمن، لأنّ الإيمان يجعلك تراعي الإيقاع، عليك أن تشعر به في داخلك”.
ليس بعيدًا من هذه المفاهيم، يفتح الرقص منفذًا على ممارسات الإنسان في مشاريع بقاء ووجود ومصائر؛ فينتج تعبيرات راقصة أثناء خوضه الحروب، وفي خروجه للصيد… والمعارك الوهميّة التي تدور في بداية الاحتفالات الذبائحيّة بعامّةٍ، والرقصات الطقسيّة التي يتّخذ فيها التناظر الشكلي والمواجهة المستمرّة طابعًا صراعيًّا، تفسّر كلّها على أنّها محاكاة للأزمة الذبائحيّة. وفي العديد من الأقطار الأفريقيّة يتبدّى الرقص التعبير الوحيد عن الديانات الأفريقيّة؛ حتى لكأن يمكننا القول بأنّ في “البدء كان العنف”، وما الرقص سوى “العبور من لا تناهي الرّغبة إلى رغبة الّلامتناهي دخولًا في سرّ الحياة”!!
- الرّسم الدّائري: باتّجاه دوران عقارب الساعة أو بخلافه
ماذا لو اتّحدت الجماعة لتشكّل دائرة، في طوافها، تتناغم مع الطبيعة والكون؟
تحيلنا الدائرة، والرسم الدائري على الأرض، في الإنثروبولوجيا، إلى دلالات التسوير والحماية والتحريم، وكلّ تسوير تقديس. فالدائرة أمتن الأشكال الهندسيّة وأكثرها قوّة ومناعة. في هذا التشكيل بمعانيه تطالعنا رقصة المولويّة أو رقصة الدراويش، والدبكة، الرقصة الشعبيّة في بلاد المشرق واليونان.
غير أنّ الّلافت في الرقصتين، حيث روح الجماعة يسود، هو اتّجاه حركة الدوران في الأصل والتّأسيس. فالمولويّة رقصة صوفيّة أسّس لها ووضع قواعدها المتصوّف جلال الدّين الرّومي، واشتهرت بأداء الحركة الدّوّارة حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ؛ حيث يدخل الدراويش ويدورون عكس عقارب السّاعة ثلاث مرّات، برمزيّة دوران الآدميين “حول الذات وسرّ الذات ونور الذات”.
والرقم ثلاثة للدورات يشير إلى مراحل التقرّب إلى الله، وهي طريق العلم والمعرفة، وطريق الرؤيا، وطريق الوصال أو المشاهدة. أمّا اتّجاه الدوران عكس عقارب السّاعة، أي عكس الزمن الفيزيائي بالتعبير الأونطولوجي، فهو إشارة إلى تخلّص المتصوّفة وتحرّرهم من قيود الزمن، وولادتهم من جديد بعودتهم إلى مصدر انبعاثهم. يقول الرّومي:” إنّ الأرواح التي تكسر قيد حبس الطين والماء تكون سعيدة القلب، فتصبح راقصة في فضاءات عشق الحقّ لتكون كالبدر في تمامه”. إذن، هذا الرقص سبيل لتجاوز الذات الإنسانيّة في عبورها إلى المعشوق، وانخطافها في حالة الوجد.
إذا كان المتصوّفة يبتغون غيابًا عن الزمن في حضرة المعبود، ف”الدّبيكة” علاقتهم بالزمان والطبيعة وحركة دوران الفصول تبرز وثيقة الصّلة إذا ما تتبّعنا جذور الدبكة، لا سيّما الجبليّة اللبنانيّة منها التي تستبطن عناصر طقسيّة تعود إلى بقايا رقصات وثنيّة، لكنّها ممارسة فنّيّة ترجع إلى بيئة من التبادل البدائي لجماعات تمارس التّعاون الإنتاجي في ما بينها، مثل “العَونة” (أي التعاون والمساعدة ماديًا وفي العمل).
ففي المجتمع الرّيفي يتجلّى صراع الإنسان/ الفلّاح من أجل البقاء، صراعًا بين جماعة متماسكة والطبيعة. والدبكة تعبير عن هذا التماسك وبناء العصبيّة في إعادة إنتاج الجماعة؛ حيث يذوب الفرد في الكلّ. رقصة تتشكّل جسمًا جماعيًّا راقصًا واحدًا، يتّخذ طابع تحدّي الآخر في استعراض القوّة تارةً، وتحدّي الأرض تارة أخرى.
تتشارك معظم الدبكات بعدد من الحركات: الخطوات، ضربة الأرجل (اليسرى) على الأرض، القمز، التقدّم والتّراجع من خلال الحركة الدّائريّة التي تتمّ عادةً من اليسار إلى اليمين. هكذا، فإنها تنطوي على مجموعتين متناقضتين من الحركات: حركات الدوران والتكرار الأفقيّة، وحركات القمز وضرب الأرجل في الأرض العموديّة.
وهي في مجموعها تختزل دلالة الرقصة في علاقة الجماعة بالطبيعة، من خلال رمزية الحركات الدائريّة المنسجمة مع تعاقب الفصول والمواسم، ودلالة الحركات العموديّة التي تتحدّى الأرض، تدقّها كي تنفتح أبوابها وتعطي زرعًا وخصبًا، ويتفتّت صخرها ويهب ماءً.
فالجسد الفلّاحي وهو ينكش التراب، يتجسّد في الرقصة، بتقدّم رجل الفلاح اليسرى إلى الأمام ومشيته المتهادية يمنةً ويسرة، فضلًا عن ال”هاه” التي يطلقها مع كل ضربة معول تكون عونًا له على زيادة زخم الحركة، لتترجم صيحات صاخبة فرحة في الرقصة.
هكذا، إنّ التباين بين الاندماج في الطبيعة، والتمسّك بها والتماهي الحركي مع فصولها، بما يعود من خيراتها على الإنسان في خوفه من الجدب، كما في الدبكة، وبين رفض الواقع استعاريًّا، على قاعدة ترك كل شيء بغية امتلاكه بكلّيته، كما في الرقص الزهدي للدراويش. هو تباين ظاهري. أمّا في العمق فثمة غائيّة واحدة وغن اختلفت طرائق الجماعات في التعبير؛ هي حبّ البقاء والبحث عن الوجود ومعنى الوجود.
جميل أن نردّد مع زرادشت “مَنْ يُريد أن يَطير في يومٍ ما، عليه أن يتعلّم أولاً كيف يقف ويمشي ويركض ويتسلّق ويرقص. حتى أسوأ الأشياء لها قدمان للرقص. ليكن يومًا ضائعًا من حياتنا كل يوم لا نرقص فيه مرّة واحدة”. ففي الرّقص سرّ السّعادة والتّصالح مع العالم حين يصل الإنسان بخيباته وفجائعه حدّ الرّقص- الرقص وسط الخراب الجميل- كما فعل”زوربا” بطل الرّوائي نيكوس كازانتزاكي.
أن نرقص هو أن نندرج بكلّيتنا في حالة تنشدها الروح والنفس والجسد معًا، ولا شيء سوى هذه الحالة الانعتاقيّة. فلنُصلِّ رقصًا لنتحرّر ونتشفّف، غائبين عن المكان، في أبهى تجلٍّ لحضور الكينونة، في حركة من نور ولهب تتلاشى لتبقى ذكرى لوحة ترسم عوالم بعيدة، ولاانطفاء جذوة انتشاء بامتلاك تلك العوالم جميعها.