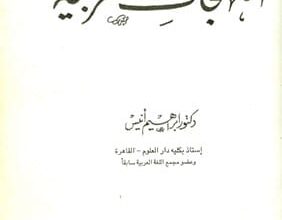اللغة العربية: من التراجع إلى التمكين

- مقدمة:
1 ـ نفترض، بدايةً، أن حاضر العربية، في الأحوال والمآل، ينتج من إدراك واقع العلاقة التبادلية بين مستويات اللغة والمجتمع؛ فقد وقر في نفوس الكثيرين أن اللغة هي مرآة تنعكس عليها صورة المجتمع العربي، بتفككه السياسي، وتعدد أنظمته الراهنة، وتعدد مستوياته الاقتصادية، إضافة إلى حلم الكثيرين أو رهانهم على غدٍ أفضل.
2 ـ ثم، إنّ ما يجبه العربية من تحديات وصعوبات، داخلية وخارجية، يؤكد أن اللغة بواقعها المأزوم، فعل اجتماعي، تمثّل بالازدواجية، والثنائية، وغياب إنتاج اللغة العلمية، ولا سيّما التقانية منها … أقول: كل ذلك يشهد، بلا مراء، على واقع اجتماعي عربي يعاني التجزئة والانقسامات الإثنية والطائفية والمذهبية، إضافة إلى الإدمان على التبعية، بوجوهها كافة، وفي مقدمتها التبعية المعرفية للغرب.
3 ـ ولكنْ، بقدر ما تبعث قتامة الصورة على القلق الكبير، نتطلع، في المقابل إلى نجاعة تلك المقوّمات الذاتية التي تتّسم بها العربية، وما فيها من روح نابضة بالصيرورة. وننظر، أيضاً، بأمل كبير إلى جهود الكثير من الأفراد والمؤسسات، الرامية إلى إقالة اللغة من عثارها، ودفع قوى المجتمع باتجاه النهوض الحضاري.
4 ـ في هذه الورقة البحثية، نجيب عن سؤالين رئيسيين، هما:
ـ ما هي عوامل تراجع استخدام اللغة العربية؟
ـ ما هي أوجه التمكين والتفاضل؟
- أولاً: قراءة في ثلاثة عوامل مُقْلِقة
- العامل الأول: التباين في السلطتين التاريخية واللغوية
أ ـ قُدِّر للغة العربية أن تشهد مرحلة فريدة الحصول، زماناً ومكاناً؛ إذ احتضن المكان في الجزيرة العربية، وتحديداً قريش (مكة المكرمة) زمان نزول القرآن الكريم، ببيان عربي مُعْجِز، فاندفعت اللغة في صيرورة فاعلة، على مدى أربعة قرون من التشريع اللغوي، وإرساء الأصول والأحكام، والتألّق في الاجتهاد. أمّا العربية في حاضرها، فقد قُدِّر لها أن تبقى الرابط بين الكثير من الشعوب والجماعات المأزومة، في كثير من الدول أو الكيانات. لكن هذا الحضور بدا مُرْبَكاً بغياب السلطة التاريخية.
ب ـ وقُدِّر للعربية، أيضاً، في مرحلة التقعيد اللغوي ووضع الأحكام، ظهور علماء أرسوا قواعد اللغة، ومكّنوا أصولها في الجزيرة والأمصار، على مساحة جغرافية شاسعة، امتدت من الصين إلى الأندلس؛ فكانت تلك السلطة اللغوية بأجهزتها الاجتماعية ذات نفوذ، تمارس من خلاله صلاحياتها على مستوى علومها كافة.
ونحن، لو قارنا سلطة طبقات اللغويين في العصور السابقة بسلطة علمائنا في المجامع اللغوية، وما تعيشه هذه المؤسسات من تهميش وعزلة، وضعف في السلطة … لهالنا الفارق بين سلطتي القيادتين، دوراً ونفوذاً.
ومن الطبيعي أن يعكس ذلك التباين الحاصل، عبر المقارنة، في كلتا السلطتين: التاريخية واللغوية، خللاً في شرعية صلاحية النظام اللغوي الذي نعيش. ولعلّ غياب إلزامية تطبيق الأحكام الدستورية الخاصة بالعربية، والتساهل إلى حدّ التراخي، والتغاضي المريب، عمّا يُحدثه انتشار الأجنبية من إزاحة للغة الوطنية «الرسمية» شكلاً، أقول …
ذلك كلّه، بات يشكّل أزمة قائمة، تمتد جذورها إلى مسألة الاستخفاف بمسألة الهوية، واعتبارها قضية إشكالية مزعجة، لا تتوافق وحال الانبهار باقتصاد السوق، ومصالح الاستثمار والمضاربة في البورصات العالمية.
- العامل الثاني: غياب المجتمع العلمي، وضآلة إنتاج البحث المعرفي باللغة العربية
أ ـ على الرغم من توفّر القدرات العلمية لدى الباحثين العرب، وما يمتلكه المجتمع العربي من موارد طبيعية غنية، ورأس مال بشري هائل … يبقى، مع ذلك، «البحث المعرفي»، ولا سيّما التقاني منه، ضئيل المحصول، إلى حدّ الافتقار إلى أساسيات ما نحتاج إليه.
والمفارقة المؤلمة في هذا الصدد تتمثل بمحدودية مراكز البحث العلمي المنتج؛ فنحن لا نمتلك مركزاً بحثياً واحداً على المستوى الأكاديمي العالمي، كما أننا لا نملك مؤشراً يلحظ إمكانية إنشاء هيكلية مؤسسية قادرة على الاستفادة من الموارد البشرية المتمثلة بعدد الخريجين الجامعيين، أو أنها قادرة على استثمار مليارات الدولارات التي تُنفقها البلدان العربية في التعليم العالي[1].
ما تجب الإشارة إليه، هنا، أننا حين نتحدث عن المجتمع العلمي المنشود، لا نعني بذلك عدد العلماء الباحثين المتوفر لدينا في البلدان العربية، فهذا العدد هو «تجمّع عددي مشتّت» لا يملك مقوّمات التكوين المؤسسي للبحث العلمي؛ فـ «المجتمع العلمي يكون موجوداً عندما توجد تقاليد وطنية في البحث العلمي تمهد لوجود هذا المجتمع العلمي، وتقدِّم له الخصائص التي تميّزه.
وإذا انعدمت التقاليد الوطنية في البحوث، لا يبقى سوى كمية من المعلّمين وتجمّع من التقنيين ذوي تكوين متساوٍ في تنافره، وفي عدم تجانسه»[2].
ب ـ من جهة ثانية، تشكّل الترجمة «الاستهلاكية»، أو لنقل «البكماء»، المتراكمة، في ما يصدر عن بعض المؤسسات ودور النشر العربية، كمّاً، على حساب البحث، ظاهرة سلبية، من الوجهة الثقافية الوطنية؛ ففي العصر الذهبي للحضارة العربية، لم يكن الهدف من ترجمة النصوص كتابة الفكر المعرفي، أو الاطّلاع على هذه النصوص وحسب، بل كانت الترجمة، لكتب مختارة، تسهم في وضع النصوص العربية الضرورية لتكوين الباحثين، أو لمتابعة البحث.
«فترجمة كتب أرشميدس كان لها أن تسمح بالدراسات الخاصة بقياس المساحات والأحجام، ولكنها لم تكن تهدف إلى الإسهام في كتابة تاريخ هذا الفصل أو إلى شرح نص أرشميدس مثلاً، ثم يقترن هذا «التوظيف العلمي» بالإنتاج الاجتهادي لمضمون النص المترجَم، والتوسّع في شرحه، ووضع ما يحتاج إليه من مصطلحات، ترتكز على توليد الألفاظ، وفق معايير ومقاييس وأوزان اللغة العربية.
لذا جاز أن نطلق على هذا الصنيع الاجتهادي «الترجمة التكوينية»؛ أي أنها ترجمة يقوم بها علماء مهتمون بالمعنى، وأن الأولويات المتّبعة ضمنياً في اختيار الكتب للترجمة، وفي تسلسل الترجمات، لا تأخذ معناها إلا إذا أخذنا في الحسبان نشاطات البحث في زمانها.
ج ـ ثم، إن ما يفتقر إليه «التجمّع» البحثي في البلدان العربية، هو غياب «التشبيك» بين الباحثين العلميين والجامعات ومؤسسات الأعمال. ولا يُخفى أن هذه الجهات الثلاث هي مركزية في كل مراحل التنمية، ولا سيّما التنمية العلمية المنتجة باللغة العربية.
وبالتالي، فإن هذا التشبيك، إن لم يكن على صلة وثيقة بالاقتصاد السياسي الوطني، وينطلق من مخطط أو سياسة علمية ـ لغوية، مركزية، فإنه سرعان ما يتعثر، وتذهب الجهود والأموال، وكذلك الوقت، هدراً.
ونحن نجد صدى هذا الشغور، أو غياب العمل المنهجي، في استطلاع رأي، حديث العهد[3]، إذ سجّلت نتائج الشكوى من غياب الاهتمام بإرساء تقاليد وطنية في التقدم المعرفي، باللغة العربية، على صعيد إنشاء، أو دعم مؤسسات تُعنى بالبحث العلمي، 53 بالمئة[4] (من عدد المستطلَع رأيهم) (***)، وبلغت الشكوى، من عدم إنشاء مركز للبحث في تاريخ العلوم، وبخاصة في التراث العلمي العربي، 74 بالمئة.
وسجلت شكوى غياب أيِّ اهتمام بإنشاء أو دعم مكتبة علمية عربية خاصة، نسبة عالية جداً بلغت 96 بالمئة، وما يماثلها تقريباً، الشكوى من غياب إنشاء أو دعم مكتبة علمية عربية، خاصة أو عامة بلغت 91 بالمئة. وقد انعكس هذا الأمر سلباً على نتائج ما يراه الباحثون من تقدم معرفي وإنتاج بحثي لتوظيف العلم، في بلدانهم، باللغة العربية.
فقد تدنّت نسبة الذين رأوا أن مستوى هذا التقدم جيد جداً إلى 1,4 بالمئة، و11 بالمئة جيد، ووسط 38,6 بالمئة؛ وهي نِسَب مقلقة عموماً[5]. ورأى 11,4 بالمئة فقط، أن الجهد يقوم على استراتيجية وتخطيط علميين. أمّا على صعيد الحاجة إلى تعاون مشترك بين البلدان العربية، فسجّل الاستطلاع نسبة عالية بلغت 84 بالمئة[6].
- العامل الثالث: خلل في الثنائية اللغوية الوطنية ـ الأجنبية
أ ـ تقضي طبيعة التثاقف الحضاري، بين الأمم، أن يفيد المجتمع النامي من معارف المجتمعات المتقدمة، ولا سيّما علوم التقانة الحديثة. من هذا المنظور الثقافي بدا المشهد اللغوي في المجتمع العربي (على مختلف بلدانه) متعدداً، وبلغ التأثر بالمرجعيات الفكرية الغربية مرحلة متقدمة، يمكن أن نحسبها مرحلة تكوينية، في حقول المعرفة كافة.
وقد يكون من المألوف، ومن قبيل إغناء اللغة الوطنية (اللغة الأم) أن يلسن أبناء الوطن بلغة ثانية؛ إذ ذاك تقترض اللغة الوطنية (الأم) من اللغة الأجنبية (لغة واحدة أو أكثر) ما هي بحاجة إليه من مفردات ومصطلحات ونصوص، وحتى نظريات ومناهج.
لكنْ، ما بدا ظاهرة مقلقة في المجتمع العربي، هو هذا التوسّع في استخدام اللغة الأجنبية، والاعتماد شبه الكلّي عليها، في عدد من القطاعات الرسمية والأهلية، ولا سيّما اللغة الإنكليزية، في البلدان العربية التي كانت مستعمرة من الإنكليز، واللغة الفرنسية، في البلدان التي عرفت الاستعمار الفرنسي.
ب ـ ويتجه الحديث، هنا مباشرة، إلى الشكوى من غياب نظام تعليم للغة العربية، ولا سيّما مواد العلوم والرياضيات. وتشمل هذه الظاهرة مراحل التعليم كافة، وبخاصة التعليم العالي، فقد أزاحت اللغة الأجنبية لغتنا الوطنية، بشكل شبه تام، عن تأدية دورها الحيوي في التكوين الفكري، وغدت اللغة الأجنبية عامل جذب مهم للطلبة.
ففي استطلاع الرأي، المشار إليه سابقاً، وردت جملة أرقام مقلقة، عن واقع التعليم الجامعي باللغة الأجنبية، فتعلّم المصطلح، مثلاً، وهو الركن الأساسي في النص العلمي، بلغ 78 بالمئة باللغة الإنكليزية في بلدان المشرق العربي، و88 بالمئة باللغة الفرنسية في بلدان المغرب العربي، مقابل 9 بالمئة باللغة العربية.
وينسحب هذا الواقع المقلق على لغة الامتحانات والأبحاث؛ فاللغة العربية لم تنل إلا 14 بالمئة، مقابل 76 بالمئة للإنكليزية، و87 بالمئة للفرنسية.
ولعلّ مفاعيل هذه الإزاحة للعربية عن مكانتها التعليمية، على مدى سنوات طويلة، أفرز واقعاً سلبياً، جعل 13 بالمئة فقط يؤيدون، حالياً، مبدأ تعلّم العلوم والرياضيات وسائر الاختصاصات التطبيقية باللغة العربية[7].
والجدير ذكره في تحليل هذه الظاهرة؛ أي التدريس بلغة أجنبية، ولا سيّما مواد العلوم والرياضيات، أنها لم تعد إرثاً استعمارياً مفروضاً على الحكومات والشعوب العربية، بل غدت نتيجة أحد أمرين، أو كليهما معاً؛ فهي أحد عوامل الجذب المهمة للطلبة وأولياء أمورهم، وهو جذب تبرّره التغييرات التي ميزت سوق العمل التي تجعل من اللغة الأجنبية، وأحياناً كثيرة جامعات بعينها، شرطاً للالتحاق بأهم الوظائف وأعلاها عائداً.
وهي نتيجة سيادة العولمة والريادة الأمريكية في مجال تقانة المعلومات والاتصالات، تلك التي جعلت من الإنكليزية لغة أسواق العمل العالمية، ولغة المؤسسات والشركات عابرة القارات، ولغة التواصل والاتصالات على مستوى العالم.
ثم، إن التوسّع بمدارس مراحل التعليم ما قبل الجامعي، التي تعتمد التدريس بلغات أجنبية، إضافة إلى المدارس الدولية التي تتبنّى بالكامل منهاجاً أجنبياً، كان خطوة مسبقة لكي تتوفر المُدْخَلاَت المناسبة من أعداد الطلبة لمؤسسات التعليم العالي التي تأخذ في مبدأ التدريس باللغات الأجنبية[8].
ويطيب للبعض أن يردّد مقولة خاطئة، مفادها أن تعليم مواد العلوم والرياضيات باللغة العربية، يدفع بالخريجين إلى البطالة، فهم لا يستطيعون العمل مع مؤسسات كبيرة تعتمد اللغة الأجنبية في إدارتها واتصالاتها ومراحل تنفيذ خططها.
وهذا أمر يعود بنا إلى استراتيجيات سوق العمل، والسياسات الاقتصادية التي تتبناها البلدان العربية في خططها ومشاريعها التنموية. وإذا أمعنّا في رصد هذه الظاهرة، تجلّى لنا سريعاً أن مثل هذه الدعوى تعني أن النظام التربوي في مفهومه السيادي هو غير فاعل، وبالتالي هو منحاز إلى عامل يهدد مقومات الهوية والانتماء.
وقد حذّرت إحدى الدراسات التي أُجريت مؤخراً من خطورة الاتجاه المتزايد نحو التعليم بلغات أجنبية، مع ما ينطوي عليه ذلك من فقدان الانتماء إلى الوطن، ومن هجرة العقول، ومن اغتراب فكري وسلوكي لأبناء الوطن. وتوصي هذه الدراسة بأن تدرِّس كلّ أمّة أبناءها العلم بلغتها، وذلك إذا رغبت في المساهمة بظهور علماء واتساع فرص الإبداع العلمي[9].
وحول تفسير هذه الظاهرة، وبيان أسبابها، نوجز نتائج استطلاع الرأي (المشار إليه سابقاً) في المجامع اللغوية ومراكز البحث الأكاديمي. فقد سجلت خمسة أمور سلبية يعانيها نظام تعليم اللغة العربية، في بلدان المستطلَعين؛ كان الأمر الأول والأبرز هو ضعف مستوى معظم معلّمي اللغة العربية وآدابها (هذا برأي 74 بالمئة)؛ الأمر الثاني،
هو غلبة اهتمام المتعلمين باللغة الأجنبية على حساب اللغة العربية (هذا برأي 70 بالمئة)؛ الأمر الثالث، هو عدم تحفيز المتعلمين وأسرهم للاهتمام باللغة العربية (هذا برأي 63 بالمئة)؛ الأمر الرابع، هو عدم ربط سياسة تعليم اللغة العربية وآدابها بسياسات باقي مواد التعليم (هذا برأي 60 بالمئة)؛ الأمر الخامس، هو غياب التجديد المستمر لبرامج اللغة العربية، بحيث تكون مواكبة لمتطلبات العصر (هذا برأي 56 بالمئة)[10].
ج ـ يضاف إلى ما تقدم ظاهرة «تَطْعيم» اللغة العربية باللغة الأجنبية، في مستوى من مستويات الثنائية اللغوية. وهي ظاهرة لغوية، كثيراً ما نسمعها في التواصل اليومي، ووسائل الإعلام، حيث تُدْرَج مفردات، أو عبارات، أو مصطلحات، أو مفاهيم وأفكار، أجنبية في سياق الحديث بالعربية، بدعوى الضرورة الفنية التقنية، أو «التفرنج»، أو تحت عناوين شتى.
كما بدا التراجع التدريجي للغة العربية في النصّ الإعلامي المقروء، والنشرة التلفزيونية (الأخبار، التعليق، الحوار في المقابلات … إلخ). والمسألة هنا مردّها، غالباً، إلى ضعف قدرة وكفاءة الإعلاميين ووسائلهم على الوصول إلى المتلقّي، بالمستوى المطلوب من الكفاية.
نخلص في محصّلة هذا المبحث إلى أن خللاً في التكيّف اللغوي يصيب العربية، في حاضرها، من جرّاء تضييق الاستخدام اللغوي لها، من قبل أبنائها المتكلمين بها، وبسببٍ من تخلّفهم في مواكبة التقدم الحضاري. فـ «اللغة (على حدّ العبارة المشهورة لإبراهيم اليازجي (1847 ـ 1906)) بأهلها تشبّ بشبابهم، وتهرم بهرمهم، وإنما هي عبارة عمّا يتداولونه بينهم، لا تعدو ألسنتهم ما في خواطرهم، ولا تمثّل ألفاظهم إلا صور ما في أذهانهم (…)».
لذلك، فإن كان ثمّة هرمٌ، فإنما هو في الأمة لا في اللغة، لأن ما عرض لها من الهجر والإهمال غير لاصق بها، ولا يلحق بها وهناً ولا عجزاً، وإنما هو عجزٌ في ألسنة الأمة ومداركها، وتأخّرٌ في أحوالها واستعدادها. ولو صادفت من أهلها البقاء على عهد أسلافهم من السعي في سُبُل الحضارة وتوسيع نطاق العلم، لم تقصِّر عن مشايعتهم في كلّ ما فاتهم من الأطوار حتى تبلغ بهم إلى مجاراة العصر الحالي»[11].
- ثانياً: صور استشراف
المستقبل اللغوي العربي
من الصعب الحديث عن إغناء لغتنا بوسائل تمكينية، تُقيلها من عثارها الاجتماعي، بمعزلٍ عن بحث العلاقة بين العربية والهوية المميزة لأبنائها. فاللغة إضافة إلى كونها رموزاً، وألفاظاً، وأساليب تعبير …، هي في جوهرها الحياتي منطق وبناء فكري، وإحساس وشعور بالانتماء إلى الأمة.
وهذا يستوجب اعتبار اللغة مقوّماً أساسياً، أو قُل حيوياً في تكوين الوحدة الثقافية، وهو أمر يتطلب، بداهةً، إعلاء شأن الاهتمام المؤسسي والفردي بالعربية، وكذلك تمثلها بمُخْرَجات التماسك اللغوي: التشريعي والتربوي والإعلامي.
ونعرض، في ما يلي، ثلاث نقاط بحثية تسهم في نقاش مسألة تنمية العربية، وتندرج تالياً في مشهد استشراف مستقبلنا اللغوي.
- 1 ـ تحقيق مبدأ التمكين اللغوي
أ ـ يرمي مبدأ التمكين في شقه الأول إلى تحقيق المزاوجة بين الواقع الدستوري لما هي عليه اللغة العربية، نصّاً، في معظم الدساتير العربية[12]، وقوة التطبيق، أو ترجمة مفاعيل النص الدستوري. فعلى الرغم من إقرار معظم الأقطار العربية بأن العربية هي اللغة الرسمية، واللغة «الأم»، يبقى خرق هذا الإقرار،
وذاك الإلزام، أمراً يمكن رده إلى أسباب عارضة، من الممكن ومن المتوقع تجاوزها، كما في لبنان والجزائر، أو إلى أسباب ديمغرافية، تتعلق بطبيعة التركيب السكاني، كما في موريتانيا والعراق والسودان. أما بالنسبة إلى الصومال التي أخذت مجدداً تكتب لغتها بأحرف لاتينية، فإن الأمر يثير مزيداً من الصعوبة.
وقد شكّلت هذه الخروقات، ولا سيّما في التعليم، كما أشرنا سابقاً، خللاً في التوازن اللغوي الذي سرعان ما تنامى إيجاباً، عبر عقود، لمصلحة اللغة الأجنبية، وهو ما جعل النظرة إلى الثنائية اللغوية الوطنية ـ الأجنبية، سلبيةً في المفهوم الثقافي العام، إضافة إلى القلق البالغ الذي يساور المثقفين الوطنيين من جرّاء ما ينتج من إزاحة اللغة العربية «الأم» الممهورة برمزية الهوية والانتماء.
ومن المؤسف أن يفرز هذا الواقع، ردّ فعلٍ غير ثقافي يتمثل بعدم الاهتمام بتعلم لغات أجنبية وإتقانها، أو يأخذ تحليل الظاهرة منهجاً غير علمي عند بعض الباحثين، إذ تغدو النزعة القومية، متعصبةً، وبالتالي تطمس الغَيْرة على العربية معالم القضية في اندفاع حماسي، لا يثمر حلاً، ولا يقدم وسيلة علاجية ناجعة.
لذا، علينا أن ندرك الفرق الواضح بين ضرورة، وحتى وجوب، تعلّم اللغة الأجنبية وإتقانها والقدرة على استخدامها في التواصل العالمي العلمي والثقافي، والاطلاع على المراجع والمصادر، والاستفادة من شبكات المعلومات العالمية، وبين الانصهار الكامل في هذه اللغة الأجنبية، أو اعتبارها لغة التعليم الرئيسية، وتدنّي مكانة اللغة «الأم» واعتبارها ثانوية، أو لغة للمحادثة المنزلية، من دون الحوارات العلمية.
وأيّاً كانت التوصيات، في هذا السياق، وهي كثيرة جداً، فإن جوهر الحل يكمن في معالجة الفراغ الذي تعانيه «السلطة» اللغوية، وفشل «المزاوجة»، حتى الآن، بين النص الدستوري والتطبيق. وأول خطوة تصحيحية هنا، جعل النصّ الدستوري، أو القانون اللغوي، على المستوى الوطني جزءاً من تطبيقات السياسة اللغوية، أي أن اللغة العربية نظام مجتمعي، وأن قانونها، أو ميثاقها له هدف مجتمعي أيضاً.
ولنا في هذا نماذج كثيرة في العالم المتمدن، ولعل المنظومة الفرنكوفونية، والاهتمام الفرنسي بالشأن اللغوي، خير دليل ينفع الباحث في إقامة المحاكاة بين واقعين لغويين: العربية والفرنسية. وما يهمنا في هذه المقارنة، فضلاً عن الدستور الفرنسي، وقانون عام 1994 الخاص بحماية اللغة الفرنسية، الإشارة إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية والاجتهادية ذات العلاقة بالتطبيق.
فالمرسوم 89 ـ 403 تاريخ 2/6/1989 قضى بإنشاء المجلس الأعلى للغة الفرنسية والمفوضية العامة للسهر على توسيع دائرة استعمال اللغة الفرنسية (المادة 9)؛ والمرسوم الرقم 95 ـ 240 تاريخ 3/3/1995 يتعلق بكيفية تطبيق قانون عام 1994، ويتضمن بصورة خاصة تفصيلاً للعقوبات (أو الغرامات) التي تنزل بمخالفي القانون.
واللغة العربية بحاجة إلى قانون مماثل للقانون الفرنسي الخاص بحماية اللغة الفرنسية (قانون 4/8/1994)، ينظّم استعمال اللغة العربية في حقول التواصل والعمل والتعليم والإعلام المرئي.
ونسوق، في هذا الصدد، نموذجين من دولتين عربيتين، جاء فيهما قَرْن النص الدستوري بالتطبيق، لكن الحلقة المفقودة في هذين النموذجين هي إحياء مفاعيل ما جاء في النصوص من مواد مفيدة في العمل الإجرائي.
ـ النموذج الأول (من الجزائر): وهو متمثل بالقانون الرقم 91 ـ 5 تاريخ 16/1/1991 حول تعميم استعمال اللغة العربية (عُدِّل بتاريخ 21/12/1996)، ووضع هذا القانون موضع التنفيذ في عام 1998، وكان قد انطوى على خمسة فصول[13]، تتناول مختلف شؤون الإدارة والتعليم والإعلام، الرسمي منها والخاص.
وتابعت الجزائر رعايتها للغة الضاد، فأصدرت في عام 1998 مرسوماً رئاسياً يتمّم القانون الصادر في العام نفسه، ويتضمن صلاحيات «المجلس الأعلى للغة العربية»، وعلى هذا الأساس نهض المجلس بمهامه التي تشبه مهام «الهيئة العليا للعناية باللغة العربية» في العراق[14].
ـ النموذج الثاني (من العراق): وهو متمثل بالقانون الصادر في عام 1977، والخاص بالحفاظ على سلامة اللغة العربية. وحدَّدت مواده ما يستوجب العمل، إذ تضمَّنت مواده التشديد الملزم (مع لحظ التغريم) بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، واعتمادها في الوثائق الوزارية كافة، وفي معاملاتها، وسريان ذلك على مناهج التربية والتعليم،
وكذلك مؤسسات النشر والإعلام كافة. وقد فرض هذا القانون عقوبة على من يخالف مواده من موظفي الدولة بخاصة، والمواطنين بعامة[15]. وأُتبع قانون عام 1977، بقانون 1983 الخاص بـ «الهيئة العليا للعناية باللغة العربية»، لتكون هذه الهيئة مسؤولة عن متابعة تنفيذ القانون، كما تتولى الرقابة والإشراف على تنفيذ «قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية»،
واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون اللغة العربية، إضافة إلى وضع تقرير سنوي، يُرفع إلى رئاسة الدولة، عن نتائج تطبيق التشريعات المتعلقة بشؤون اللغة العربية[16].
ب ـ ويرمي مبدأ التمكين اللغوي في شقه الثاني إلى استنبات وعي لغوي في نسيج بنى ومؤسسات وفعاليات «المجتمع الأهلي» يتشكّل تدريجاً، في صورة رأي عام، يتبنّى قضية حماية اللغة العربية، وينشط في «تطبيعها» وجعلها تواكب الأنشطة الحياتية كافة. ويقترن هذا الوعي بـ «خارطة طريق» تتعلق بمشروع تحديث الفكر اللغوي، لتجاوز إشكالية العلاقة المأزومة بين استخدام اللغة والمجتمع.
هذا المفهوم للوعي اللغوي، في إطاره الاجتماعي، يبقى نجاحه مرهوناً بقدر ما ينطوي على: (1) «الطوعية» باعتبارها مؤشراً رئيسياً في تكوين التشكيلات الاجتماعية؛ و(2) «فكرة المؤسسية» باعتبارها نسقاً وسيطاً يجمع العلاقة الاجتماعية بالعلاقة السياسية؛ و(3) من الضروري أن تتسم العلاقة الجامعة بين مؤسسات حماية اللغة في طابعها الأهلي، ومؤسسات الدولة، بالتنسيق والمرونة والتكيّف والتجانس.
ج ـ ولعل أكثر أشكال الغرس فائدة، لاستنبات الوعي اللغوي، في قطاعات الرأي العام العربي، العمل الدؤوب على تنشيط مهارات التواصل باللغة الأم، في المناخ التعلّمي، من خلال غرسها في عقول الطلبة في المراحل الدراسية كافة، ولا سيّما المراحل التكوينية الأولى. وجلّ ما يتطلبه الأمر في هذا المجال الحيوي معلّمون متمكّنون من لغتهم الوطنية وذوو دراية بطرائق التدريس الحديثة، وذوو ثقافة في اختصاصهم، لتسهيل غرس هذه المهارات في أذهان طلبتهم.
وربّ امرئٍ، في هذا السياق، يكون مقتنعاً بأن جودة التعليم في اختصاصات العلوم الإنسانية، وتحديداً اختصاص اللغة العربية، هي قليلة الأهمية، في حين أن رجل الشارع يدرك أن رداءة نوعية المهندس يمكن أن تسبّب انهيار البناء، وأن طبيباً غير كفوء قد يتسبب في زيادة كبيرة في نسبة الوفيات. لكن قلّة يدركون أن تعليماً رديئاً للغة والثقافة الوطنية يمكن أن يكون له من التداعيات السيئة أكثر من انهيار بنايات، ومن خدمات طبية متدنية[17].
ونتوسع في هذه الحالة التربوية لنؤكد أن خميرة الفساد التي تتنامى في حياتنا اللغوية، موطنها الأساسي ارتباك النظام التعلّمي، وتحديداً هشاشة التعليم في المرحلة الابتدائية. فالتدريس في المدرسة الابتدائية هو أساساً تدريس اللغات والتفكير المنطقي الأساسي.
ومن البديهي أن اللغة هي أهم أداة للتفكير المنطقي، فالشخص الذي لا يمتلك ناصية اللغة، لا يمكنه أن يتعلّم أي موضوع بشكل مناسب. ونجد أن خريجي الجامعات الذين يقومون بالتدريس في المدارس الابتدائية يتخرجون عادة في فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهم بسبب الحصول على وظيفة ما، وإن كانت متدنية الدخل، يُقبلون على هذه «المهنة»،
وهذا يعني، في المحصلة التربوية ـ الاقتصادية، وجود صفوف دراسية ذات حجم كبير، وذات مستوى تواصل لغوي ـ ثقافي محدود، وهذا يعني أن السياسة التربوية الوطنية، والإعداد اللغوي، في التعليم التكويني يقصران عن تقديم الحد الأدنى المطلوب لضمان حصول الأطفال على أفضل إعداد معرفي للمستقبل.
لذا، لا يمكن ضمان تحسين نوعية تدريس العلم والتقانة إلا من خلال امتلاك أفضل للغة العربية وأساسيات المعرفة في المدارس الابتدائية والثانوية. ويمكن تحقيق هذا الهدف، ببساطة شديدة، عن طريق تحسين تدريس العلوم الإنسانية في الجامعات العربية[18]، وإقامة الدورات التدريبية، في مدة كافية، لا تقل عن شهرين، في كل سنة، وجعلها شرطاً، في حال تحقيق كفايتها، في الترفّع واكتساب الدرجة.