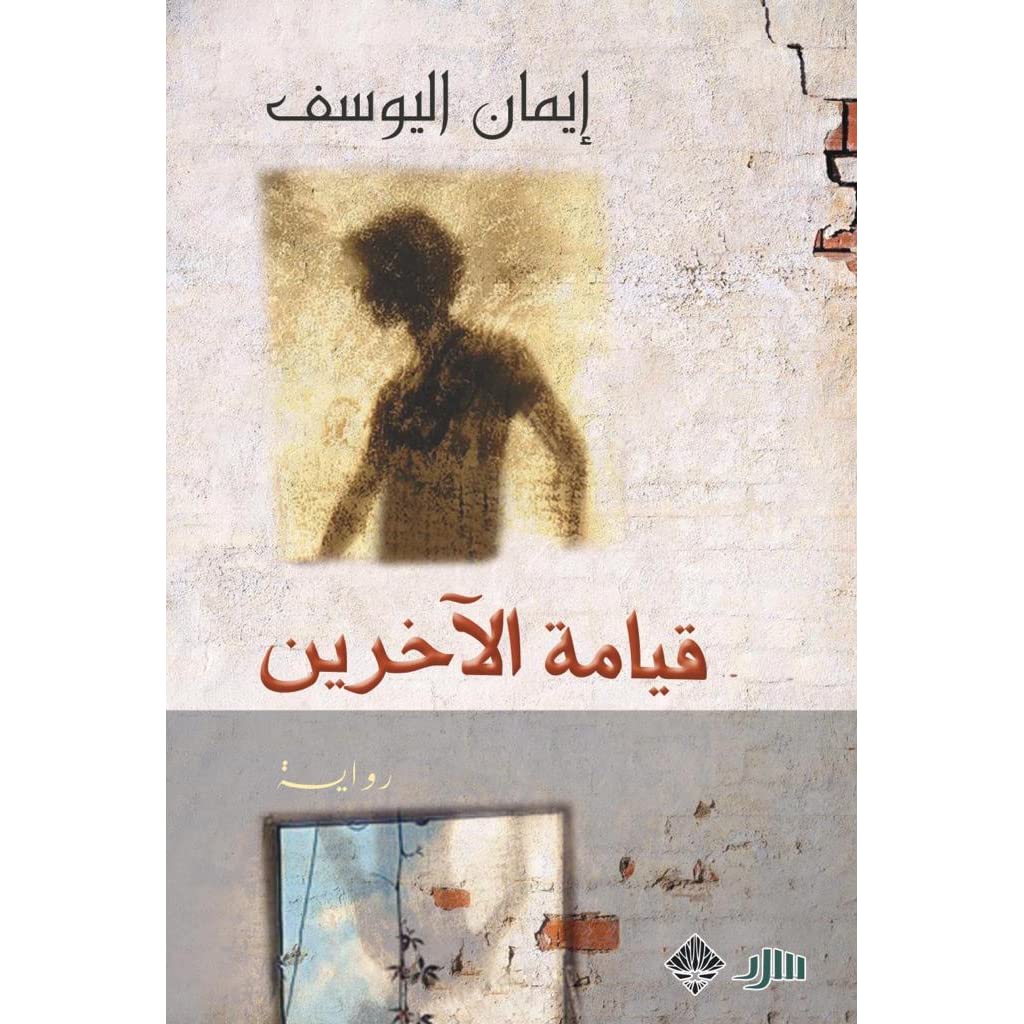بحثًا عن المعنى الضائع

يُذكِّر عنواني هذا بعنوان الروائي الفرنسي مارسيل پروست، بحثا عن الزمن الضائع، الذي هو في آن بحث عن مكان ضائع، مكان ولّى وفات، بلدةِ كُومبراي Combray بالنسبة لراوي بروست، مهد طفولته. يتعلق الأمر في نهاية المطاف ببحث عن المنزل الأول، المنزل الأول كما عبر عنه الشاعر أبو تمام في بيت مشهور، وكما تطرق إليه عبد القاهر الجرجاني في حديثه عما يسميه «العلم الأول»، الذي يأتي النفس، كما يقول، «من طريق الحواس والطباع»، معتبرا إياه أساس التخييل والإبداع الشعري. كتابة الشعر وقراءته استئناف للعلاقة مع العلم الأول.
في كتابه خواطر، يقول بليز پاسكال: «ما تبحثُ عنه قد وجدتَه من قبل». إذا صدق هذا القول فإن المعرفة سابقة للبحث الذي نقوم به بغية إدراكها. المفارقة في هذه الحالة أننا نبحث بجهد وعناء عن شيء هو في قبضتنا، نبحث عما هو موجود لدينا، كالذي يبحث في حالة ذعر واضطراب عن مفتاح بيته بينما هو يمسك به في يده.
قريبا من هذا ما ورد في يوميات فرانتس كافكا: «في أغلب الأحيان، من نبحث عنه بعيدا، يقطن قربنا». أذهلني هذا القول الغريب إلى حد أنني جعلت منه عنوانا لكتيِّب صدر لي مؤخرا. وهو قول من العمق والغموض بحيث يمكن تأويله إلى ما لا نهاية. من نبحث عنه قريب منا، إنه جارنا. وفي سعي إلى تفسير هذه الظاهرة الغريبة، كتب كافكا: «يعود ذلك لكوننا لا نعرف شيئا عن هذا الجار المبحوث عنه». قول يمكن أن نفهمه، لكن الأمر يزيد تعقيدا حين يضيف مؤلف المسخ: «وبالفعل، فإننا لا نعلم أننا نبحث عنه، ولا كونَه يقطن قربنا، وفي هذه الحالة، يمكننا أن نكون على أتم اليقين أنّه يقطن قربنا».
في هذا الكلام تناقض واضح، لا شك أنه مقصود، فمن جهة لا نعلم أننا نبحث عن الجار ولا نعلم أنه يقطن قربنا، ومن جهة أخرى وبالضبط بسبب جهلنا، نحن على يقين أنه يقطن قربنا. لنلاحظ مع ذلك أن كافكا لا يعمم إذ يعلن أن ذلك يحدث «في أغلب الأحيان»، أي أن هناك استثناءات لهذه القاعدة. ترى متى يكون ذلك؟
حاولت أن أستدل على ما جاء في يوميات كافكا في كتيبي المشار إليه بحكاية موجزة نجدها في ألف ليلة وليلة، تعرفونها جميعا، تتحدث عن رجل من بغداد رأى في المنام أن كنزا خاصا به موجود في القاهرة، ذهب إلى القاهرة فلم يجد شيئا، لكنه علم هناك بالصدفة أن الكنز الموعود مدفون في بيته ببغداد، وسيعثر عليه بالفعل عند عودته. كان لا بد أن يذهب بعيدا لكي يكتشف ما هو موجود في بيته. لولا ابتعاده عن المنزل وتنقله في البلاد، لولا التيه لما اكتشف الكنز. إنه، بتعبير آخر، بعيد من القريب، قريب من البعيد.
اشتغل بورخيس على هذه الحكاية في قصة له عنوانها «الحالمان» (1934)، أعاد فيها كتابة الحكاية أو قام بترجمتها بتصرف، بمعنى أنه مططها وأدخل عدة تعديلات عليها. ومن الراجح أنها راودته وخطرت بباله أيضا حين كان يعد قصته الشهيرة «بحث ابن رشد» المنشورة في كتاب الألِف (1947). والملاحظ أن عنوانها بالعربية لا يشي تماما بالمقصود في الأصل الإسباني La busca de Averroes، وفي الصيغة الإنجليزية Averroes Search، حيث يعني في الوقت ذاته البحثَ عن ابن رشد، والبحثَ الذي يقوم به ابن رشد لمحاولة فهم كلمتين يونانيتين. لهذا يجد المترجم العربي نفسه ملزما بالحسم بين صيغتين اثنتين للعنوان: إما يختار «البحث عن ابن رشد»، أو «بحث ابن رشد». لا أرى شخصيا إمكانية للجمع بين الصيغتين في تعبير واحد.
على أي فالقصة من أروع ما ألف بورخيس وتكشف عن معرفته الدقيقة بالأدب العربي الذي اطلع عليه في ترجمات مختلفة وظل مخلصا له طيلة حياته، بحيث يمكن اعتباره إلى حد ما نقطة وصل بين الأدب العربي والأدب الغربي. ويمكن القول إن ذلك كان إلى حد ما شأنَ ابنِ رشد عندما شرح فن الشعر لأرسطو. وهذا يجرنا إلى التساؤل عن القارئ المستهدف، القارئِ المفترض الذي تتوجه إليه قصة بورخيس. لمن يا ترى كتبها؟ قطعا ليس للقارئ العربي، وإنما للقارئ، لنقل الغربي، المتشبع بالثقافة الأوروبية، مع اهتمام ضمني بل مكشوف أَوْلاهُ للمستعرِبين الذين أحال إلى أربعة منهم في النص. وحسب علمي لم يول الدارسون الغربيون كبير عناية لهذه القصة، وبورخيس نفسه لا يكاد يشير إليها في حواراته، بحيث يظل وضعها في كتاب الألِف هامشيا. ذلك أنه إذا استثنينا المستعرِبين، ستغيب عن القارئ الغربي، أو غير العربي، العديدُ من الإحالات الأدبية، بل كل الإحالات المذكورة بدون استثناء، فهو لم يسمع أبدا بالمعلقات، بابن قتيبة، بمَتَّى بنِ يونس الذي نقل فن الشعر إلى العربية، بالخليل الفراهيدي، صاحبكتاب العين، عنوان ذكره بورخيس كما هوQuitab-ul-ain ، لكن بدون عين، ولم يسع إلى ترجمته لقارئه، ولعمري هل بالإمكان نقله إلى لغة لا يوجد فيها حرف العين.
لا أقصد أن هذا يقلل من قيمة استقبال القارئ غير الملم بمثل هذه الأسماء والعناوين، فكونها غريبة ولا تحيل إلى شيء مضبوط تجعلها ربما قمينة بخلق جو من الغموض المشوب بالشاعرية. لن تكون قراءته قطعا ضعيفة أو أقل شأنا من تلك التي يقوم بها القارئ العربي، ستكون فقط، من عدة جوانب، مختلفة. فبصفة عامة سيمر على الإحالات العربية مر الكرام قائلا لنفسه: هذه أشياء تخصهم، لا تهمني معرفتها، ليست معرفتها لازمة أو قضية مستعجلة. كان هذا حالَ ابن رشد وهو يشرح كتاب الشعر لأرسطو: لم يفهم أغلب العناصر اليونانية الواردة فيه، فأعرض عنها قائلا: «وسائر ما يُذكَر فيه أو جُلُّه مما يخص أشعارَهم وعادتَهم فيها». وعلى هذا النحو سيقبل القارئ الغربي على قصة بورخيس كما أقبل ابن رشدعلى فن الشعر، هو الذي لم يكن يعرف شيئا عن الأدب اليوناني.
كمثال على المسافة الفاصلة بين القارئ والأدب الأجنبي، يمكن أن نورد عبارة قصيرة جاءت في خاتمة قصة أخرى، ذات طابع أيضا عربي، لبورخيس، «الملِكان والمتاهة» (ضمن كتاب الألف): تحدث فيها عن شخص مات عطشا في قلب الصحراء، وختمها بقوله: سبحان الحي الذي لا يموت. جملة تبدو بسيطة، عادية، ولكن بورخيس أحس بالحاجة أن يضيف في الهامش: «كتبت السطر الأخير لأنه غني عن القول إن نصا إسلاميا يجب ان يحيل باستمرار على الله». يقول بورخيس ما هو غَنِيّ عن القول لكي ينأى بنفسه عما قال، وقصده: تلك عادتهم، ذلك شأنهم.
دون شرح ملائم، لن يفطن القارئ غير العربي لدلالة الإشارات والتلميحات العربية في «بحث ابن رشد». وفي هذا السياق لنتساءل عن علاقة بورخيس باللغات، وعلى الأخص باللغة العربية. كان بطبيعة الحال يعرف الإسبانية، وأيضا الإنجليزية (جدته إنجليزية)، وكان يتقن الفرنسية والألمانية. كان يعيش بأربع لغات. أما العربية… في قصيدة له بعنوان «ماذا سيحدث للمسافر المتعب؟» (1980)، أثار انتباهي بيت نادر مبهَم: «بأية لغة سيكون علي أن أموت؟» تساءلت طويلا عما يقصد بهذا الكلام؟ قد يكون معناه: بأية لغة سيفاجئني الموت؟ وقد يكون: بأية لغة يجب أن أموت، ما هي اللغة التي من واجبي أن أموت بها؟ حسم بورخيس الأمر جزئيا حين أضاف مُخمِّنا: هل ستحضرني إذ ذاك الإسبانية أم الإنجليزية؟ ذَكَر اللغتين العزيزتين عليه والأقربِ إلى قلبه. لكن الغريب في الأمر أنه لن يموت بأية واحدة من اللغتين، لا بالإسبانية ولا بالإنجليزية، ناهيك عن الفرنسية والألمانية. سيموت بلغة خامسة لم تخطر على باله حين طرح السؤال على نفسه سنة 1980، لغة لم يكن وهو ينشئ قصيدته يتوقع أو يحدس أنه سيموت بها، لغة جديدة سيتاح له تعلمها. أية لغة يا ترى؟ اللغة العربية.
لم يكن حينئذ يعرفها (طبعا كان في بعض الأحيان يذكر كلمات أو عناوين بالعربية)، شرع في تعلمها سنة 1986، سنة موته، وقد بلغ من العمر السابعة وثمانين. قيل إنه تعلمها ليقرأ كتاب ألف ليلة وليلة في النص، وهو كما تعلمون كتاب مؤذ، بل كتاب قاتل، يُعرِّض المقبل عليه لا محالة للخطر. تعلم بورخيس العربية وتوفي أو، ربما على الأصح، تعلم العربية فتَوفَّى. قيل إنه خاض غمار تلك التجربة رغبة منه في إدراك سر الكتاب السحري، سر اعتقد أنه لا يمكن التوصل إليه إلا بالعربية. من المعلوم أنه كثيرا ما تحدث عن اللياليفي قصصه وشعره ومحاولاته النقدية، لكن بقي مع ذلك في نفسه شيء من حتى، والعبارة مناسبة هنا (قالها سيبويه أو الفراء في سياق نحوي، و«حتّى» كما هو معلوم حرف يدل على الانتهاء، إلى أن، أي انتهاء الغاية الزمنية، في حالة بورخيس حتى الموت). الحاصل أنه شعر ذات يوم أن لا بد له من تعلم اللسان العربي، غدا تحصيله ضرورة قاطعة. بدا له هو الكنز الذي وُعِد به وظل يبحث عنه طيلة حياته.
ها هو يدرس اللغة التي يجمل به أن يموت بها، ها هو على وجه الاستعجال يسعى إلى الإحاطة بها، ولا شك أنه أحرز تقدما ما، لكن الموت عاجله في وقت كان قاب قوسين أو أدنى من قراءة الأدب العربي مباشرة. حين صارت اللغة متاحة، لم يرحمه الموت، لم يُتِح له فائضا من العيش لتحقيق مراده. وفي هذا المضمار من المثير للاهتمام الإشارة إلى تجربة مماثلة عاشها فيما قبل، عندما عُين مديرا للمكتبة الوطنية ببيونيس أيريس (1955)، كان هذا بالنسبة إليه شيئا عظيما وتجسيدا لأمنية لا شك أنها كانت عزيزة عليه (لنتذكر ما كتب عن مكتبة بابل وشغفه بالمكتبات)، لكن حلمه تحقق في الوقت ذاته الذي فقد فيه البصر. ها هو كمدير مكتبة يشرف على ما لا يحصى من الكتب، ولكن لن يتسنى له أبدا أن يقرأها. وضع مذهل ومأساوي أن مُنح مع العَمى تسعمائة ألف كتاب. أشار إلى ذلك في «قصيدة الهِبات»، فكتب أن القدر، بسخرية رهيبة، وهب له «في آن واحد، الكتب والليل».
سخرية القدر هذه تتكرر في قصة ««بحث ابن رشد» حيث يصور بورخيس فيلسوفَنا وهو يتطلع جاهدا إلى إيجاد مقابل لكلمتي طراغوديا وقوموديا. لن يفهم دلالتها، لن يراها، وأؤكد هذه الكلمة بالذات لأن موضوع العين ذو أهمية قصوى في القصة. ذكرت قبل قليل كتاب العين للخليل، ولقد أُطلِق عليه كما قلنا هذا العنوان لأن مؤلفه جعل حرف العين أول الكتاب، لكن ألا تتبادر إلى ذهن القارئ، وربما لأول وهلة، العين المبصرة؟ قد يبدو هذا الكلام إسرافا في التأويل، لا أنكر ذلك، ولكن موضوع النظر، أوالعين، الرؤية وعدم الرؤية، يلفت الانتباه في القصة. إضافة إلى بيت زهير عن المنايا خبط عشواء تَشَبُّها لها بالناقة الضالة في الظلام الدامس، أحال بورخيس على الجاحظ (لجحوظ عينيه)، وعلى بنِ سيدة اللغوي الأندلسي الذي كان أعمى، وعلى ابن شرف القيرواني صاحب مسائل الانتقاد، الذي لم يكن سوِيَّ العين، أسوة بمنافسه الشرس، ابنِ رشيق، صاحبِ العمدة.
سبق أن أشرت إلى هذا في بحث سابق لي، لكن السؤال الذي أود طرحه الآن، والذي ربما غفل عنه شراح بورخيس هو: هل بمحض الصدفة أن قسما كبيرا من المؤلفين الذين ذكرهم يعانون من عاهة أو مشكل في العين، أم أنه كان واعيا تماما بهذا وأن الأمر كان في حساباته؟ أرجح أنه لكونه لم يعد يبصر، أو ضعُف بصرُه، انتبه بالضبط إلى هؤلاء المؤلفين، وأن اختياره وقع عليهم لملاءمة وضعهم مع المعنى العام الذي قصده في القصة، أي العمى الذي أصاب ابن رشد أثناء قراءته لِـ فن الشعر، فلم يتبين دلالة طراغوديا وقوموديا، كلمتين تردان كثيرا في الكتاب.
من المؤكد أن بورخيس بنى قصته حول النقل الخاطئ لابن رشد، موحيا أن شارح فن الشعر هو المسؤول عن سوء الفهم، بينما الواقع أن المسؤول هو من قام بترجمته، أي النِّسطوري متَّى بن يونس بما يقرب من قرنين قبل ابن رشد. ابن رشد كان في الواقع ضحية الترجمة الخاطئة لمتى بن يونس.
لكن بورخيس نسب الخطأ إلى ابن رشد لأنه بنى ضمنيا قصته على فكرة كافكا أن من نبحث عنه بعيدا يقطن قربنا. وهكذا صوره مشغولا بالبحث عن معنى المأساة والكوميديا بينما كان يجهل المسرح، والمقصود المسرح كجنس أدبي، كنص يُجسَّد وقد يُكتب ويقرأ، أي المسرح كجنس أدبي كما وصفه أرسطو. صور بورخيس ابنَ رشد في مكتبته يبحث عن معنى الكلمتين و«يقول لنفسه (دون أن يصدق ذلك أكثرَ من اللازم) إن ما نبحث عنه يكون في أغلب الأحيان في متناولنا» (لم يذكر بورخيس المصدر الكافكاوي لهذا الكلام). ثم صور ابن رشد ينظر من شرفته إلى أطفال صغار يلعبون تحت ويقومون بتقليد أحد المشاهد[1]. لم ير ابنُ رشد الصلة بين نشاط الصبيان وما تحدث عنه أرسطو. لم يفطن لتعطُّل بصره فالتحق بالعُميان أو شبهِ العميان الذين جرى ذكرهم.
كان من المنتظر (بالنسبة لي، وربما بالنسبة للقارئ العربي بصفة عامة) أن يذكر بورخيس ضمن فئة هؤلاء، لا أقول بشار بنَ برد، وإنما أبا العلاء المعري، أقربَ الأدباء العرب إليه، إذ تجمعهما أمور كثيرة، من بينها العمى، والارتباطُ الشديد بالأم، والتقززُ من الإنجاب، والارتيابُ الساخر، وتكريسُ العمر للأدب دون الالتفات إلى شيء آخر. وزيادة على ذلك، أو غير بعيد عن ذلك، ألم يكن أبو العلاء كافكاويا بمعنى ما؟ على الأقل حين قال في إحدى قصائده:
ولَدَيّ سِرّ ليسَ يمكنُ ذكـرُهُ يخفَى على البُصَراءِ وهوَ نهارُ
لن يبوح أبو العلاء بسره، وهذا ربما ما يفسر تعلق القراء، أو بعضِهم، به. والمفارقة أنه سر واضح وضوح النهار، ومع ذلك لا يراه أحد. إن كان للكلام معنى فأبو العلاء، رغم عماه، هو المبصر الوحيد. قراءه المصابون حتما بالعمى بحيث لا يلمحون سره، يعكسون تماما ابنَ رشد الذي فقد الرؤية لما تصدى لتفسير فن الشعر.
لم يقتصر صمتُ بورخيس عن أبي العلاء على قصة «بحث ابن رشد»، بل لم يذكره في محاضرته التي تحت عنوان «العَمى»، لم يذكره مع هوميروس وديموقريطوس وميلتون، ولا توجد إشارة ولو عابرة إليه في كل ما كتب. لا يجوز الاعتقاد بأنه لم يسمع به، ذلك أنه قرأ كتاب المستعرب الإسباني أسين پلاثيوس، الذي خصص فيه فصلا عن علاقة رسالة الغفران ب الكوميديا الإلهية لدانتي (علم الأخرويات الإسلامي في الكوميديا الإلهية، 1919). قرأ بورخيس هذا الكتاب، بل أورده كمرجع في نهاية «بحث ابن رشد». ما هو إذن سر صمته عن أبي العلاء؟ يقتضي ذلك بحثا آخر.
[1] لماذا اختار بورخيس أن يصور الأطفال الصغار وهم يمثلون طقس الصلاة؟ كان بالإمكان أن يصورهم في مشهد آخر، فما هي الضرورة البنيوية التي جعلته يركز على الصلاة؟
الورقة التي قرأها د. عبدالفتاح كيليطو في افتتاح مهرجان “رحلة المعنى” بمناسبة السنوية الثالثة لمكتبة تكوين، بتاريخ 7 مارس 2019.