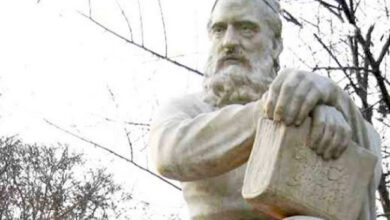بحثاً عن إبدال أدبيّ

ما الذي يجمع المشتغلين بالأدب اليوم؟ سؤال لا نطرحه عادة، وحين لا يجمع بين المهتمين في أي حقل من الحقول المعرفية نسق معرفي محدد، يفكرون جميعهم في نطاقه، وكل حسب اختصاصه، فليس لذلك من معنى سوى هيمنة التسيب.
يعود الفضل في ميلاد هذا المفهوم إلى توماس كون الذي انطلق من أن العلوم لا تتطور بسبب ما تراكمه من اكتشافات واختراعات فردية، لأن كل علم يتطور حسب إبدالات غير قابلة للقياس. وهذه الإبدالات ليست سوى مجموعة من القواعد الضمنية أو المباشرة التي توجه البحث العلمي، في زمن ما، محفزة على أساس معارف يقر بها المجتمع العلمي، على اتباع طرائق معينة في طرح الأسئلة، وإنجاز الأبحاث للوصول إلى نتائج».
أجدني كلما قرأت دراسة، أو كتابا في النقد الأدبي العربي المعاصر، أتساءل ما هو الإبدال الكامن وراء هذا العمل؟ وما الذي يجمعه مع الدراسات التي تدور في الفلك نفسه؟ وغالبا ما لا أجد هذا الانخراط في الوعي المعرفي الذي يمكننا من التفكير الجماعي، بأسئلة محددة، بحثا عن أفق جديد للنظر والعمل. ولعل «الإبدال» المركزي الذي بات يهم الكثيرين، وهناك استثناءات، هو النشر، وحضور المؤتمرات، والحصول على الترقيات. لا أظن أن عز الدين إسماعيل، ولا محمد مفتاح مع فئة قليلة من معاصريهما، كانوا منشغلين بما يهتم به الأكاديميون أو نقاد الأدب اليوم. بدون خلفية معرفية محددة ينطلق منها الباحث في تعامله مع النص الأدبي لا يمكن إنتاج المعرفة الأدبية.
كثيرا ما نتحدث عن التحليل والبحث والأطروحة، ولكننا لا نجد وراء الأكمة ما وراءها. لقد بات الاستسهال وعدم المسؤولية، وانعدام المحاسبة إبدالا شائعا في كل شيء، من السياسة إلى الدراسة، ومسؤولية السياسات «غير السياسية» في التعليم والتربية، كبيرة في تركيز قيم لا علاقة لها بالعمل الجاد، ولا بالأخلاق العلمية. عندما أتذكر فترة السبعينيات والثمانينيات، وأنا أتذكرها الآن ليس من باب الحنين، ولكن من الرغبة في إعادة قراءتها نقديا، أجد أننا كنا نفكر، رغم الاختلافات، وفق إبدال معرفي مشترك، هذا الإبدال له خلفية سياسية، وهم اجتماعي، وقلق فكري وأدبي وجمالي.
كيف يشتغل الباحثون العرب المعاصرون بالسياسة والاجتماع والفكر؟ وما هو الإبدال الفكري الذي ينطلقون منه الآن في تحليل الواقع السياسي والاجتماعي والفكري العربي؟
ما هي الخلفية السياسية التي تجمع الآن بين المشتغلين بالسياسة والأدب؟ ما هو الهم الاجتماعي الذي ننطلق منه في البحث في النص الأدبي؟ وما هو القلق المعرفي والجمالي الذي يوجه الدراسات الأدبية المعاصرة؟ أسئلة كثيرة تفرض نفسها، ونحن نقارن بين الفترات التي ازدهر فيها الإبداع الأدبي العربي بعد هزيمة 1967، وارتقى فيها الدرس الأدبي. لا أحد ينكر علاقة الأدب بالسياسة، ولا بالاجتماع ولا بالفكر. كل هذه المجالات معنية بشيء واحد هو التقدم، بل إنه هو ما يوحد كل الممارسات التي يقوم بها الإنسان، وهو أيضا، ما يجمع بينها كلها، من خلال ربطه إياها بالعلم الذي أبان أنه تخلص بصورة كبيرة من أغلب العوائق التي تحول دون تحصيل المعرفة العلمية.
ما دمنا ربطنا الأدب بالسياسة والاجتماع والفكر، يحق لنا التساؤل: كيف يشتغل الباحثون العرب المعاصرون بالسياسة والاجتماع والفكر؟ وما هو الإبدال الفكري الذي ينطلقون منه الآن في تحليل الواقع السياسي والاجتماعي والفكري العربي؟ على اعتبار أن ما يمكن أن يكون رائدا في بعض هذه المجالات، بسبب ما حققه من تطور في فهم الظواهر وتفسيرها، يمكن أن يكون مثالا تسترشد به باقي المجالات؟ ما قلته عن الدراسة الأدبية، وغياب إبدال معرفي جامع ينسحب بصورة كبيرة على العلوم السياسية والاجتماعية والإنسانية. إنها جميعا تعيش التسيب نفسه، وكل يتحدث في الفكر، وفي الاجتماع، وفي السياسة حسب هواه. وماذا عن الدراسات الدينية واللغوية؟ وقد صارت رجز البحث، على غرار بحر الرجز عند الشعراء، حيث كل من يتحدث فيهما صار عالما ومختصا في الدين واللسانيات.
إذا لم تمكنا العلوم الاجتماعية والإنسانية التي يشتغل بها العرب المعاصرون، ونحن نتساءل عن الإبدال الأدبي، من تقديم النموذج الذي يحفزنا على التفكير في الأدب، وعلى اتباع طرائق محددة في طرح الأسئلة بحثا عن الأجوبة، لنتساءل ما هي المنجزات العلمية والمعرفية التي يقدمها لنا المشتغلون في كليات العلوم والتقنيات العربية المعاصرة، وهي التي ندعي «علميتها»، و«نموذجيتها»، ونعطيها الأسبقية على ما عداها من الاهتمام والدعاية، ومن الدعم المادي؟ ما هو الإبدال الذي يفكر في إطاره علماؤنا في العلوم الطبيعية، وماذا يقدمون لنا ـ نحن المشتغلين بالأدب؟ يمكننا تعداد الأسئلة بخصوص علاقات مجالات الدراسة والبحث، وغياب الإبدال الجامع بينها، لنؤكد أن العمل الفردي ما يزال مهيمنا، وأن الحديث عن المختبرات ومراكز البحث ليس سوى ذريعة لادعاء التجديد، وتقديم الاعتمادات التي تصرف في ما لا يفيد ولا يعود بأي نتيجة على المجتمع، عامة والمجتمع العلمي الذي لم نوفر مستلزماته وجوده. إذا كان تطور الإبداع رهين تطور الدراسة، ففي تغييب سؤال الإبدال الأدبي لا يمكن تطوير الدراسة الأدبية ولا الإبداع، وسيظل العمل الفردي خاضعا للأذواق، والأهواء.