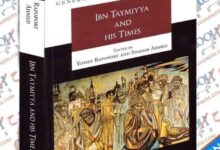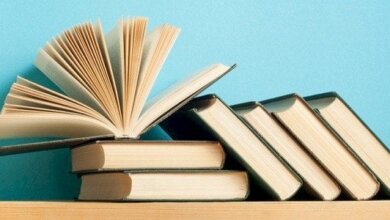الأستاذ أحمد اليبوري والنقد الروائي
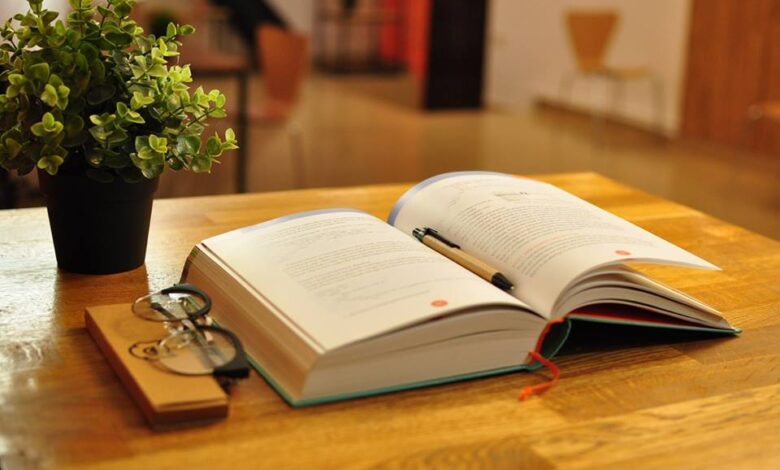
صدر للأستاذ أحمد اليبوري عن شركة النشر والتوزيع ” المدارس” كتاب بعنوان: “في الرواية العربية، التكون والاشتغال”. وهو كتاب في النقد الروائي يتناول فيه مجموعة من الظواهر السردية كما تحققت في النصوص الروائية العربية بشقيها المغربي والمشرقي.
ويتوزع الكتاب على ثلاثة أجزاء: تناول في الجزء الأول منه مجموعة من القضايا الخاصة بملابسات النشأة والتطور. وتناول في جزئه الثاني قضايا نصية ذات طبيعة تكوينية لها علاقة بالبناء الداخلي للنص الروائي. وفي جزء ثالث تناول بالتحليل ثيمتا ” الحرية” و” الوعي القومي” في مجموعة من النصوص الروائية في المغرب والمشرق، وهي دراسة لا تبحث في جوهرالثيمات بل تناقش ما سماه المؤلف ” اشتغال الأطروحي”.
ولن نقدم في هذا العرض المختصر وصفا شاملا للكتاب، فالكتاب موجود وفي متناول القراء ولهم وحدهم الحق في إنجاز قراءاتهم الخاصة. وسنكتفي من جهتنا بتقديم بعض الملاحظات الخاصة بالأسس المعرفية التي يستند إليها اليبوري في تناوله للقضايا النصية التي تثيرها الرواية العربية.
وهي قضايا، نعتقد من جهتنا، أنها تشكل الإضافة الحقيقية التي جاء بها الأستاذ اليبوري في هذا الكتاب.قد يوحي العنوان بأن الكتاب يقدم بانوراما شاملة عن الرواية العربية وعن قضاياها العامة والخاصة من زاوية تعيد إنتاج السائد من الأفكارالنقدية الجاهزة، كتلك التي تتحدث عن النشأة والتطور والثيمات العامة والخاصة، وكذا عن بعض القضايا المرتبطة بالبناء الهيكلي للرواية كالتجريب والسرد الكلاسيكي أوالسرد الواقعي، وما إلى ذلك من المفاهيم السهلة التوظيف والتداول الخ.
إلا أن الأمر ليس كذلك. فالغاية من هذا الكتاب، في تصوري على الأقل، هي محاولة لإعادة الاعتبار لما تم إهماله من طرف الدراسات النقدية التي ظلت تلهث وراء أحكام تصنيفية غالبا ما كانت تفقر النص عوض أن تكشف عن دلالاته.
لهذا فهو لا يدعي أنه يقدم في هذا الكتاب قراءة شاملة تقوده إلى الإمساك بكون دلالي، أو أكوان دلالية مثبتة في بنيات سردية-خطابية بشكل نهائي وكلي. على العكس من ذلك، فالمؤلف يقترح علينا قراءة مهمتها إثارة الانتباه إلى العناصر التي يصفها النقد عادة ب”الجزئية” و”الهامشية” و”الثانوية”، وهي عناصر لا تدخل ضمن البنية الكبرى للنص الروائي.
فالنقد ” الشمولي” يرى في هذه العناصر أثاثا تكميليا أو تزيينيا أو مجرد ملء لكون في حاجة إلى أشياء الحياة لكي يكتسب صفة الواقعية والمقبولية. أما البنية الدلالية الأساس بحصر المعنى فهي في مكان آخر، إنها في البنيات الكبيرة التي يقع على عاتق النقد تجلية جوهرها وتحديد أبعادها.
وهذا بالذات ما يرفضه الأستاذ اليبوري، ويرفض أن يعيد كتابة تعاليق عامة قد تصدق على كل النصوص. ومن هنا فإن تصوراته التي قدمها لنا في هذا الكتاب تبدو وكأنها تسير ضد السائد من الأحكام النقدية، فهي تعيد النظر في التصنيفات السابقة كما تُنَسِّب الأحكام النقدية التي غالبا ما تهمل عناصر كثيرة من أجل الوصول إلى هذا الحكم أو ذاك.
وتلك هي المبادئ التي سيستند إليها في تناوله لمجمل القضايا التي تطرحها الرواية العربية بشقيها المغربي والمشرقي. فهو لا يعرض لنظريات كبرى، ولكنه يكتفي بتقديم تصورات عامة يلتقط من خلالها بعض المحاور المعرفية الأساس تاركا للقارئ فرصة استكمال البناء النظري المفترض من خلال هذه القضايا ذاتها.
وعبر هذه المحاور، أو استنادا إلى بعدها التطبيقي، يتناول بالتحليل مجموعة من الروايات استنادا إلى سلسلة من الافتراضات الأولية الضمنية الخاصة بالبناء الدلالي في تعدده وغناه. وبعبارة أخرى، إنه يقدم لنا فرضيات للقراءة أو تساؤلات أولية حول المعنى تعد في نظره الأساس الذي سيستند إليه من أجل الإمساك ببعض المسارات التدليلية داخل النص الروائي. ولهذا فإن التحليل الذي يقدمه ليس “تحليلا جامعا مانعا” يستعيد من خلاله أحكاما جاهزة أو انفعالات ضحلة تخص مجموع الكون الدلالي الذي يُفترض أن الراوية تختزنه.
إن التأويل، كما يبدو من خلا ل النماذج التي يقدمها، هو إجراء انتقائي، والانتقاء هو تفضيل مسارات على أخرى ( انظر مثلا دراسته للطبيعة في نجمة أغسطس لصنع الله ابراهيم). وقد يكون الانتقاء هو الفرصة الوحيدة التي قد تمكننا من الاقتراب من البنية الدلالية للنص الروائي، إذا أمكن الحديث فعلا عن بنية دلالية واحدة تستوعب مجموع عناصرالنص.
ولهذا فإن التحليل الذي يقدمه الأستاذ اليبوري هو تحليل جزئي – بالمعنى النبيل والإيجابي للكلمة – إنه يتصف بالجزئية لأنه لا يعترف بكلية التحليل، والسبب في ذلك واضح فلا وجود لكلية في التمثيل أيضا. وهو بهذا الاختيار فهو يسير في الاتجاه المعاكس لمجموعة كبيرة من الدراسات النقدية الخاصة بالرواية. فمن المعروف أن التيار الغالب في الدراسات الأدبية ينطلق، في غالب الأحيان، من مسلمة، تقول بإمكانية التناول الشمولي للنص الروائي.
ولقد ساد الاعتقاد طويلا، ومازال، أن بإمكان النقد / الناقد أن يتناول بالتحليل نصا روائيا في كليته محاولا الإمساك ب” دلالاته العميقة”، استنادا إلى نوع من الحدس الصوفي. وهو اعتقاد أثبت تاريخ النقد نفسه عدم صحته، ولم يؤد في غالب الأحيان إلا إلى إنتاج أحكام عامة لا تعرفنا بالرواية ولا تزيدنا معرفة بثقافتنا.
فلاشعور النص لا يسكن البنيات الكبرى، إنه غير مرئي لأنه يعشش في العناصر الهامشية ” غيرالأساسية ” لذلك فإن الأستاذ اليبوري يعتبر أن “كل قراءة للأعمال التخييلية من خلال خطابها المباشر، تبدو تجزيئية من جهة لأنها تغفل العناصر الرمزية ذات الطابع الإيديولوجي الكامنة في صلب النص، وسطحية من جهة ثانية لأنها تهتم بالمستوى الأفقي الذي يحيل العمل الروائي إلى مجرد خطاب استدلالي” ص 137 إن النص، في ضوء ذلك، ليس وحدة مطلقة الوجود، إنه كذلك من خلال أجزائه.
وما دام الموضوع ليس واحدا فليس من السهل أن نتحدث عن فعل تمثيلي قادر على احتواء التجربة في كليتها. فما يستوهي الأستاذ اليبوري في النص ليس وحدة شاملة مزعومة، بل أجزاء تؤكد تشظي وتفكك التجربة الإنسانية ذاتها.وهذا ما يوضحه في مدخل أغلب التحاليل التي أنجزها حول النصوص الروائية من خلال تشديده على ما يسميه “المكونات الصغرى في النص الروائي”.
ولقد كان هدفه من التركيز على هذه المكونات الصغرى هو ” إثارة الانتباه إلى الفرق القائم بين الكلية البنائية النصية والانسجام الدلالي، كل ذلك في إطار إدراك أدق وأعمق لخصائص الرواية كمنظومة معرفية واستطيقية في آن واحد ” ص 70 ( التشديد من عندنا).
إنه إحالة ضمنية على حالة التشظي التي تحكم التجربة الإنسانية، وهو أيضا إشارة إلى الفكرة القائلة بأن فرضية القراءة التي يستند إليها القارئ من أجل إنجاز تأويلاته، فرضية غالبا ما تستند إلى معطى قبلي يمثل على شكل أسئلة توضع على النص كما يقول إيكو.
وعلى هذا الأساس، فإن التأويل ليس كشفا لمعنى استنادا إلى حدس لا يتوفر عليه إلا قلة من الناس، بل هو في المقام الأول صياغة جديدة للقصدية التي ولدت النص، أو هو، بعبارة أخرى، بحث عن علاقات جديدة لا يمكن أن تكون معطاة من خلال التجلي النصي المباشر.
فالوقوف عند الوصف الخارجي، معناه ” تهميش عناصر تمثل المهاد الداخلي للنص الروائي “. ص 116وليس غريبا أن تكون أغلب عناوين الفصول التحليلية إحالة على قضايا نصية ذات صلة بالبناء الشكلي لا على أحكام تأويلية. فكل عنوان هو سؤال موضوع على النص، وهو أيضا توجيه للقراءة وتحديد لمساراتها المقبلة.
أما البحث عن الآثار المعنوية المتولدة عن هذه التقنية السردية أو تلك، فلا يأتي إلا لكي يدعم منابع النهر الكبير، أي البناء النصي في كامل تجلياته. فالبناء النصي، من خلال مكوناته المتعددة، ليس عرضيا، إنه هو ما يؤسس المعنى، أو هو، بشكل من الأشكال، معنى المعنى.
لهذا فهو يختار منذ البداية البحث في عناصر لا تعتبر ذات أهمية في التاريخ العام للرواية، وهذا الموقف هو الذي يفسر عدم اهتمامه بالكليشيهات التي تعج بها الكتب التأريخية كتلك التي تتحدث عن السبق الزمني، أو معركة الريادة، أو تتحدث عن أمير للرواية العربية.
لقد حاول أن يفهم فقط لماذا ظهرت الرواية في أقطار دون غيرها، ولماذا كانت نشأة الرواية نشأة ملتبسة: فهي ارتبطت في ظهورها تارة بالفكر العقلاني العلماني الذي تبرأ من التراث بكل إرغاماته ( فرح أنطون المنظر والمبدع)، وارتبطت تارة أخرى بالفكر السلفي الإصلاحي الديني ( المويلحي وحديث عيسى بن هشام ).
ومن خلال هذين النموذجين بالذات حاول الأستاذ اليبوري أن يجد تفسيرا للنشأة في الحالة الأولى، وأن يجد ما يفسرها في الحالة الثانية. ولقد قام بذلك استنادا، في غالب الأحيان، إلى نصوص المبدعين أنفسهم، لا من خلال تصريحاتهم ولا من خلال ما قالوه، بل بحث عن ذلك فيما لم يقولوه، أو في ما قالوه بشكل ضمني أو بشكل ملتبس.
لهذا فإن كتابته لهذا الفصل كانت مكثفة ومختصرة، لأنها في تصوري، كانت تفترض أن القارئ المختص ملم بتاريخ الرواية العربية وتاريخ نشأتها، أو على الأقل يمتلك من المعلومات ما يسمح له بفهم ما يود المؤلف قوله.
وبما أن الأمر لا يقتصر من جهة ثانية، على تحديد نص روائي ووضعه ضمن حلقة زمنية تجعل منه نقطة الانطلاق وبداية التأسيس، بل يتعلق أيضا برصد كل الظواهر المصاحبة لتكون هذا النص وإعلانه عن نشأة نوع أدبي لم يكن معروفا بشكله الأكمل قبل هذه المرحلة، فإن الأستاذ اليبوري يقدم سلسلة من المكونات التي نشأ في أحضانها هذا النوع.
ذلك أن الأمر لا يقف عند حدود الإعلان عن ميلاد نوع أدبي، بل هو في العمق محاولة للإمساك بجوهر لحظة حضارية كانت تؤثر في اللغة والمتخيل والسلوك الجمعي.
وفي هذا المجال يتحدث الأستاذ اليبوري عن المكون اللغوي والمتخيل الروائي والمثاقفة باعتبار هذه المكونات هي ما يشكل، في الأساس، مؤسسة الرواية المرتبطة بدورها ” بمؤسسة ثقافية كانت آخذة في التشكل، ساعية إلى فرض أنماط سلوكها وتفكيرها على فئات واسعة من المثقفين.
ومن أهم علامات هذه الظاهرة بروز محفل للتلقي عمل بوسائل مختلفة، بوسائل غير مباشرة في أغلب الأحيان، على تكييف الإنتاج الروائي وتوجيهه وفق الذوق الأدبي الجديد والحساسية الأدبية الجديدة ” الكتاب ص 19وهذا أيضا ما يتضح من خلال اختياره لقضايا نظرية بعينها من جهة، ومن التبريرات التي يقدمها لهذا الاختيارمن جهة ثانية.
فتناوله ل” الانشطار الروائي” مثلا لم يكن ترفا فكريا يبحث فيما لم يبحث فيه الآخرون، بل كان نتيجة لتصور مسبق عن الأبعاد الرمزية ل ” ما يسميه ” البقايا” أو ما شابهها في النص الروائي. وهذا يدعم أيضا ما ذهبنا إليه سابقا من أن التأويل يحتاج إلى الانتقاء السياقي، والانتقاء السياقي كما هو معروف، تأويل للعناصر من خلال إعادة تعريف موقعها ضمن هذا النسق أوذاك.
“فخلافا لما تم تداوله منذ الشكلانيين الروس، وخاصة منذ تنظيرات ياكبسون حول الشعر والنثر السردي، فإنه يمكن اعتبار العلاقات بين مكونات الرواية، أحيانا كثيرة، قائمة على الانشطار والتفاعل، لا على مجرد التجاور الصرف، أي على علاقات بين أشياء متمايزة لكن بينها صفات مشتركة وأخرى ناتجة عن طابعها الانشطاري -الاستعاري”. الكتاب ص 61.
وهكذا يقدم لنا المؤلف فصلا كاملا يتناول فيه قضية الانشطار الروائي من زاوية نظرية تبدأ بتقديم مجموعة من التعاريف الخاصة بهذه التقنية السردية، ليقدم لنا في نفس الآن ثمان دراسات وكل دراسة تجسد شكلا خاصا من الانشطار.
فالانشطار في تصوره قد يكون مرآويا كما تجسده رواية ” حكاية المؤسسة ” لجمال الغيطاني، و”جنوب الروح ” للأشعري ، و” خميل المضاجع” للميلودي شغموم و”جارات أبي موسى” لأحمد توفيق. وقد يكون مجرد ” بقايا” منفلتة من البناء الكلي الظاهري للنص، كما قد يتحقق على شكل أساطير أو إحالات رمزية، أو وصف لأجزاء من الطبيعة أوآلة من الآلات.
ويقدم المؤلف بعض الروايات التي تعد نموذجا هاما لهذا النوع من الانشطار. وبالإضافة إلى الفهم الخاص الذي يقدمه الأستاذ اليبوري للانشطار باعتباره خاصية من خاصيات الكتابة المرتبطة، في حالتنا، بتقنية سردية لها علاقة بالطريقة التي يبنى من خلالها النص الروائي، فإن اليبوري يبحث عن صورة لاواعية لهذا الانشطار على مستوى الموصوف أو الممثل ذاته.
وهكذا فإن المؤسسة، ذلك الغول الذي يبلع أبناءه، لا تدرك آلياتها المدمرة إلا من خلال حالة الانشطار ذاتها. فالمؤسسة “جزئيات” و”بقايا”و”تفريعات”، و” مصالح” و” أفراد موزعون بين “الهنا والهناك”، وهذا ما يرصده الأستاذ اليبوري من خلال صياغة الغيطاني لدواليب الموسسة وفضاءاتها وأزمنتها أيضا.
فالتركيز على المؤسسة من خلال جزئيات حضورها في الحياة اليومية ” يعني في نظرنا تحولا على مستوى الوعي النصي الذي أمكن بواسطته تحديد الأطر الكبرى التي تعمل على إفراز الظواهر الجزئية والشعور بضرورة الانطلاق مما هو شمولي وجوهري إلى تمظهراته على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية “. ص 73 وبطبيعة الحال فإن هذه المحاولات التحليلية لا تفرز أحكاما، ولا تقدم أجوبة جاهزة عن أسئلة مصاغة بشكل قبلي، إنها فقط ترصد مسارات جديدة للتدليل لا يمكن للنقد الشمولي، في لهاثه وراء التصنيفات الكبرى، أن يستوعبها.
وأنا نفسي وقعت في هذا الفخ في دراستي لرواية حنا مينه الشراع والعاصفة، فقد أهملت الكثير من العناصر النصية ذات الدلالة البالغة، لأني كنت أبحث عن ” تأويل كلي” للنص، وهذا ما يشير إليه المؤلف في الصفحة 97. فالعناصر الأسطورية التي يحفل بها النص والتي لم أعرها اهتماما لم تكن تنويعا على ثيمة الشجاعة أو التضحية أو إشارة إلي خطورة الإبحار كما تصورت فحسب، بل تعد عنصرا مركزيا في فهم مجمل التحولات التي تطرأ على الشخصيات وأنماط سلوكها وعلى رأس تلك الشخصيات ” الطروسي، بطل الرواية.
لذلك فهذه المحكيات لها دلالة أساس عند اليبوري فهي ” تقوم على الخارق والصدفة وسرعة التحول والمفاجآت، والغريب، خاضعة في ذلك لقانون ضمني تشكلت وفق توجهاته، ولا يتمثل ذلك القانون في الانعكاس الذي يعتبر أن ” الرواية لا تخلق كونا يبدع علاقات جديدة، إنها تشرح كونا من خلال خلق سنن خاص: قصة السياسة هي الخالقة لقصة الطروسي، ” إن مثل هذه القراءة تتبنى، في نظرنا، تصنيفا جاهزا للرواية، وقراءة مسبقة وتحدد في نفس الآن سننا للتأويل انطلاقا من ذلك التصنيف “. ص 97.
من هنا لا يمكن تجاهل هذه ” البقايا ” ولا يمكن اعتبارها جزءا من “العناصر غير الدالية ” داخل الرواية ” فالمحكي المركزي لا تستقيم دلالته إلا في علاقته المتعددة بالمحكيات الأخرى التي تتداخل معه، وتكيفه وتلونه وتعيد بناءه، على رأسه المحكي العجائبي الذي يتمثل في حضور السندباد وملك البحر وعروسة البحر، لأنه رحم النص الروائي.” ص 98 وهو افتراض سيعمل على تأكيده من خلال دراسته “لنجمة أغسطس” أيضا.
وخلافا لمجموعة كبيرة من الدراسات التي اتجهت نحو التأويلات السياسية والإيديولوجية المباشرة لهذه الرواية من خلال تقديم ” قراءة كلية” تتوهم أن بإمكانها الإمساك بالقصدية العميقة للمؤلف، التقط الأستاذ اليبوري جزئية نصية نادرا ما تلتفت إليها الدراسات النقدية الكلاسيكية أو تلك التي تتوارى وراء مصطلحات حديثة لتخفي روحها التقليدية. ويتعلق الأمر بمقطع وصفي خاص بالطبيعة.
فالطبيعة بعناصرها وتحولاتها، حالة رمزية يتم من خلالها التعبير عن الحياة ذاتها: حياة السياسة والمجتمع والفرد، فما ” يلاحظ هو أن السارد الجيولوجي، الراصد لدرجات الحرارة وتمدد الصخر وانكماشه ركز على تحول ” المفكك” و” الرخو” …. وفي هذه الحالة بالذات من الوصف يتحول العالم الجيولوجي في نظرنا إلى إيديولوجي، وينتقل الخطاب من مستواه العلمي ” المتوهم ” إلى مستواه الفني رامزا بذلك إلى أن نفس القانون الطبيعي ينطبق على المجتمع “. ص 111.
وفي الفصل الأخير من الكتاب يختار المؤلف أن يدرس مجموعة من الثيمات، استنادا إلى المقترحات النظرية التي جاء بها بعض منظري رواية الأطروحة. وفي هذا المجال أيضا، فإن المؤلف لم يشرح لنا الثيمات ولم يقدم لنا تاريخا لها، إنه، على العكس من ذلك، اكتفى برصد نمط بنائها.
وهذه رؤية بالغة الأهمية في تصورنا. فالنص لا يخلق الثيمات ولا يبتدعها، ولكنه يخلق العلاقات الممكنة التي تقود إلى إنتاج هذه الثيمات وتنويع مضامينها. وتلك هي العقدة في كل بناء، ذلك أن المضمون ليس مادة مطلقة التكوين والوجود يتوجب علينا الكشف عن جوهرها. إنها شكل، أي مرتبطة في وجودها واشتغالها بسلسلة العلاقات التي ينسجها النص.
من هنا كانت صياغة العنوان ذاتها صياغة دالة، فالمؤلف لا يتحدث عن أطروحة جاهزة، بل يتحدث عما يسميه عن حق ” اشتغال الأطروحي” ص .124 لذلك، فإن المضمون العميق لهذه الدراسة يكمن في تجلية الترابط بين شكل الثيمة والبناء السردي الذي يحققها.
لذلك فإن هذه ” المقاربة ليست تأريخا لمختلف تجليات الحرية في نصوص روائية عربية بقدر ما هي محاولة لاختبار فرضية مركزية تتمثل في أن الوعي بالحرية وبالانتماء باعتبارهما ثيمتين أساسيتين، تساهمان في تحديد بعض العناصر البنائية في النص الروائي من خلال تقديم شخصيات لها سمات متميزة: ديكتاتور، مستعمر، وطني، مقاوم، متمرد… كما أنها، في ارتباط مع المكون الفكري، ترسم فضاءً ذا طابع خاص، وتوظف لغة ذات حمولة محددة ” ص 125.
ومن هذا المنطلق النظري العام يتناول المؤلف ثيمتين: الحرية والوعي القومي، كما تتحققان في مجموعة من الروايات العربية.
وهنا أيضا لم تكن غاية المؤلف هي الوصول إلى تصنيفات وأحكام تدين من تدين وتمجد من تمجد. لقد تساءل المؤلف كيف يمكن للرواية أن تستوعب، شكليا بطريقتها الخاصة، مجموعة من الثيمات ويكون لذلك أثر على بنائها الداخلي وصياغتها للقيم.
وهذا ما يتضح جليا من الخلاصة التي يقدمها في نهاية المقاربة، فقد اتضح له أن الروايات الأطروحية، شأنها في ذلك شأن كل الروايات التي تشتغل بإيديولوجيا جاهزة، ” تفقد في حديثها عن الحرية والقومية …. خصائصها البنائية الفنية، من ثم فإنها في شكلها العام، تقترب من الأسلوب الاستدلالي ذي الطابع السردي”.
دون أن يعني هذا الحكم أن كل روايات الأطروحة لا تتميز بأية جمالية. فقد قدمت لنا المدرسة الواقعية ممثلة في أرقى نماذجها قمما شامخة في الفن الروائي.
وفي ختام هذا العرض السريع يمكن تقديم ملاحظتين: – الملاحظة الأولى تتعلق بطريقة تصريف المؤلف للمخزون النظري المتضمن في صياغة الأطروحات التحليلية. فعلى الرغم من أن مجمل القضايا التي تناولها الأستاذ اليبوري بالدرس هي قضايا ذات أبعاد بنائية تحتاج إلى رصيد نظري هام يسعف على فك رموز البناء النصي من أجل البحث عن انسجامه الممكن، فإنه لم يثقل نصه بمصطلحية جافة بلا قلب.
فهو يعوض الحضور المصطلحي بتأويل ما يعود إلى تلك اللغة الواصفة من خلال وصف دقيق لعصب الكتابة وجوهرها. لذلك، فإن النظرية حاضرة بقوة في كل الدراسات الواردة في هذا الكتاب – فكل دراسة من دراساته هي في واقع الأمر جواب عن سؤال ضمني أو صريح – إلا أنه لا يفعل ما يفعله الذين يختفون وراء مجموعة من المصطلحات والمفاهيم معتقدين أن الناقد المسلح ب”النظرية الصحيحة” أو “المنهج الصحيح” سينتج نقدا عظيما.
والحال، كما يثبت ذلك الأستاذ اليبوري أن النقد إنتاج لمعرفة، وهذه المعرفة لا يمكن أن تستقيم دون استنفار ثقافة هائلة هي أساس مقاربة النص وفهم العوالم الدلالية القريبة والبعيدة التي يشير إليها هذا النص.
فالتأويل ليس شرحا للكلمات ولكنه إعادة لتنظيم العلاقات، أو هو الكشف عن علاقات غير مرئية من خلال التجلي المباشر للنص.- الملاحظة الثانية تتعلق بثقافة الناقد. ولقد أثبت الأستاذ اليبوري في كتابه هذا أن الناقد يحتاج أولا إلى ما كان يسميه ابن رشيق بالدُّربة، والدربة هي الصبر والجلد، ولا يتأتى ذلك إلا بالتمرس بالنصوص.
فالقراءة الواحدة وقول ما يرتضيه المبدع لا ينتج نقدا ولا يدخل ضمن الممارسة النقدية الجادة التي هي، في عرف الغربيين على الأقل، جزءا من الحركة الفكرية للأمة. ويحتاج في المقام الثاني إلى معرفة، أي إلى ثقافة، بالمفهوم الموسوعي للكلمة. فالناقد لا يرمم آلة، ولا يرقع حذاء، بل يدخل إلى نص حافل بالإحالات المتعددة الأصول والمشارب تختزن فيما تختزن روح الأمة ووجدانها.
لذلك فإن المصطلحات لا تنتج نقدا ولا نقادا، وكذلك هو الأمر مع الانفعالات الضحلة أو اللجوء، باسم حداثة مريبة، إلى كلمات ساقطة لتفسير نصوص أدبية من المفروض أنها تؤرخ لوجدان شعب.
إن القارئ لكتاب الأستاذ اليبوري يدرك ذلك جيدا، يدرك أنه استند في دراساته إلى خبرته الطويلة مع النصوص، واستند وهذا هو الأساس، إلى ثقافة واسعة لها علاقة بالمدارس النظرية في أصولها المعرفية العميقة، ولها علاقة بكل التراث الفكري لهذه الأمة، ” فالإبداع مرتبط، في شطر كبير منه بتقاليد الثقافة-الأم، وبأطرالإدراك الأصلية، وبالذائقة الجمالية الجمعية التي هي، في آن واحد، جزء من التراث ومن الذات المبدعة والذات المتلقية في تشبعهما العميق بذلك التراث ” ص 72.